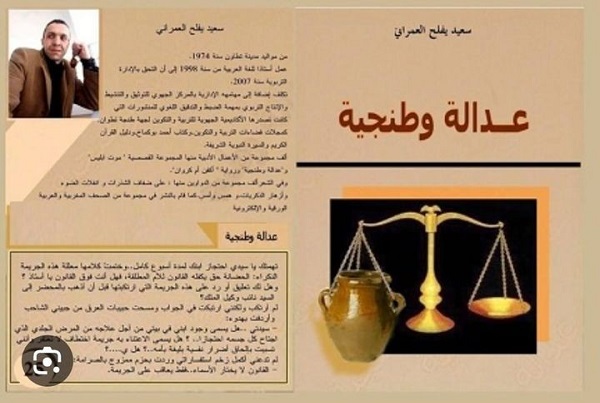صحيفة المثقف
منى زيتون: إصلاح التعليم في مصر
 يقولون إن الجهل هو أس البلاء، ولكني أرى أن الفساد هو رأس الأفعى الذي يقف أمام تطور أي مجتمع، بل ويعيده عقودًا إلى الوراء، والتعليم ذاته هو مما يفسد بفساد المجتمع، فيصبح الجهل في المجتمع مستترًا بأوراق لا قيمة لها، يحملها من لا يستحقونها، وتتحدد درجة وقيمة الفرد في المجتمع على أساسها.
يقولون إن الجهل هو أس البلاء، ولكني أرى أن الفساد هو رأس الأفعى الذي يقف أمام تطور أي مجتمع، بل ويعيده عقودًا إلى الوراء، والتعليم ذاته هو مما يفسد بفساد المجتمع، فيصبح الجهل في المجتمع مستترًا بأوراق لا قيمة لها، يحملها من لا يستحقونها، وتتحدد درجة وقيمة الفرد في المجتمع على أساسها.
كما أنه لا شك أن الدافعية للتعلم هي شرط أساسي لحدوث التعلم، بل ربما كان توافرها أهم من شرط القدرة، لأن جميع البشر لديهم قدرات متفاوتة، وهم قادرون على التعلم بأشكال ودرجات مختلفة، بشرط أن يتوفر الدافع لدى الإنسان، ولكن الفساد يعطل الدافعية للتعلم لدى أفراد طبقات المجتمع الراقية والبسيطة على السواء؛ فكثير من أبناء الأغنياء لم يعودوا يبالون ببذل الجهد الكافي للتعلم لأن مكانتهم محفوظة في المجتمع، ويختارون دراسة ما يمكنهم من الحصول على شهادة دون تعلم حقيقي ودون كثير عناء، وأبناء الفقراء لم يعد كثير منهم يأملون أن يغير التعلم من وضعهم الاجتماعي شيئًا وسط الفساد المستشري الذي لا يكافئ المجتهد ويرفع درجته، فعزفوا هم أيضًا عنه.
ومع كون إصلاح التعليم يتطلب العمل على إصلاح المجتمع ككل، إلا أن هذا لا يعني أن يُخلي التربويون مسئوليتهم، فالتعليم في مصر بحاجة لتطوير في جميع مراحله، وهي مسئولية التربويين بالدرجة الأولى ولا شك. ولنتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته"، فكل من هو في موضع مسئولية –مهما كان صغيرًا- وهناك تصرف رشيد بإمكانه أن يفعله ليحسن من الوضع العام في المكان الذي يديره سيُسأل أمام الحق سبحانه إن لم يفعل. وربما أمكن القول إن المسئولية على عاتق التربويين هي العمل على تطوير التعليم قبل الجامعي والجامعي، مع مراعاة الواقع ومشكلات المجتمع، وما لا يُدرك كله لا يُترك كله.
ولعل الاهتمام بالتغذية المدرسية من أكثر الموضوعات التي لها تعلقها الواضح بجودة التعليم؛ فللتغذية السليمة أثرها في رفع درجة التحصيل الدراسي لدى الطلاب، كما أنها لا تتعلق بالتعليم وحسب، وإنما بصحة النشء أيضًا، وأعتقد أنه لو تم التعامل بحكمة مع هذا الملف فسيوفر لميزانية الدولة ملايين تُنفق على علاج الأطفال من أمراض تصبهم بالأساس بسبب سوء التغذية. حكت لي مربية فاضلة تعمل حاليًا وكيلة لمدرسة ثانوية بمدينة الإسماعيلية أنها في بدء حياتها الوظيفية عملت في مدرسة إعدادية كبيرة في واحدة من أكبر القرى وأقربها لمدينة الإسماعيلية، وأنها لاحظت أن أحد التلاميذ في فصل من الفصول التي كانت تُدرِّس لها كان دائم التأخر يوميًا عن موعد طابور الصباح، وأحيانًا عن بداية الحصة الأولى، ولما كلّمته بلطف طالبة منه أن يستيقظ مبكرًا ليصلي ويفطر على مهل ثم يتحرك إلى المدرسة ليصل في موعده، فاجأها الطفل قائلًا إنه يستيقظ يوميًا قبل الفجر، ويبدأ التحرك من قبل شروق الشمس بكثير! فسألته: أين تسكن؟ فأجابها بأنه يسكن في عزبة بعيدة متطرفة عن القرية تبعد ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات مشيًا من المدرسة! فصُعقت المُدرسة وقالت له: لماذا لا تحول إلى مدرسة كذا، وهي أقرب لبيتك؟ فسقطت على رأسها المفاجأة الأكبر عندما قال الطفل: هذه المدرسة "شِينة" لا يوزعون فيها بسكوتًا للتغذية! فهذا طفل صغير ضعيف البنية يتكبد عناء المشي لساعات ذهابًا وإيابًا يوميًا من أجل هذه الحلوى البسيطة التي يرفض بعض مديري المدارس عديمي المسئولية أن يستلموها ليوزعوها في مدارسهم، فيحرمون منها الأطفال.
وحقيقة إنني لا أفهم إلى متى سيستمر التباكي على الكيف الضائع، دون أخذ خطوات جادة نحو التوسع في مدارس المتفوقين، أو على الأقل بفصول المتفوقين، والاهتمام بهم اهتمامًا حقيقيًا مكثفًا، بدءًا من رفع مصاريف الدراسة عن كاهل أولياء أمورهم، والاهتمام بتغذيتهم –خاصة في المناطق الفقيرة-، ورفع الحد الأدنى للتفوق إلى 90% -مثلما كان الحال قبل عقود- وتقليل كثافة التلاميذ في فصول المتفوقين مهما بلغت كثافة الفصول الأخرى بالمدرسة، أو بالمدارس المحيطة بمدرسة المتفوقين، وتحديد أفضل المعلمين للتدريس لهم، والتدريس لهم بأفضل استراتيجيات ووسائل التعلم، وجعل الأولوية لهم في كل شيء. فهؤلاء هم زُبدة العقول في مصر، وكما ذكر الفلاسفة القدامى فإن المجتمع الذي لا يهتم بالمتفوقين عقليًا من أبنائه محكوم عليه بالفناء.
وفي مرحلتي التعليم الأساسي، لماذا لا نُعلِّم وفقًا لقاعدة "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها" بدلًا من انتشار الغش لمساعدة الطلاب الضعاف على اجتياز اختبارات لا يسمح لهم مستواهم باجتيازها؛ فيكون في كل مادة مقرر أساسي ومقرر اختياري، فالمقرر الأساسي في اللغة العربية لا يمكن لأحد أن يختار ألا يدرسه، وكذلك كل المقررات الأساسية في كل المواد، ولا بد أن ينجح الطلبة في اختبارات المقررات الأساسية، ولكن على كل طالب أن يختار مقررات اختيارية إضافية ليدرسها ويمتحن فيها، ولا سقف أو حد لها، فيمكن للمتفوقين أن يختاروها كلها إن أرادوا، ولكن لا يرسب أي طالب بسبب عدم اجتيازه لهذه المقررات، على أن يكون لما اجتازه الطالب من مقررات في سجله التعليمي أثره في التحاقه بعد ذلك بالمراحل التعليمية الأعلى، وتوزيعه على التعليم العام والفني.
أما عند الوصول لمرحلة الثانوية العامة فيمكن الإكثار من المواد الاختيارية، والتي على أساسها تتحدد الكليات التي يمكن للطالب الالتحاق بها، ويمكن لأحد الطلاب أن يمتحن في السنة التالية مقررًا ما أو بعض المقررات ليضيفها إلى ما سبق أن درسه، وذلك ليستكمل مؤهلات التحاقه بإحدى الكليات.
والاهتمام بالمعلمين وتحسين أوضاعهم وتوفير مواصلات آدمية للمدارس البعيدة أمر ولا شك هام لتحسين العملية التعليمية، فلماذا لا توفر كل إدارة تعليمية أتوبيسًا يتحرك في الصباح الباكر يوميًا من عاصمة المحافظة، ويسير على خط المدارس البعيدة التابعة للإدارة في المراكز والأرياف، حتى وإن كان المعلمون يدفعون أجرته.
أمر آخر لا مفر من التساؤل عنه، وهو استغلال شبكة الانترنت في التعلم، وأعني هنا التعلم الذاتي غير النظامي. فمنذ أكثر من عشر سنوات، كنت أعمل في جامعة بالمملكة العربية السعودية، وأذكر أن إحدى زميلاتي الأردنيات كانت تتشكى كثيرًا من ضعف شبكة الانترنت في البناية التي يسكنون فيها؛ إذ أن ابنتها -التي كانت بعد طفلة- تدرس باستخدامها؛ فالطالبة النجيبة لم تكن تكتفي بقراءة ومذاكرة كتب المدرسة، بل كانت تفتح جهاز الحاسوب الخاص بها وتلج إلى الشبكة العنكبوتية لتتصفح وتقرأ وتشاهد مقاطع فيديو من خلالها عن موضوعات الدروس التي أخذتها في المدرسة.
وكنت أتساءل وقتها: إلى متى ستبقى شبكة الانترنت وسيلة للترفيه لدى أكثر من 90% من أطفالنا وشبابنا، بينما هي في العالم كله وسيلة أساسية للتعلم؟ فالتعليم النظامي –على علّاته الكثيرة في بلدنا- هو السائد لديهم، ولا يكادون يعرفون التعليم غير النظامي. وربما كانت من حسنات جائحة الكوفيد التي ابتلي بها الكوكب أنها أجبرت الناس على تطبيق التعليم النظامي عن بعد وأخذ التعليم غير النظامي أيضًا في الاعتبار، ليكتشف كثير من أبنائنا هذا الكنز الذي يتلهون به ولا يدركون قيمته.
ولكن ينبغي علينا الاعتراف بأن التعليم الالكتروني عن بعد قد لا يكون كافيًا في تعلم واكتساب المهارات، وأن الممارسة لا بد منها لإتقان التعلم، ومما يضاف إلى مشاكل نظامنا التعليمي أنه لا زال قاصرًا وعاجزًا عن إدخال مدارس وكليات تعلم المهارات التي يحتاجها أفراد المجتمع. وقد جربنا إنشاء المدارس الفنية التي يحصل خريجوها على شهادات الدبلومات الفنية، فكانت وسيلة لتخفيض عدد سنوات الخدمة العسكرية للبنين، وشهادة صورية لضعيفات المستوى العلمي من البنات، وخريجوها لم يتعلموا شيئًا ذا قيمة طوال دراستهم فيها، إلا ما ندر. بينما في أوروبا وأمريكا إن أردت أن تتعلم أي حرفة مهما بدت بسيطة فسيلزمك الالتحاق بدورات تعليمية تؤهلك فيها، ومن أجل ذلك تكون لكل مهنة أو حرفة احترامها في المجتمع.
ودومًا يقولون إن بلدنا هي "بلد شهادات"، والحقيقة إن العالم كله لا يعترف سوى بالحاصلين على الشهادات أو من يمكن الاستدلال على كفاءتهم بمعيار موضوعي، ونحن بالفعل بحاجة إلى استحداث مزيد من الكليات في نظامنا التعليمي الجامعي، ولكن من نوعيات أخرى، فنحتاج –على سبيل المثال- إلى كلية تؤهل لمهنة النجارة والحفر على الخشب والأرابيسك، وكلية تؤهل لأعمال البناء والدهانات وتنفيذ الديكورات، وغيرها من المهن التي تعتبر حرفًا فقط تُكتسب عن طريق الخبرة، وتكاد تنقرض لعزوف الشباب عن تعلمها، بينما المجتمع في حاجة إليها.
إن الواقع يقول إن مجتمعنا يحترم التعليم النظامي ويحدد المستوى الاجتماعي للفرد على أساسه، وفي المقابل لا يحترم التعليم غير النظامي والخبرات بالقدر ذاته إلا في أضيق الحالات، وكثير من الآباء في مصر على استعداد لتزويج ابنته من مهندس ميكانيكا افتتح ورشة ميكانيكا كمشروع ربحي خاص به، ولكنه غير مستعد للقبول بعامل ميكانيكا له المهنة نفسها، مهما كانت درجة إتقانه لعمله التي تدل على تعلمه الدقيق له بالخبرة.
واستحداث أمثال تلك الكليات الجامعية التي تعلم الحرف تعليمًا نظاميًا سيخفف من الأعداد التي تلتحق بكليات أخرى ولا مكان لها في سوق العمل، فما الذي يحتاجه المجتمع من كل هذه الأعداد الغفيرة من الخريجين من خريجي كليتي الحقوق والآداب! علمًا بأن أغلبهم قد التحقوا بهاتين الكليتين بسبب المجموع الذي لم يؤهلهم لغيرهما، وهو ذاته المجموع الذي يظهر أن ذكاءهم اللغوي ليس أعلى ذكاءاتهم، وأنهم غالبًا أذكياء بدرجة أعلى في نطاقات عقلية أخرى لم يكشف عنها التعليم المدرسي التقليدي.
وبعد، فهذه ليست وصفة طبية كاملة لإصلاح وعلاج ما فسد من حال التعليم في بلدنا، ولكنها دردشة عن موضوعات أراها هامة، ولا تلقى القدر الكافي الذي تستحقه من النقاش حولها.
د. منى زيتون
الخميس 14 أكتوبر 2021