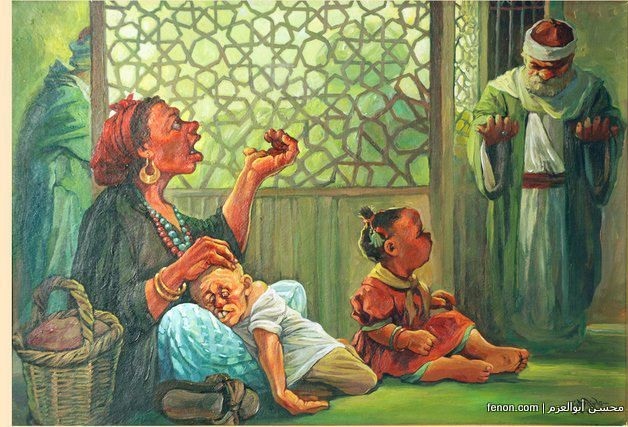صحيفة المثقف
إكويكي إميزي: من يشبه الله
 بقلم: إكويكي إميزي
بقلم: إكويكي إميزي
ترجمة: صالح الرزوق
كانت والدتي تتكلم عن الله طوال الوقت، كما لو أنها صديقة مقربة له، كما لو أنه اقترض منها فمها ربما لأنه وثق بها كثيرا أو لأن الكلام أسهل من تدمير الغابات وقصف الرعد في السماء دون أن أذن مصغية له. كبرت وأنا أعتقد أنه يتغلغل في داخلها، بهدوء، كما ينتشر السكر الأبيض الناعم في البيض المخفوق، أو يشكل جيوبا منفصلة في الزوايا. كنت صبيا، وليس من المفروض أن أنتظر في المطبخ لأراقب يديها وهما تقومان بتلك الأعمال النسائية - هذه مهمة أختي يوري، ومن المتوقع أن تقدم لها يد المساعدة في مثل هذه الواجبات: المزج والتقليب والسكب. ولكن كانت يوري تمقت المعجنات، وتكرهها مثلما يكره الطفل شيئا يمقته، ولذلك كانت تختبئ في الخزانة خلف جدار من الثياب المعلقة، وتمد لسانها لي بمقت واستفزاز إذا ما أرسلتني الوالدة لإحضارها.
اشتكت بقولها: ”الجو حار جدا ومضجر جدا. لا أريد هذا”. ونظرت لي بعينين دعجاوين وقالت: ”اذهب أنت وعاونها يا كاشي”. تنهدت وتركتها وحدها مع كتابها ومصباح يدوي. وحينما سألت الوالدة أين يوري، لم أنظر بعينيها خشية أن يكون الله ينظر بهما. وكذبت قائلا: ”لم أشاهدها”. كنت بالتاسعة من العمر. هزت الوالدة رأسها وشدت من المئزر حولها وقالت: ”تلك البنت. عنيدة منذ الآن - لا أعلم كيف سيقبل بها أي زوج حينما تتقدم بالعمر. أتمنى أن يكون لديها إحساس بهذه المشكلة”. ونظرت لي وفكرت للحظة من الوقت، ثم قدمت لي طبقا مع ملعقة خشبية وقالت: ”هيا بسرعة اخفق المحتويات حتى تصبح قشدة متجانسة”. نظرت بالطبق وشاهدت كتلة من المارجرين وتحيط بها أنهار وبحيرات من حبات السكر. سألتها: ”هل بمقدوري أن أفعل ذلك في غرفة المائدة؟”.
كانت هذه هي مهمتي المفضلة، ورغبت أن أكون وحيدا وأنا أؤديها. وافقت الوالدة بهزة من رأسها، فأسرعت بالابتعاد، ووضعت الطبق على طاولة الطعام وركعت على إحدى الكراسي، لأتمكن من استعمال كلتا يدي لتحريك وخلط المزيج. وما أن أصبح قشدة حبيبية صفراء اللون، حتى غمست أصابعي وسكبت القليل منه، وجعلت أمتصه ببطء وتلذذ. غلف الطعم الحلو الزيتي لساني، وأمكنني الاستماع من المطبخ لصوت غناء الوالدة وهي تنشد أغنية مسيحية بلغة الإغبو كما لو أنها أغنية غرامية، وكان صوتها يرتعش بالمشاعر والعاطفة الخالصة. كنت صبيا، ولم أكن أعلم أنها في الحقيقة أغنية عن الحب، وموجهة للإنسان الذي عشقته أكثر منا. ولم أكن أعلم أنها تفضله علي، ولم أكن أتخيل صورة هذا الشخص الذي اختارته من بين الجميع. لم يخبرني أحد أي شيء عن إبراهام أو إسحاق أو عن الأشياء المزعجة التي يمكن للكبار القيام بها حين يكونون في أعلى الجبل. كنت سعيدا لأن الوالدة سمحت لي بالمشاركة في صناعة المعجنات، وأن هذا سر صغير بيننا، ولن يخبر أحد به الوالد، ولا حتى حينما يلتهم الكعكة ويهمهم معربا عن إعجابه بما شاركت به. لو علم ذلك سنكون أنا ويوري في ورطة. وأوضحت لي الوالدة المسألة فقالت: ”أبوك لا يحب أن تدخل إلى المطبخ. ومن الأفضل أن تكون منكبا على كتبك حين يعود للبيت”.
وحددت لي بعض الفقرات من الإنجيل لقراءتها، وكنت أفضل الفقرات التي تقول إن الله، سواء الروح أو الابن، موجود في داخلي. وفهمت المعنى كله. بما أنني ابن أمي أنا ابن الله أيضا، وبما أنه في داخلها، من المؤكد أنه في داخلي أيضا. وأحيانا أستلقي وأفكر بهذه القضية، أن الله يسكن تحت جلدي. وتساءلت إن كان وزن شيء من هذا القبيل ثقيلا، لكن في الحقيقة لم أشعر أنه ثقيل أبدا. وأصبحت حذرا. ولم أكن أريد أن ألعب ألعابا عنيفة مع يوري كي لا أتأذى. وكنت أحسب حساب أي جرح، في هذه الحالة سينزف جزء من الله ويغادرني، وأنا لست مستعدا لخسارة أي جزء منه. وحتى حينما بلغت الثانية عشرة وأدركت أن الله ليس حقا موجود في دمي، بدأت أهتم بجسمي. وكرهت القذارة والجروح والفوضى. وأسعد ذلك الوالدة. قالت لأختي التي تمزق دوما ثيابها وتخدش ركبتيها وكوعيها: ”هكذا يجب أن يكون مظهرك. اتبعي طريقة كاشي. حافظي على بعض الاتزان بمظهرك”. رمقتني يوري بنظرة نارية وبعد عدة أيام، حينما كنا في الشارع على متن دراجتينا، ودخلنا بنزاع، فقدت أعصابها واستعملت دولابها الأمامي لأفقد توازني، ولتلقيني على الأرض وتجرح شفتي. ثم عدت للبيت وأنا أبكي، والدم يسيل من ذقني. فركت الوالدة أذن يوري وأجبرتها على مواجهتي وهي تصيح: ”انظري ماذا فعلت بأخيك”. هربت يوري ببصرها إلى الأرض، ونظرت لخفيها المنزليين، ولكل الأرجاء كي لا تنظر لي. وفي وقت لاحق من تلك الليلة، مدت يدها وهي على سريرها ودست لفافة علكة تريبور بالنعناع تحت وسادتي وهمست: ”آسفة يا كاشي”. تظاهرت أنني نائم، ولكن في اليوم التالي دخلت إلى الحمام وهي تنظف أسنانها وقدمت لها النعناع دون أي كلمة. كنت أود أن أؤكد لها أنني غير غاضب منها. نظرت يوري للباب لتتأكد أن أيا من والدينا غير موجود ثم قبلتني، لأول مرة، بنعومة بالغة. كانت قبلة دافئة ولطيفة، مثل لقمة أكاراجي، ولدغني الألم بسبب الجرح مثل الفليفلة. نظرت إليها بفمي المنتفخ حينما ابتعدت عني، وتابعت تنظيف أسنانها كما لو أن شيئا لم يحصل.
انصرفت وقلبي يدق. في المرة التالية حينما أرسلتني الوالدة للتفتيش عنها، شاهدتها تقرأ في الخزانة، تماما بنفس الطريقة حينما كنا صغارا. أغلقت الباب وطبعت قبلة على ظهرها، وحاصرتنا الثياب الرقيقة والظلام. وكانت شفتي يومذاك قد شفيت تقريبا.
بعد عدة سنوات، حينما بلغت السادسة عشرة، لم يبق غير مجرد ندبة على شفتي العليا، مع ثوران غامض في صدري حينما أفكر بيوري. وفي المدرسة حينما كنت أتبادل رواية الحكايات مع زملائي عن قصصي الغرامية مع البنات، لم أكن قادرا على التطرق لأول قبلة لي معها. بعض الأولاد يذكرون ابن عم في القرية وخلال احتفال عيد الميلاد، واجبات منزلية في مستودع مغلق، أحدهم ذكر لنا شيئا عن معلم وغرفة صف فارغ بعد انتهاء ساعات الدوام. ولكن كانت حكايتي مختلفة، ولو اعترفت بها علنا سألفت انتباه الآخرين. ولذلك احتفظت بهذا السر. في المنزل كنت أراقب أختي. كانت ترتدي الجينز الضيق، مع صدارة لها حمالات رفيعة كالسباكيتي، وكانت الوالدة تطلب منها باستمرار استبدال ثيابها. كانت تستعمل طلاء شفاه براق، وكحلا يزيد من سعة العينين، وظل عيون لا نراه إلا في الحفلات. كانت يوري مشرقة دائما وجميلة. وهي لي، ولكن في نفس الوقت، ليست لي على الإطلاق. وكانت ترفض تقديم العون للوالدة في أعمال المطبخ، ولكن حينما يغيب الوالدان عن البيت، تراقبني وأنا أصنع كعكة ومعجنات، وتسخر من طريقتي بإضافة السكر، ولكنها تساعدني في التنظيف لاحقا. وكانت الوالدة مسرورة من مشاركتي بالمطبخ لأنه شيء يربطني بها، ولكنها لم تذكر ذلك علنا ما لم يكن على سبيل التشجيع وبالصدفة. وكنت لا أزال صبيا صغيرا. وبعد عودتها كانت تتذوق كمية قليلة مما أطهو، وتقول دون أن توجه كلامها لشخص بعينه: ”هذه المحاولة جيدة. ليست سيئة. ليست سيئة. في المرة القادمة يفضل إضافة المزيد من الطحين”. وكانت يوري تهرب بعينيها، وتضحك، وتبرز أسنانها من فمها اللماع الأحمر. وأتمنى لو أقبلها مجددا.
*
جلست وحيدا في غرفتي ومرآة يدوية بين فخذي، وهي من بلاستيك أزرق، والسروال خاكي عريض. نظرت لفمي في الزجاج. كان شبيها بفم الوالد. جعلت المرآة تميل للخلف لأتمكن من ملاحظة عيني والجدار الكريمي وراء رأسي. كانت هذه الغرفة مكتب والدي - أما يوري فقد بقيت في غرفتنا القديمة ذات الجدران الزرق بلون السماء، وانتقلت أنا إلى غرفة نوم جديدة لأن الوالدة تعتقد أننا كبرنا ولا يمكننا الاشتراك بغرفة واحدة. كان معي قلم كحل والدتي، وهو أنبوب رفيع من البلاستيك بلون أخضر خافت مثل أفعى الأعشاب. ضغطت عليه حتى برز رأسه الناعم الأسود وتساءلت كيف أباشر باستعماله. كان كل من الوالدة ويوري تخططان عيونهما لكن بطرق مختلفة. كانت الوالدة ترسم خطا عريضا على رموشها السفلية، والقلم يجري على الرموش فتنحني وتميل مثل أوراق الأعشاب الطويلة. وكانت رموشها أشبه بسور يجذب الأنظار لتلاحظ ماذا يوجد وراءه. أما يوري فقد كانت تضغط على رموشها للأسفل حتى تظهر الشرايين الحمر المنتفخة في الداخل. ثم ترسم الخط على الرف الجلدي الرقيق هناك. كنت أحب أسلوبها، فلون القلم الأسود يحتضن بدفء ومحبة القوس الأبيض للعين، كما لو أنه جزء منها. توقفت لحظة. كانت المرآة محجوزة بين فخذي، والقلم الخفيف في يدي، نظرت لانعكاس صورتي، وقلت لوجهي: ”ما هذا يا كاشي. ماذا تفعل”. لو رآني الوالد سيقتلني. لكن الوالدة ستجن وتثور. ولربما جن جنون الله المحبوس في داخلها، لست متأكدا من ذلك. ربما كان الله ينظر لي كلما نظرت لنفسي. وربما يكون الله متختبئا في عيني الآن، ويستخدمهما كنافذة ينظر منها. أسدلت جفني ولاحظت الخط الرفيع للجلد الرطب. وحينما حاولت أن أرسم عليه بالقلم، لدغتني عيني ونبعت الدموع منها، وبللت طرف القلم فاضطررت للتوقف، جففته وطرفت بعيني حتى تحسنت حالتها. حاولت مجددا ونجحت بالمرة الثانية - لم يكن الخط منسابا، لكنه كامل تقريبا، وكانت الزاوية الخارجية تميل للداخل. نظرت بالمرآة وكانت إحدى العينين مكتملة. رسمت الثانية. وأصبح وجهي على الزجاج رقيقا ومدهشا، ومقلتاي غائرتين. وددت أن ألفت انتباه يوري. انزلقت من غرفتي وتابعت في الممر إلى غرفتها. وسمعت صوت ماء الدوش ينهمر وصوت المولد يدمدم في الخارج. وعندما دخلت الحمام، مسحت يوري زجاج الدوش لتشاهد القادم.
قالت: ”آه، هذا أنت”. ابتسمت وعادت لمتابعة غسل شعرها. تنهدت وجلست على غطاء دورة المياه، وقلت لها: ”كم بقي لك”. نظرت لخيالها من وراء ضباب الزجاج. كانت ثيابها الداخلية على الأرض، سروال وحمالة صدر. انحنيت لالتقاط السروال ولاحظت البطانة الملتصقة بالقفل، وكانت مطوية ونظيفة. حملته بيدي وكان لا يزال حارا، وانتقلت ذاكرة جلدها الدافئ لراحة يدي. ضغطته وألقيته في علبة النفايات، ثم اتكأت على خزان البورسلان، كان قطن سروالها مثل عصفور أبيض في يدي. وبدأ صدري يدق. وجاء صوت يوري من خلف البخار يقول: ”هل عادت الوالدة؟”.
قلت: ”سمعت صوت سيارتها قادمة”.
كانت حنجرتي جافة، وشعرت بالاضطراب والتردد. كنت أود أن ألفت انتباه يوري لزينتي ولكن كنت أيضا بحاجة لتنظيف وجهي من هذه الزينة قبل أن تأتي الوالدة.
أضفت قائلا: ”أنت تسنفذين مخزون المياه الحارة”. أغلقت يوري الماء الحار، وفتحت باب الدوش. نظرت إليها كان جلدها صفحة طويلة رطبة مثل برية ذات لون بني داكن. مدت يدها وسبحت أصابعها في الهواء الفاصل بيننا.
قالت: ”أعطني المنشفة”.
وقفت ويدي التي تحمل سروالها وراء جسمي كي لا تراها، ثم ألقيت السروال على الأرض. سقط دون صوت. كانت منشفة يوري الزهرية معلقة على قضيب الحديد، على بعد يسير من متناولها. قدمتها إليها، وأنا أنظر لقطرات الماء التي تسقط من شعرها وتسيل على رقبتها. ابتسمت لي ثم لاحظت الكحل. قالت: ”آها. ما هذا؟”. حاولت أن أفسر نبرة صوتها. كانت مندهشة، ولكنها غير مشمئزة، وهذا فأل طيب. مع ذلك خفضت عيني، وكنت أختنق بالحرارة التي تدق في صدري. قالت: ”إنها تناسبك”. كان كلامها عذبا مثل مكعب سكر مسروق، والإعجاب يشع من صوتها. شعرت بالراحة وهي تنتشر في داخلي مثل عدد من الأنوار الصغيرة، ونظرت إليها مع ابتسامة، وكل ما أذكره، أنني عانقتها بقبلة طويلة، ويداي تضغطان على جدار الدوش. وأفترض أنني شعرت كأنها أول قبلة لي في حمام، بينما كانت قبلة الخزانة هي الثانية، وهي تعبير عن محبة بريئة، ولكن بدهشة بالغة، شعرت أنني ألتصق بها، ويداها تنزرعان داخل صدري، وتضغطان وتخلفان أثرا نديا.
سألتني: ”برأيك ماذا تفعل؟”. وكان في صوتها تحذير ثلجي وبارد. وبدأت أفكر بشيء أرد به على كلامها. وقفت مثل أحمق، جامدا وصامتا. لفت يوري حولها المنشفة لتستر نفسها من نظراتي.
قلت مخنوقا: ”آسف”. وكان صدري ينفصل عني. وتابعت: ”توقعت... بناء على ما سبق... توقعت أنك لن تمانعي”.
قطبت ملامحها ودفعتني بعيدا عن طريقها، وتوجهت لغرفة نومها. وهي تقول: “بناء على ما سبق؟. تقصد بعد حادثة الدراجة؟. بربك، يا كاشي، كنا طفلين”.
تبعتها بصمت ووقفت على بساطها. لم يمر على ذلك غير أربع سنوات، فهل تغيرت الأمور لدرجة ملحوظة؟. كيف فهمت المسألة على نحو خاطئ؟. كنا متقاربين، متقاربين مثل معظم البنات والشباب الأغراب الذين أعرفهم. ولم أكن أعتقد أن لذلك أي معنى سلبي، قبلة صغيرة واحدة من ذلك النوع، ألا تعني أنني أعرب لها عن محبتي فقط؟. امتلأت عيناي بالدموع وتورمت بالإحساس بالخزي. وفكرت إن البكاء أمامها سيزيد الأمر سوءا. لكنها راقبتني بوجه فارغ من الملامح، والماء يقطر حولها. ثم سألتني: ”هل استعملت قلم تخطيط عيوني؟”. هززت رأسي وقلت: ”استعملت قلم الوالدة”.
“من الأفضل أن تعيده قبل أن تكتشف ذلك”.
أومأت بالموافقة وتوجهت نحو الباب ولكنها أوقفتني قائلة: ”انظر يا كاشي”.
التفت برأسي للخلف. كانت لا تزال حانقة، ولكنها تحاول أن تجد كلمة طيبة تقولها. ولم يحسن ذلك من نفسيتي. وتلاشى الفراغ الذي يحتل وجهها ولم يتبق سوى الاشمئزاز الصامت المجرد الذي ترسب عليه.
قالت: ”مهما كانت مشاعرك نحوي لن يكون بيننا أي علاقة، هل تفهم؟”.
لم أستوعب ماذا تريد أن تقول. غير أنها تنهدت وحملت منشفتها وقالت: ”أنت لا ترغب بي. أنت تريد أن تكون مثلي”.
تبادلنا نظرة لعدة دقائق. كانت مخطئة، ولم أكن أعلم كيف أبدد النظرة السلبية التي تظهر في عينيها. كنت أريد أن أعبر عن نفسي وأقبلها، وهذا كل شيء. ولكن لم تستوعب ذلك، ولن يقبله مني أي مخلوق آخر. خفضت عيني واستدرت مستعدا للمغادرة، وأغلقت ورائي الباب، وسمعت صوت إغلاق القفل من الداخل. وهكذا جرحت مشاعري كأنها تعتقد أنني نوع من الوحوش الضارية المفترسة، مخلوق مرعب وهي بحاجة لحماية نفسها منه. توجهت إلى غرفتي وحملت قلم تخطيط العين من السرير، وأنا أصيخ السمع في طريق عودتي للممر. كان بمقدوري سماع صوت التلفزيون من الأسفل وهو يلفظ الأصوات، لا بد أن الوالدة أشعلته، وهذا يعني أنها تتربع على الكنبة الآن. إذا لدي وقت. تسللت إلى غرفة الوالدين، ثم تابعت نحو الطاولة التي تحتفظ الوالدة فيها بمكياجها. كانت أقلام العين محفوظة في علبة صغيرة، أقلام داكنة شمعية تغطيها حروف براقة، مع أغطية بلاستيكية رفيعة لحماية نهاياتها المدببة. الأقلام الثانوية وغير السوداء أو البنية التي اعتادت استعمالها كانت مودعة في العلبة بالمقلوب، ويمكنها أن تتعرف عليها من ألوان الأغطية التي تحمي نهاياتها - فضية مثل معدن رقيق، وأخضر لماع، وأزرق مثل مياه البحر. أعدت القلم المستعار لمكانه وبحثت عن ورق تنظيف لأمحي التخطيط الأسود من حول عيني. ولكن ترددت كلمات يوري في رأسي وبدأ شيء يتسرب مني، وتصورت أنني سأفقد لوني وأصبح شفافا بعد أن تنتهي هذه الحالة. نظرت للعلبة التي تحتوي كل الأقلام وانتقيت القلم الفضي، وفتحت الغطاء واقتربت من المرآة. حتى لو أن هذا آخر يوم لي في الحياة فقد عزمت على تجريبه، كنت أريد أن أراه على وجهي، ولو لدقيقة واحدة، وبعد ذلك أعاود تنظيفه، وأهبط للأسفل، وأتظاهر أنني ابن وأخ مطيع ويتبع التعليمات والأصول. بيد ثابتة ضغطت رأس القلم للزاوية الداخلية من عيني اليسرى، بما فيه الكفاية ليخلف بقعة مضيئة هناك. وكررت نفس الشيء مع الزاوية الثانية. ثم وضعت غطاء القلم وأعدت القلم لمكانه، وتراجعت عدة خطوات لأرى نفسي من مسافة كافية، ولأتأكد أن البريق سيحافظ على إشراقتي المفقودة. لم أشاهد حقيبة الوالدة اليدوية ملقاة على الأرض خلفي لذلك تعثرت بها، وفقدت توازني وارتميت فوق الكرسي. وبإثر ذلك سقطت علبة أحذية وتبعثرت المحتويات في أرجاء الغرفة وطرقت الأرض بصوت مرتفع. وضرب كوعي الأرض بقوة والتهبت عيناي من الألم ودمعتا. قلت: ”اللعنة. اللعنة. اللعنة”. نهضت بسرعة، وأعدت الكرسي لمكانه، وكان كوعي يؤلمني وانتشر الألم في كل ذراعي. وكنت أحاول إيداع الحذاء في العلبة حينما دخلت الوالدة من الباب، وألقت حقيبتها على السرير وهي تصيح: ”ما هذه الضجة؟. أنتم لا تسمحون لي ببعض الراحة والخصوصية؟”. وجمدت حينما وقعت عيناها علي.
قالت: ”كاشي؟. هل أنت من يحطم هذه الغرفة؟. من سمح لك بالدخول إلى غرفتي، آ.؟”.
“آسف يا ماما. كنت أبحث عن شيء ما”.
وتركت الحذاء وحاولت أن أهرب منها ورأسي منكس للأسفل وذلك قبل أن تضع يدها علي، ولكن كان هناك الكثير من لون الفضة في زاوية عيني. وكانت تلمع.
قالت بصوت آمر كأنها تضرب بالعصا: ”قف مكانك يا صديقي”.
وأطعت الأمر كالعادة، والتصقت قدماي بالبساط.
قالت: ”ماذا تضع على وجهك؟”.
حاولت أن أمحوه بسرعة ولكنها أسرعت بالاقتراب وقبضت على ذراعي.
قالت: ”توقف عن هذه الحركة البلهاء. دعني أشاهد ما فعلت”.
وجرت رأسي نحوها وقطبت ملامحها وقالت: ”آه، آه!. يا كاشي. والآن أخبرني ما هذا؟. منذ متى وأنت تستعمل قلم عيوني؟”.
كان وجهها مكفهرا، والدهشة والاضطراب يغطيان على الغضب الذي توقعته.
دمدمت: ”اسمحي لي أن أنصرف لأغسله”. وتأهبت للمغادرة والإفلات من قبضة يدها. قررت أن أهرب، أن أغادر الغرفة، ولكنها عقدت ذراعيها على صدرها وقالت: ”هل تريد أن أخبر والدك؟”. كانت أشبه بصفعة على الوجه. توقفت فورا، ونظرت إليها بانتباه. قالت: ”الأفضل أن تنتظر معي، وتجلس، لتفسر لي هذا الهراء الطائش”. جلست على طرف السرير ووقفت هي أمامي، ويداها معقودتان على صدرها. تنحنحت ونظرت للبساط وقلت: ”هذا لا شيء. فقط رغبت أن أرى كيف يبدو”.
“جيني كا ا نا-إكوو؟. لم أفهم ماذا قلت للتو”.
راقبتها وهي تحرك قدمها بخفها المنزلي وبقلق. ترددت وعضت شفتها، كما لو أنها تفكر بما ستقول. وحينما تكلمت، كان صوتها ناعما وغدارا، مثل السم، قبل أن يقتل. قالت: ”والآن يا كاشي، أخبرني بالحقيقة واستعذ من الشيطان. هل أنت شاذ”.
رفعت عيني لوجهها وقلت بخزي وقهر: ”ماما. أنا لست لوطيا”.
أسدلت الوالدة ذراعيها، وحركت عينيها، وكانت تنظر في كل الأرجاء وتبحث عن شيء غير موجود. ثم قالت: ”آه يا إلهي. انظر كيف زارنا الشيطان وتقمص ابننا”. وغرست قدميها وحركت يديها. وشعرت بالاستفزاز. وتخلصت من رعبي وقلت: ”المسألة ليست خطيرة يا ماما. كنت على وشك غسل الألوان”. وقفت بلا حراك ونظرت لي، مصدومة، وقالت: ”إه؟ ماذا تعني أن المسألة ليست خطيرة؟. شيطان اللواط يدفعك لتتزين بقلم تخطيط عيوني وأنت تقول إن المسألة لا تستحق التفكير؟”.
“لماذا دائما تفكرين بالعفاريت والشياطين؟ لماذا ليس هناك شيء آخر؟. مثلا أن الله يخاطبني ويوحي لي بذلك -”.
ولم أتم كلامي لأن الوالدة لطمتني بقوة، ولمس خاتمها طرف فمي وجرحه.
رفعت يدي بسرعة لألمس الدم، ونظرت هي لي مليا، وصدرها يلهث. جلست على السرير على وشك البكاء وأنا أقول: ”ميشي أونو جي! هل جننت؟”. كان كلاما غبيا، ولكن توقعت أن تفهم، باعتبار أنها تؤمن بالله. واعتقدت أنها رأته وهو يشرق في وجهي، كما هو الحال الآن. وشعرت بفجوة تتوسع بيننا، وتتركني على السفح وحدي. وكانت تواصل صياحها، ولكن لم أستمع لها. وتطاير البصاق على وجهي من فمها وزاد ضيق صدري تدريجيا. وصفعتني مجددا وهي تقول: ”هل تستمع لما أقول؟”. رفعت نظري إليها، وفي تلك اللحظة غلبني المقت والكره. وبدأ المقت يغلي في صدري ويندفع إلى عيني، وهكذا أصبح بوسعها أن ترى كل شيء. فبدأت تنوح وتتلوى وتهمس: ”يا إلهي. دم مسيحي ينزف في بيتنا". ووقفت وهممت بالمغادرة، والدموع تسد مقلتي. ولكن فورا انفجر في قفا رأسي ألم فظيع. وصرخت. ثم سقطت على ركبتي. ورفعت ذراعي غريزيا، والتفتت لأرى ماذا ورائي. كانت الوالدة تقف هناك، وبيدها حذاء الكعب العالي، وعيناها تلتهبان بالشرر والرعب. قالت: ”الشيطان لن يسرق ابني مني. انقلع! أطلق سراحه باسم المسيح”. وضربتني مجددا بحذائها، وخدشت ساعدي.
قلت لها: ”ماما ماذا تفعلين. توقفي يا ماما”.
“أستطيع أن ألمحك في عينيه! شيطان اللواط! أطلق سراحه! أطلق سراحه!”. وكانت تعقب على كل عبارة بضربة إضافية، تودع بها كل القوة المتوفرة في ذراعها. لم أكن أعلم أن الحب يمكنه أن يأخذ هذا الشكل العنفي.
توسلت لها: ”من فضلك يا أمي”.
لم تستمع لرجائي. وانطويت على نفسي كالكرة، وحميت رأسي وهي تضربني بالحذاء وبراحة يدها، ضربات عنيفة لم أتحملها. وصرخت من الألم. وفي النهاية طلبت النجدة. قلت: ”يوري! يوري! ساعديني يا يوري”.
وتحول غضب الوالدة لجنون وجهته ضدي وهي تقول: ”لا يمكنك استعمال قلم العيون. ابني لن يكون لوطيا”. ونسيت موضوع الشيطان المفترض الذي يتقمصني. هل غيرت قناعتها حيال الدافع الذي شجعني على استعمال قلم تخطيط العين؟. ويبدو أنها قررت، بغض النظر عن من هو المسؤول، أن هذا الضرب سيحل المشكلة بطريقة أو أخرى. نظرت من بين تسارع وتيرة ضرباتها، والدم ينبع ويسيل على عيني اليسرى، وشاهدت يوري واقفة بالباب، صامتة وعاجزة عن الحركة. فتحت فمي لأطلب منها المعونة، وهنا ضربتني أمي على صفحة وجهي. كنت أبكي. كنت أبكي منذ البداية. ونظرت أختي لي فغاصت معدتي في داخلي. وتلاشت اللامبالاة القاسية وأعرب وجهها عن كل شيء - إنها لن تمد يد العون لي، ولن تحاول أن تمنعها. كان هناك شيء فظيع خاطئ ينمو في داخلي، وحتى لو أن الوالدة كانت تضربني لسبب مفتعل، فقد كنت أستحق العقوبة لسبب آخر، لم تكن الوالدة تعلم به، وهو خطأي الفظيع في الحمام، عشقي المخزي. لم تشاهد الوالدة يوري لأنها لم تحول بصرها عني، وسقط الحذاء بقربها وبدأت تلطمني على رأسي، وهي تصفني بالكافر. وأعتقد أنني كفرت. وأن الله سيعاتبني لأنني أهنته حين تشبهت بالنساء، ولم أتصرف مثل الرجال، مع أنه خلقني على هيئة رجل. لكن كان الخطأ يقع على الوالدة لأنها سمحت لي بالعمل في المطابخ مثل النساء.
قالت الوالدة: ”أنت رجل. هل تسمعني. لن أسمح لهذا الخطأ في بيتي”. خفضت يوري نظراتها وغادرت. ونظرت للفراغ في محيط الباب حيث كانت تقف، وأعتقد أن قلبي تصدع فورا. كان رأسي ينزف وكانت عيني اليسرى محمرة. لو أن الله موجود في داخلي، هل شعر بهذا الألم الذي أشعر به، الألم النفسي والجسمي. هل شاركني هذا المصاب؟. هل امتزج دمه بدمي؟. ولو أن الله كان موجودا في الوالدة، هل كان هو من يضربني؟. وهل هذا يعني أنه كان يلطم جزءا منه؟. ضغطت بيدي على وجهي ومسحت عيني حتى لوث الكحل أصابعي، وحتى خرج الله من وجهي، وبقيت وحيدا أستلقي هناك على البساط، وأمي فوقي، وهي تتنفس بمشقة، وذراعها مكدودة والدم يغلف خاتمها.
أكويكي إميزي Akwaeke Emezi روائية نيجيرية. من أهم أعمالها: مياه منعشة 2018، حيوان أليف 2019، موت فيفيك أوجي 2020، عزيزتي سينثوران 2021. سيصدر لها في عام 2022: مرارة، تحذيرات مؤكدة، أنت تسخر من الموت. تلقت علومها في جامعة مدينة نيويورك. وتبلغ الآن من العمر 34 عاما. وهي على خصومة علنية مع مواطنتها الكاتبة المعروفة “شيماماندا نغوزي أديشي”.
***
.......................
* نشرت مجلة غرانتا بالتعاون مع إدارة “كتاب الكومونولث” أعمال الفائزين بجائزة القصة القصيرة في الكومونولث لعام 2017. وقد مثلت القصة المدرجة أدناه القارة الإفريقية.