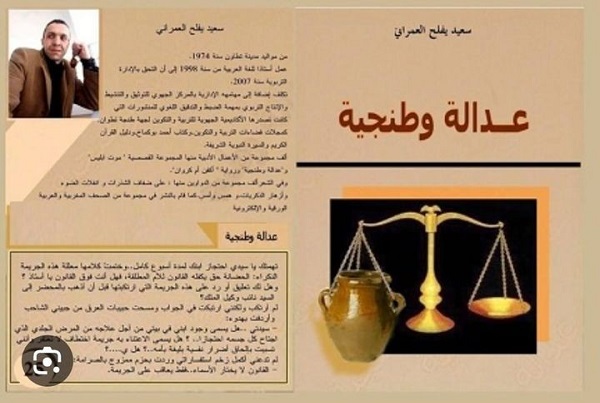صحيفة المثقف
مجدي إبراهيم: منهج الدّرس الفلسفي في الإسلام.. رؤية نقدية (8)
 ــ القراءة والمعرفة:
ــ القراءة والمعرفة:
وتجدر الإشارة إلى أهمية فعل القراءة وهى تجري تحت مظلة القيم العليا؛ فالقراءة في حدّ ذاتها قيمة معرفيّة، وستظل قيمة معرفيّة كائنةً ما كانت تلك المعرفة، سواء تمثلت في ثقافة العقيدة والدين أو ثقافة العقل والفلسفة. ولم يكن الأمر الإلهي بكلمة (اقرأ) بالأمر الهين البسيط الذي يُستغنى عنه مع الغفلة والتردي وسقوط القيم، ولكنه كان أمراً، ولا يزال، ذا دلالة تندرج في ذاتها في وعي معرفي تام؛ لتشكل نظام القيم، ثم لتصبح هذه القيم فاعلة فينا أولاً، ثم تكون أفعل في حياتنا تباعاً، ذات أثر بيّن ظاهر في السلوك وفي الحركة وفي الحياة، لا لتنعزل بالتجاهل أو بالإهمال عن حاضراتنا الواقعيّة.
لم يكن الأمر الإلهي "اقرأ" مُجرد كلمة عابرة وكفى، ولكنه نظام معرفي موثوق بمعطيات القيم العليا، متصل شديد الاتصال بنظمها العلوية الباقية.
قد لا نتجاوز الصواب إذا نحن قلنا إنّ مردُّ جرثومة التخلف في بلادنا إلى إهمال الأمر الإلهي "اقرأ"، فكأنما الأمر يقول : اقرأ كيما تعرف؛ لأنه لو أطيع الأمر الإلهي بالقراءة، لكانت المعرفة على اختلاف مطالبها وفروعها مُحققة لدى القارئ، وتحقيقها هو العرفان (أن تعرف)، ولا مناصّ منه مع فعل القراءة على اختلاف توجهاتها وميادين النظر فيها، وتسخيرها للعقل، وتسخير العقل لها، ولكل ما يعلوها، ويعلو بالإنسان مع المعرفة، ومع القراءة، ومع العلم في كل حال.
إمّا أن نقرأ فنعرف، وإمّا أن لا نقرأ، فتنطمس أبصارنا وبصائرنا؛ فنتخلف ويقودنا التخلف إلى أدنى درجات التّسفل والانحطاط، وليس من وسط بين طرفين.
هذه واحدة. أمّا الثانية؛ فإنّ القراءة تأتي بمعنى التحليل النقدي أو النقد التحليلي، وكلاهما قراءة على قراءة، لكن الفارق فيما يبدو أن الأول يشمل تحليل النّص المكتوب ونقد متونه وفحص إشاراته ورموزه.
والثاني : تصحيحُ لمسارات العقل في أعماله من جهة كاتب النّص نفسه، ولذلك يتقدّم النقد في هذه الحالة على التحليل، والمُرادُ به نقد الأدوات المعرفيّة، وأهمها وأولاها : تلافي القصور في عملية القراءة نفسها وتصحيح مسار الذهن عن انحرافه بإزائها، ووضع الأطر التي تقوّمه في طريقه بغير اعوجاج أو انحراف، الأمر الذي يترتب على هذا كله، أهمية التفسير من جهة وقدرة العقل على التأويل ثم التنوع فيهما بمقدار الكفاءة العقلية وتذوق المقروء والمكتوب.
وعليه؛ تصبح القراءة هى القاعدة التي يقوم عليها أساس البناء المعرفي بكل ما يصدر عنه من تفسيرات وتأويلات وتخريجات، تنصب في النهاية في خدمة ضروب المعرفة، وخدمة النصوص المُراد تصريفها وفق قدرات العقل في التفسير والتأويل والتخريج. وليس بالإمكان أن يقوم النقد في مجال من المجالات بغير قراءة واعية. فكما لا تقوم المعرفة العقلية الحصيفة بغير قراءة دائمة ينشط فيها العقل؛ فكذلك النقد الفاعل المؤثر لا يقوم إلا على شعلة القراءة ووهج العناء فيها. والناقد الجيد قارئ جيد بامتياز. والقراءة الناقدة بديهة حاضرة لا تخفى على أحد : هى ألزم سمات المنهج بإطلاق.
ــ من المنهج إلى النقد:
ومن الأهمية بمكان أن نشير في هذا الصدد إلى نقطة جوهرية تدور عليها مناهج الدرس الفلسفي في الإسلام : دراسة وتدريساً، وتدخل ـ من ثم ـ في صميم "تكوين الرؤية" التي سبقت الإشارة إليها، وتضفي على هذه الرؤية بُعداً تنويراً يتصل بإعمال العقل وعمل القلب سواء بسواء، نستطيع استخلاصه من دوائر الفكر الإسلامي الثلاث (فلسفة فلاسفة الإسلام، وعلم الكلام والأصول، والتصوف بأقسامه وأنواعه المختلفة) أو إنْ شئت : منهج العلم والبرهان، ومنهج الشرع والاستدلال، ومنهج الذوق والاستبصار.
هذه النقطة الجوهرية تتمثل في الاكتراث الشديد بتنمية الحسّ النقدي لدى دراس الفلسفة على وجه العموم؛ فلا معنى للفلسفة على الإطلاق ما لم يكن المنهج النقدي فاعلاً فيها، إذ إن الفلسفة لا تستقيم بغير الجانب النقدي، ولا يعتد بدَرْسها على الإطلاق والنقد في معزل عن الفاعلية والتأثير. ونظراً لأن منهجية الفلسفة منهجية نقدية بالأساس؛ فلا عبرة للباحث فيها إذا هو وقف أمام الآراء والمذاهب الفلسفية وقفة الناقل لها تارة، والعارض إليها تارة أخرى، دون أن يسلط عليها معاول النقد والتمحيص أو يضفي ـ من ثم ـ بعداً ذاتياً هو من صميم الرؤية الخاصة به، فوق ما يعرضه من موضوعية في التناول المنهجي. فالنقد على هذا فوق كونه منهجاً يشكل أيضاً نواة كبرى في تكوين الرؤية.
وليس النقد بداهةً هو الهجوم والسباب واستخدام الألفاظ الوبيئة النابية، ولكنه معيار للتقييم يتوافر فيه إطلاع وفير، ويتأتى من ملكة عليا تعتمد الاجتهاد بشروطه المقنّنة بمقدار ما تعتمد على هضم أكبر قدر من الحقائق الكبرى، ولا تعتمد بحال على الغفلة والجهالة، والمعارضة لمجرد المعارضة، والسطحية والقشور وقلة الإحاطة بموضوع البحث وخطوات السير فيه على وعي وبصيرة.
وقد يقابل الدراس فيما تقابله من آراء واتجاهات كثيراً مما يحتاج إلى النظر الدقيق مقروناً بالنقد الصائب. فإذا لم تكن هناك قدرة لديه على النقد التحليلي؛ فإنه سيقع لا محالة فريسة للتقليد، ولأسر هذه الآراء يكررها ويعيدها ويجتر ما فيها اجتراراً مذموماً، ولا يمل من تكرارها واجتررها وإعادتها في غير نقد منه أو تمحيص.
وربما كانت جملة هذه الآراء هدامة؛ فيها من الخطأ والتضليل أكثر مما فيها من الوجاهة والتحديث مما شأنه أن يساير حركة الزمن مع تطور التفكير. أو ربما كانت جملة تلك الآراء تساغ لأهل التخلف والتبعية، ولا تساغ لأرباب الفكرة الواعية والتحضر المقبول ومسايرة الواقع المتطور كما ينبغي أن يساير الواقع ويعاش على التفاوت بينه وبين عصور سلفت ووقائع مضت، وأحقاب من الزمن تطورت، وأحكام بناءً على ما يتطور ويتبدل تغيرت؛ فلا يسع الباحث إن لم يكن قادراً على النقد إذ ذاك إلا أن ينساق وراء هاته الآراء انسياق التبعية والتقليد.
وفي تراثنا العربي توجهات تملكت اتجاهات ليست بالقليلة، وصفحات ملوثة بنزعات أدعت امتلاك الحقائق على طلاقتها، وحرمت غيرها فريضة التفكير، مع أنها تحمل الكثير والكثير من المغالطات والأضاليل، وتعادي فكرة التقدّم الحضاري في عمومها، وتحتاج ـ لحذفها وتنحيتها ـ إلى ملكة في النقد عالية، بالمقدار الذي نحتاج فيه إلى تنمية هذه الملكة عن طريق الاهتداء بوسائل المنهج النقدي التحليلي لدى الفلاسفة أنفسهم؛ لأن التحليل النقدي يُعري الدعاوي ويفضحها ويبطل المزاعم التي تقف عائقاً أمام حرية العقل والتفكير. ولم يكن سقراط الفيلسوف اليوناني (469 ـ 399 ق. م) بالمخطئ وهو يحارب ـ مع منهجية السخرية والتهكم ـ أغاليط السوفسطائيين ويبصر شباب أثينا بتوليد الأفكار من طريق جدل المحاورة متجهاً إلى سبر غور الروح الإنساني ممثلاً في العقل : يستطلع الافتراضات ويستوجب اليقينيات، ويتسأل؛ ليكون هو أول من ابتدع فلسفة السؤال على الحقيقة، فظهر من منهجه أن السؤال الفلسفي أبلغ من محاولة الإجابة عنه.
وكانت طريقته تحتاج إلى تعريف دقيق وتحديد محكم للألفاظ بمقدار ما كانت تتوخى التفكير الصحيح؛ الأمر الذي جعل الثورة قائمة من السفسطائيين عليها، وعلى منهج سقراط ليقولوا : إنه يسأل أكثر مما يجيب، ويترك عقول الرجال أكثر اضطراباً مما كانت عليه قبل المحاورة والنقاش. ولكن الفلسفة كانت عند سقراط من حيث هى منهج تعني الوضوح بكل ما تحمله الكلمة من معان.
ولم يكن أفلاطون (427 ـ 347 ق. م) بأقل من أستاذه في ابتداع فن المحاورة الفلسفية كنوع من الكتابة، فياض بفنون الدراما والمناقشة والشرح المرسل، وفي كل هذه الركائز الرئيسة، لم يكن النقد يخلو مما كان يضمها ويشملها فيعكس عصره من جميع جهاته الثقافية : سياسة، وشعر، وفلسفة، وأدب، وخطابة، ثم قصة مصطنعة يصوّر فيها أفلاطون بالرمز ما لا ينال بالبرهان.
أمّا أرسطو (384 ـ 322 ق. م)؛ فهو الواضع الحقيقي للغة العلمية العامة، وهو الذي كشفت مصنفاته عن منهجية علمية فلسفية لذلك نجده أولاً يُعيّن موضوع البحث، ثم يسرد الآراء في هذا الموضوع ويمحّصها. وهو بالفعل قد جهد نفسه للوقوف على الآراء في جميع فروع العلم. ثم يسجل "الصعوبات" أي المسائل المُشْكِلة في الموضوع.
ويعرّف "الصعوبة" :" أنها وضع رأيين متعارضين لكل منهما حجته في الجواب عن مسألة بعينها ". وأخيراً : ينتقد في المسائل أنفسها، ويفحص عن حلولها، مستعيناً بالنتائج المستخلصة في المراحل السابقة. فلم يكن النقد ببعيد عن منهجية أرسطو؛ لأنه بغير النقد لا تقوم للفلسفة قائمة، ولا يعول على رأي فيها ما لم يكن قائماً على النقد التحليلي حقيقةً.
ويعتبر أرسطو بحق أول من وضع مناهج البحث العلمي والفحص الدقيق في العلوم. وكان يقول :"من الضروري أن يبدأ العلم بالفحص عن مسائله؛ لأن العقل إنما يبلغ إلى الاطمئنان بعد حل الصعوبات التي اعترضته، ثم لأن الباحث لا يدري إلى أي جهة هو متوجه؛ بل هو مستهدف لعدم معرفته إنْ كان قد وجد ما يبحث عنه أم لم يجد، من حيث إنه لا يتوخى غاية. أمّا الذي يبدأ بمناقشة الصعوبات؛ فهو الذي يستطيع أن يعيّن لنفسه غاية. وأخيراً : إنّ الذي يسمع الحجج المتعارضة جميعاً يكون موقفه أفضل للحكم.
ولتعيين الموضوع مزية أخرى، هى تعيين نوع الدليل الذي يلائمه؛ فإنّ البعض لا يقبل إلا لغة رياضية، والبعض لا يريد إلا الأمثلة، والبعض يريد الاستشهاد بالشعر، والبعض يحتم في كل بحث برهاناً محكماً، بينما غيره يعتبر هذه الأحكام إسرافاً ... ولكن يجب أن يبدأ بتعريف مقتضيات كل نوع من العلم؛ فلا تقتضي الدقة الرياضية في كل موضوع، وإنما فقط في الكلام على المجرّدات. ولذلك؛ فالمنهج الرياضي لا يصلح للعلم الطبيعي، لأن الطبيعة تحتوى المادة"؛ ولتأصيل الحركة النقدية الفلسفية تأصيلاً لا شك فيه لقدرة العقل على اكتشاف المجهول.
وكما كان النقد من الأهمية بمكان لدى فلاسفة اليونان، كان كذلك عند فلاسفة الإسلام، فلم يترك مستأخرهم لأسبقهم حركة ذهنية إلا وفحصها، وأتى على كنه الرأي فيها، فكل فيلسوف من فلاسفة الإسلام سواء كان من فلاسفة المشرق العربي أو من فلاسفة المغرب العربي، تمثلت عنده ملكة النقد في قبول ما يراه صالحاً للقبول ورفض ما يجده مخالفاً لما يراه من اتجاهات حول مشكلة من المشكلات.
والقبول والرفض بناءً على حجج عقلية وأدلة برهانية، ولم يكن يجري جزافاً بغير دليل معقول. ولقد كانت للواحد منهم معرفة شاملة بآراء عديدة للمفكرين والفلاسفة الذين سبقوه، عاشوا قبله أو عاصروه. لكنه مع ذلك كان يلتزم أدق التزام بخصائص وأشراط الفكر الفلسفي. ولم تكن ملكة النقد التحليلي في غيبة عن تلك الخصائص والأشراط؛ بل ولعلها أبرز هذه الخصائص الفلسفية بإطلاق. وإذا كان النقد من السمات البارزة في الفكر الفلسفي عامة، فهو كذلك من السمات البارزة في خصائص الفكر الفلسفي في الإسلام على وجه الخصوص؛ يجيء تعبيراً عن البعد الذاتي وعلامة على الرؤية التنويرية والحضارية الخاصّة بفلسفة الفيلسوف؛ فإذا اتسعت الرؤية الخاصّة بالفيلسوف كان ذلك دليلاً على اتساع أفق النظر عنده إلى أعمال الآخرين وأفكارهم ومذاهبهم؛ فلا يكون حكمه على هذه الأعمال والأفكار والمذاهب إلا ميزان اعتدال ينصف حين يكون الإنصاف ويبخس رافضاً حين يرى البخس والرفض حقاً لازماً من حقوق البحث والنقد والمراجعة والتحقيق.
ولا يخفى على دارس الفلسفة أشهر معركة فكرية في الفكر الإسلامي قامت على النقد، والنقد المحرّر الدقيق، بين الفلاسفة والغزالي من جهة، وبين ابن رشد والغزالي من جهة ثانية؛ ذلك لأن الفلسفة في جملتها منهجٌ له قواعده وخصائصه وأصوله تحتم على الباحث أن يلتزم بخصائص التفكير الفلسفي. والشك والنقد والاعتراض على ما يوافق المعقول أشراط دالة على الالتزام بخصائص الموقف الفلسفي عند هذا الفيلسوف أو ذاك.
ومن شأن الشك أن يرفع صاحبه فوق مرتبة الاعتقاد التقليدي؛ بمثل ما رفع المعتزلة الشك فوق الإيمان عن طريق التقليد. وبمثل ما فعل الغزالي؛ إذْ حدّد ـ بوجوب النقد ـ مراتب المعرفة والإيمان في ثلاث مراتب. الأولى : إيمان العوام. وهو إيمان تقليديُّ محض تقليد. والثانية : إيمان المتكلمين, وهو ممزوج بنوع الاستدلال؛ ودرجته قريبة من درجة إيمان العوام. والثالثة : إيمان العارفين، وهو الإيمان المُشَاهَدُ بنور اليقين.
وبمثل ما وضع ابن رشد هذه الخاصة الفلسفية موضعها الصحيح؛ فرفع الإيمان مراتب إلى الأدلة البرهانية ـ والبرهان من علامات اليقين عنده ـ على الإيمان عن طريق الخطابة والجدل والتقليد أو عن طريق الجدل الكلامي بعد أن نقد الفرق الكلامية، أشاعرة ومعتزلة، نقداً عنيفاً، فكان نقده معبراً عن منهجية نقدية متميزة.
وكذلك فعل ابن طفيل فنقد الفارابي، وابن سينا، والغزالي، وابن باجه، وغيرهم من فلاسفة كبار. ولا تخلو الحركة الفلسفية في الإسلام في القديم والحديث، ولن تخلو على الإطلاق، من تبعة النقد الفاعل في التفكير الفلسفي على وجه العموم.
ثم بعد هذا النقد المشروع الذي يدل على استفادة كبيرة من آراء هؤلاء الفلاسفة، يأتي الفيلسوف بمذهبه الخاص وبرؤيته الفلسفية التي إنْ دلت على شئ، فإنما تدل أكبر دلالة على التزامه بالخصائص الفلسفية مميزة للتفكير الواعي والرشيد، وهو في تفكيره الهادئ المتزن لم يكن عازفاً عن التخلي عن آراء يعتقد بها فيما لو وجد آراءً أخرى جديرة بأن يسلم بها وتتوافر لديه ماصدقاتها، إذا رأى فيها الأفضلية والقناعة والاستمرار.
هذه بغير ريب سمة التفكير المنطقي على كل حال يقود إلى منهج النقد ورعاية التقييم والاعتراض بالحجج والأدلة المنطقية كما يقودُ إلى ثقافة التنوير أكثر مما يقود إلى الخطأ والتضليل. وتلك السِّمة البارزة ينبغي أن نقتدي بها ونهتدي؛ فلا ننظر إلى أفكار الفلاسفة في بحوثنا الجديدة إلا بتطبيق معيار التحليل النقدي فلا نقبل منهم سوى ما يتفق ونهضة حاضرنا المعاصر، حتى نكون جديرين بشرف النسبة إليهم وممارسة حاضرتنا الواقعية كما تنبغي أن تكون الممارسة وتصلح لزمن غير الزمن الذي عاشوا فيه.
أمّا أن نوافق الفلاسفة وتخضع لهم خضوع المنقاد، وكأنهم هبطوا علينا من عنان السماء، فهذا ضرب من العته العقلي غير مقبول ولا معقول. ناهيك عن أنهم أنفسهم لم تتقرّر لديهم مثل هذه التبعية المنقادة في عالم الرأي والتفكير. ولم يفرضوا على أحد رأي ولا فكرة، ولم يحجبوا عن أحد حرية الرأي والتفكير، ولكنهم جميعاً أجمعوا على أنّ الفكر الفلسفي لا ينبت إلا في جوِّ من الحرية، يتنفس هواء نقياً صالحاً للإبداع وللاستمرار.
الفيلسوف حرُّ. وحريته سرّ إبداعه الفكري. والنقد بالنسبة له شريعة فلسفية لأنه شريعة التفكير وركيزة التطور فيه، ما دامت هى ركيزة الفهم المستنير المؤسس على ربط الفكر بالواقع في أغلب الأحيان. وهذا دوره الفاعل في كل الأجيال.
فهل نستطيع موافقة ابن سينا مثلاً في بحوثه الطبيعية والطبية ونهمل أسباب التقدم في الأزمان المعاصرة؟ صحيح أنه يبدو من جملة ما ذكره في هذه البحوث صادق المجهود الذي بذله في طبيعياته؛ إذْ كان يدفعه لاكتشاف الحقيقة ما توخّاه من مثل أعلى يسعى إليه بكل قوته العاملة وطاقاته العلمية. لقد ضرب ابن سينا مثلاً علمياً نادراً في زمنه، وهو وإنْ كان وضع لبنة من اللبنات العلمية يجب أن نكملها ونتممها ولا نهملها كل الإهمال، إلا أنها قياساً إلى فعل التطور في العصور والأحقاب جاءت ساذجة بالقياس إلى تقدم العصور الحديثة والمعاصرة، إنما ننظر إليها في عصره لا في عصرنا الحاضر.
(وللحديث بقيّة)
بقلم: د. مجدي إبراهيم