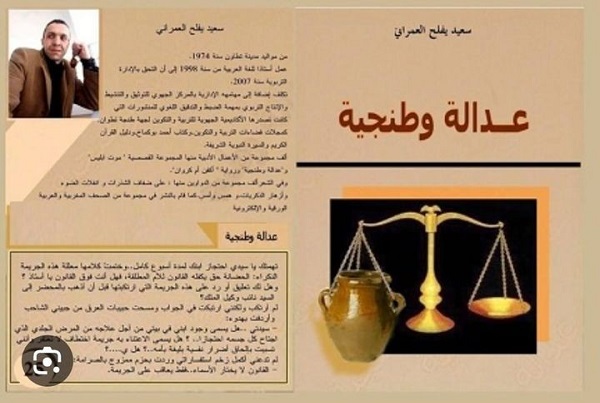شهادات ومذكرات
وداعًا أبا سعود.. الأديب العماني عبد العزيز الفارسي
 يومًا بعد يوم، يتعمّق فينا الوعي بأنّ المبدعين يرحلون مبكّرا، لا سيّما الطيّبون منهم.. فقد صدمني فجر الحادي عشر من أبريل 2022 رحيلٌ مفاجئ للزميل الأديب العماني عبد العزيز الفارسي، بعد وعكة صحية قصيرة تناسب عمره القصير الذي لم يتجاوز ستةً وأربعين عاما، ولا نقول إلى ما يُرضي ربنا: إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
يومًا بعد يوم، يتعمّق فينا الوعي بأنّ المبدعين يرحلون مبكّرا، لا سيّما الطيّبون منهم.. فقد صدمني فجر الحادي عشر من أبريل 2022 رحيلٌ مفاجئ للزميل الأديب العماني عبد العزيز الفارسي، بعد وعكة صحية قصيرة تناسب عمره القصير الذي لم يتجاوز ستةً وأربعين عاما، ولا نقول إلى ما يُرضي ربنا: إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
عرفتُه عام 2002 إثر تخرّجه في كلية الطب جامعة السلطان قابوس، فزاملَني في العمل لمدّة عام، كان في السمْت هادئا وادعا متأمّلا يُؤثر الصمت على الكلام، وفي العمل دؤوبا يعرف حقّ الزمالة ويبجّل من هم أسنّ منه ولا يأنف من السؤال.
أذكر ذات يوم، كانت مناوبته ليلية، وتسلّمتُ منه العمل في الصباح، وبات حرّا في الذهاب على عجل إلى فراش يداوي به جفونًا أثقلها السّهَر وبَدنًا كدّه الركضُ بين المرضى. وبعد نحو ساعة لمحْت سيارتَه ما زالت رابضة في مكانها! خمّنتُ أنّ النوم لم يمهله، فافترش الكرسي الخلفي وتوسّد ذراعه وراح يغطّ في سبات عميق، ولكن خاب ظني حين ذهبت أستطلع الخبر، إذ وجدته على كرسي القيادة متيقّظا مستغرقا في الكتابة، فنقرت على زجاج السيارة نقرا خفيفا يليق بمقام الكتابة، وسألته: ماذا تفعل؟ فقال: ما ترى! قلت: أ كاتبٌ أنت؟! فردّ بتواضع وخجل: نعم. ثم أخرج مجموعته القصصية (جروح منفضة السجائر) التي طُبعت حديثا عن دار الكرمل الأردنية وأهداها إليّ بعدما صدّرها بتوقيع رقيق وخطّ بديع كعادة مَن يكتبون بيُسراهم.
وفي ليلة صائفة، أغرى البحرُ زميليْن لنا، فراحا يتجوّلان بالسيارة على الشاطئ، وإذ بالإطارات تغوص في الرمال ويَعْلق الزميلان كالأسْرى خلف الأبواب، ولمّا استنجدا بي في جوف الليل، كان المنقذ هو الشهم النبيل عبد العزيز الذي اصطحب في سيارته مجموعةً من الشباب الفتيّ، ونزعوا السيارة من بين أنياب الرمال، ثمّ أودعوها الرصيفَ بأمان وسلام.
مضت السنون، وافترقنا افتراق الغرباء، فارتحل إلى أقصى الأرض بكندا للتخصص في علاج الأورام، وواصل مشواره الإبداعي في القصة والرواية، وتحصّل في مناسبات عدّة على جوائز خليجية وعربية، ودُرّست بعض إبداعاته بالمدارس. بينما رحت من آن لآخَر أستمع لأحاديثه في الإذاعة ولقاءاته القليلة في التلفاز، وأطالع بعض أخباره ومنشوراته ضمن المنشورات الأدبية.
وأثناء حديث عابر، أخبرتْني الزميلة الممرّضة العاملة معي في عيادة السكّري، أنها جارته القريبة، ولديها مجموعاته القصصية مهداة إليهم منه، وبدورها أهدتني (مسامير- لا يفل الحنين إلا الحنين- العابرون فوق شظاياهم) ليجتمع لديّ أغلب ما سطّره في السرد القصصي، بعد إضافة مجموعة (رجل الشرفة) عبر سلسلة كتاب مجلة نزوى الشهرية.
وحالما هممتُ بتحبير كتاب أحاور فيه الأطباء العرب المبدعين قبل شهور، لم أجد أقرب ولا أفضل منه ليكون واجهة عمانية مشرّفة، فتواصلْت معه وظننتُه نسي ما كان بيننا من وصال، إذ مضى ما يقرب من عشرين عاما عبرَت فيها أحداث كثيرة فوق جسر الحياة ومياه أكثر في نهره، ولكنه فاجأني بذاكرة حادّة حافلة بتفاصيل نسيتُها جملة وتفصيلا، كبعض مهارات طبية ادّعى أني علّمته إيّاها، وخرْبشات طالما خلّفتُها على المكتب بعد انتهاء مناوبتي واجتهد هو في فكّ شفرتها..
رحّب بالفكرة ودعا بالتوفيق، ثم وعد بإنجاز الحوار في أقرب وقت والمرور عليّ في العيادة أثناء عودته من العاصمة مسقط حيث يعمل كاستشاري أوّل للأورام. ولم يتوان في تزويدي برقم هاتف أحد الأطباء الأدباء في الكويت لإنجاز حوار معه وهو الطبيب الأديب خالد الصالح.
سألتُه في الحوار عن سرّ إيثاره للعزلة وهروبه من الأضواء، وعن فكرة التأليف الروائي المشترك الذي خاض غماره في رواية (شهادة وفاة كلب)، وعن عشقه لمسقط رأسه (شناص)، وعن صندوقه الرمادي الذي يغرف منه ويسرد للقراء، وعن قضايا أخرى تخصّ الطب والأدب.. ثمّ توالت الأسابيع، وقبلْت عذره في التأخير لبعض الوقت، وليتني ما فعلت؛ إذ بقي الحوار في حوزته، والوعد باللقاء على طاولة الانتظار، وغافلنا الموت فقلب الطاولة وأنهي الحوار على غير ما نرجوه ولا نتمنّاه، ولم يشفع لنا تصالحه الشديد مع هذا الموت بقوله على لسان أحد شخصياته القصصية: "سيدي الموت: إن جئت على غفلة فمرحبا بك، وغن استأذنت بمرض عضال فعلى الرحب والسعة. لن أردّك. لا حُبًّا، ولكن رغبة في معرفة المطلق".
إلى جنّة الخلد زميلي عبد العزيز، ولعلّ في بركة رمضان الماثل بيننا خير شفيع، وأشهد أنك نزّهت قلمك عن إطعام قرائك لغة غير مقشورة، لإيمانك التام بأنهم أصحّاء لا يعانون الإمساك ولا تلبُّك الأمعاء.
***
بقلم د. منير لطفي
طبيب وكاتب