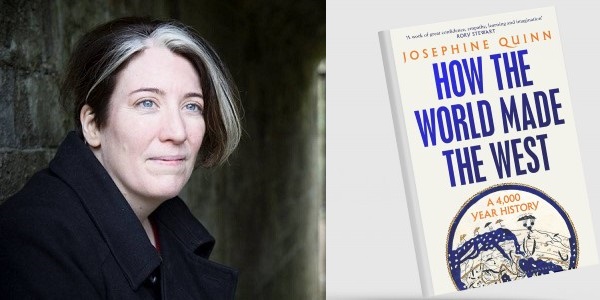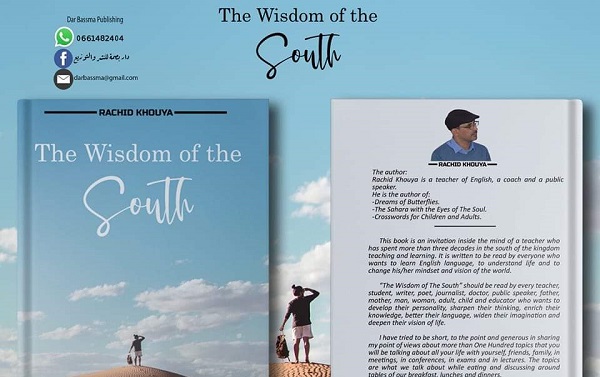قضايا
السياسة والفلسفة.. تقارب أم تضارب؟!

منذ أن أجبرت السلطة الأثينية شهيد الفلسفة الأول (سقراط) على تجرّع كأس السم الزعاف، الذي وضع حداً "لحياة ذلك الفيلسوف المشاكس والمثير للريبة من وجهة نظر خصومه ومناوئيه، والى حدود يوما هذا والسياسة تنازع الفلسفة وتناوئها بمنطق القوة والتكفير، مثلما إن هذه الأخيرة تقارع الأولى وتناهضها بمنطق العقل والتنوير. للحد الذي يشير إلى إن تاريخ العلاقة بينهما (السياسة والفلسفة) كان ولا يزال قائما"على الشك المتقابل والرفض المتبادل، وهو الأمر الذي طالما أثار ويثير إشكاليات العلاقة بين أهل السلطة والقهر من جهة، وبين أهل الفكر والنظر من جهة أخرى. خصوصا"لجهة التجاذبات والتقاطعات ما بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع حيال قضايا الحقوق والواجبات والحريات والممنوعات، وما قد يترتب على هذه العلاقة من ترسيم للحدود وتأطير للتخوم التي غالبا"ما يتم تخطيها أو إزالتها من قبل هذا الطرف أو ذاك، وفقا" لتغيرات ميزان القوى بينهما وطبيعة السياقات المترتبة عليها والمعطيات المتمخضة عنها.
والحال هل يمكن اعتبار هذه العلاقة الموسومة بالتنافر والتباغض بين فكرة القوة وقوة الفكرة، هي من نمط العلاقات الثابتة والتواضعات القارة في حقل الاجتماع الإنساني، أم أنها مرهونة بطبيعة القوى السياسية والأوضاع الاقتصادية والظروف الاجتماعية والشروط والحضارية والسياقات التاريخية، التي تحدد لتلك العلاقة شروط صيرورتها وبالتالي حدود تلك الصيرورة ؟!. ولكي لا نتوه في خضم هذه المطارحات النظرية والسجالية، يمكننا – في بداية الأمر - الاسترشاد بفحوى الحقيقة التي مؤداها ؛ إن علاقة (الفكر) بشكل عام و(الفلسفة) على نحو خاص بعناصر الحقل السياسي، لا يمكن استخلاصها مباشرة بالاعتماد على ماهية الدولة القائمة ونمط السلطة الحاكمة، ذلك لأن حصيلة ذلك هي بمثابة حاصل تحصيل لأواليات وديناميات وتفاعلات وصراعات لا تنتهي، فيما بين البنى الاجتماعية والأنماط الاقتصادية والأطر الثقافية والأنساق القيمية والتمثلات الرمزية.
ولعل ما يزيد الأمر صعوبة في إطار هذا المبحث هو انه بقدر ما يكون المجتمع في أطواره الأولى من الحضارة، بقدر ما يعتمد تبلور أفكاره السياسية وتصوراته الفلسفية على حصيلة تلك الأواليات والديناميات والتفاعلات والصراعات وبالعكس. أي بمعنى انه في حالة كون المجتمع المعني يعيش في ظل ظروف تتسم بتداخل البنى الاجتماعية المختلفة، وتعايش الأنماط الاقتصادية المتباينة، وتشابك الأطر الثقافية المتعددة، وتناضد الأنساق القيمية المتنوعة، وتراكم التمثلات الرمزية المتعارضة. فانه من غير المجدي الركون إلى تحديد ماهية الدولة القائمة (ديمقراطية أو شمولية)، لاستخلاص طبيعة العلاقة ما بين السياسة والفلسفة، سواء في حالة التجاذب والتقارب أو في حالة التنابذ والتضارب بينهما، فذلك يعتمد – كما بيّنا – على سيرورة البنى ودينامية العلاقات وتفاعل التصورات، التي تضفي على المجتمع المقصود الطابع السياسي المتناسب مع مستوى نضوج وعيه الاجتماعي وتطور سياقه الحضاري. ذلك لأن الخصائص (الديمقراطية) أو (الشمولية) للسلطة السياسية لا تتأتى عن طريق الدولة مباشرة وبصور أوتوماتيكية، وإنما تصبح السلطة كذلك بناء على معطيات اجتماعية خاصة، واقتصادية نوعية، وثقافية محددة، وحضارية معينة.
وعلى هذا الأساس تختلف علاقة السياسة بالفلسفة - قربا"أو بعدا"- من مجتمع لآخر ومن دولة لأخرى، وفقا"لتباين التشكيلات الاجتماعية – الاقتصادية – الحضارية (بحسب التصور الماركسي) التي تجعل من نمط تلك العلاقة يبدو بهذا الشكل دون ذاك. ففي المجتمعات التي بلغت أطوارا" حضارية متقدمة وعلاقات اجتماعية متطورة، ودلفت من ثم إلى أروقة التوافق السياسي والانسجام الثقافي والتجانس القيمي، نجد إن علاقة السياسة بالفلسفة تمتاز بالتلاحم العضوي والتخادم الوظيفي، بحيث إن الأولى تدعم الثانية ماديا"وتشجعها مؤسسيا"، هذا في حين إن الأخيرة تجتهد لاجتراح أفضل السبل وانجح الوسائل الممكنة التي من شانها تسهيل مهام الدولة في بناء مجتمع ينعم أفراده وجماعاته بالرخاء المادي والاغتناء الروحي. وهو ما يسهم في تفتح شخصية الإنسان وتنامي إبداعاته العلمية والفكرية والثقافية، عبر تحرير طاقاته الحبيسة وإطلاق العنان لقدراته المعطلة.
وبالمقابل، ومن منظور مختلف، نجد إن المجتمعات التي لم تبرح تتعثر بمخلفات أطوارها البدائية، حيث تنازع البنى الاجتماعية البطريركية والليبرالية من جهة، وتقاطع الأنماط الاقتصادية الإقطاعية والرأسمالية من جهة ثانية، وتصارع الأنساق الثقافية التقليدية والحداثية من جهة ثالثة، والتي من أبرز آثارها وعواقبها استمرار قوى المحافظة والتقليد على مناهضة كل ما له علاقة بتغيير العلاقات الاستزلامية على صعيد السياسة، وتحرير الإرادات الاستتباعية على صعيد الاجتماع، وتنوير العقليات التعصبية على صعيد الثقافة، وبالتالي إبقاء الإنسان حبيس قيود الخرافات الدينية والتراتبيات الاجتماعية والتمايزات الاقتصادية المفاضلات السياسية، بحيث يتعذر عليه إدراك ماهيته الإنسانية ومعرفة المطالبة بحقوقه المشروعة. وهنا نكون قد وصلنا إلى مفترق طرق حيث الإشكالية المزمنة والمتمثلة برفض السياسة للفلسفة وبغض السياسيين للفلاسفة.
***
ثامر عباس