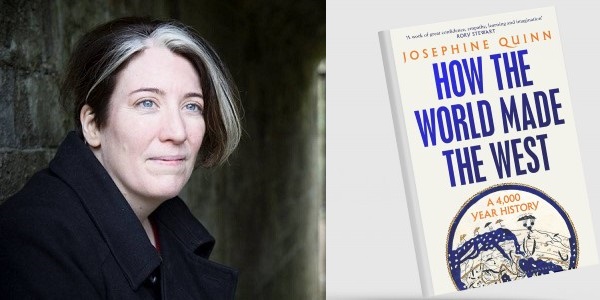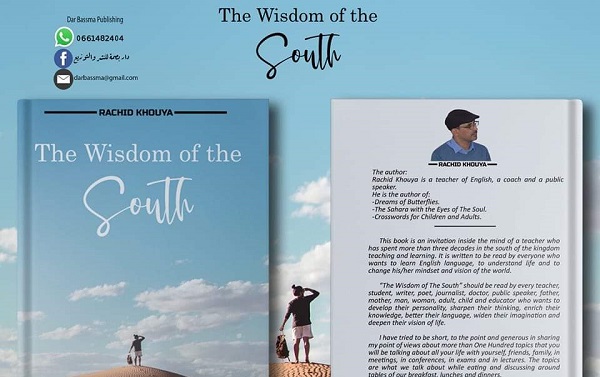قضايا
التغيير.. بحاجة إلى حامل قيمي وأخلاقي

يقول المهاتما غاندي: ” كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في هذا العالم “. فمنذ قديم الزمن كان من بين البشر من يعتقد أن الثبات وعدم التغير هو الصورة الفعلية للوجود والمجتمع، ومن بينهم أيضاً من اقتنع أن التغير والتحول هو الصورة الفعلية الكامنة في الفرد والجماعة والمجتمع. ومن المؤيدين للموقف الأول الفيلسوف اليوناني " بارمنيدس " الذي ذهب إلى أن الوجود هو الحقيقة الأزلية، وأن الحقيقة كائن ثابت غير متغير، أما التغير فهو عبارة عن وهم من الأوهام. ومن المؤيدين للموقف الآخر: الفيلسوف اليوناني " هيرقليطس " صاحب المقولة الشهيرة: ) لا يمكن للإنسان أن يستحم في النهر الواحد مرتين (فأنت لست أنت، والنهر ليس النهر. إشارة إلى التغير الكامن في البشر والوجود.
تبني هيرقليطس لهذا الموقف لم يكن فيه مخترعاً لأمر جديد بقدر ما كان ملتقطاً لمشهد مسلماً به من سيرة الطبيعة والحياة أي مكتشفاً لأمر موجوداً. ولكن من الصعب القول بأنه اكتشف ما لم يسبق إليه، لأن التغير في مختلف الحياة والطبيعة ومناحيها أمر معروف لعامة الناس، فهو لا يعدو كونه وصفاً لظاهر يدركه أقل الناس ثقافة وربما وعياً، وخاصة أن هذه الظاهرة قديمة قدم الإنسان. لكن تكمن أهمية هيرقليطس على أية حال هي أنه استطاع أن يصوغ من حالة التغير هذه فلسفة أو رؤية فلسفية ستغدو مذهباً أو مدرسة يسير على هديها المفكرون. وبعد أكثر من ألفي سنة جاء من فَخَر بالانتساب إلى هيرقليطس وفَخَر بتجاوزه، وهو كارل ماركس Karl Marx الذي أعاد الكرة ذاتها بالانتقال من المعرفة الشائعة المسلم بها في الممارسة اليومية، إلى النظرية الفلسفية للفكرة ذاتها بعد إعادة صوغها من جديد في قالبٍ جديدٍ عندما قال: " ليست مهمة الفلسفة تفسير العالم وإنما تغييره "، وفي إشارة منه بذلك إلى أن الفلاسفة لم يقوموا إلا بتفسير العالم بطرق مختلفة، بينما الواجب هو تحويل العالم. لذا يجب على الفلسفة بعد هذا التوضيح الالتفات إلى تفعيل مهمتها الجديدة في العمل على تغيير العالم تمهيداً لإعادة بناء عالم الإنسانية حسب ماركس. هذه المهمة التي علّقها ماركس على كاهل الفلسفة ليست جديدة أيضاً ولا هي اكتشاف، فقد أدركها الفلاسفة منذ القدم ولكن ينحصر فضل كارل ماركس في أنه صاغ هذه الفكرة في قالب نظرية فلسفية ستؤدي أيضاً دوراً بارزاً في تاريخ الفكر البشري. فالتغير بهذا المعنى ظاهرة طبيعية تخضع لها ظواهر الكون وشؤون الحياة بالإجمال. وهو من أكثر مظاهر الحياة الاجتماعية وضوحاً. وفعل التغيير ممارسة قام بها الإنسان في مختلف الميادين منذ القديم، في الطبيعة والأخلاق والسياسة والاقتصاد والاجتماع وغير ذلك.
بناءً على ما تقدم، تتصف المجتمعات الإنسانية بالتغير المستمر، فالتغير صفة ملازمة للحياة الاجتماعية، وآثاره واضحة في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية، فالنظم الاجتماعية والعلوم والعادات والتقاليد والقيم وأنماط السلوك جميعها معرضة للتغير بين فترة زمنية وأخرى، ولذا كان موضوع التغير الاجتماعي واحداً من أهم الميادين التي يعنى بها علم الاجتماع، بل اعتبره بعض علماء الاجتماع الموضوع الرئيسي لهذا العلم على اعتبار أن المجتمعات لا تتوقف عن عملية التغير. فهو ظاهرة اجتماعية.
ومن الملاحظ، أن معظم علماء الاجتماع يستجيبون لمعطيات التغير الاجتماعي بوصفهم أفراد ملتصقين بواقعهم الاجتماعي، من خلال تشكيل الإيديولوجيات المعلنة والخفية بأساليبهم السوسيولوجية المختلفة، لكي يفسروا ويشرحوا التغيرات التي تصيب الحياة الاجتماعية.
وتظهر هذه التغيرات دائماً على شكل أزمات في المجتمعات المعاصرة، حيث تشكل فيها الأزمة السياسية العامل الأبرز الذي يطفو على سطح الواقع الاجتماعي.
وفي حقيقة الأمر، لا تعني هذه الأزمات أن صورة الحياة الاجتماعية ثابتة أو جامدة، حتى لو أراد علماء الاجتماع عدم التفات إلى حركة التطور وجريانها في تلك المجتمعات، لكن بالمقابل نجد أن علماء الاجتماع وهم يراقبون ما يحدث يساهمون بشكل أو بآخر في التجربة المباشرة لصناعة الحدث الاجتماعي.
ويمتلك عالم الاجتماع مستويين أساسيين لمواجهة وتحليل وتفسير التغيرات التي تحدث، وهما: التحليل المادي للمجتمع، والإيديولوجيا. فهو عملياً (أي عالم الاجتماع) يطرح وصفاً وتفسيراً عاماً لمجريات الحياة الاجتماعية والإيديولوجية التي تعبر عن رؤيته الشخصية، وافتراضاته الضمنية، والمركز الاجتماعي الذي يشغله داخل البناء الاجتماعي.
ربطاً مع ما تقدم نجد أن موقف علماء الاجتماع مما يحدث بالمنطقة العربية من تغيرات دراماتيكية موقف يتصف بتذبذب حول طبيعة ما يجري. لكن بطبيعة الحال ينبؤنا هذا الوضع أن ما يحدث في العالم العربي ليس نتيجةً لفساد الأنظمة السياسية ونخبها والأزمات التي تعيشها مع شعوبها بكافة الأصعدة فقط، وإنما أيضاً نتيجة الأزمات الداخلية غير المعلنة التي يعاني منها البناء الاجتماعي لتلك البلدان المتمثلة بالفساد الأخلاقي، والقيمي، والاجتماعي. لكن بطبيعة الحال تتصدر الأزمة السياسية المشهد الرئيسي لتمثل السبب الأولي لكل المشاكل التي يعاني منها المجتمع، وهذا ليس بصحيح.
فلو كان سبب الأزمات التي نعاني منها الأنظمة السياسية مع تثبيت كل العوامل والمتغيرات لوجدنا نجاحاً باهراً لتحقيق دافعيات التغيير الاجتماعي والسياسي بالمنطقة، لكن فقدان الحامل الأخلاقي والقيمي وتصدع البناء الاجتماعي والثقافي حال دون تحقيق تلك الغايات المنشودة من عملية التغيير. فدخلت تلك المجتمعات بعملية إعادة إنتاج الذات بأطياف وألوان مختلفة تناسب الإيديولوجيا السائدة التي تدغدغ العواطف والمشاعر، والتي تهتم بالمظهر دون الجوهر.
فليس كل تغير تقدم وإنما يمكن أن يكون خطوة إلى الوراء، والدليل على ذلك أن التقدم الاجتماعي Social Progress هو تغير المجتمع من حالة إلى حالة أفضل سواءً في الجوانب المادية أو المعنوية، ويشير إلى عملية مستمرة بمقتضاها ينتقل المجتمع الإنساني من حالة إلى حالة أفضل، أو يسير في اتجاه مرغوب.
ارتبط التقدم ببعض النظريات القرن التاسع عشر سواء في فلسفة التاريخ (كما في نظرية كوندرسيه) أو في مجال علم الاجتماع (نظرية أوغست كونت)، حيث أكدت هذه النظريات على أن التاريخ يسير في خط تقدمي، أوشك أن يبلغ ذروته، بعد الثورة الصناعة والديمقراطية.
ويُعرّف أيضاً بأنه العملية التي تأخذ شكلاً محدداً واتجاهاً واحداً مستقيماً يتضمن توجيهاً واعياً مخططاً ومقصوداً لتوجيه عملية التغير نحو الأمام، بهدف تحقيق بعض الأهداف المرسومة والمنشودة المقبولة، أو الأهداف الموضوعية التي تنشد خيراً أو تنتهي إلى نفع، كما يشير إلى التحسن الإيجابي المستمر الصاعد نحو الأمام، وينطوي على مراحل ارتقائية، أي أن كل مرحلة تالية أفضل من سابقتها من حيث الثقافة والقدرة الإنتاجية والسيطرة على الطبيعة، بينما (التغير الاجتماعي) قد يكون إيجابياً أو سلبياً، أي تقدماً وازدهاراً أو تخلفاً وتأخراً ونكوصاً.
ومن هنا يستدل على الاختلاف بين المفهومين: التقدم الاجتماعي والتغير الاجتماعي، إذ الأول يحمل معنى التحسن المستمر نحو الأمام، أي أنه يسير في خط صاعد، في حين أن التغير قد يكون تقدماً أو تخلفاً، وبالتالي يكون مصطلح التغير أكثر علمية، لأنه يتوافق وواقع المجتمعات (واقع التقدم وواقع التخلف)، فالمجتمعات ليست دائماً في تقدم مستمر وإنما يعتريها التخلف أيضاً.
وهكذا فإن التغيير بحاجة إلى حامل قيمي وأخلاقي. فالباطل لا يدحض باطل، إنما الحق هو الذي يقضي على الباطل، والعدل أساس الملك. لذا ليس كل تغير خطوة إلى الأمام بل من الممكن أن يكون خطوة إلى الوراء. ويقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز (إنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ) (الرعد الآية :11).
والدليل الجازم على ما نقول هو فشل عملية التحول الديمقراطي في معظم البلدان العربية التي قامت بها ثورات ضد أنظمتها السياسية، ويمكننا إرجاع أسباب الفشل بشكل أساسي إلى غياب الحامل الأخلاقي والقيمي وتفشي الفساد والارتهان الإيديولوجي والسياسي لمعظم الفاعلين الثوريين الذين يقودون علمية التغيير في بلدانهم، مما إلى تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة للشعوب.
***
د. حسام الدين فياض
الأستاذ المساعد في النظرية الاجتماعية المعاصرة
قسم علم الاجتماع كلية الآداب في جامعة ماردين- حلب سابقاً