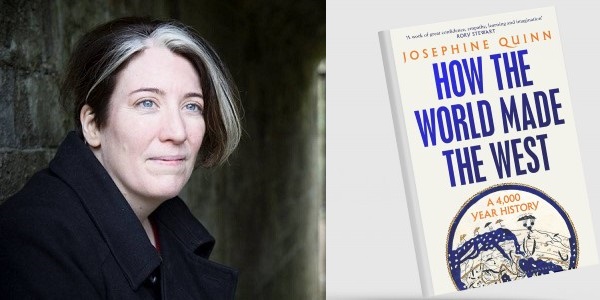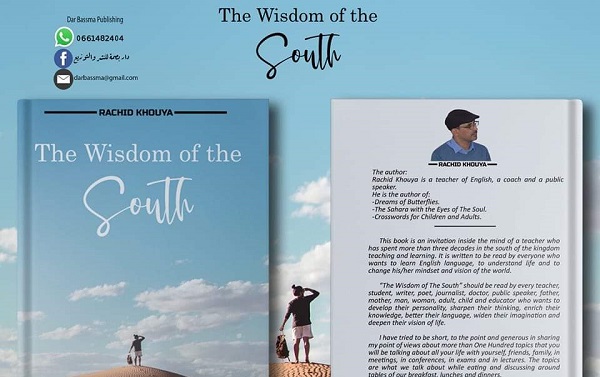قراءة في كتاب
وقـفة مع كتاب: التحليل الجديد للشعر للدكتور عبد الملك مرتاض

(معالجة تحليليّة لِخَمْسِ القصائدِ التي قُدِّمت في نهائيّ الموسم السادس لأمير الشعراء)
مقدمة: احتلّ الفكر الشعري في الثقافة العربيّة مكانة مرموقة، وحظي بعناية فائقة؛ إذ أسهم في تراكم المعرفة، وكما وًف من لدن القدماء؛ فهو علم العرب الذي ليس لهم علم غيره، والحقّ أن الشعر يتميز من مجموع الفنون الراقية، والجميلة بضرورة انطلاقه من مضامين فكرية ظاهرة في صريح العبارة، وإنه«ليتهيأ للمنشئ أن يؤلف من مواد اللُّغة كلاماً هادفاً خالياً من كل نفحة شعرية، ولكن لا يتهيأ له بحال أن يؤلف كلاماً شعرياً من دون مضمون فكري إلى حدّ ما معقول على عكس ما يتهيأ للفنان في الموسيقى أو التمثيل؛ فقد يوضع الحن الموسيقي على (كلمات) منظومة، كما قد تبنى التمثيلية على قصة محكية، ولكنّ الأصل في الموسيقى أن تؤسس على الأصوات وحدها، وفي التمثيل أن يؤسس على الحركة التشخيصية؛ فالموسيقى تنطلق من أصوات مجردة قد يكتفى بها لإنتاج لوحات فنيّة طريفة، والتمثيل ينطلق من حركات تشخيصية مجردة قد يكتفي بها لإعداد مشاهد فنيّة رائعة، أما الشعر فلا انطلاق له إلا من مضمون فكري، ولكنه لا يسمو إلى درجة الفنّ المتميّز إلا بما يتجاوز به المضمون الفكري من إمكانيات الأداء ». (محمد الهادي الطرابلسي، 1981م، ص:10) . ولعل من أبرز المفاهيم التي انشغل بها النقاد العرب، وانكب على تحليلها الفكر النقدي العربي طويلاً، ومازالت إلى أيامنا هذه تشكِّل هاجساً مؤرقاً بالنسبة إلى كثير من الدارسين، مفهوم (الشعر)، أو مفاهيمه المتعددة، والمتنوعة، والتي تخص الشعر كدلالة، ومنطوق فني، وأبرز الرؤى التي قدمت عنه انقسمت إلى شقين رئيسين:
أ- قسم يخص نقاداً تحصنوا برؤى فلسفية، وانكبوا على دراسة الفلسفة، فأتى مفهومهم للشعر على درجة كبيرة من العمق، والوعي، والفهم الدقيق كما هو الشأن في بعض الرؤى، والأفكار التي قدمها السجلماسي.
ب- في حين أن أصحاب القسم الثاني يبدو أنهم ائتزروا بمئزر المحافظة الخجولة، وانغلقوا على أنفسهم، فاستهلكوا التراث، ولم يتجاوزوا ذلك . (مسلك ميمون، 2001م، ص:129) .
في كتاب :« التحليل الجديد للشعر (معالجة تحليليّة لِخَمْسِ القصائدِ التي قُدِّمت في نهائيّ الموسم السادس لأمير الشعراء) »، للناقد المعروف الدكتور عبد الملك مرتاض، والصادر عن أكاديمية الشعر، في هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة والتراث، بدولة الإمارات العربية المُتحدة؛ نلفي دراسة علميّة مُتميّزة، ناقش فيها الباحث عدة قضايا تحتل منزلة فائقة في الشعرية العربية.
أولاً: الشعريات والشعر: محاولة لتحديد المفاهيم:
عرفت الشعريات تطورات ملحوظة على مستوى الحركة العلمية، والدراسات النقدية الحداثية، حيث إنها شهدت ارتقاء في البحث، والمُساءلة العلمية الجادة، و حظيت في السنوات الأخيرة بعناية فائقة من قبل الباحثين، والدارسين، فأفردت لها دراسات، ورسائل جامعية ضمن دراسات الأدب القديم والحديث، ومفهوم«الشعرية أو الشعريات الذي لقي اهتماماً كبيراً في الفترة المتأخرة، سواء في النقد العربي أم النقد الأجنبي له جذور تراثية قديمة وآفاق غربية معاصرة، وهذا الاستخدام بوصفه مصدراً صناعياً لا على صيغة النسب هو ما يعطيه طرافته وطزاجته النقدية، وإلا فالكلمة مبتذلة وشائعة، ومنذ أرسطو كان يتحدث عن جوهر الشعر الحقيقي وما يلتبس به من المحاكاة والتخييل، واستخدمه بهذا المعنى عدد من نقاد العرب بنفس الصيغة مثل حازم القرطاجني (ت 684هـ)، وشراح أرسطو من فلاسفة الإسلام كالفارابي وابن سينا وابن رشد.وظهر مصطلح ( poetics) في النقد الغربي الحديث كوريث شرعي للبنيوية والأسلوبية ليردها إلى الوظيفة الشعرية في الخطاب اللغوي بعد أن تعاظم الاهتمام في المناهج السابقة (بالشفرة) اللغوية وكيف انبثقت إلى الوجود؟أي باللغة نفسها بوصفها دالاً، لا لما تحمله من مدلولات، وهناك عدد من المصطلحات العربية التي ترجم إليها المصطلح مثل (الإنشائية) و(الأدبية) وغيرها...، وتبحث الشعرية عن قوانين الخطاب الأدبي، وعن الخصائص المجردة التي تصنع فرادة العمل الأدبي، أي بصورة أخرى ما الذي يجعل من الرسالة اللغوية عملاً أدبياً (شعرياً) ثم أخذت معنى أوسع لتعني ذلك الإحساس الجمالي الخاص الناتج عن القصيدة أو عن نص أدبي، أي بعبارة أخرى قدرة العمل على إيقاظ المشاعر الجمالية، وإثارة الدهشة وخلق الحسن بالمفارقة، والانزياح عن المألوف... » (إبراهيم عبد المنعم إبراهيم، 2008م، ص:02) .
ولقد ركز النقد العربي في رصده لمختلف القضايا الشعرية، على بعض المفاهيم الجمالية التي يجب أن تتوفر في النص الأدبي، حيث إن الجمال بمفهومه العام، والسطحي عبارة عن عملية تأثرية ناتجة عن رؤية، وتبصر في الأشياء الجميلة، ومنذ العصور التليدة اهتم فكر الإنسان بقضية الجمال، وما يزال مشغوفاً بها إلى أيامنا هذه، ويبدو أنه سيظل كذلك إلى النهاية، وللجمال جملة من الأبعاد المعرفية الخاصة، التي تقتضيها طبيعة الثقافات الاجتماعية، وهو «ينعكس على مختلف مجالات الحياة الإنسانية، وخاصة في أنواع الفنون لديها، ولكل حضارة مفهوم للجمال ينسجم مع نظرية المعرفة فيها، ويعكس ثقافتها، وقد كان للعرب المسلمين فهمهم الخاص للجمال الذي انطلقوا فيه من الأسس المعرفية للثقافة العربية الإسلامية، وقد اهتموا اهتماماً واضحاً بتحليل الجمال، وتنظيره، ولا ننكر أنهم كانوا مدفوعين إلى ذلك بتأثير المنطلقات الجمالية المتأصلة في العقيدة الإسلامية، وغنى الثقافة الإسلامية من جانب، وبتأثير الازدهار الحضاري المادي من جانب آخر، لذلك فقد قدموا أسساً جمالية متميزة، ومستمدة من خصائص الثقافة العربية الإسلامية»». (راوية جاموس، 2013م، ص:216)، وهناك مجموعة من النقاد العرب المعاصرين الذين تناولـوا »الشعرية« بالدراسة والبحث، فلم يعرفوها تعريفا واضحا كما لم يفرقوا بينها وبين الشعر، ولكنهم أداروا حولها بحوثا تتلخصُ في البحث عن قواعد الشعر العربي، وقوانينه التي تتحكم في الإبداع الشعري، كما هو الحال عند رشيد يحياوي، ونور الدين السد، وحسن ناظم، وأدونيس، أمّا الذين حاولوا تحديد مفهوم » الشعرية « من النقاد العرب المعاصرين فإنّهم لم يعطوها تحديدًا واحدًا فقد كان مفهومها عندهم مختلفًا عّما تعنيه » الشعرية« في النقد الغربي، إذ » ليس للشعر أو (الشعرية) مفهوم مطلق، وإنَّ هذا المفهوم عرفٌ يكتسب دلالته من المرحلة التاريخية والحضارية التي يعيش فيها الشاعر والباحث . ويذهب أدونيس إلى أنّ » سرّ الشعرية هو أنْ تظل دائما كلامًا ضد الكلام، لكي تقدر أن تسمّي العالم وأشياءه أسماء جديدة – أي تراها في ضوء جديد – والشّعر هو حيثُ الكلمة تتجاوز نفسها مُفْلِتَةً من حدود حروفها، وحيثُ الشيءُ يأخذُ صـورةً جديدةً، ومعنى آخر، ». (أدونيس، 1971م، ص:78) ويرى أدونيس أن قصيدة نثرية يمكن أن لا تكون«شعراً ولكن مهما تخلص الشعر من القيود الشكلية والأوزان، ومهما حفل النثر بخصائص شعرية، تبقى هناك فروق أساسية بين الشعر والنثر.أول هذه الفروق، هو أن النثر اطراد وتتابع لأفكار ما، في حين أن هذا الاطراد ليس ضرورياً في الشعر.وثانيها، هو أن النثر ينقل فكرة محدودة، ولذلك يطمح أن يكون واضحاً.أما الشعر فينقل حالة شعورية، أو تجربة، ولذلك فإن أسلوبه غامض بطبيعته.والشعور هنا موقف، إلا أنه لا يكون منفصلاً عن الأسلوب كما في النثر، بل متحد به.ثالث الفروق هو أن النثر وصفي تقريري، ذو غاية خارجية معينة ومحدودة.بينما غاية الشعر هي في نفسه، فمعناه يتجدد دائماً بحسب السحر الذي فيه، وبحسب قارئه. هذا يعني، بتعبير آخر، أن طريقة استخدام اللغة مقياس أساسي مباشر في التمييز بين الشعر والنثر». (أدونيس، 1971م، ص:112)، وينطلق أدونيس من وصف التعبير الشعري الجديد بأنه تعبير بمعاني الكلمات وخصائصها الصوتية والموسيقية، والقافية هي جزء من هذه الخصائص لا كلها، وهذا ما يجعله يخلص إلى أنها ليست من خصائص الشعر بالضرورة، أي أن الشكل الشعري الجديد هو، بمعنى ما، عودة إلى الكلمة العربية، إلى سحرها الأصلي، وإيقاعها، وغناها الموسيقي والصوتي. كما يشير كذلك إلى أن في قصيدة النثر موسيقى «لكنها ليست موسيقى الخضوع للإيقاعات القديمة.بل هي موسيقى الاستجابة لإيقاع تجاربنا وحياتنا الجديدة، وهو إيقاع يتجدد كل لحظة. تتضمن القصيدة الجديدة، نثراً أو وزناً مبدأ مزدوجاً: الهدم، لأنها وليدة التمرد، والبناء لأن كل تمرد على القوانين القائمة، مجبر ببداهة، إذا أراد أن يبدع أثراً يبقى، أن يعوض عن تلك القوانين بقوانين أخرى، كي لا يصل إلى اللاعضوية واللاشكل.فمن خصائص الشعر أن يعرض ذاته في شكل ما، أن ينظم العالم، فيما يعبر عنه. إن الشعر بطبيعته، يرفض القيود الخارجية، يرفض القوالب الجاهزة والإيقاعات المفروضة من الخارج، وهو يتيح طواعية شكلية إلى أقصى حدود التنوع، بحيث إن القصيدة تخلق شكلها الذي تريده، كالنهر الذي يخلق مجراه. التغير لا الثبات، الاحتمال لا الحتمية ذلك ما يسود عصرنا، والشاعر الذي يعبر تعبيراً حقيقياً عن هذا العصر هو شاعر الانقطاع عما هو سائد ومقبول ومعمم، هو شاعر المفاجأة والرفض، الشاعر الذي يهدم كل حد، بل الذي يلغي معنى الحد، بحيث لا يبقى أمامه غير حركة الإبداع وتفجرها في جميع الاتجاهات.هكذا تتجه القصيدة العربية لكي تصبح ما أسميه (القصيدة الكلية)، القصيدة التي تبطل أن تكون لحظة انفعالية، لكي تصبح لحظة كونية تتداخل فيها مختلف الأنواع التعبيرية، نثراً ووزناً بثاً وحواراً غناء وملحمة وقصة». (أدونيس، 1971م، ص:116) .
أمّا كمال أبو ديب فيحدد تعريفه لمفهوم الشعرية بقوله : » لا يمكن أنْ توصف الشعرية إلا حيثُ يمكن أنْ تتكون أو تتبلور، أي في بنية كلية، فالشعرية إذن خصيصة علائقية، أي أنَها تجسد في النّص لشبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونّات أولية سِمَتُها الأساسية أنّ كُلا منها يمكن أنْ يقع في سياق آخر دون أنْ يكون شعريا، لكنّه في السياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات، وفي حركته المتواجشة مع مكوّنات أخرى لها السّمةَ الأساسية ذاتُها يتحول إلى فاعلية خلق للشعرية، ومؤشر على وجودها«» (كمال أبو ديب، 1987م، ص:92) .
ويبدو أنَّ كمال أبوديب قد تخلى عن المفهوم القديم للشعرية العربية، واقترب من مفهوم الغرب لمصطلح الشعرية، الذي ركز بعض نقاده (الغرب)، على الجوانب الجمالية، كما ألفينا هذا التركيز، والاهتمام في الرؤى، والأفكار التي قدمها فاليري، حينما أشار إلى أن اسم شعرية يتفق مع كل ماله صلة بإبداع الكتب، وتأليف الأسفار، حيث تغدو اللغة هي الجوهر، والوسيلة، لا بالرجوع إلى المعاني التي يراها ضيقة، والشعرية تُفهم كذلك على أنها جملة من القواعد، أو المبادئ الجمالية التي لها صلات وطيدة بالإبداع الشعري، فالجانب الجمالي كثيراً ما يحضر مع دلالات الشعرية. (سعد بوفلاقة، 2007م، ص:22) .
ومن المفيد أن نشير إلى أن من بين الذين ناقشوا إشكالية الكتابة الأدبيّة والشعرية بين اللّغة واللّسان، الناقد عبد الملك مرتاض الذي أكد في مناقشته لهذه القضية الشائكة على أن كلّ أدب محكوم عليه بأن ينضويَ تحت لواء لغة ما. فاللّغة (من حيث هي نظامٌ صوتيّ ذو إشارات وعلامات مصطلَحٌ عليها فيما بين مجموعة من النّاس في زمان معيّن، وحيز معين) هي التي، وذلك بحكم طبيعتها الأداتيّة التّبليغيّة، تحتوي على ما يمكن أن نصطلح عليه في اللّغة العربيّة مقابلاً للمفهوم الغربيّ (Langage littéraire) «اللّغة الأدبيّة». ويؤكد الدكتور عبد الملك مرتاض على أنه لابد من الاِستظهار بالتّاريخ الذي «يمكن أن يحدّد لنا، بدقّة ما، العَلاقاتِ القائمةَ بين اللّغة الأدبيّة، ولغة أدب ما (Langue d’une littéra¬ture) ؛ أو، إن شئت، بتعبير لسانيّاتيّ تقنيّ، بين اللّغة واللّسان. واللّغة واللّسان مفهومان مختلفان منذ قريب من قرنين من الزّمان. فاللّغة الأدبيّة كأنّها المعجم الفنّيّ الذي يصطنعه كاتب من الكتّاب، أو يردّده في كتاباته كلغة الحريريّ في مقاماته فيعرف بها، وتعرف به. ومثل هذه اللّغة هي التي تحدّد طبيعة التّفرّد الذي يتفرّد بها كلّ أديب عملاق. وأمّا اللّسان فهو مجموعة القواعد النّحويّة والصّرفيّة، والألفاظ المعجميّةِ الأوّليّةِ الدّلالةِ، أو ذات الدّلالة العامّة التي يغترف منها جميع الأدباء والكتّاب. فاللّغة الأدبيّة هي الخصوصيّة التي يتفرّد بها الأديب؛ في حين أنّ اللّسان يمثّل الرّصيد، أو المخزون العامّ لكلّ الذين يستعملون لغة ذلك اللّسان. ويكون اللّسان، في مألوف العادة، أداةً للتّعبير مشتركةً ضمن محيط جغرافيّ. وقد يتميز هذا اللّسان، أثناء ذلك، بأنّه كائن اجتماعيّ يتطوّر إذا تطوّر متحدّثوه، وينحطّ إذا انحطوا هم أيضاً: اجتماعيّاً وحضاريّاً وتكنولوجيّاً. و اللّغة الأدبيّة (Le lan¬gage) يتّسم نظامها، على عكس اللّسان، بالنّوعيّة من وجهة، وبقِصَر الأزمنة التي تحكم نظامَها الدّاخليّ من وجهة أخرى. فهذه اللّغة الأدبيّة المتّسمة بالخصوصيّة والتّفرّد هي التي تتيح لشخص ما، أو قل على الأصحّ لأديب ما، أن يعبّر عن هذه الخصوصيّة اللّغويّة مستعملاً طائفة من الألفاظ والتّراكيب التي تنتمي إلى النّظام اللّسانيّ العامّ. إنّ اللّغة الأدبيّة تنبع من طبيعة النّتاج الأدبيّ نفسِه الذي تجود به قريحةُ أديبٍ من الأدباء؛ فكأنّها تجسّد النّظام الذاتيّ الخالصَ الذي يؤسّسه الأديب في كتابته؛ فيتميّز بهذه الذاتيّة، أو الحميميّة التي تمتدّ إلى الدّلالة والأسلوب جميعاً، ويغتدي متميّزاً عن غيره في هذه اللّغة؛ وذلك على الرّغم من أنّه ينهل من معين اللّسان العامّ الذي ينهل منه أدباء آخرون أيضاً» . (عبد الملك مرتاض، 2012م، ص:170) .
والحقّ أن الشعر يتميز من مجموع الفنون الراقية، والجميلة بضرورة انطلاقه من مضامين فكرية ظاهرة في صريح العبارة، وإنه«ليتهيأ للمنشئ أن يؤلف من مواد اللغة كلاماً هادفاً خالياً من كل نفحة شعرية، ولكن لا يتهيأ له بحال أن يؤلف كلاماً شعرياً من دون مضمون فكري إلى حدّ ما معقول على عكس ما يتهيأ للفنان في الموسيقى أو التمثيل.فقد يوضع الحن الموسيقي على (كلمات) منظومة، كما قد تبنى التمثيلية على قصة محكية، ولكنّ الأصل في الموسيقى أن تؤسس على الأصوات وحدها، وفي التمثيل أن يؤسس على الحركة التشخيصية.فالموسيقى تنطلق من أصوات مجردة قد يكتفى بها لإنتاج لوحات فنيّة طريفة، والتمثيل ينطلق من حركات تشخيصية مجردة قد يكتفي بها لإعداد مشاهد فنيّة رائعة، أما الشعر فلا انطلاق له إلا من مضمون فكري، ولكنه لا يسمو إلى درجة الفنّ المتميّز إلا بما يتجاوز به المضمون الفكري من إمكانيات الأداء » (محمد لطفي اليوسفي، 1992م، ص:15) .
وبناء على هذا الأساس فقد أُثر في التراث النقدي، والأدبي العربي عدد من التعريفات، والمفاهيم، والرؤى الكثيرة التي كان هدفها الأساس وضع الفروقات، والاختلافات بين الشعر، والنثر بتمييز الأول عن الثاني، أو إيضاح وظيفة كل منهما مع بعض التحديدات لأجناس أدبية محددة، ولعل أبرز، وأشهر تعريف تم تداوله بكثرة، وكثيراً ما كُرر، وتداوله الدارسون أن الشعر هو (كلام موزون مقفى يدل على معنى، أو له معنى)، بيد أن الإجماع يقع كذلك على أن هذا التعريف يتسم بالقصور، وأنه ليس دقيقاً- رغم شهرته وتداوله-، وليس جامعاً مانعاً فثمة جملة من النقائص التي تشوبه، والملاحظات التي تؤخذ عليه، ولاسيما من حيث إنه لا يُراعي الأبعاد الحقيقية للشعر، ولاسيما الوظيفة الجمالية، حيث إن الوزن، والقافية، والدلالة على المعنى هي معايير ليست رئيسة، وأساسية، وكافية لرصد المميزات الدقيقة للشعر، وتمييزه عن غيره، ولعل السبب الرئيس يعود إلى النقائص التي تتبدى في سببها الأول في الاعتماد على الاتجاه المنطقي الذي ساد عند أصحابها، إذ نظروا إلى الشعر نظرة ساورها الجمود، واستبد بها، فهذه الرؤية اتسمت بأنها منطقية، وجامدة، وجافة، وابتعدت عن الأبعاد الجمالية، والفنية. (عبد الرحيم الرحموني، 2005م، ص:9) .
ثانياً :عرض وتحليل أهم مضامين الكتاب:
بيّن الدكتور عبد الملك مرتاض الأسباب التي دعته إلى النهوض بتأليف هذا السفر الثمين؛ حيث يقول : « الموسم الأوّل لمسابقة «أمير الشعراء»، وقد جرت فعاليّاته في ربيع سنة 2007، اقترح عليّ، المغفور له، الأستاذ محمد أبو خلف المزروعي، وقد كنت جالساً في بيته مع شُهودٍ من شخصيّاتٍ إماراتيّة وعربيّة، أن أنقل التجربة التي أقوم بها تعليقاً مرتجَلاً على القصائد المستابقِ بها صِحابُها: كتابةً؛ وذلك لكيما يُفيدَ منها الناس، وشباب القراء خصوصاً. وقد قبِلت العمل باقتراحه. وبدا لي ساعتئذ أنّه اقتراح قابلٌ للتنفيذ. ثم تكاسلت فتثاقلت. ثمّ تغافلت وتناسيت. ثم كأنّي استصعبت الأمر، من بعد ذلك، ولم أَستسْهِلْه. ثمّ كأنّي لم أرَ فيه نفعاً كبيراً للناس... إلى أن كان الموسم السادس لمسابقة أمير الشعراء التي جرت فعاليّاته بمسرح شاطئ الراحة بعاصمة الإمارات العربيّة المتحدة: أبو ظبي، وقد كان ذلك في ربيع 2015 حيث إنّ الاقتراح الذي كان اقتُرح عليّ أصبح واجب التنفيذ، بعد أن فقدْنا صاحبه، رحمه الله، في أواخر سنة 2014 في حادثة سيرٍ مروِّعة.ولذلك، وبعد أن استشرت الأستاذ سلطان العميمي، مدير أكاديميّة الشعر، بهيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة والتراث، أبدى استحساناً لإنجاز هذا العمل، وتحقيق رغبة رجل كان له فضل، بعد فضل سموّ الشيخ محمد بن زايد، (مع حفْظ الألقاب) على مسابقة أمير الشعراء...وهنالك، وبعد كلّ هذه الاستخارات، أزمعت الشروعَ في كتابة هذا الكتاب الذي أعالج من خلال مستوياته الخمسة، القصائد الخمسَ، التي تسابقَ بها خمسة شعراء في الحلقة الختاميّة من مسابقة «أمير الشعراء»: من السعوديّة، ومن مصر، ومن موريتانيا، ومن لبنان، ومن العراق، وهم على التتابُع: حيدر العبد الله، وعصام خليفة، ومحمد ولد إدوم، ومُصعب بيروتيّة، ونذير الصَّمَيدعيّ.ولعلّما القارئُ المتابع لبعض كتاباتي أنّي لأوّل مرّة أتناول خمسةَ شعراءَ مجتمعِين من أقطار عربيّة متباعدة جغرافيّاً (المغرب العربي؛ أرض الكنانة؛ العراق، الحجاز؛ الشام)، وكنّا في أعمالنا التحليليّة السابقة نَقِف أمرَنا على شاعر عربيّ واحد، من قطر واحد.فتِيك، إذن، هي قصّة العوامل التي أفضت إلى صناعة هذا الكتاب» . (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:22) .
وقد تساءل المؤلف: ما الجديد في شعريّات هؤلاء الشعراء الخمسة الشباب؟ ويعتد الباحث عبد الملك مرتاض، لدى إجابته على هذا السؤال أن الجديدَ، كلَّ الجديد، في الفنون والآداب، والمخترعات بعامّةٍ، لا يكون، في الغالب، كاملاً غيرَ مسبوق، وعلى غير احتذاءِ مثالٍ. فعلى الرغم من أنّ القدماء كانوا ينظرون إلى صناعة كتاب، مثلاً، على أنّه عمل يُنشأ «على غيرِ مثالٍ يحتذيه» مؤلِّفُه، إلاّ أنّ ذلك قد يفتقر إلى بعض النظر؛ إذ يستحيل على مخترِع أو مُنْشئٍ أو مبدعٍ، أنّه يُنجِز عمله «على غير مثال يحتذيه» حقّاً، فعمله إنّما يتّصف بالإضافة في حدودها الممكنة، لا بالجِدّة المطْلقة.ولذلك، وحين نتحدّث عن الجِدّة في أشعار هؤلاء الخمسة، فذلك إنما هو من باب إضافة شيء ما، على نحو ما، إلى هذه الجِدّة، وليس من باب الجدّةِ الكاملة نفسِها، التي تعرَّف في كتب الأجداد ومعاجمهم: ما كانت «من غيرِ سابقِ مثالٍ». وهؤلاء الخمسةُ الذين كان أوّلُهم أميراً للشعراء للموسم السادس، إنما جَهَدوا جَهْدَهم، وتعلّقوا ببلوغ غايتهم من الشعر، فكان لهم بعضُ ذلك تحقيقاً. وقد تكمُن الجِدّة في أنّهم قرضوا قصائدهم العموديّة على غير «عمود الشعر» التقليديّ، وهي المسألة الفنّيّة التي كان أوّلَ من أثارها، ونظّر لها، في الفكر النقديّ العربيّ، هو أبو عليّ المرزوقي في المقدّمة المنهجيّة الكبيرة لكتابه شرْح أشعار الحماسة لأبي تمّام. والحقّ أنّ هؤلاء قدّموا موضوعاتٍ شعريّةً، شديدةَ الشُّفوف، بالغة اللطف، ضاربة في التعميَة، موغِلةً في التهويم، دون أن يبتعدوا بها عن الحدّ الذي يجعلها مُعتاصةً على الفهم، أو مستحيلة على إدراك المتلقّي، فكانت تقع في منتصف الطريق، بين الفهم واللاّفهم، كما يقول جان كوهين؛ وذلك باستثناء قصيدة ﷴ ولد إدوم التي كانت مباشِرة: مباشَرةً اقتضاها الموضوع الذي آثره بالقرْض، وهو مدح النبيّ ﷺ، وليس خروجاً عن الأصول الفنّيّة لكتابة القصيدة الحديثة. (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:45) .
كما بيّن المؤلف المنهج الذي اعتمده في تحليل هذه القصائد، حيث يقول: «ما الجديد في هذه الإجراءات التحليليّة التي زعمناها؟ ولقد يعني ذلك أنّ المسألة المنهجيّة تظلّ إشكاليّة عويصة في البحث في العلوم الإنسانيّة، وليس رفْضاً للمنهج من حيث هو، أصلاً. ولذلك نحن لا نستنيم إلى أيّ منهجٍ على وجه الإطلاق فنتّخذه لنا صنَماً، أو نظلّ له عبداً، نتبنّاه، ولا نبحث عن سواه. ولعلّ ذلك ممّا يبدو واضحاً لدُنْ من يتابع مسيرتنا النقديّة، من حيث تعمّد التنقّل في كتاباتنا من منهج إلى منهجٍ آخرَ. وعلى أنّا كثيراً ما نعمِد لِلمنهج الذي كنّا تبنّيناه سابقاً فنعدّل منه، ونطوّر من شأنه. ولقد نعَى علينا أحد النقّاد البحرانيّين أنّا بذلك نوصَف بالاضطراب، وعدم الاستقرار على ما نتنّاه اليوم، فنغيّر من أمره غداً. والحقّ أنّ ذلك كان منّا شأناً متعمَّداً.ولقد حملَنا عليه أمران اِثنان:أوّلهما: ما رأيناه من بعض النقّاد العرب، ممّن يَتْخَذون المنهج الاجتماعيَّ لهم طريقاً في معالجاتهم التحليليّة، مثلاً، حيث ظلّوا أوفياءَ، حتّى النُّخاعِ، لمنهجهم هذا الاجتماعيّ حتّى ماتوا عليه، وكأنّه قدَرٌ مقْدُورٌ نُزِّلَ عليهم من السماء! بل نجد الآخَرين من أصحاب المناهج الجديدة، هم أيضاً، يأتون ذلك، ويُصِرّون عليه إصراراً، ويتمسّكون به تمسّكاً، ويدافعون عنه دِفاعاً، وكأنّه، في تمثّلاتهم، الحقيقةُ المطلقة! ولو وُفِّقَ، هؤلاء وأولئك جميعاً في أمرهم، لكانوا اجتهدوا في التنقّل مِن منهج إلى منهج آخر، أو لكانوا سعَوْا إلى تغيير منه ما يمكن أن يتلاءم مع تبدّل العصر، ومع تطوّر الفكر، ومع قيمة التجدّد، ومع لَذْوَى التعدُّد؛ ولكنّهم لم يأتوا من ذلك شيئاً، لأنّ أمرهم كان ناشئاً عن الهوى الفكريّ المريض (الإِدْيولوجيا) فلم يستطيعوا عنه، أو عنها، حِوَلاً.والإِدْيولوجيا كالحَمُوقَةِ، إذا سكنتْ عقلاً لا تخرج منه أبداً! وآخِرُهما: ما سبق أن قلناه من تأثّرنا بمقولة أستاذنا أندري ميكائيل، وهي المقولة التي فهِمْنا منها عدمَ رفْض المنهج مطلقاً، ولكن ضرورة الحيْدُودَة عن المتَّخَذِ منه سابقاً ابتغاءَ تطويره وتعصيره، وتجديده وتنضيره. وذلك بعضُ ما دأَبْنا عليه دُءُوباً، فجَهَدْنا جَهْدَنا في أن يكون لنا ذلك سعياً مستمرّاً». (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:53) .
اتبع الباحث والناقد عبد الملك مرتاض، منهجية واضحة عند معالجة بنية اللغة الشعريّة في القصيدة؛ تنهض على:
1. رصْد الحقل المعجميّ (من نصّ القصيدة) ؛
2. تصنيف اللغة الشعريّة بتحويلها من الحالة المعجميّة إلى الحالة الدلاليّة؛
3. المعالجة والتحليل؛
4. شَعْرَرة اللغة
كما نبّه المؤلف إلى أن تتغيّر الإجراءات الدّاخليّة، بالقياس إلى بواقي المستويات، بحيث يكون أساسُ المعالجة المركزيّة، في المستوى الأوّل، قائماً على خمسةِ مفاهيمَ: «الشعررة» (وذلك ضمن البنية الشعريّة في النصّ الشعريّ وتفاعلها) ؛ وفي المستوى الثاني قائماً على مفهوم «الدَّوْلَلة» (وهي عبارة عن تفاعُل التداول بين السمات اللفظيّة وتعاوُرها) ؛ وفي المستوى الثالث قائماً على مفهوم «الحَيْزَزة» (التي تعني، لَدُنّا، تفاعُل الحيْزِ وتمثّلاته، وتخاصبه عبر تبادل العَلاقات بين أشكال الأحياز)، وفي المستوى الرابع قائماً على مفهوم «الأزْمَنَة»، (وتعني، لدُنّا، تجلّيات الزمن الضمنيّ (le temps impli¬cite)، بالإضافة إلى الزمن الصريح (Le temps explicite)، أو التقليديّ، الكامنِ في السمات اللفظيّة. وهو، إن شئت، الزمن السيمَائيّ الكامن في بعض السمات اللفظيّة كالشجرة، والصبيّ، والشيخ...) . ثمّ أخيراً «الأَوْقَعَة»، (وهي عبارة عن تفاعُل الإيقاع وتبدّلاته، وتقابلاته وتجلّياته معاً، عبر الوحدات التشكيليّة ذاتِ الخصائص الإيقاعيّة بتفعيل السمات اللفظيّة ذات الإيقاع المتجانس، أو الصوت المتماثل) . وتمثّل الأَوقعةُ ذروة الجمال الفنّي الماثل في النصّ الشعريّ، والقائم على تفعيل الصوت مع الصوت، والنغم الناشئ عنهما مع نغَمٍ مثلِه، من أجل الرقيّ بالشعريّة إلى ذروة مستواها الإيقاعيّ ابتغاء التأثير الجمالي في المتلقّي. وبذلك حدّدنا، من الوجهة التأسيسيّة إمكان تحليل أيّ نصّ شعريّ من حيث خمسةُ مستويات. (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:57) .
استهل الباحث والناقد عبد الملك مرتاض كتابه بمناقشة قضية تكتسي أهمية بالغة، وتتصل بأقدمية الشعر الجاهلي، وعُمره، وذلك تحت عنوان: «مقدِّمة منهجيّة ما قبل الشعر الأوّل: النشأة والتكوّن»، والحقيقة أن عُمر الشعر الجاهلي الذي نتدارسه اليوم مختلف فيه؛ ويذهب الباحث عبد الملك مرتاض إلى أن كثيراً ما تحدّث الناس عن قِدَم الشعر العربيّ دون أن يُقْدموا على الخوض في تحديد عمره على وجه التدقيق، لعدم شيوع ثقافة الكتابة، ولصمت التاريخ، ولِشُحّ التوثيق، في عهود ما قبل الإسلام لدى أوائل العرب. وكلّ ما عثرْنا عليه من النصوص التاريخيّة التي تحدّد عمر هذا الشعر، أنّ ميلاد الشعر العربيّ يعود إلى «دهر طويل»، قبل ظهور الإسلام. والحقّ أنّ عبارة «دهر طويل» التي شاعت في طائفة من كتب التراث، كما سنرى، والتي وُصِفتْ بها أبياتٌ شعريّة عُزِيَتْ إلى الأضبط بن قريع السعديّ، وهو الأضبط بن قُرَيعٍ بن عوف بن سعْد بن زيد بن مناة بن تميم، لا تعني شيئاً كثيراً. ذلك بأنّ هذا الدهر قد يكون قرنين أو ثلاثة، كما قد يكون عشرين قرناً فما فوق ذلك. مثلها مثل عبارة: «وهو قديم»، وذلك وصْفاً للشاعر الأضبط نفسِه، حين ذُكِر قبل إثبات شعره. ولكنْ من حسن الحظّ أنّ عالماً نحويّاً وراوية للشعر، تفرّد، فيما يبدو، بتحديد هذا «الدهر الطويل» بـ«ألفِ عامٍ»، قبل الإسلام. فقد ذكر أبو العلاء المعريّ أنّ أبا عبيدة، معمر بن المثنى، كان يقول عن الأبيات المرويّة للأضبط بن قُريع السعديّ التي سنُثبتها: إنّها «قيلت: من ألف سنة». (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:77) .
ويقرّر الناقد عبد الملك مرتاض في الأخير أنّ العربَ كانت ثانيَةَ اِثنتيْنِ من الأُمم، بعد الإغريق، عُنِيَتْ أعظمَ عنايةٍ بشِعرها، مُقارَضةً ومُرَاوَاةً، ومُذاكرةً ومُدارَسةً، معاً، قبل أن ينبرِيَ النَّقَدة، المتأخّرون عن ذلك العهدِ الضارب بِجِرانه في الزمن، إلى التأسيسات النظريّة التي نهض بها غيرُ واحدٍ: منهم مَن ذكرْنا، ومنهم من لم نذكر، وهم أكثرُ، هنا؛ وذلك بناءً على ما أوردتْه الرواة شِفاهاً، لا كتاباً. (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:102) .
تحليل القصائد الخمس
في تحليله للقصائد الخمس، توقف الباحث عبد الملك مرتاض في المستوى الأول مع تعاطِي الشَّعْرَرة في تحليل بنية اللغة الشعريّة؛ حيث انطلق في المبحث الأول من معالجة البِنية الشعريّة في قصيدة حيدر العبد الله، الموسومة ب: «قُبلة على فم القصيدة»، وقد لاحظ أن المادّة، أو الموادّ، اللغويّة (matières langagières)، أو السمات اللفظيّة، أو الوحدات الصغرى (Les unités minimales)، كما يطلق عليها ذلك جلمسليف، التي وقع بها البناء، تمثُل فيما يأتي: الرضيع؛ الاشتهاء؛ الجوع؛ الثدي؛ المراودة؛ المطاردة؛ الوحي؛ القصيدة؛ ضِيق المسعى؛ البقاء؛ الصحراء؛ الإهداء؛ الرُّوح؛ النبيّ؛ الرّعْي؛ أبو ظبي؛ الرخام؛ النداء؛ الظبي؛ القَلب؛ الصدَى (الظمأ) ؛ الشَّفّ؛ الثوب؛ الوشي؛ التلفُّت؛ ليلَى؛ السؤال؛ الهوى؛ الأمر؛ النهي؛ الرّفْع (التشمير) ؛ بلقيس؛ المشي؛ اللّبِن؛ الأحجار؛ الوعي؛ التقبيل؛ الرمل؛ التوت؛ التبليل؛ الماء؛ الفم؛ الإتعاب؛ الجرْيُ؛ الإكمال؛ التَّرحال؛ الخُلْد؛ الرِّجْلان؛ القصيد؛ السَّلام؛ النأي؛ الناي؛ المشابهة. (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:177) .
وأشار المؤلف إلى أن عدد السمات اللفظيّة المرصودة من هذا النصّ بلغ زهاءَ ثلاثٍ وخمسين، فشملت طائفة من الحقول الدّلاليّة سنتعرّفُهَا، ثم نعمِد لِمعالجتها.ولعل من الواضح لدى القارئ أن يعلَم أنّا أسقطنا، من الإحصاء، إدراج الحروف والقيود والظروف والصفات، وذلك بحُكم أنّها لا تستطيع أن تكوّن كلاماً مفيداً وحدَها، وإنّما هي محكوم عليها، في الاستعمال اللغويّ، بأنْ تظلّ مُظاهِرةً لسمات اللغة ليستويَ لها التركيب السليم، والبناء الصحيح، ومِن ثَمّ قيام الدلالة، بفضل استقامة الكلام تركيباً، وإفادتِه مدلولاً. كما أقصَيْنا السماتِ اللفظيّةَ المكرَّرة لأنّها تعني مأدّة واحدةً. ولم نأْتِ إلاّ ذلك مع الصفات التي أقصيناها من الرَّصْد، وإن كانت قليلة جدّاً في هذه القصائد الخمس. وقد حوّلنا الأفعال إلى مصادرَ أو أسماءٍ ليسهُل التعاملُ معها.وبالنسبة إلى تصنيف اللغة الشعريّة إلى حقول دلاليّة؛ يرى الدكتور عبد الملك مرتاض أنه يمكن لِمُعالِجِ النصّ بالقراءة «التحليليّة» أن يصنّف هذه الموادّ اللغويّةَ بِسَلْكِها في مجموعات، مجموعاتٍ، تتشاكل مع بعضها بعضٍ وتتآخَى، وذلك كأنْ تكونَ:
أوّلاً. مجموعة الحبّ والجمال وما في حُكمهما
بِلْقِيسُ؛ الثوب؛ الرَّفْع (التشمير والكشْف) ؛ الوشْي؛ التقبيل؛ ليلَى؛ التّلفُّت؛ الهوى؛ النّاي؛ القَلب؛ السَّلام؛ الإهداء: باثنتيْ عَشِرَةَ مادّةً.
ثانياً. مجموعة المشي والتَّرحال وما في حكمهما:
المشي؛ السّعي؛ الإتعاب؛ الجرْي؛ التَّرحال؛ الرِّجْلان؛ النأي؛ الصحراء؛ المطارَدة: بتِسْعِ موادَّ.
ثالثاً. مجموعة الأكل والشرب وما في حكمهما:
الثدي؛ الرضيع؛ الاِشتهاء؛ الجوع؛ المراودة؛ الماء؛ الصّدَى (الظّمأ، لا رَجْع الصوت) ؛ الفَم؛ الشَّفُّ (هنا واردٌ بمعنى الشُّرب بمَصّ الماء، لا بجَرْعه والعَبّ فيه دَغْرَقةً بلا غَنَثٍ، وليس السِّتر الرقيق، ولا الهمّ الذي يَشُفّ المرءَ شَفّاً) بتِسْعِ مَوادَّ، أيضاً.
رابعاً. مجموعة البناء والعُمْران ما في حكمهما:
اللّبِن؛ الأحجار؛ الرّمْل؛ الرُّخام؛ أبوظبي (المدينة المبنيّة ببعض هذه الموادّ) بخمسِ موادَّ.
خامساً. مجموعة الذوق والإلهام وما في حكمهما:
الوحي؛ النبيّ؛ القصيدة؛ الرُّوح، بأربعِ موادَّ.
سادساً. مجموعة الرّعْي والرَّتْع وما في حكمهما:
الظبي؛ الرَّعْي؛ التُّوت: بثلاثِ موادَّ لغويّةٍ فقدْ.
ونجد مجموعةً من الموادّ اللغويّة الأخرى، في نسج هذا النصّ الشعريّ، لم تتمكّن من القدرةَ على الاِعْتِزاء إلى أيٍّ من هذه المجموعات السّتِّ، فندَّتْ عنها وشرَدتْ منها، وهي مَوادُّ سِتٌّ:
البقاء؛ النداء؛ الوعي؛ الخُلْد؛ السؤال؛ المشابهة.
ولَكأنّ ذلك يعني أنّ كلّ مجموعة تحتوي على مأدّة واحدة اعتاصت على الاعتزاء إليها، فنفرت منها نفوراً. ولقد يعني ذلك أيضاً أنّ نُدُودَ هذه السّمات عن صِنْواتها في المجموعات السّتِّ، واختلافها عنها، إنما كان لتوطيد عَلاقة التبايُن من أجل تعزيز مَواتِّ الدلالة فيما بينها، إذِ التعارض، أو الاختلاف، بين السمات اللفظيّة في تركيب نسْج الكلام هو الذي يحدّد القِيَم الدلاليّة، ويُقِيمُ صِحّة المعاني فيحفظها من العبث والهراء. . (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:204) .
كما قام الدكتور عبد الملك مرتاض بمعالَجة تحليليّة لهذه المجموعات؛ لاحظ فيها أنّ هذه المجموعاتِ السِّتَّ، المكوَّنةَ من السّمات اللفظيّة الإفراديّة، تتشاكل فيما بينها تشاكُلاً داخليّاً وهي في مجموعتها، بحيث تعتزي إلى معانٍ متماثلة، أو متقاربة متآخيَة؛ فتكوّن كُتَلاً، كُتلاً داخل البنية اللغويّة الإفراديّة من خلال سماتها اللفظيّة التي بفضلها يكتمل البناء. بيْد أنّها تتباين خارجيّاً، أي خارج مجموعتها، فتتباعَد تباعُداً؛ فإذا كلُّ مجموعة تتّخذ لها معانِيَ تختلف عن معانِي صِنْوَاتِ المجموعاتِ الأخرى اختلافاً بعيداً، كما لاحظ أيضاً أنّ هذه السّماتِ اللفظيّةَ التي تكوّن المأَدّة الأولى لنصّ هذه القصيدة تَدْرُج، في عامّتها، في معانٍ جماليّة؛ فهي لا تدلّ على القُبح والفقر والمرَض والضنى والمكابدة والعذاب؛ ولا على الجفاف والجدْب والغَلاء والمجاعات؛ ممّا يُفضي إلى شظَف العيش وشُحّ الأرزاق؛ ولا على الضَّلال والتُّوهِ في الْمَفازاتِ والصحارِي؛ ولا على الخوف والفزع في الليالي الدَّآدِي، مثلاً؛ بل تناولتْ معانِيَ دالّةً على الأناقة والزِّينة والسعادة والخِصب والمرْع والحبّ والرّتْع ولَحْن النّاي؛ وعلى جلال الموقف، وبَهاء الْمَرْأى، وجمالِ العُمران...وعلى أنّ الذي قد لا يمكن التدرّج إلى الفقرة الآتية دون الحديث عنه، فهو هذا العنوان الذي تتفاعل فيه الشعريّة الفاهِقة مع نفسِها؛ ذلك بأنّ تقبيل فمِ القصيدة، هو استعارة جميلة نشأت عن عَدِّ المرأة قصيدةً، أو عدّ القصيدة امرأةً ذاتَ ثغْر جميل؛ فإذا كلٌّ منهما تغتدي أهْلةً للرَّفِّ والْمَصْد والتّقبيل. والذي يرى أنّ القصيدة الفخمة، هي ليستِ اِمرأة جميلة، أهْلةٌ للتقبيل، لا نراه يفهم الشعر، ولا يعي معنىً للجمال. (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:213) .
وفي المستوى الثاني من التحليل؛ توقف الدكتور عبد الملك مرتاض مع تجلّيات «الدَّوْلَلة» في شعريّة اللغة في القصائدِ الخمس، وأشار إلى أنه قلّ مَن حلّل نصّاً أدبيّاً كاملاً، شعريّاً أو نثريّاً، عربيّاً أو أجنبيّاً، وفيما وقفْنا عليه من قراءاتنا وقْفاً: بالإجراء التداوليّ. ولذلك، ووفاءً لقِيلِنا: «جديدُ التحليل»، ارتأينا أن نسعى إلى النهوض بهذه التجربة التي كنّا نهضْنا بها، في الحقيقة، من قبلُ، في بعض أواخر كتُبنا التحليليّة التي تَخِذَتْ من الشعر العربيّ حقلاً لها، في أحَدِ مستويات هذا التحليل؛ لكِنّا نطمع، اليوم، في أن نضيف شُيَيْئاً إليها في هذا العمل، جديداً. (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:292) .
كما سلط الدكتور عبد الملك مرتاض الضوء على نظريّة «اللاّمقول» أو المسكوت عنه في الإجراء التداوليّ، حيث نبّه إلى أن امبرتو إِكو يرى في كتابه «حدود التأويليّة» (Les li¬mites de l'inter¬préta¬tion) أنْ ليس من الضرورة أن تتّفق قصديّةُ القراءةِ المرادُ بها التحليل، مع قصديّة التأليف، ونحن نرى، وركوحاً إلى هذه الفتوى النقديّة التي نعمل بها، أنْ ليس من الضرورة أن تتّفق قصديّة النّص الواصفِ مع قصديّة النصّ الأوّل، اتّفاقاً مطلقاً. ذلك بأنّ النصّ الواصف، في منظورنا لمفهوم «التداوليّة الكبرى»، هو نصّ ثانٍ بامتيازٍ، كُتب عن النصّ الأدبيّ الأوّل (حتّى نُقْصيَ النصَّ غيرَ الأدبيِّ)، في زمن منفصل عنه؛ فهما، إذن، يتكاملان، ولا يتماثلان. (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:347) .
وعلى أنّ «المسكوت عنه» (L'illocution) هو الحقل الشاسع لنشاط التداوليّة [Prag¬matique] الأدبيّة وعطائها، وذلك بشِقَّيْها الأصغرِ والأكبرِ جميعاً. وكأنّ المسكوت عنه، في منظورنا لهذه المسألة، هو تمثُّلُ النصِّ الواصفِ لِما كان النصّ [الأدبيّ] الأوّلُ يريد قوله، فلم يَقُلْهُ، فيتكفّل هو بقوله، فيكون إبداعاً من حول إبداع، وخطاباً أدبيّاً على خطاب آخرَ من جنسه. ولذلك لا يكون الفعل التداوليّ في اللغة المعجميّة، بل لا بدّ من أن يكون في الخطاب المبنيّ من اللغة خارج معاجمها التي تُعنى بالمعاني المنفصلة للألفاظ. ويختصّ التداول الأكبر بالنصّ الأدبيّ، في حين ينصرف التداول الأصغر إلى التعابير اليوميّة.بيْد أنّ النصّ الأوّل، إذا كان سطحيّاً، فإنّه يفتضح أمام الإجراء التداوليّ فلا يصنع النّصُّ الواصف (المسكوتُ عنه)، له، شيئاً كثيراً. لأنّ المسكوت عنه مهما يَظْلَلْ بعيداً عن النّصّ الأوّل، فإنّه يبقَى، على ذلك، مرتبطاً به، مضطرباً في فَلَكه اضطراباً قريباً. (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:369) . وقد جاء في نقد الدكتور عبد الملك مرتاض للتداوليّة : «وركوحاً إلى ما سبق، فإنّا لا نرى أنّ هذا الإجراء الخالص لتحليل الخطاب الأدبيّ ممّا يتّفق عليه كلّ الناس؛ أو ممّا يضيف شيئاً كثيراً إلى إجراءات تحليل الخطاب المعروفة، بين المتعاملين، حقّاً. ولذلك ظلّ محدود الاستعمال، فيما يبدو لنا، بين المحلّلين الحداثيّين أنفسِهم. وربما يتقاطع هذا الإجراء مع بعض الإجراءات التقليديّة أو المعروفة لدى الناس، منذ القِدم، كبعض إجراءات التحليل البلاغيّة، القاصرة على كلّ حال؛ و«حتّى»: ذات التخريجات النحويّة، وما ينشأ عن اسـتعمالها من مسكوتٍ عنه في الخطاب (نريد إلى نحو المعاني، ونحو الألفاظ معاً ) . وقد رأينا أنّ كثيراً من محلّلي النصوص الأدبيّة العربيّة الكبيرة كاختيارات أشعار الحماسة لأبي تمام الـتي كلِف بتحليلها خلْق كثير من الناس في القديم، أشهرُهم أبو عليّ المرزوقيّ، والخطيب أبو زكرياء يحيى بن عليّ التبريزيّ: كانوا يعمِدون إلى قراءة النصوص الشعريّة فيحلّلونها بما يماثلها بألفاظ أُخرَ لا تبتعد عن ألفاظ النصّ الشعريّ المحلَّل إلاّ قليلاً. وإن كنّا نلاحظ على وتيرة التحليل لدى أمثال هذين العِملاقين أنّها كانت لا تكاد تَعْطُو إلاّ وجهاً واحداً من الـتحليل، في حينَ أنّ التحليل التداوليّ يتّسم، في الحقيقة، بالانفتاح الواسع على قراءة النصّ بحيث يمكن تأسيس التحليل بتعاوُر ألفاظ كثيرة تعالج مضموناً واحداً في النصّ. ولذلك، فنحن لا نرى أنّ هذا الإجراء التحليليّ الذي يتبجّح به، اليوم، الحداثيّون يُضيف إلى إجراءات التحليل الأدبيّ المعروفة ما يكون ثورةً عارمة في مجاله حقّاً. وقد يكون انعدامُ قدرة هذا الإجراء على متابعة النصّ الأدبيّ الطويل ومُجاراته سبباً مركزيّاً في ذلك القصور.يضاف إلى ذلك تجرُّد هذا الإجراء من القيم الجماليّة والفنّيّة، واجتزاؤُه بالاحتفال على تعاور الألفاظ اللغويّة وتبادل المواقع في معانيها، فقدْ. وأيّ إجراء يعطُو النصَّ الأدبيّ فلا يراعي الجانب الجماليّ فيه، قد يكون غيرَ ذي جدْوَى. ونحن سعَينا، على كلّ حال، في هذا العمل الذي نقدّمه إلى القراء، وفي هذا المستوى من التحليل، إلى الخوض في الجانب الجماليّ، إذ لا نرى أيّ تحليل أدبيّ، مهما تكُ أسسه النظريّة والإجرائيّة، يكتسب شرعيّته الأدبيّة خارج الوظيفة الجماليّة التي هي ركن مركزيّ في التعامل الأدبيّ ماهيّةً وإرسالاً واستقبالاً. كما يضاف إلى كلّ ذلك غيابُ أيِّ قاعدة صارمة تحكم هذا الإجراءَ الذي يظلّ خاضعاً لمقدار براعة المحلِّل وذوقه وقدرته على افتراع اللغة، وعلى أسْلَبة الكَلام، قبل كلّ شيء». (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:391) . وقد قدم المؤلف أنموذجاً من التحليل التداوليّ الفرنسيّ لعبارة «أحبّك» لِألان فينكيلكرو، كما حلّل الناقد عبد الملك مرتاض القصائد الخمس بالإجراء التداولي؛ وفي المستوى الأخير، تحدث الدكتور عبد الملك مرتاض، عن : «سِيمَائيّة الأَوْقَعة في المدوّنة - النغَم، والتنغيم، والتناغُم- »، وهو يعتقد في مستهل هذا القسم أنه قد لا يُصيبُ في رأيه كلُّ مَن يرى أنّ الإيقاع، بالمفهومين الحرَكيِّ والجماليّ مَعاً، في العربيّة، هو جديدُ النشأة، حديث الظهور؛ وأنّه مجرَّدُ موروثٍ دَعِيٍّ عن الثقافة الغربيّة المعاصرة؛ وأنّ الثقافة العربيّة الأصيلة منه بعيدٌ.بل لقد كان ابن منظور عرَض للإيقاع في «لسانه» بوعْيٍ لغويّ كاملٍ. بل إنّا ألفينا الخليل بن أحمد يؤلّف كتاباً كاملاً في القرن الثاني في هذا الفنّ بعنوان: «كتاب الإيقاع». كما ألفَيْنا عدداً كبيراً من كتّاب القرون الأُولى يستعملون هذا المفهوم بالمعنى العامّ الأوّل، وهو ضرْب من أضرُب الموسيقى، كما يتحدّث عن ذلك المثقّفُ الأوّل للأمّة، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، فيصطنع هذا المفهوم بوعي معرفيّ واضح، فيقول: « (...) أو بعض ما في حَنجَرته من الأصوات الملحَّنة، والمخارج الموزونة، والأغاني الداخلة في الإيقاع، الخارجة من سبيل الخطأ...». كما تحدّث محي الدين بن عربيّ عن المعنى الصوفيّ الخاصّ للإيقاع، في أكثرَ من موضع، وذلك في كتابه «الفتوحات المكّيّة».بل إنّا وجدنا إبراهيم الموصليّ يميّز بين اللَّحن والإيقاع، فيعرّف الإيقاع بأنّه: «حركات متساوية الأدوار، لها عودات متوالية»، في حين أنّ «اللحن صوت ينتقل من نغمة إلى نغمةٍ أشدَّ وأحطَّ». وسعَى السيوطيّ إلى تدقيق أكثر في تعريف الإيقاع فذهب إلى «أنّه لا فرْقَ بين صناعة العَروض وصناعة الإيقاع، إلاّ أنّ صناعة الإيقاع تقسم الزمان بالنَّغَم، وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة». ويبدو أنّ الإيقاع العربيّ بعد أن افترعه علاّمة الأمّة، الخليل ابن أحمد، في كتابه المعروف بهذا الاسم، كلِف به أهل التصوّف فكان الإيقاعُ شأناً من شؤون مجالسهم وحضرتهم، وتجلِّي حالهم، فكانوا يطبّلون بالطَّبْل ليؤدّوا الحضرة الروحيّة الراقصة على صوته، فإن تعذّر وجود طَبْل أو طبّالٍ، كان المسمِّعُ يصطنع قاعدة القدَح الذي يشربون فيه الشاي فيوقّع به على صينيّة من النُّحاس، ليؤدّيَ أهلُ الحضرة حركاتِهمُ الراقصةَ على وقْع ضرْب قاعدة القَدَح على الصينيّة المصوّتة، بانتظام دقيق، وتنغيم مضبوط، يتلاءمان مع هيئة حركة الحضرة المؤدّاة رقصاً بالأجسام القائمة.غير أنّا لم نعثر، فيما قرأنا، على أحدٍ ممّن عرض لاشتقاق «الإيقاع». ونحن نودّ أن نخوض في هذا الأمر، وعلى هذا المستوى من المعالجة التحليليّة لهذه المدوّنة الشعريّة، فنقرّر أنّ الإيقاع قد يكون أَتَا إِيمَا من وقْع قَطْرِ المطرِ على الأرض، وهو شِدّة ضرْبِهِ إيّاها إذا وَبَلَ؛ وإمّا من وقْع ضرْبِ حوافر الدوابّ، حين تسير في الطريق اللَّحْبِ فيكون لها صوتٌ يكاد يكون منتظِماً منغَّماً. ونميل إلى الوجه الآخِر حيث إنّ أيّ شخصٍ يسمع الدوابّ وهي تضرب الطريق اللاّحِبَ بحوافرها، يدرك التشابُه القائم بين ذلك الفعل وضرْب العود، أو الدُّفّ، أو الطَّبل، أو الصينيّة، أو سوى ذلك ممّا يمكن أن يقع الضرْب عليه من الآلات المصوّتة فتسمعه يُحدث صوتاً مُوَقَّعاً.وأمّا مصطلحُنا، نحن، فيعني تفاعلَ الإيقاع، وتبادُلَ جماله، بين عناصر السّمات اللفظيّة ذاتِ الأصوات المتقاربة أو المتشابهة أو المتماثلة، في تجلّياتها الصغرى (داخل البيت الواحد وفي قافيته بالقياس إلى سَوائه من الأصناء)، وفي تمثّلاتها الكبرى (داخل نصّ القصيدة بجذاميره) . ». (عبد الملك مرتاض، 2021م، ص:413) .
خاتمة:
إن هذا الكتاب يمكن أن ندرجه ضمن الدراسات النقدية المتميّزة؛ التي تسعى إلى النهوض بتحليل جديد للشعر العربي، فقد سلط الناقد عبد الملك مرتاض الضوء على قصائد جديدة، وحلّلها بمنهجية دقيقة، كما تطرق إلى كثير من القضايا المهمة التي تتصل بعمر الشعر العربي، والجدير بالذكر أن الدكتور مرتاض يتوسع في التعليق والتحليل والشرح والتفسير، ويذكر المصادر والمراجع عقب كل بحث بدقة وتفصيل، وهو ما جعل الكتاب ذا قيمة علمية وأكاديمية، فهو صالح سواء لعامة القراء، وكذلك للباحثين المتخصصين .
***
الدكتور محمد سيف الإسلام بوفلاقة
كلية الآداب واللُّغات، جامعة عنابة، الجزائر
................
قائمة المراجع:
أ- المؤلفات:
1- إبراهيم عبد المنعم ( إبراهيم)، 2008م، بـحوث في الشعرية وتطبيقاتها عند المتنبي، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر.
2- أدونيس (علي أحمد سعيد)، 1971م، مقدمة للشعر العربي، منشورات دار العودة، بيروت، لبنان.
3- بوفلاقة (سعد)، 2007م، الشعريات العربية: المفاهيم والأنواع والأنماط، عنابة، الـجزائر.
4- أبو ديب (كمال)، 1987م، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان.
5- الرحموني (عبد الرحيم)، 2005م، في مفهوم الشعر والشاعر، منشورات مطبعة آنفو- برنت، فاس، المغرب الأقصى.
6- الطرابلسي (محمد الهادي)، 1981م، خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة التونسية، تونس.
7- مرتاض (عبد الملك)، 2021م، التحليل الجديد للشعر (معالجة تحليليّة لِخَمْسِ القصائدِ التي قُدِّمت في نهائيّ الموسم السادس لأمير الشعراء)، منشورات أكاديمية الشعر، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
8- اليوسفي (محمد لطفي)، 1992م الشعر والشعرية :الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا عنه، منشورات الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا.
ب- المقالات:
1- جاموس (راوية)، 2013 م، مفهوم الجمال لدى ابن سينا وأهميته في الدراسات الجمالية المعاصرة، مـجلة بونة للبحوث والدراسات، مجلة دورية محكمة تعنى بالبحوث والدراسات التراثية والأدبية واللغوية، عنابة- الجزائر، ا لعدد المزدوج (19/20)، ربيع لأول:1434هـ/يناير (جانفي)، صفر1435هـ/كانون الأول (ديسمبر)، ص:216.
2- ميمون (مسلك)، 2001م، التأصيل الإجرائي لمفهوم الشعر عند ابن سلام الجُمحي، مجلة عالم الفكر، مجلة دورية مُحكمة تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، العدد:02، المجلد:30، أكتوبر، ديسمبر، ص:129.