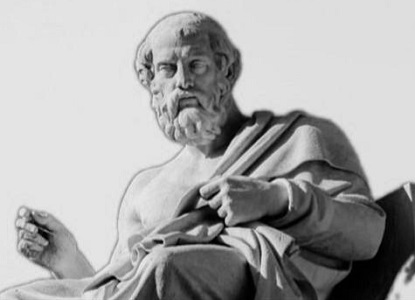قراءة في كتاب
سمير البكفاني: قراءة في اللاهوت العربي وأصول العنف الديني ليوسف زيدان

يأخذنا صاحب اللاهوت العربي، المفكر الدكتور يوسف زيدان، في تطواف لاهث عبر زمنٍ يمتد لآلاف السنين؛ إلى بداية تكَوّن التراث الثقافي، والفكري، للحضارات القديمة، في مصر واليونان؛ وفي الجزيرة العربية، والهلال الخصيب (الشام والعراق)، التي ظهرت فيها دياناتها المتعددة، بحسب التراث الحضاري والثقافي، المطابق لوعي الناس في كل منطقة منها، قبل ظهور المسيحية بقرونٍ طويلة من الزمان. ذلك التراث الفكري، الذي شكل الأرضية (الأساس) أو البنية الثقافية التي سوف تبنى بموجبها، لاحقاً، جُلَّ المفاهيم، والبنى الثقافية، والفكرية؛ سواء ما يتعلق منها بالدين، ونظرته للعلاقة بين الإله (الله) والإنسان، أو ما يتعلق بالبنية الفكرية والثقافية، المُكَوِنة، لثقافة هذه الحضارة، أو تلك، والتي سوف تفرض إيقاعها بعد ذلك، على مُجمَل النشاط الفكري في المجتمع المعني؛ بل والعالم! سواء من ناحية النظر إلى الدين، أو السياسة، أو إلى العنف المرافق لهما وكذلك، بنية الدولة وأشكال الحكم فيها، وكيفية النظر إلى الآخر المختلف!
وهنا، أراد مُفكرينا الكبير، أن ينقلنا إلى جذر المشكلة، التي نشأت مع ظهور الديانة (الإبراهيمية) اليهودية، والمسيحية، والإسلام. تلك الديانة الرسالية أو (الرسولية) التي جاءت عبر رُسلٍ وأنبياء، يدعون إلى الله، وينشرون رسالته.. بعكس، ما شاع بين الناس، وتداولته، ألستنا، وكتاباتنا؛ على أنها ديانة أو ديانات (سماوية)، دون انتباه إلى أن أيَّ دينٍ، أياً كان هو بالضرورة سماويُ لغة واصطلاحاً! فالسماء في اللغة، أي من حيث المفهوم الأصلي للكلمة، تعني العلوّ. ومن هنا، وحسبما يقول العلامة اللغوي الشهير ابن منظور وغيره كثيرون من علماء العربية: فإن كل ما أظلَّك وعلاك هو سماء.. ويصل بنا إلى نتيجة فحواها؛ أن، الديانات أو (الديانة الإبراهيمية) هي من حيث جوهرها، ديانة واحدة، ظهرت بتجليات ثلاث (اليهودية، المسيحية، الإسلام). وكان لكل ديانةٍ من هذه الديانات، شريعةٌ هي واجبة الاتباع، وأهلها هم فقط المؤمنون، وغيرهم غير مؤمنين. ومن هنا، تعمل الديانات الثلاثة، في النقش على صفحات بيضاء (الأطفال)، حيث يكون هذا النقش، مقبولاً في أذهان أهل الابتداء؛ وهي لا تزال في بياضها الناصع، لتضع (هذه الديانات) عليها، بصمةٌ، لن تَكُون إزالتها، بالأمر الهيِّن، عبر الزمن. على اعتبار أن بواطن المبتدئين كالشمع، تقبلُ كُلَّ نقش من دون أيّ نقاش! جاء في التوراة: قد ميَّزتكم من الشُّعوبِ؛ لتكونوا لي.. (التوراة، سفر اللاويين). وجاء في الإنجيل: وأما كل الذين قبلوه، فأعطاهم سلطاناً، أن يصيروا أبناء الله... والكلمة صار جسداً (إنجيل يوحنا)، وجاء في الإسلام: (كُنتُم خَيّرَ أُمَةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ) (آل عمران: 110). ومن هنا، نرى كيف أسست هذه الديانات الثلاث، لفكرة الإعلاء الموهوم للذات؛ وعدم قبول الآخر، وما تبع ذلك، من حوار (العنف) الملتهب، بين الديانات الثلاث، وحتى بين المذاهب، أو النزعات، ذات الصفة (الفكرية) الاجتهادية، داخل الدين الواحد... وكان بعدها، العنف، الذي سيفرض إيقاعه، عبر تاريخنا الممتد إلى يومنا هذا. من أجل إعلاء شأن دينٍ على دينٍ آخر.
يقول د. زيدان: الرؤية المنهجية التي انطلق منها..، تتلخص في المحاولة الدؤوب للتَجرُّد من الميول والاعتقادات الدينية والمذهبية، سعياً للوصول إلى الموضوعية اللازمة لتفسير الظواهر الدينية، واقتران التديّن بالعنف والتخلف عن (الإنسانية)..، فنحن دوماً نفكر عبر اللغة، المشبعة بالدلالات الدينية.. وهي عميقة في تراثنا وغائرة... ولذا، فمن العسير أن نصل إلى تلك الدرجة من التجرد والتجريد العقائدي اللازمين لأيّ عملية فَهْمٍ عميق للماضي وللحاضر أيضاً، خاصةً أننا، على المستوى الجمعي العام، أدْمنَّا الوجبات العقائدية الجاهزة التي تُقَّدم عندنا في الأزهر الشريف، وعند المسيحيين في الكليات الإكليريكية.. وكلها أصلاً معاقل ديانة. ولا أدري كيف يمكن لهؤلاء المشايخ أو أولئك القسوس، أن يقابلوا بموضوعية بين ديانةٍ يدينون بها، وديانةٍ يُدينونها مسبقاً.
ومن خلال العرض المكثف، ومتعدد الزوايا، الذي قدمه د. زيدان، نجد هناك، ثلاثة مراكز في العالم القديم، مصر واليونان، من جهة. والجزيرة العربية، ومنطقة الهلال الخصيب (الشام والعراق) من جهةٍ أخرى. ففي مصر واليونان، كانت؛ الميثولوجيا (الأساطير) التي رَوَتْ، ما كانت عليه دياناتها القديمة، من حيث إيمانها بالتعددية، وبامتزاج البشر (بالآلهة) (الفرعون أبن الإله) والإنجاب من دون نُكاح حِسِّي (إيزيس تحبل من زوجها الميت).. ومثل ذلك، ما نجده في (الديانة) اليونانية القديمة، التي قَصَّت الإلياذة والأوديسة حكاياتها الملحمية الجامعة بين البشر والآلهة، وبين العمالقة وأنصاف الآلهة؛ حيث نرى كثيراً من آلهة جبل الأوليمب، خاصةً كبيرهم زيوس، يغرمون بنساءٍ من بني الإنسان، ويعاشرونهن فيلدنَ لهم (أنصاف الآلهة) مثل: سيزيف، هيراكليس، ديونيسيوس.. إذن، بعد خروج المسيحية، من مكان نشأتها الأول (فلسطين)، وجدت في كلٍ من ثقافة مصر واليونان، ودياناتها، ما يتوافق مع نظرتها المماثلة، لتمازج البشر (بالإله) حيث يسوع (المسيح) هو الأب (الرب) وهو، الأبن (أبن الله) وهو (الإنسان) الذي صُلب ومات من أجلنا، والذي عاد إلى الحياة، بعد ثلاثة أيام؛ ومن ثم عاد وصعد إلى السماء، مَرةً ثانية وجلس إلى جانب الرب (الله). ذلك التماثل، بين ديانات مصر واليونان القديمة، وما تبعه، من وحدة العقيدة (الأرثوذكسية) على مبدأ (الإيمان القويم)، لكن بعد الصراعات، والخلافات التي حفلت بها المجامع المسكونية، والتشدد (القبطي) في مناوئة مركز الإمبراطورية في القسطنطينية، بدأ التمايز يبدو واضحاً للعيان، بين مصر واليونان، التي لم تشهد تشدداً، كالذي حصل في مصر.
ولكن على العكس من ذاك النزوع الميثولوجي القديم، المصري واليوناني، لتألُّه الإنسان وتأنُّس الإله؛ كانت الديانات القديمة السابقة على المسيحية في الجزيرة العربية والهلال الخصيب، تُعلي من مرتبة الآلهة، وتعتبرهم مفارقين تماماً لعالم البشر.. واعتقدوا بوجود مساحة شاسعة بين الإله (الله) والإنسان.. وهي المنطقة التراثية، التي ينتمي إليها اللاهوت العربي، والتي ظهر في أهلها اللاهوت وعلم الكلام، معاً، في زمنين متصلين، بين مسيحيٍّ وإسلامي. وفي هذه المنطقة، دارت حمى الحرُمات الكنسية، المتضادة، بين أصحاب (الإيمان القويم) وخاصة الكنيسة القبطية، وبين آباء الكنائس، الذين نشأوا في الشام والعراق، والذين نُعِتوا بالهرطقة.
كان العنف، أحد السمات المشتركة بين هذه الديانات (الإبراهيمية) الثلاث؛ منذ بدايات ظهورها، على نحو ما فعلت اليهودية مثلاً، في حروب الرَّبِّ التي قادها خليفة النبي موسى (يهوشع، يوشع) بن نون، لإجلاء سكان فلسطين العرب (الكنعانيين) فأباد في حربه تلك، حسبما ذكرت التوراة عشرات الممالك. وهم ما زالوا، وحتى اليوم؛ يتفنَّنون في إخلاء فلسطين (أرض إسرائيل) من ساكنيها، الموجودين فيها (حسب اعتقادهم) بطريق الخطأ، والمخالف للأمر الإلهي؛ حيث وعدهم الله بها، وأنه سوف يُعينهم على إبادة أهلها، أو إجلائهم عنها، ليتحقَّق وعده لهم وعهده معهم، وقد وعد الله، (التوراتي) النبي إبراهيم، وانتقل الوعد إلى بنيه: لنسْلِك يا إبراهيم أُعطي هذه الأرض، من نهر مصر إلى النهر الكبير، نهر الفرات.
وفي الإسلام، ومن (سقيفة بني ساعدة) بدأ الصراع على خلافة النبي (ص) قبل أن يُدْفَنَ جثمانه الطاهر، بعد. وهنا يمكن القول: هل هناك من تفسير، في أن تنتهي حياة ثلاثة من الخلفاء الراشدين قتلاً، غير الصراع على السلطة! ولقد تابع، الخليفة الأول أبو بكر الصديق (ض) الحروب التي بدأها الرسول (ص) ضد المشركين، ومن ثم حروب (الردة)!
ولأن العقلية العربية التي نزل فيها القرآن، حسبما دلَّت عليها الشواهدُ، هي عقلية عملية (براغماتية) تُعنى بالواقع المعيش، فقد مَدَّهم القرآن (المدني) بنظام حياتيٍّ، ومن هنا، تحول (الدين) على أيدي المسلمين الأوائل، إلى رايةٍ يحاربون تحتها بغرض تأسيس الدولة، ومَدِّ حدودها لتشمل كل ما يمكن أن يكون داراً للدين الجديد الذي كان العربُ يترقبونه. فصارت جزيرة العرب في سنواتٍ قليلة، داراً للإسلام، وصار غيرها من أنحاء الأرض دار حَرْبٍ، حتى تُفتح.
ومن هذه الناحية، جاء الأمرُ الإلهي في النصف المدني من القرآن (فَإِذا انسَلَخَ الأشهُرُ الحُرُم فَاقتُلُوا المُشرِكِينَ حَيثُ وَجَدتُّمُوهُم) (التوبة: آية 5). ومن هذه الناحية أيضاً، جاء الحديثُ النبويُّ: أُمرتُ أن أُقاتل الناس، حتى يقولوا لا إله إلا الله.
ويمكن القول، إجمالاً، إن المسيحية قد عرفت أيضاً، من يوم انتشارها، طفرات عنف توالت وتطوَّرت حتى أدَّى الحال إلى انفجار أنهار الدم في أرض الله، بسبب الفهم المتناقض للديانة، وظهور اجتهادات متباينة لتعريف (الإيمان القويم) وهي اجتهادات متنازعة متضادة، لا تمتُ بصلة إلى ما دعا إليه المسيح من محبة. وقد أدرك الناسُ آنذاك، في غمرة هذه القتامة المسكونية، أن مشكلة العالم أساسها ديني.
وتأتي حادثة مقتل البطريرك (الملكاني) بروتيرويوس، الذي أُرسِل بقرار من الامبراطور؛ ليعتلي كرسي أسقفية الإسكندرية. والتي جرت في الوقت الذي كان البطريرك بروتيرويوس يستعد فيه للاحتفال بشعائر الأسبوع المقدس في الكاتدرائية، فهجم عليه الأسقف تيموثيوس ومعه بعض اتباعه من العوام، فاحتمى بروتيرويوس منهم في مكان المعمودية المقدس (عند المحراب) إلا أن ذلك لم يرحمه منهم، إذ قام البطرك (القبطي) تيموثيوس ومن معه، بالهجوم على بروتيرويوس وذبحه في قلب الكنيسة على مرأى ومسمع من الناس!
تأتي هذه الواقعة الدالة، على تأصُّل العنف في التاريخ الديني، ليس المسيحي فحسب، بل الإسلامي أيضاً! فهي تذكرنا بواقعة ذبح الجعل بن درهم تحت المنبر؛ وهو أحد أباء الكلام في الإسلام، والذين كان مصيرهم جميعاً، مثل مصيره.. وإن بطرق وأشكالٍ أخرى. والذي يحتاج أن نعرض له في مقال آخر.
في المقابل، كانت الديانات القديمة، التي سُميّت اعتباطاً، بعد ظهور المسيحية بالوثنية، كان كل دين منها يفسح مساحةً لغيره من الديانات (الوثنية) الأخرى، المختلفة عنه. ولم نعرف تاريخياً، أن هؤلاء الوثنيين تقاتلوا يوماً فيما بينهم، من أجل إعلاء ديانةٍ وثنيةٍ فوق ديانةٍ وثنيةٍ أخرى.
وفي الختام:
أراد الدكتور زيدان القول، بعد تلك المادة الدسمة، التي قدمها لنا في كتابه (الموسوعي)؛ أنه لم يكن يقصد، الغرق في المباحث الدينية (اللاهوتية/الكلامية)، وإنما كانت غايته من وراء ذلك، فَهْمَ ارتباط الدين بالسياسة، وبالعنف الذي لم يخل منه تاريخنا الطويل، اليهودي والمسيحي، والإسلامي، والذي لن يخلو منه يوماً.
إلى اللقاء...
***
سمير البكفاني - كاتب سوري