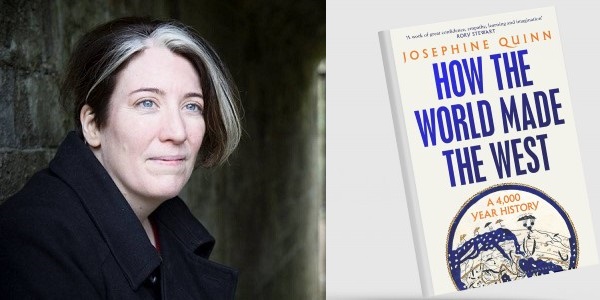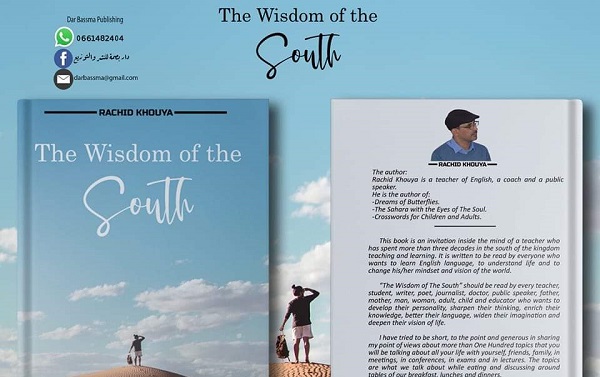قراءات نقدية
دور الرمز في تخصيب المخيال الوطني الفلسطيني وإثرائه اجتماعيا وسياسيا

في رواية "عندما تزهر البنادق" (دير ياسين)، للروائية الأردنية: بدية النعيمي
كنت قد تناولت في دراسة نقدية سابقة رواية الروائية الأردنية بديعة النعيمي " عندما تزهر البنادق " (دير ياسين)، تحت عنوان، التفاعل بين ثلاثية الذاكرة والهويّة والواقع المعيش في الذات الفلسطينية من منظور رواية "عندما تزهر البنادق " (دير ياسين). ارتأيت العودة إلى الرواية من بوابة المصطلح الرمزي وزاوية دلالته الاجتماعية والسياسية والتاريخية، وعلاقته بالهويّة الفلسطينية، العربية والإسلامية، كما وظفته الروائية في معمارها الروائي السالف الذكر.
ولا يمكن للرمز أن يتجذّر في المخيال الفردي والجمعي في المجتمع، ما لم يأخذ أبعاده النفسيّة والفلسفيّة في سيّاق السعي الحثيث لتخصيب الذاكرة الجماعية وإنتاج مقاربة موضوعية، واقعية، هدفها إعادة بعث آليات جديدة وفعّالة للفعل الثوري، في ضوء عولمة غربيّة شرسة. وتعدّد أساليب المقاومة وصورها ومنطلقاتها.
و لأبدأ بعنوان الرواية " عندما تزهر البنادق " (دير ياسين). مادام العنوان في النص الإبداعي، أكان نثرا أم شعرا، هو عتبته، كما اتفق معظم نقاد الأدب.
فالعلاقة بين هذا الأثر الأدبي (الرواية) ذي النسق والبنية المتكاملة والمتآلفة، التي لا تقبل التجزئة لعناصرها، وبين لفظتي العنوان (تزهر / البنادق)، علاقة تفضي إلى الغوص فيعناصر الرؤيا والانفعال والموقف الفكري والعقائدي لدى الروائية بديعة النعيمي، ونظرتها إلى إلى الوجود والكون والتاريخ والإنسان والغاية من الحياة. هناك معادلة وجودية سرمدية في الحياة الإنسانية منذ الأزل وإلى الأبد. هي علاقة الحرب بالسلام (الزهور /البنادق). حين يكون السلام غاية سامية ووسيلة مشروعة لمنع وقوع الحرب بين الإنسان وأخيه الإنسان، وبينه وبين نفسه وبين الطبيعة. والحرب لا يوقفها إلا السلام العادل. كما أنّ الحرب في قاموس الأمم والشعوب والجماعات البشرية المضطهدة والمسلوبة الحياة، وسيلة لافتكاك الحرية والكرامة، وليست غاية. لا حرب من أجل الحرب، بل حرب من أجل الحريّة، إذا فشل الكلام وعجز اللسان عن جلب السلام. هذا هو السلوك البشريّ، الإنسانيّ المنطقي.
لقد فشلت كل الجهود السلمية، بل انهزمت كل الخيانات والترقيعات والتطبيعات في إعادة الحقوق المشروعة للفلسطينيين ؛ استولت العصابات الصهيونية على المدن والقرى والبيّارات وطردت الشعب الفلسطيني إلى مخيّمات اللجوء والنزوح، حين سكتت " البنادق " وجفّت ولم " تزهر ". ما أجمل هذا الرمز الطبيعي المضيء الدال على الربيع والتفاؤل والنور والجمال في انتظار الحريّة القادمة على صهوات الجهاد المقدّس لا الاستسلام تحت مظلة السلام المزعوم الذي (بشّرت) به صفقة القرن، بل صفقة الخيانة والخنوع.
وظفت الروائية بديعة النعيمي في معمارها الروائي مجموعة من الرموز (شخصية الجد أسعد، البنادق، زيتونة البيت، الصبّارات الصامدات، الغليون الأبنوسي، زينب، الأفعى الضخمة، دير ياسين، المنحدرات، أيوب، الشمس، المفاتيح، كروم العنب والتين، القدس، الهنود الحمر ريشة الإوزة..). ومن عادة كتاب المذهب الرمزي استغلال الرموز الأسطورية أو الطبيعية أو الدينية أو التاريخية أو السياسية بغرض إخفاء المعانى المرغوب إيصالها للمتلقي خوفا من مقص الرقابة، وسوط الرقيب. وعليه تصبح الرموز وسيلة للتخفّي والتأويل. وظاهرة التخفّي خلف الرمز ليكون ممرّا لغاية في نفس (يعقوب)، وُجدت لدى بعض الشعراء العرب، قبل الإسلام، الذين استعملوا الأطلال والرسوم والظباء والديار والطيور رموزا لحبيباتهم خوفا من بطش قبيلة الحبيبة، أو مراعاة لحرمة العشيرة. من مثل قول عنترة بن شدّاد:
يا دارُ أينَ ترَّحلَ السُّكانُ
وغدتْ بهم من بعدنا الأظعانُ
*
بالأمسِ كان بكِ الظباءُ أوانساً
واليومَ في عرصاتكِ الغربان
*
يا طائر البان قد هيَّجتَ أشجاني
وزِدْتَني طرَباً يا طائرَ البانِ
*
إن كنتَ تندب إلفاً قد فجعتَ بهِ
فقد شجاكَ الذي بِالبينِ أشجاني
لكن، هنا، لم تأت الرموز لأداء هذا الدور. بل جاءت لتعرية المعنى أكثر فأكثر، لإيقاظ الضمير الفردي والجمعي، وبثّ روح المقاومة فيه.
الرمز لا يعني- كما يعتقد البعض - الغموض والتعقيد والإبحار في عالم اليوتوبيا " التي تتأسس على واقع متخيّل، لا وجود له إلاّ ضمن قوانين خاصة وظروف استثنائية قد تكون خارجة عن نواميس الطبيعة " * أو عالم الغرائبية والعجائبية الذي لا تحكمه " ضوابط وقوانين ولا تقيّده تجليّاته وتشكّلاته " **، لأن علاقة الأديب، ناثرا كان أم شاعرا بالقاريء الشغوف والناقد الموضوعي، علاقة جدلية، تفاعليّة، واعية. لا علاقة انطباعية عابرة.
و قد وظفت الروائية بديعة النعيمي الرمز في رواية " حين تزهر البنادق ". لصون الذاكرة الفلسطينية من عوارض النسيان. فا حتفاظ النازحين والمهجّرين واللاجئين الفلسطينيّون بمفاتيج بيوتهم المغتصبة، تذّكرهم، وتذكّر الأجيال المتعاقبة بحقهم في العودة، الإصرار عليه. كما تمرّر رسالة مشفّرة إلى الضمير العربي والإنساني، بأنّ الحقّ لا يسقط بالتقادم، مهما امتدّ زمن اللجوء والشتات. ولن يحدث للشعب الفلسطيني، مثلما حدث (للهنود الحمر) في قارة أمريكا أو لسكان أستراليا الأصليين. من إبادة جهنّمية. فقد استغلّت الروائية بديعة النعيمي تقنية المقارنة بين ما جرى للهنود الحمر، وما جرى للفلسطينيين، فكان وعد بلفور المشؤوم، الذي منح أرضهم للصهاينة، بمثابة (ريشة الإوزة)، التي قضت على الهنود الحمر. وغرض الكاتبة، من هذا الإسقاط والمقارنة، هو التنبيه والتذكير والتحذير من مخطّطات الصهيونية العالمية العاجلة والآجلة، وما صفقة القرن إلاّ بداية لزمن (هنديّ أحمر)، وهكذا نلاحظ أن الرمز، هنا، أدّى دورا وطنيّا خصبا، توعويّا، فعّالا ونابضا بالإيجابية واليقظة، لدحض المزاعم الصهيونية الهادفة إلى تذويب الهويّة الفلسطينية ومحوها. إنّ الشعب الفلسطيني صامد أمام المخاطر كلّها مثل تلك (الصبّارات الصامدات) " التي تتكيء على طول المنحدر " ص 26. وهو شعب الجبّارين المتأصل بجذوره في أعماق أرضه، مثل (شجرة الزيتون). وهكذا لن تستطيع يد غير يد الله، إزاحته عن أرضه. لأنّ معركته ضد الصهاينة، هي معركة وجود، وليست معركة حدود. هنا، يؤدي الرمز وظيفته التاريخية، ورسالته الإنسانية بامتياز.
هنا، يتحوّل الرمز إلى قبس من أعماق الذاكرة، لينير لأجيال الانتفاضة والمقاومة سبل الخلاص، المتمثّلة في الصبر والتحدّي والصمود والتمسّك بالأصالة والأمل، لطرد العدو الصهيوني (الأفعى الضخمة) من أرض الآباء والأجداد.
لقد ابتلعت الصهيونية (الأفعى الضخمة) - التي حلمت بها (زينب)، رمز جيل النكبة والنكسة معا - الأرض ودنّست العرض في غفلة من العرب والمسلمين، وبتواطؤ من بعضهم، ومساندة مطلقة من الغرب، وخاصة انجلترا وأمريكا. غير أنّ انتفاضة جيل الحجارة، قد قضت على الأحلام الصهيونية الزائفة، وحوّلت (كابوس) زينب المظلم إلى شعاع خلاص من الاحتلال البغيض، وأمل في العودة إلى دير ياسين والقدس وكامل فلسطين المغتصبة. " (فالشمس) لم تخن الأرض يوما " ص 24. وهنا، لفتة رمزية ذكيّة للحريّة، التي هي القاسم المشترك بين بني البشر جميعهم.
و لم يعد مفهوم المقاومة محصورا في بندقيّة أو قنبلة، بل صارت الكلمة المباشرة أو المجازية الرامزة تحقّق – أحيانا - ما عجز عن تحقيقه السلاح الفتّاك. كما أنها، أيضا، تعني مقاومة الذات وتطهيرها من الجبن والخنوع والقابلية للخضوع والاستسلام للضعف والانكسار، قبل مقاومة الآخر. وهنا، تلعب الذاكرة الموجوعة (الجدّ الحاج أسعد) لعبتها الحيّة والواعية والشعوريّة واللاشعورية في ترك طائر العنقاء تحت رماد الانتكاسة والاستسلام لصفقة القرن، وما تلاها من عورات التطبيع الأعمى، أو بعثه من جديد، تحت لواء الرفض المطلق لمعادلة الأرض مقابل السلام المزعوم. ومتى كان السلام بين الحق والباطل ؟ ومتى كان الذئب حارسا أمينا للشاة ؟
كما أنّ الرموز الواردة في هذه الرواية، كان هدفها، دفع الأساطير الصهيونية مصوغة ومفبركة ومزيّفة في جمل دينية وتاريخية خرافية الشكل والمضمون، من مثل: أرض الميعاد وشعب الله المختار والبحث عن هيكل سليمان وأرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وهي أساطير مؤسسة على قوة الباطل فقط.
إنّ أغلب الرموز المتداولة لدى الكتاب والشعراء، لم تنشا من عوالم الفراغ، ولم تولد من مخيّلة مجرّدة من الحس والحركة والصورة والخبرة والتجربة والمحاكاة والمعاناة. بل كانت وليدتها كلّها. فهي مزيج وتركيب كيميائي بين الشعور واللاشعور، بين الواقع والحلم، بين المشاهدة البصريّة وقوّة البصيرة.
و بعد، إنّ لغة الرمز عند الروائية بديعة النعيمي، في معمارها الروائي الموسوم ب (عندما تزهر البنادق)، هي لغة منتجة، نابضة بالحياة، واخزة للضمير الوطني، موقظة للذاكرة الفلسطينية ؛ الجماعية والفرديّة ؛ أيّ أنّها انتقلت من الرمز بوصفه نسقا جماليا ميتافيزيقيا، فانتازيّا، إلى نسق مثير للإدراك في حيّز روائي واقعيّ وأصيل.
***
بقلم الناقد والروائي:علي فضيل العربي - الجزائر