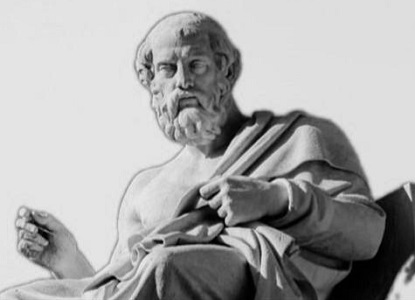قراءات نقدية
ملامح ألمثلث البنائي في سهول وتضاريس "جواد غلوم" الشعرية

جواد غلوم شاعر لا يكشف عن هويته العمرية لكي يُفلت من سجن التجييل، لاسيما أنّ النقاد والكتبة درجوا على اعتبار سنوات العمر هي أبعاد هذا السجن وقضبانه، وقلما كان للملامح الجمالية والإبداعية أثر في تحديد تلك الأبعاد. إنّ إفلات جواد غلوم من قيود التجييل مكّن قصائده من أن تمتح من أجيال الشعر في كلّ عصوره بحرية شاعر لا يتبنى مدرسة، أو اتجاهاً شعرياً محدداً، ولا يقيّد انتماءه سوى للشعر بمفهومه الذاتي النقي المتجرّد من أية مؤثرات موضوعية مفروضة عليه من خارجه، تُعقلنه، وتُحرّفه عن عفويته الغنائية. أما (سهول وتضاريس شعرية) فهي مطوّلة جواد غلوم، وهي بيانه الشعري الذي على خلاف البيانات الشعرية المعهودة أصرّ على صياغته شعراً. فبالرغم من قدرته على تطويع النثر في معالجاته التي لا تغلب عليها في العادة قضايا الشعر وإشكاليات صراعاته المزمنة، بل تغلب عليها قضايا الشأن العام، إلا أنّ معالجات الشأن الخاص تفرض عليه آليه تعبيرية تتوافق مع صوته الداخلي، وتضمن لذلك الصوت محاوراً مفترضاً يُكمل معه متطلبات مونولوجاته الذاتية، إنها آلية الشعر.
لقد رسم جواد غلوم بهذا البيان الإستثنائي اللغة ظروف تشكل تجربته الشعرية، والعوامل الخارجية – تحديداً – التي أثّرتْ فيها، وساهمت في نموّها، مع ملاحظة أنه في رصده لتلك التأثيرات عادة ما يتناولها من جانبها الحياتي كموجّه لحياة الشاعر - الإنسان، وليس كمفتاح لتجربة الشاعر - اللغة، مما يوحي بأنّ هناك حالة تماهي ما بين خارج القصيدة وداخلها ربما نجم عن عفوية النظر لتحولات كليهما (الخارج – الحياة) و(الداخل – الشعر) من قبل الشاعر بدليل أنّ الوقوف على محطات مسيرة الشاعر المثقلة بتجارب الألم والمعاناة لم تكتنفه أية محاولة لتبيان مدى انعكاسها جمالياً على مغامراته التجريبية في الكتابة الشعرية، ولم تخض في تحديد أبعاد طموحات التجديد والابتكار، فهو يكتفي بتناول خريطته الحياتية ببعدها الإنساني، وليس ببعدها الجمالي، رابطاً ما بين التأثيرات التي طرأت عليها وبين الشعر دون أن يكون لهذا الربط من تفسير.
ربما يفترض المنطق الجمالي أن يكون اتجاه التأثير الإبداعي من الشاعر على الشعر، وليس من الحياة على الشعر، وذلك من أجل أن تتحدد أبعاد التجربة بقصديتها وبوعيها، أما أن تكون الحياة، أو الشعر - بمفهومه الذوقي المجرّد والمكتفي بعفوية السليقة هما محركا التجربة، ففي الحالين سيبقى الشاعر يدور حول خلية العسل، مستمتعاً بمذاقه الذي سيصرفه عن التفكير في تنقيته وتحسينه. ومهما كانت التخريجات المنطقية والجمالية للعلاقة ما بين أطراف ثلاثية الشاعر والحياة والشعر، أو مهما كانت اتجاهات التأثر والتأثير بين تلك الأطراف فجواد غلوم ما زال يُصغي لصوته الداخلي، مشغولاً بعذوبته عما تدور في الوسط الثقافي من جدالات المتحاورين والمتخاصمين حول تحولات الشعر، فصوته الداخلي هو خلاصة إرثه القديم، يحرص على إبقائه نقياً، صافياً من التزويقات اللفظية، والشكلانيات الحداثية. إنه يعود بشعره إلى مرحلة الرواد، بل إنه ينزلق أحياناً حتى إلى ما قبل تلك المرحلة مازجاً في بوتقة واحدة ما بين آليات الكتابة الجديدة، وطرائق التعبير التقليدية، متمسكاً بتقاليد القصيدة العربية في رصانتها الأولى، ليُبقي لها روحها الغنائية ذات الصوت الواحد، مكتفياً باستبدال الثوب الإيقاعي القديم بثوب إيقاعيّ جديد، هذه الطريقة الإنتقائية توفر للشاعر من الجدّة حرية اللعب بالإيقاعات الوزنية، وعدا ذلك ستبقى اللغة مرهونة بمحدداتها البلاغية، ولغتها الوصفية المتماسكة ذات الطبقات المتراكبة على وفق علاقات سببية، يؤدي ضمنها السابق منطقياً إلى اللاحق، بحيث أنّ إيّ إخلال بهذه الهندسة يُربك معادلة المعنى، وهي معادلة تتوخى الفهم قبل كلّ شيء على طريقة التطابق القاموسي ما بين الكلمة ومعناها، أو ما بين الدال والمدلول.
هذه الطريقة في الكتابة الشعرية تمثل القالب الشعري الثابت لجواد غلوم حتى فيما يكتب من قصائد النثر، حيث أن ما يطرأ عندئذ على هذه الخرسانة البنائية هو التخلي عن قشرة الإيقاعات الوزنية، وعدا ذلك فاللغة الوصفية الرصينة ذات الطبقات المتراكبة سببيّاً هي التي تحكم بنائية القصيدة، وهي التي توجه القراءة توجيهاً تسلسلياً من السابق إلى اللاحق، وتنازلياً من الأعلى إلى الأسفل من دون انحراف أو تقطّع.
تتكون قصيدة (سهول وتضاريس شعرية) من خمسة مقاطع، ويمكن عدّ المفردات الثلاث التي تتشكّل منها العنونة هي المفاتيح لكل مقطع من المقاطع الخمسة، فالظل الذي تلقيه بعدّها تركيبة نصية متجانسة واحدة يغطّي كلّ القصيدة، على الرغم من أن كل واحد من تلك المقاطع يمكن عدّه قصيدة مكتملة ومنفصلة بذاتها عن الأخريات، فهو يمثّل نموذجاً إنعكاسياً جزئياً للموضوع العام، إضافة لذلك ليس هناك من مفصل تصوري ناقص في مقطع ما ويُرجأ اكتماله إلى المقطع التالي، وليس هناك من رابط محدد يشدّ المقاطع إلى بعضها، وأن الروابط التي تشكلها أضلاع المثلث البنائي (الجغرافيا / الشعر / المرأة) التي سنأتي عليها لاحقاً، لا تساهم في توحيد بنية القصيدة بقدر ما تساهم في بناء مقاطع متماسكة بشكل انفرادي بحيث يمكن عدّ كل مقطع جملة شعرية مكتملة بحدّ ذاتها.
إنّ حصر العنونة للشعر بهذين البعدين الجغرافيين (ألسهول والتضاريس) جعل منها تركيب استعارية من مجالين متقابلين مجازياً ومتباعدين واقعياً، ومهّد للانفتاح داخل القصيدة على أبعاد جغرافية أخرى، وكل بعد منها غير مقصور على حدود جغرافيته الأرضية، بل يمتد على وفق متطلبات التشبيه أو الإستعارة أو المجاز ليقترن بأبعاد أخرى تمتدّ إلى مجالين من عالمين آخرين هما (الشعر) و (المرأة). وبذلك يكتمل مثلث الدلالة بأبعاده البنائية الثلاثة التي يحيل كل منها إلى عالم مستقل ومنفصل عن العالمين الآخرين، ولكنها تتّحد معاً في مثلث واحد يمثل الوحدة البنائية للقصيدة:
- ضلع المثلث البنائي الأول = ألجغرافيا مجازاً
- ضلع المثلث البنائي الثاني = ألشعر
- ضلع المثلث البنائي الثالث = ألمرأة
وسيتمخض كل ضلع من الأضلاع الثلاثة عن مجموعة من الإشارات، تترابط مع بعضها سيميولوجياً لتشكّل معاً بنية القصيدة، وليس من العسير تبيّن العلاقات ما بين الدوال والمدلولات ضمن عناصر تلك المنظومة، والتي تغلب عليها العلاقة السببية، كما في النموذج المثالي التالي من المقطع الأول:
- (ألوسادة × ألنوم):
(يستلّ مني الوسادة كي لا أنام)
- (ألعوم × " ألثلج والزمهرير "):
(أعوم مع الثلج والزمهرير)
- (ألجمال × ألشهوات):
- (يُريني من الشقر والبيض والسمر والسود
كي يُشعل القلب جمراً من الشهوات)
وتلك العلاقات ما بين الدوال تؤدي لتشكيل مجموعة من الثنائيات الضدية التي قد لا يقتصر الكشف أحياناً عن ضديتها البحث داخل اللغة، بل يتجاوزه إلى خارجها كالثنائية ما بين (صدور العذارى)، أو ما يمكن أن نطلق عليه إغراء الجمال من جهة، وما بين (العجز) أو العجز عن تلبية دعوة الشهوة التي يُحفّزها أو يُهيّجها هذا الإغراء من جهة أخرى. فبدون البحث داخل وخارج اللغة لن نتبيّن دواعي هذه العلاقة ما بين طرفي الثنائية، فالداخل اقتصر على التلميح بالعجز والهوان، أما الخارج فيقودنا إلى شعاب أخرى ليس من الضروري الكشف عن تفاصيليها الدقيقة، ولكن لا بدّ من الوقوف على أطرافها البعيدة، أو التلميح لها بعمر الشاعر والذي يمكن تخمينه من سيرة حياة الشاعر، ومن الواضح أن التخمين هو أحد معطيات القراءة الخارجية، ولكنه اضطر للإشارة إليه:
(غدونا كبارا
أحسّ الحياة مزارا
والأماني صخوراً عثارا)
أما القراءة الداخلية الممكنة لتبيّن سر العلاقة الضدية لثنائية (الإغراء × العجز) فتقدمه تجربتة الشاعر الإغترابية خارج الوطن (مبطئاً طاعناً مزقته المنافي)، وكذلك تجربة الإغتراب الأقسى داخل الوطن:
(هنا عثرتي عند باب الأغا
هروباً من الأمن والسافلين)
وفيما يلي ما يرشح عن العلاقة ما بين الدوال في المقطع الأول من ثنائيات ضدية:
- صدور العذارى (الإغراء) × ألعجز
(يُريني صدور العذارى
أقول له: إنني قد عجزتُ، وهنتُ)
- (ألارتقاء × ألجبال):
(فيرقى أعالي الجبال)
- (ألدحرجة × ألسفوح):
(يُدحرجني مرّة إثر أخرى
لمرعى السهول وسفح التلال)
- (ألعهر × ألرعشة):
(فأغرق في عهر غانية علّمتني
رعاشَ الغرام ووهج الوصال)
تتشكّل بنية القصيدة من التداعيات الصورية التي تتمخض عن كل ضلع من أضلاع المثلث البنائي المشار إليها سابقاً، ولنبدأ بالعنونة التي تحدد ثنائية الضلع الأول من كيانين ماديين مستلين مجازاً من الفضاء الجغرافي (سهول + تضاريس) وكلا الكيانين منسوبان وبصيغة استعارية إلى فضاء الشعر (سهول وتضاريس شعرية). وما تلك الثنائية إلا من قبيل القصر اضطراراً، لأن إطلاق كامل المفردات القاموسية لمكونات هذا الضلع سيُخرج العنونة من مقطعيتها اللغوية المكثفة كنص موازٍ يُدلل ولا يُفصّل، ولكنه سيُمهّد للمتلقي تلقي ما تطلقه القصيدة من بقية تجليات هذا الضلع والتي سنأتي عليها فيما بعد.
قد يبدو الضلع البنائي الأول خروجاً عن الشعرية وشروطها الجمالية باعتبار أن الجغرافيا فضاء مستقلاً ومغايراً عن فضاءاتها المفتوحة، بحكم انغلاقه على نظامه المعرفي غير اللغوي، وعدم تقبله لتعدد المعاني والتأويلات. وقد أدرك الشاعر ما يمكن أن يوحيه ذلك للمتلقي، ولذلك جاء الربط ما بين المعاني الغائبة للضلعين الأول والثاني بعد تحرير القاموس الجغرافي من انغلاقه، وتمكين مفرداته من تلبس طاقة الإيحاء، ومن ثمّ الإنحراف أو التفجر ضمن حركة إبداعية شاملة لاستبدال دلالاته الموضعية المقيدة بمدلولات مفتوحة على معان متغيرة ومفاجئة. وستمتد آلية الربط ما بين المعاني الغائبة إلى مكونات الأضلاع الثلاثة مع بعضها على امتداد القصيدة بما يُخرج كل ضلع منها عن استقلاليته الدلالية مولداً نوعاً من الإستعارات المفتوحة التي تنبسط لتشمل جملاً شعرية بكاملها، ولتفارق بهذه الآلية نمطية الإستعارات التقليدية المقصورة عادة على مفردتين تمثل كل منهما مجالاً تصورياً مقابلاً ومستقلاً عن الآخر.
تجليات أضلاع المثلث البنائي:
ألضلع البنائي الأول – ألجغرافيا مجازاً لغوياً:
تتجلى أضلاع هذا المثلث البنائي من خلال عدة مظاهر، فالضلع الجغرافي ألمحرف معرفياً سواء بالانزياح أو بالإيحاء ليتواءم مع مقصديات الشاعر وغائية الشعر يتجلى:
1 - من خلال المظاهر المناخية (ألجغرافيا المناخية):
- (ألثلج والزمهرير): (أعوم مع الثلج والزمهرير)
- الهجير: (أحتمي هرباً من هجير)
- ألصيف: (عرق الصيف والحيف والمنهكات)
- ألغيم: (أمتطي غيمة من دخان السكائر)
- ألفصول: (... وترجع مثل الفصول)
2 - من خلال التضاريس الطبوغرافية:
- ألجبال: (... فيرقى أعالي الجبال)
- ألسهول وألسفوح والتلال: (... لمرعى السهول وسفح التلال)
- البيد والشِعاب: (إلى أين تزحف بي أيها الشعر؟ / في السهل والبيد بين الشِعاب)
- ألوديان: (وتخشى سقوط الصخور / بين واد وواد)
- البحار: (بين بحر العيون)
- ألانهار: (سِدارته أبحرت عبرَ دجلة) أو (ما بين دجلة والكرخ...) أو (هنا كبوتي / على سفح دجلة لما سبحتُ بها)
- الموانيء: (بميناء قلبي شراعاً عتيق)
- ألشواطيء: (لعلي أحطّ على شاطيء) أو (وتلك القباب على شاطيء النهر)
- ألقفار: (أبوسُ القفار)
3 - من خلال الأماكن:
- ألعراق: (... أو أرى محفلاً ضائعاً للعراق) أو (سأبقى مكبّاً أديم صلاة العراق)
- بغداد: (وتعشق بغداد منذ المهاد لحد الرقاد) أو (وبغداد كرخانة للزناة)
- ألمسيّب: (فجسر المسيب أضحى خيالاً بعيد المنال)
- شارع الرشيد: (إلى حانة في الرشيد)
- باب الأغا: (هنا عثرتي عند باب الأغا)
- ألأزقة: (لساني مذاق الأزقة)
- ألكرخ: (ما بين دجلة والكرخ والقشلة الصامتة)
- عقد النصارى: (أدخل عقد النصارى)
- ألبصرة: (من بصرة الشوق).
- خان مرجان: (إلى خان مرجان حيث المقامات دانية)
- شارع النهر: (إلى شارع النهر والسحر والعطر والغانيات)
ألضلع البنائي الثاني – ألشعر:
هذا الضلع لا يتجلى سوى بذاته، والقصيدة – البيان بأغلبها تقريباً هي خطاب موجه إليه، ولذلك ينفتح على خبايا التجربة الحياتية للشاعر، ولكنه، وتلك مفارقة لا ينفتح على نظامه الداخلي، والمقاطع (1، 3، 4، 5) تستهلّ به، باستثناء المقطع الثاني فهو موجه عبر الإستهلال إلى الذات من خلال قرينها الزمني العمر (أيها العُمر، مرماكَ أقربُ مما تظنّ) وهو مقطع استذكاري لمسيرة حياتية خالصة، ولكنه سرعان ما يعدل عن انحرافه الإستهلالي بمخاطبة الذات – العُمر وذلك بالعودة بدءاً من السطر الخامس لهذا المقطع إلى مخاطبة الشعر عبر الإستفهام المكاني مقروناً بالنداء (إلى أين تزحف بي أيها الشعر).
وقبل إكمال الخوض في أثر هذا الضلع البنائي – ألشعر في توجيه المعنى العام للقصيدة، لا بدّ من الإقرار بأهمية المقطع الثاني في فتح خزانة التاريخ الشخصي للشاعر، وهي خزانة متخمة بإرث غني بالأصوات والمذاقات والروائح وطُرُز الأزياء والألوان والعلاقات الإنسانية، تمثل باجتماعها معاً فردوساً مفقوداً في الواقع، لكنه ما زال حيّاً باقياً في ذاكرة من عاش فيه، ويتجلى هذا البقاء في الحنين والشوق إليه، لكنه ليس كما يبدو على سطح التداعيات حنيناً لماضي المدينة بقدر ما هو حنين الذات إلى المراحل الأولى لتشكل وعيها بنفسها، وبما حولها، بدليل أنّ تاريخ الأمكنة المُستَذكرة لا يمتدّ إلى مرحلة أبعد من طفولة وفتوة وشباب الشاعر، أي أن الماضي لديه لم يعد رمزاً كونياً أو قناعاً أسطورياً كما كان يراه جيل الرواد، بل أنّ الماضي توحّد بالشاعر حتى صارا كياناً واحداً من الصعب إعادة فصلهما عن بعضهما. وأنّ حنين الشاعر لماضيه هو حنينه إلى طفولة الذات وبراءتها.
هذا، ويمكن القول أنّ كل المقاطع الخمسة موجهة إلى الشعر سواء بصيغته كمخاطب أو بصيغته كغائب، مع ملاحظة أن حضوره في المقاطع (1، 2، 3، 4) جاء مقروناً باستفهام مكاني تدليلاً على ضياع الشاعر، وفقدانه الإتجاه، باستثناء المقطع الأخير الخامس حيث جاء حضور الشعر مبدوءاً بأداة نداء مقرونة بالاستعطاف والتوسل:
- المقطع الأول: إلى أين يأخذني الشعر؟
- ألمقطع الثاني: إلى أين تزحف بي أيها الشعر؟
- ألمقطع الثالث: إلى أين يدفعني الشعر؟
- ألمقطع الرابع: إلى أين يركلني الشعر في رجله؟
- ألمقطع الخامس: أيها الشعر هوناً على شيخك المستكين
ألضلع البنائي الثالث – ألمرأة:
تقدم القصيدة أربعة مظاهر واضحة للمرأة، وعداها فيمكن تبيّن أثرها في طيف واسع من التداعيات التي يستحضرها إلى ذهن المتلقي حديث الشاعر عن الجمال أو (إشعال القلب بجمر الشهوات) أو (الرغبة الماجنة)، أو من خلال التشبيه البعيد الذي يشدّه إلى عالم المرأة فيقرن انزواءَها بحانة في الرشيد (إلى حانة في الرشيد انزوت مثل بلهاء ساكنة). أو حتى من خلال تلمّس أثر المرأة في التناص الذي يُقارب ما بين قول شاعرنا (أمرّغ هذا الجدار وذاك المزار) وما بين قول الشاعر قيس بن الملوّح:
أمرّ على الديار ديارِ ليلى أقبّلُ ذا الجدارَ وذا الجدارا
أما المظاهر الجلية لهذا الضلع البنائي فيمكن تبينها من خلال:
1 - تتجلى المرأة في القصيدة بلوازمها، وتلك اللوازم قد تكون أعضاء الجسم:
- ألصدور: (يُريني صدور العذارى)
- ألعيون: (بين بحر العيون)
- ألجفون: (بين نعس الجفون)
- ألغدائر: (أنفثها خصلة من غدائر محبوبتي)
- ألخصور: (ونقذف شهوتنا حول تلك الخصور)
2 - وقد تكون تلك اللوازم الجسدية عبارة عن إسقاطات لونية تحيل إلى المرأة :
- (يُريني من الشُقر والبيض والسُمر والسود).
3 – أما المرأة بكيانها الإنساني، فقد جاء حضورها سلبياً عبر مظهرها الشهواني كمصدر للرغبات المحرمة من خلال الغواني والعواهر:
- (فأغرق في عري غانية علمتني
رعاش الغرام ووهج الوصال)
- (... إلى " شارع النهر " والسحر والعطر والغانيات
إلى غرفة
في " جبهة النهر "
نعرى مع الموبقات
تجيءُ العواهر تقتاتُ أرواحنا علكة بين أسنانهنّ
ونقذفُ شهوتنا حول تلك الخصور)
4 – وعدا تلك الصورة السلبية، فالصورة الإيجابية الوحيدة للمرأة هي صورة في غاية القتامة، وهي صورة مزدوجة، إحداهما للحبيبة، والثانية للأم، وقد اقترنتا معاً من خلال الموت، فالأولى ماتت في ربيع عمرها، بينما الثانية ليست سوى أطلال قبر، وإنه لمن المفارقة أن يرسم الشاعر الصورة الإيجابية للمرأة بهذه الصورة المزدوجة، والمعتمة الألوان.
وبالعودة إلى العنونة، فأن ألمثلث البنائي الناقص الذي تمثله لا يخلو من التلميح إلى الضلع الناقص / المرأة، إذ أن المظهرين الطبوغرافيين مجازاً اللذين نُسبا في صيغة إستعارية للشعر يعودان في متن القصيدة ليُلمّحا إلى علاقة تشبيهية مع جسد المرأة، أي إلى جسد الضلع الغائب:
(يدحرجني مرة إثر أخرى
لمرعى السهول، وسفح الجبال
فأغرق في عهر غانية...)
لكننا لن نضطر دائماً لهذا التأويل بحثاً عن الضلع الغائب، حيث يتجلى المثلث البنائي بكامل أضلاعه بدءاً من المقطع الأول من دون أن يكون لتداخل الأضلاع ببعضها، وتكررها أثر في الإخلال بالبنية الثلاثية. فمع الاستهلال بالشعر يكون هذا المقطع قد أحضر ضلع بنيته الثلاثية الأول، ويبدو حضوره أستفهامياً مقروناً بفعلين ذواتي دلالتين متقاربتين تدل كلتيهما على الإنتزاع، وقد يكون المعنى المجاور الآخر هو الخُسران، وهذان الفعلان هما فعل الأخذ (يأخذني) وفعل الإستلال (يستلّ) وفي الحالتين فالفاعل هو الغائب، بينما الخاسر أو المُستلب هو المتكلم:
(إلى أين يأخذني الشعر
يستلّ مني الوسادة كي لا أنام)
إلا أن الطبقة العميقة من البوح والتي يمكن تبينها من رضا المشتكي المُستَلَب (بفتح التاء) – المتكلّم عن المستِلب (بكسر التاء) الغائب يوحي بأنّ هذا الأخير يُعطي بقدر ما يأخذ، بل إنّ ما يُعطيه لا يقلّ جمالاً ووفرة عما ينتزعه، وحسب عطاياه أنها تخنق الشاعر المشتكي من فرط وفرتها (إنه يخنقني بالجمال) أو بمعنى آخر أنّ ما يرشح عن هذا الضلع البنائي من العطايا تترك المشتكي غارقاً إلى درجة الإختناق في محمولات ضلع مثلث البناء الثالث / المرأة في تدرجية بنائية توصل الأخير بالضلع التالي، أي الجغرافيا بتضاريسها المجازية.
ألمرفق
(سهول وتضاريس شعرية)
الى أين يأخذني الشعرُ
يستلّ مني الوسادةَ كي لا أنام
أعومُ مع الثلج والزمهرير
يُريني صدورَ العذارى
أقول لهُ: إنني قد عجزتُ، وهنْتُ
يسامرني ضاحكا هازئا
ويخنقني بالجمال.
يُريني من الشقر والبيض والسمرِ والسودِ
كي يشعلَ القلبَ جمرا من الشهَوات
فيرقى أعالي الجبال
يدحرجني مرةً إثر أخرى
لمرعى السهول وسفح التلال
فأغرق في عهْرِ غانيةٍ علّمتني
رعاشَ الغرام ووهج الوصال
***
أيها العمر، مرماك أقربُ مما تظنّ
غدونا كبارا
أحسُّ الحياة مزارا
والطريق حصىً راجما
والأماني صخورا عثارا
الى اين تزحف بي أيّها الشعرُ؟
في السهل والبيد بين الشِعاب
وتخشى سقوط الصخور
بين وادٍ ووَاد
تمهّلْ ؛ خطاي ارتعاش السقامِ المرير
لساني مذاق الازقّـة في حيِّنا
حين كنّا حفاةً صغار
حين نلتمّ بيتا فبيتا
نكاد نلامس كل القلوب التي عايشتنا
فتعصرني رعْدةٌ ماجنة
تعيد رفات حياتي
مُبْطئاً طاعناً مزّقته المنافي
أعودُ بحنّاء أهلي
أمرّغ هذا الجدار وذاك المزار
وتلك القباب على شاطئ النهرِ
مابين دجلة والكرخ و" القشلة " الصامتة
أعود وأنهك من تعبٍ يستريح بعظميَ
أدخل " عقد النصارى "
وأرشيف أهلي الغيارى
أرى محفلا ضائعاً للعراق
قلنسوة الراهب الموصليّ يقبّل وجهي
وكوفيّةً تحتمي بالعقال تؤازرني
وسروال جدّي من الكرد أمسحُ في ثوبهِ
عرَقَ الصيفِ والحيفِ والمنهكات
أحتمي، هرَبا من هجير
فألمحُ عمّي الافنديَّ " صبري "
"سدارتهُ" أبحرتْ عبر دجلة
من بصرة الشوقِ حتى رستْ
بميناء قلبي، شراعا عتيق
يميل كأعوامنا الماسخات
أمتطي غيمةً من دخان السجائرِ
أنفثها خصْلةً من غدائرِ محبوبتي
يومَ قبّلْتها في الوداع الاخير
وأقبرتها جنب أمي الرؤوم
أناشدُ ذاكرتي ان تحلّق في جنحها
لعلّي أحطّ على شاطئٍ
بين بحر العيون
بين نعْس الجفون
أنام هنيئا وأصطاد رؤياك في الحلْمِ كي أستريح
فهيهات هيهات ان أستريح
***
الى اين يدفعني الشعرُ!؟
خارت قواي
أريد الوصول الى غايتي ومناي
الى "خان مرجان " حيث المقامات دانيةٌ
لِنقطفَ ألحانها في النهاوند والرسْت حتى السحور
الى " شارع النهر" والسحر والعطر والغانيات
الى غرفةٍ
في "جبهة النهرِ"
نعْرى مع الموبقات
تجيء العواهر تقتاتُ أرواحنا علكةً بين أسنانهن
ونقذفُ شهواتنا حول تلك الخصورْ
وترجع مثل الفصول
كأيامنا الحالكات
***
الى أين يركلني الشعر في رِجْلهِ
الى حانةٍ في "الرشيد" انزوتْ مثل بلهاء ساكنة
تستحي أن تعبئ من خمرة الأمس دِنّاً وزِقَّا
تخاف اللحى الخادعة
عاقرت قتل من يحتسي لذّةً
حرّم الله نشوتها هاهنا
أباح لنا نهرَها في الجنان
هكذا دخلوا عقلنا
وسّخوا باحةَ البيت والروحِ
بأحذيةٍ قَــذْرةٍ موحلة
{جوادٌ جوادْ
أمازلت تسبي الهوى والجوى
وتبكي النوى والبعاد؟؟!
أجبني، كفاك العناد
كفاك تبوس تراب البلاد
وتعشقُ بغداد منذ المهادِ لحدّ الرقاد
كفاك بكاءً على الرائحين
كفاك كلاما على اللائمين
فجِـسْرُ " المسيّبِ " أضحى خيالاً بعيد المنال
خراباً يداسُ بهذا المداسِ وذاك النعال
نطاردهُ في أغاني الزمان المحال
وهشَّ الحديد بأركانهِ ناخراً
بقايا الجمال
وبغداد " كرخانةٌ " للزناةِ شبيه الرجال
وناعورةٌ تحتويها البغال
علامَ تدور، وتهوى الوصال؟
إلامَ تغني وتشدو: " أمانٌ..أمانْ "؟!
فهلاّ سكَـتَّ، خرسْتَ اللسان
فما من مجيبٍ وما من أذانْ
أإنصافُ منك تطيلُ الغياب؟!
وتنسى المباهج وسط الصحاب
فماذا أقول لمن شاقني في السؤال؟
وكيف أردّ الجواب؟
***
أيها الشِّعرُ هونا على شيخِك المستكين
هنا عثرتي عند " باب الأغا " أثقلت مشيتي
هنا كبوتي
على سفح دجلةَ لمّا سبحتُ بها
هروباً من الأمن والسافلين
سأبقى مكبّاً أديمُ صلاة العراق
وأصدحُ بين الركام
أبوسُ القفارْ
الى أنْ تلوّحَ كفيَّ يوم الغياب
***
ليث الصندوق