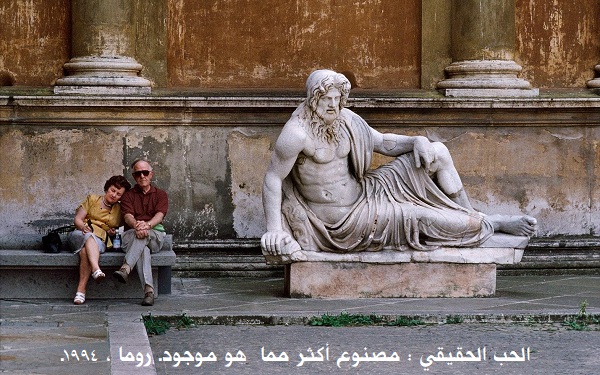دراسات وبحوث
عصمت نَصَّار: من الشّك في الروايّة والإرتياب في السرّد إلى المراجعة النقديّة في الردّ والقصد

لقد انطلقت نقدات وإنتقادات “ابن عاشور” تجاه كُتب جُمّاع الحديث وروّاة السيرة النبويّة المتواترة بغيّة الإصلاح، وذلك لإستحالة الفكر الإسلامي السائد من طَوّر المعلومات والمعارف التي تفتقر إلى الرؤية النقديّة في التحصيل والترابط في البنيّة إلى طوّر المراجعة والتحقيق العلمي الذي ينتهي إلى اليقين العقلي؛ ذلك الذي لا ينفذ من جناباته الشك حتى الوصول إلى المقصد الحقيقي الذي يُميّز نسقيّة الفكر الإسلامي الصحيح، دون غيره من الثقافات التي تستلهم جوهر أفكارها من الكُتب المقدَّسة وأخبار الأنبياء.
لذا نجده يناقش في مَعرض حديثه عن حلقة الوصل التي تربط بين واقعات السيرة النبويّة، والوقائع التي رُوّي فيها الحديث الشريف، موضحاً أهمية غربلتهما (أي الواقعات والوقائع) بمنهج عقلي نقدي، للكشف عن مواطن التلفيق والدَسّ والخلط، ذلك الذي خَلّف ورائه عشرات المسائل والقضايا التي أعيّت الجماعات السُنية والمعاهد السلفية المعاصرة، نَذكُر منها قضية الحاكميّة والخلافة الإسلامية، والفرقة الناجيّة، والعلاقة بين الدين والدولة، وذلك في ميدان السياسة، ومسألة غلق باب الإجتهاد وجعل التجديد الديني في تقليد السَلّف والتلويح بتهمة التكفير في وجه المعارضين للفكر السائد وضرورة تطبيق الحدود الشرعية في كل المجتمعات الإسلامية على نهج السَلّف وذلك في الفقه وأصوله، وتوجيه بعض الأحاديث للنيّل من حرية الإعتقاد والفكر والبَوّح، وذَمّ الأغيار من أرباب الديانات الأخرى والاعتداء عليهم، ناهيك عن المسائل التي شغلت حيّز كبير من اللجَاجَة واللغوّ في أحاديث أدعيائهم، مثل ما جاء في التراث بشأن إرضاع الكبير وعذاب القبر وخِتان المرآة ونقابها وعملها، وحقيقة أميّة النبي ومعجزة حديثه في المهد وغير ذلك من الأمور التي يَبّرأ منها النسق المعرفي للفكر الإسلامي المُتمثل في القرآن وصحيح الحديث والثابت من السيرة واجتهادات أهل الرأي من الفقهاء والعلماء المتبحرين في مقاصد الشريعة. لذا نجد ابن عاشور” يُقسّم الأحاديث النبويّة وكذا الواقعات المُتعلقة بتَسييّس أمور العباد من السيرة النبوية إلى ثلاثة أقسام لا ينبغي الخلط بينها في العمل بالسُنة وإقتفاء آثر المُصطفى (صلى الله عليه وسلم) فيها، وهي:
أولها: ما صَدّر عن النبي قولاً أو فعلاً وهو في مقام الإمامة أي الحاكم ووليّ الأمر، وهي من الأمور التي لا يجوز السَيّر على نهجه فيها باعتبارها سُنة ويجوز العدول عنها تبعاً لإختلاف الأزمان والمواقف والحاجات، فهي من أمور السياسة التي يُوكل أمرها إلى الحاكم أو الوليّ القائم بالرئاسة في مجتمعه مثل أمور السلم والحرب والإقتصاد والأموال العامة وأملاك الدولة والعلاقات الخارجية والقوانين المُنظمة لمصالح العِباد في مجتمع ما،
وثانيها: سُنته وهو في مقام القاضي الذي يَفصِل في القضايا المختلفة؛ فهي لا يجوز لأحد أن يقتفي آثر أحكامه إلا بحُكم حاكم، وذلك لأن هناك ظروفاً وأسباب قد دفعت النبي وهو في مقام القضاء أن يُصدر ذلك الحكم مقدماً درئ المفاسد على جلب المصالح وموازناً في الوقت نفسه بين المقصد الإلهي وما يتطلبه الواقع المعيش، فهناك حيثيات تتعلق بالأمور النفسية والاجتماعية والمادية، وغير ذلك من أمور ذات الصِلة بالواقع المُراد الفصل فيها.
وثالثها: سُنته وهو في مقام المُفتي أو الإفتاء وهو جزء من رسالته في التبليغ الشرعي، وهو واجب على كل المسلمين بالضرورة اقتفائه والسيّر على حرفيّة أوامره ونواهيه بدقة، ومن ثم يجب التحري عن تلك الأحاديث أو الأفعال لكي تُصبح قطعيّة الثبوت وقطعيّة الدلالة، حتى يتسنى لكل المسلمين العمل بها دون أدنى شطط أو جنوح أو جموح شأن الأوامر المتضمنة في آيات القرآن أو الشارحة لها، وأطمئن الجمهور إلى مقاصدها ومآلاتها.
ويقول “ابن عاشور” في ذلك: (إنّ لرسول الله صفات وأحوالاً تكون باعثاً على أقوال وأفعال تصدر منه، فبنا أن نفتح لها مشكاة تضئ في مشكلات كثيرة لم تزل تُعنت الخلق وتشجي الخلق، وقد كان الصحابة يُفرّقون بين ما كان من أوامر الرسول صادراً في مقام التشريع، وما كان صادراً في غير مقام التشريع، وإذا أُشكل عليهم أمراً سألوا عنه).
وإذا ما تأملنا اجتهاد “ابن عاشور” في هذا الدرب، فسوف ندرك أنه قد وازن بين الأصيل التليد والجديد المُبتَكر دون أدنى وقوع في الطرفين المذموميّن (أي الجمود، والشرود)، وتقسيمه للسُنة على نحو سابق قد سبقه إليه العلماء الأوائل مثل (شهاب الدين القرافي ١٢٢٨م – ١٢٨٥م ) في كتابه (أنوار البروق في أنواء الفروق). أما شرحها والكشف عن مدى صلاحيتها لمجتمعنا المعاصر فهو تجديد وابتكار لا يتعارض مع الحوادث المماثلة في الثابت من السيرة النبويّة والقياس والإستباط والإستدلال من الأمور الإجتهادية التي لايَصِح الحُكم عليها بالقطع نفعاً أو ضرراً إلا بالتجربة والتطبيق العملي.
كما فَرق “ابن عاشور” بين الروايات التي تعرّضت لخصوصية النبي في مظهره أو مسلكه اليومي، وبين السُنن التي يجب على المسلمين الإقتداء بها، ولاسيّما ما يُدرج منها في المعاملات الراقية والأخلاق الفاضلة والجميل من الأقوال والهيئات، فما أكثر الأفعال والأقوال التي يُقدِم عليها العوام ظناً منهم بأنها من الشرع والتديّن والسيّر على سُنة النبيّ وصحابته دون أدنى تمحيص أو نقد، والوقوف على مدى نفعها من عدمه ومقاصدها ومآلاتها شأن إطلاق اللحية والإستنجاء والأكل بالأيدي وإرتداء الجلباب، أو ما رُوّي عن النبي في حديث هَزِرّ أو ضحك أو نُصح أو لوّم أو ترغيب أو ترهيب، وذلك لأن لكل حادث حديث ولكل واقعة ظروفاً وملابسات، وإنتهى رأي “ابن عاشور” في حديثه عن السُنن الواجبة إلى ضرورة إعمال العقل في تحقيقها ثم في نفعها ومآلاتها في ضوء واقع كل مجتمع يعيش فيه المسلمون ولا تقليد واجب إلا ما كان من السُنة مقطوع في صحته وثبوته، ويقول: “فلابد للفقيه من إستقراء الأحوال، وتوّسم القرائن الحافة بالتصرفات النبويّة، فمن قرائن التشريع الإهتمام بإبلاغ النبي إلى العامة والحرص على العمل به والإعمال بالحُكم وإبرازه في صورة القضايا الكلية … واعلم أن أشد الأحوال التي ذكرناها إختصاصاً برسول الله هي حالة التشريع؛ لأن التشريع هو المراد الأول لله تعالى من بعثته حتى حصر أحواله في قوله تعالى ” وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ” (آل عمران ١٤٤).
وينتقل شيخنا إلى مناقشة موضوع لا يقل أهمية عن سابقه، ألا وهو تنقيّة سيرة النبيّ من بعض الروايات التي دُست فيها بقصد خبيث أو بغيّة إجلال وتعظيم من قدره ومكانته، وعلى رأس تلك الأكاذيب المروّية الكثير من المعجزات الحسيّة ومعظمها يرجع إلى رغبة روّاتها مقابلة معجزات المُصطفى (صلى الله عليه وسلم) وأقرانه من الأنبياء الذين سبقوه، وقد أراد “ابن عاشور” تقويم وتنقيح بعض الكتابات التراثية التي تحدثت في هذا المضمار، فذهب على صفحات (مجلة الهداية الإسلامية عام ١٩٣٦م) خلال إستعداد العالم الإسلامي للإحتفال بالمولد النبوي والإشادة بسيّرته وعِظم مكانته عند الله وبين الأمم مؤكداً مع “ابن رشد” والمُعتزلة على أن المُعجِز الجواني أقوى وأروع وأصدق للعقلاء من المعجزات البرّانيّة الحسيّة التي يُمكن للسحرة والمشعوذين والمُدلسين اصطناعها أو خداع العوام بحدوثها مع تسليمه وإيمانه بصدق الخوارق التي أجراها الباري على أيدي أنبيائه لإثبات صدقهم والإعلاء من شأن قدرهم، وذلك بالإتيان بما يُعجِز أقوامهم عن تحقيقه ويفوق تصوارتهم لحدوثه، كما لا يُكَذب أو يرتاب في ما ثَبُت من هذا الدرب المُعجِز من سيرة النبي وذلك في الخبر المُجمع على صحته وأكدته آيات القرآن ومروياته بالواقعات التي يَصُعب الشك في حدوثها إذا ما حاول الأغيار ذلك.
ثم اجتهد في توضيح الفارق بين المُخالف للعادة والخارق للسُنة الطبيعية، ليُميّز بين الكرامات التي تَجري على أيدي بعض الأولياء والأصفياء والأتقياء من الصوفية، والمعجزات التي خَص بها الله الأنبياء دون غيرهم، ثم ميّز بعد ذلك بين المُعجز النبوي الذي تَفردّ به المُصطفى (صلى الله عليه وسلم) ودونه من سائر البشر، وعبّر عنها بقوله أن سيرته وخصاله وطباعه ومجاهدته وجهاده وقدرته على التبليغ ورأفته ورحمته وتسامحه وشدته وحبه وورعه وجماله وكماله، هو المُعجِز الخفيّ على الحسيّين، والواضح أبداً والظاهر دوماً للعقلاء والمحللين وللعلماء والمحررين وكُتاب السيّر من القدماء والمُحدثين، وقد لَخصّ “ابن عاشور” المُعجِز الجواني أو المُعجزة الخفيّة التي أُختص بها النبي في (طهارة النفس وصفاء السريرة وخيريّة الجِبِلة قبل البعثة، وكمال الخِلقة والخُلق والعِصمة وهي جامعة بين ما اكتسبه بالإرادة البشرية والنعِمة الإلهيّة، ثم حاجة العالم إلى وجود رسالته وذلك لتفشي المكاره والإنحطاط بين البشر وجحودهم للشرائع السابقة بعد التجديف عليها وتحريف متونها، ثم خلوّ سيرته من أي فصام بين القول والعمل وإستشرافه للعديد من الحوادث والأخبار والأخطار وإخباره عن أمور يستحيل عليه تحصيلها دون علم الباري وثبات صحة ما نهى عنه بالقطع وأكد تحريمه، ثم الحكمة الربانيّة والشريعة الإلهية التي وُرِدَت في القرآن وما يحويه من صور عديدة للإعجاز اللغوي والبلاغي والإخباري والمعرفي والعقلي والثوابت الحِكميّة المتمثلة في توجيه الخطاب للعقلاء للتأمل والتدبر وإعلأه من شأن العلماء للتزود من المعارف لجلب النافع ودفع الضار، والدستور القابل للتطور دوماً وإستيعاب ما يستجّد من حوادث إلى أن تتنهي الأرض وما عليها)،
ويقول:” فإنّ أهل النظر والعلوم يحبون أن يعثروا على نِكّت – أي طُرفة – جديدة على قاعدة “كم ترك الأول للآخر”؛ ففي ذلك نشاط لهممهم العلمية لا تحصل لهم من الإشتغال بالفوائد المعادة على قاعدة “هل غادر الشعراء من متردم؟”، وهي تشبه خوارق العادات من حيث إنّ جميعها إنْ تأملته وجدته صادراً في أزمنة وأحوال يَعِز أن يصدر أمثالها في أمثالها، أما إذا إعتبرت مجموع طائفة منها قليلة أو كثيرة، فإنّك تجد إجتماعها وتظاهرها يقارب أن يكون خارق عادة، وتقوى تلك المقاربة بمقدار تكاثر ما لاح للناس منها، لأن إجتماع الأمور المتناسبة يبعدها عن الصدفة، ويقربها من قصد نصب الدلالة، فيوشك حينئذ أن تساوي المعجزة المشهورة في نيابتها مناب قول الله تعالى ” صدق عبدي فيما أخبر عني”.
ويقول في موضع آخر إنّ القرآن الكريم هو المُعجز الأكبر والدليل الأعظم على صدق النبي، وهو الشاهد الخالد على حقيقة الشريعة الربانيّة التي حملها المُصطفى (صلى الله عليه وسلم) إلينا في تلاوته للوحيّ وصحيح حديثه وسُنته، ويقول مُستشهداً بأقوال الرسول في هذا السيّاق:(هذه الخصيصة يشارك هذا النوع معجزة القرآن في الدوام وعدم الإنهاء، ولعلنا نستروّح لهذا النوع من المعجزات لمحة من قول النبي “ما من الأنبياء نبي إلا أؤتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنّما كان الذي أؤتيت وحيّاً أوحى الله إليّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة)؛ فلفظ الوحيّ وإنْ كان يتبادر إلى القرآن وهو بحق أجَلّ أنواع الوحيّ … ويتضح من هذا أن هنالك صِلة متينة وإنتساباً قوياً بين عموم دين الإسلام ودوامه، وبين المعجزات الخفيّة الصالحة لإستمرار الحجيّة بها والمتجدد بعضها عقب بعض).
ولا ريّب في أن “ابن عاشور” قد عَبر بما أورده في كتاباته عن العلوم الشرعيّة مدى أصالة إنضوائه للمشروع الحضاري الإسلامي الذي طالما نبهنا على وجوده، أصيلاً في بنيته ومتطوراً في نسقه وثرياً في تصورات وآراء رواده عبر العصور، وقد صَدق الأستاذ الإمام “محمد عبده” في وصفه شيخنا “الطاهر ابن عاشور” بأنه (سفير الدعوة الإصلاحية في الجامعة الزيتونيّة).
وللحديث بقيّة عن قضايا الفكر الإسلامي، وآثر “ابن عاشور” في تجديد الخطاب الدعوي الإسلامي الحديث.
***
بقلم: د. عصمت نَصَّار