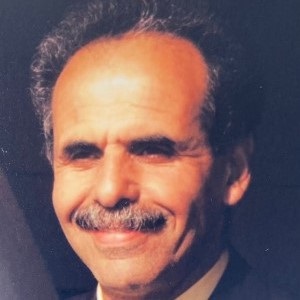أقلام حرة
لماذا لا يحكمنا الإسلاميون؟
يقابل دائماً بحجة أن الأديان الثلاثة ومنها الإسلام تحديداً، نبعت جميعاً من الشرق الأوسط .
ولأن الإسلام يملأ هذه البقعة الجغرافية المترامية الأبعاد والمسماة بالشرق الأوسط، ويشكل فيها الأغلبية العظمى، هذا وحده ما يفسر انسلال تلك الجماعات والحركات من رحم تلك البقعة التاريخية الغنية بثرواتها الباطنية، مصدر الطاقة، والموبوءة بالأمية والتشتت العقلي لصالح هيمنة سلطان الخرافة .
كل الأسباب والحجج التي يتذرع بها الإسلاميون على اختلاف مشاربهم المذهبية والإيديولوجية، متوفرة لهم بالحد الأدنى، لتبرير نظريتهم في السلطة القائمة على نصوص القران كدستور ثابت لا يقبل التغيير أو التعديل، وعلى الحاكمية المطلقة لله أولاً، وللشريعة ثانياً، وبالتالي ما الذي يحول دون وصولهم إلى سدة الحكم،
لاسيما وأن نظريتهم في السلطة الإلهية المطلقة، رغم ما يعتريها من استبداد ديني محض، لا يقل ضراوة عن الاستبداد السياسي الممارس باسم نظرية " الأمة القومية " الشوفينية، يرتضيها حشد من جمهور المسلمين لا يعد ولا يحصى؟.
من الطبيعي، بل من المتوقع أن يكون جواب تلك الجماعات عن السؤال السابق، منسوباً بالكامل إلى " المؤامرة الكبرى" التي تواطأ عليها الغرب مع لفيف من
"ملاحدة الشرق " المغرر بعقولهم، وذلك في محاولة يائسة من الإسلاميين، لتبرير قصورهم الفكري وتأخرهم الحضاري الراهن من اللحاق بركب عجلة التطور العلمي وقطار الحداثة، تماماً " كالمؤامرة الكبرى " التي ينجرف إليها أنصار التيار القوموي في تخوين خصومهم من التيارات الأخرى، وذلك لحظة سؤالهم عن سلسلة الهزائم المتتالية، وتخلفهم في بناء الدولة القومية الديمقراطية .
إذا ما تحدثنا عن الدول العربية، فليس أمامنا نماذج إسلامية ناضجة على مستوى الحكم، قدر ما لدينا جماعات إسلامية تناور السلطة القائمة، كالإخوان المسلمين في مصر، أو تتحالف معها من خارج بيتها ومحيطها الإيديولوجي، كالتحالف بين حركة حماس وحزب الله مع السلطة في سورية، أو تتصارع معها، كالصراع الدامي بين جماعة الحوثي والسلطة اليمنية .
ولا نغفل في هذا المجال من الحديث عن النماذج الإسلامية في الحكم، النموذج الإسلامي المبعثر في عراق ما بعد صدام حسين، والقائم على مجموعة أحزاب دينية لا يجمعها رابط العرق – الأحزاب التابعة لإيران مقابل نظريتها العربية – ولا المذهب - خليط من الأحزاب السنية والشيعية .
هذا النموذج الإسلامي الوليد من رحم الاستبداد القومي – العشائري الذي كان سائداً أبان حكم صدام حسين، كردة فعل غير مباشرة على الحرب الأميركية على نظامه، يحاول أن يبرر كل سقطاته وهفواته في الحكم، بالإرهاب العابر للحدود تارة
( حزب الدعوة )، وبالاحتلال القائم على الأرض تارة أخرى ( التيار الصدري ) مستخدماً كل أدوات الديمقراطية، بدءاً من الانتخابات إلى حرية الإعلام والرأي .
لكنه يظل مرتهناً في نموذجه السياسي، مهما بلغ منسوب حراكه الديمقراطي، رغم العنف والفوضى، يظل مرتهناً إلى سلطة المرجعية الدينية، صاحبة الكلمة العليا، والضامن الوحيد لشرعية تلك الأحزاب، والداعم المباشر لوصولها السلطة، عبر التأثير على خيارات الناخبين، وربطها بسلسلة فتاوى تحدد مَن هو الأصلح ومَن هو الأقوى على الساحة السياسية، بما يحاكي نموذج الجمهورية الإسلامية في إيران .
وإذا تحدثنا عن الشرق الأوسط، فلن نكون أمام نموذج بعينه، مع اختلاف تجربة كل نموذج عن غيره من النماذج الأخرى، انطلاقاً من النموذج الإيراني القائم على التسليم المطلق بمبدأ ولاية الفقيه، الذي يمثل سلطة الله وظله على الأرض، وينوب في ذات الوقت عن إمام الزمان المغيب ( المهدي المنتظر ) إلى حين ظهوره .
ولا شك في أنه نموذج تسيطر عليه جملة من الغيبيات بما هو آت، ولو بعد حين، ومثلما هي غيبيات مطلقة، هي أيضاً غيبيات تدعي اليقين المطلق في إيمانها، ويقينها هذا، يختلف في التفسير والتأويل، عن يقين نموذج حركة طالبان في أفغانستان وباكستان، فهي تسلم بمبدأ الإمارة الإسلامية، التي تحاكي شكل ومضمون ما كان قائماً قبل 1400 عام، وقد كان لها نموذجها في قندهار قبل أن يطاح به على خلفية هجمات الحادي عشر من سبتمبر في الولايات المتحدة الأميركية، والتي أعلنت تبنيها لتلك الهجمات الدامية التي راح ضحيتها الآلاف .
وبالانتقال إلى تركيا، فإن المشهد فيها، يبدو مختلفاً عن مجمل تفاصيل المشهد في عموم الشرق الأوسط، فالبرغم من التوجهات الإسلامية لحزب العدالة والتنمية، إلا أن النموذج الإسلامي في تركيا له خصوصيته التي تفترق كثيراً عن النماذج الأخرى لعدة أسباب، أولها أن الإسلام لم يدخل تركيا إلا متأخراً، بعكس البلدان المحيطة بها، فدخوله الفعلي كان على يد الأتراك أنفسهم ( العثمانيون ) عكس دخوله لبلاد فارس الذي تم قديماً على يد العرب .
وثانيها، أن الحضارة - بما أن الدين يدخل في وعائها الجامع - التي كانت سائدة في بلاد الأناضول، بما هي حضارة رومية – بيزنطية، فإنها تختلف اختلافاً عميقاً في نظرتها للدين وممارستها لطقوسه، عن الحضارة التي كانت سائدة في بلاد فارس من حيث غرقها واستغراقها المزمن في بؤرة الدين قديماً وحديثاً .
أما الاختلاف الآخر في النموذج التركي، أن الإسلام في تركيا، لم تقلم أظافره على يد الغرب ( الحلفاء آنذاك ) بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، كما لم تقلم بعد إعلان مصطفى كمال أتاتورك أفول دولة الخلافة ( السلطنة ) وولادة عهد الجمهورية، بل لأن الإسلام فيها أقل غرقاً في ممارساته الطقوسية، دون أن ينفي غرقه ( السابق) في الخلافة، أما غرقه الحاضر في السلطة، فهو يتم أمام عين العلمانية وعلى مرأى منها .
ويظهر التمايز في النموذج التركي عن النماذج الأخرى، أن الإسلام فيه، أكثر تحزباً في الحياة السياسية، وأكثر تكيفاً معها، فالتحزب على أساس الدين، ممنوع لدى الجماعات الإسلامية، لأنها تنظر إلى الأحزاب على إنها أحزاب الشيطان، وليست أحزاباً لله.
أما ما يفسر ظاهرة التحزب الإسلامي في تركيا ( الرفاه، السعادة، العدالة ) أن المجتمع أقل انغماساً وغرقاً في مزاولته الطقوس، لهذا ينعدم وجود الجماعات والحركات الإسلامية وما تمثله من نظريات خاصة في الحكم، سبق أن أشرنا إليها، وليس السبب في قلة انغماس المجتمع التركي بالدين، عائد إلى قوة العلمانية وحسب، بل إلى الطبيعة النفسية والتنشئة الاجتماعية التي فطر عليها الأتراك .
فكلما غرق المجتمع في طقوسه الدينية، كلما ارتفع منسوب التشدد والتعصب والتطرف، الذي تغذيه وتتغذى عليه الجماعات الإسلامية بشتى الطرق والوسائل، وكلما قلت مستويات الغرق، كلما كان المجتمع أكثر تحرراً في فهم الدين ومزاولته بعيداً عن الوصاية وسلطة المرجعية، وأقل حركيةً في فرض أجندته السياسوية من خلال الجماعات الإسلامية، التي لا تتفق نظريتها في الحكم المطلق مع روح العصر وتطلعات المستقبل .
كاتب سوري
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1307 الخميس 04/02/2010)