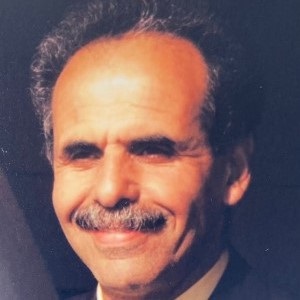أقلام حرة
مسرحية "الشمع" لجعفر القاسمي: بؤس المسرح أو في فن ادعاء الحرفة.
في إطار افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته 19، وبتاريخ 08/12/2017 تم تقديم عرض "الشمع" للمخرج جعفر الڨاسمي في قاعة "الريو" بالعاصمة، هذا العرض أثار عندي بعض الأسئلة ولاسيما التي تتعلق بالمرجعيات والخلفيات التي دفعت المخرج للإقدام على هذا المشروع وعن مدى راهينيته والاستعجالية التي تحركه.
أن تقدم عملا مسرحيا ويأتي إليك الجمهور ويصفق مشجعا عملك لا يؤدي ذلك بالضرورة للإقرار بأنك صاحب رؤية جمالية منسجمة المفاهيم، فما يحرك الجمهور نحو العرض ليس بالضرورة الأفكار والتصورات، فالجمهور يتلقى العرض بأحاسيس وشحنات وأحكام بعضها حيني وبعضها الآخر مسبق، وحتى وإن حضي العرض بالإعجاب فإننا نتوجه مع المخرج للبحث في فكر العرض وأرضيات إنشائه. فأن تقوم بتجميع مفردات ومكونات العرض المسرحي من ممثل ونص وإضاءة وأزياء وموسيقى ...وغيرها حول موضوع أو فكرة أو لسرد حكاية ما بشكل ذوقي أو عفوي أو تلبية لرغبات حسية أو بدوافع "إستشباحية " لا يعني ذلك أنك تتقن الإخراج، فهذه القناعات ربما تتعارض مع فكرة الإخراج وتنحرف عن جوهرها المحكوم بضوابط وقواعد غاية في الصرامة و"العلمية"، وأكثر من ذلك فالإخراج وباعتباره خلقا لعالم "سحري" فوق الركح يتجاوز تعريفاته التقنية ليصبح فعل مغامرة لاجتياز الحدود والحواجز التي تحول بين المبدع والأثر الفني.

لا جديد في عرض "الشمع" سوى إعادة ما تم تقديمه في عروض سابقة تكرار لما سبق تكرار وتكرار وتكرار في روح جافة مسطحة فما معنى أن يكرر المخرج نفسه ويعيدها بنفس الشكل ؟ فالتكرار في النهاية ليس إلا تمثل لذلك الجدار العازل الذي يفصل بين المبدع وفعل الإبداع، التكرار من حيث هو إعادة لشئ ولمادة ما، من حيث هو نسخ لمقترحات جمالية وصور فنية قديمة، ففي مسرحية "الشمع" ينبش المخرج نفس المكان ونفس المقترحات الفنية التي مثلت جسدا لأغلب أعماله وهو ما يحيل على ضيق أفق وتصورات هذا الفاعل المسرحي وعلى مدى إنغلاق دائرة تفكيره ومخياله وحسه تجاه الفن بصفة عامة والمسرح بصفة خاصة، فالفن خاضع لمبدأ التحول والتغير واللافن يخضع لمبدأي الثبات والجمود، وما مسرحية شمع إلا ترجمة لتلك الرغبة الجامحة في رفض التجديد ورفض المغامرة بالقديم ودحضه والاقتناع بالثبوت وحده ولاشيئ غير الثابت والنظر إليه من نفس دائرة التفكير والتصور، فإعادة وتكرار نفس الأدوات والأساليب الفنية والجمالية والإصرار على المحافظة عليها رغم تطور الزمن ورغم التحولات الإجتماعية والسياسية التي تقع خارجا هو دليل "تكلس" و عجز وهو يدل في عمقه على غياب لأرضية الجدل مع الواقع ومع ما يقع فيه من متغيرات، إن ما قلناه يحلينا بطريقة ما على أن التحفير في نفس الدائرة لا يعنى التحفير بنفس الأدوات الأولى فالإنتهاء إلى نتائج جديدة قد يفترض السير في نفس المسار لكن لا يوجب التمسك بنفس التقنيات والوسائل والأدوات، فتغيير المنطلقات والأرضيات في كل مرة قد يتيح للمبدع الوصول إلى نتائج مختلف، أما أن نكتشف بأننا في ذات المكان رغم تقدم الزمن فإن عيبا فينا من الضروري الإقرار به وإلا فإننا سنسقط في محاولة بائسة وفاشلة هدفها مراوغة الجمهور ومخادعته فقد تنجح في ذلك برهة ولكن لن يستمر ذلك دائما.
بهذا المعني يمكننا القول أن عرض "الشمع" لا يطرح في عمقه أي بحث جمالي أو تقني جديد يكسر مع القديم و لا يتيح لقارئه إنفتاحات وانزياحات تمكن من إنفتاح المعنى وإنفجاره على أفاق غير معلومة في المعنى وفي الأفكار وإنما هو مجموعة من الأدوات والأساليب والتقنيات الجمالية الجاهزة مسبقا غرضها صنع المبهر في الفرجة، فالإبهار في المسرح لا يعنى اشتغالا على الصورة في المسرح بما هي إبداع وابتكار لشبكات علاماتية مفادها تحفيز حس المتفرج ووعيه والارتقاء بذوقه وإلا فان هذه التقنيات تتحول إلى عبئ وعنف واستغفال للجمهور وتزييف لوعييه وحسه .
يطرح علينا الإبهار بما هو الشكل الخارجي للعرض سؤالا مهما : هل مهمة المسرح هي إبهار الجمهور؟ وإن كان إبهارا بماذا نبهر هذا الجمهور؟ ينبهر الجمهور بممثل قدم أداءا مفعما بالطاقة الخلاقة المنجزة للشخصية والحاملة لخطاب العرض، فالجمهور في المسرح ليس الجمهور في السيرك وليس الجمهور في قاعات الرياضة أو غيرها من الفضاءات ففي المسرح الجمهور يوضع أمام الأثر مفتوحا على القراءات التي تتجه نحو الذات والمجتمع تحاول تفسيره وتقريب معادلاته، إنها إبحار نحو معلوم من خلال مجهول وإبحار من خلال غموض نحو مكشوف وهي قيمة المسرح التي تحاول ترسانة التوحش الإعلامي أن تلغيه.
مسرحية "الشمع" هي نموذج وترجمة "للمسرح الغني" بالعيوب والفقير من روح العضوية، عضوية الجسد الاجتماعي والثقافي، فالعرض يضع نفسه أمام إشكال أساسي مثل عقبة رئيسية في بنيته وتركيبته وهو عدم قيامه على مشروع جمالي واضح بمعنى أنه غير مؤسس وفقا لمفهوم فكري / فلسفي / علمي تبنى عليه مختلف عناصر العرض الفني (النص، السينوغرافيا، الأداء...) هذا الإشكال ساهم في تعطيل الميكانيزمات الداخلية للعرض وأظهر لنا عدم ترابط وتناسق بين مفرداته، فلا توجد مثلا أي علاقة عضوية بين الموسيقي والحدث الركحي وبين النص السينوغرافيا وبين المؤثرات والمعنى.
في المستوي الإخراجي تم العمل في مسرحية "الشمع" على عناصر قديمة من الموروث "البريشتي" من أجل أن يقنعنا بأن العرض ينتمي وينتسب لحقل فكري وإيديولوجي وجمالي معين، وما التنصيص على استعمالها والعمل بها بتلك الطريقة إلا تأكيد على عدم فهم معمق ل "البريشتية" بما هي جمالية تشتغل على مفاهيم وأسس واضحة المعالم فالمسرح الذي أعلنه "بريشت" قيمه خالدة أما تقنياته فهي متجددة وحتى لو عاد "بريشت" اليوم لما أعاد وسائله التي أنجزها في القرن الماضي. فاستعادة "بريشت" بهكذا طريقة إنما يؤكد على فهم لسطوح "البريشتية" وقشورها فتقنيات التغريب متجددة ونابعة من جدة العرض ومن قيمه الجمالية الجديدة وليست تكرارا لتقنيات ولدت في عهود سابقة ولهذا وجب التيقظ حتى لا نقع في الرجعية الفكرية فالمسرح استشرافي وفن يأتي من المستقبل لا من الماضي .
من زاوية أخرى من المهم الإشارة إلى كون العرض الفني وفي لحظة اكتماله يعلن وفقا للمفاهيم التي قام عليها أنه جسد متناسق ومتناغم الأجزاء يستحيل الإضافة إليه أو التخلي عن جزء منه وربما يعد اكتماله كجسد "حي " مقياسا للفنية والإبداعية فيه ومن هذا المنطلق يمكننا القول أن الاستغناء عن أجزاء ومشاهد من مسرحية "الشمع " لا ينقص من العرض شيئا كما أن زيادة أي عنصر للمسرحية لا يفسد لجوهر المقترح شيئا وهو أمر يضعف من قوة الأثر ويهلك جوهره وينزع عنه أية روح إبداعية.
يعد هذا النوع من العروض المسرحية تنفيسا يفرج فيه أصحابه عن بعض الإستشباحات والتوهمات بفعل النبيل والرائع داخل الممارسة السائدة وهو في الحقيقة ليس إلا كشفا لعدم نضج الفكرة الجمالية التي يستوجب بناؤها حذرا شديدا لا استبساطا واستسهالا والفكر عدوه الاستسهال وغياب الجدل .
حسام المسعدي
باحث ماجيستير في العلوم الثقافية بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس