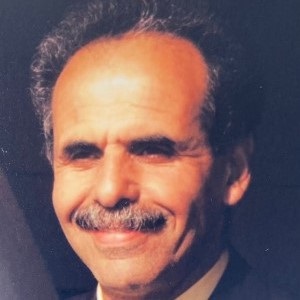أقلام حرة
فساد الإسلام أم فساد السلطة؟
أينما وجدت السلطة، وجِدَ الفساد، والفساد بطبعه أصل لكل داء، والدين لا يفسد، إلا عندما يستشري الفساد في ثنايا العقل والمجتمع وكل مرافق الدولة ومؤسساتها العلمية والاقتصادية وحتى العسكرية، وليس الدين بريئاً عن ساحة الفساد، لكونه إحدى المؤسسات التي تتكون منها الدولة، وهو ما قد يعني أن الدولة الإسلامية بحقيقة أمرها فاسدة، لطالما وجدت فيها السلطة، لكن أي سلطة وجدت فيها ؟.
إن من علائم قوة الدولة، انعدام الفساد وانتفاء أسبابه، وهذا يكشف لنا عن طبيعة السلطة التي كانت سائدة آنذاك، فلم تكن الدولة الإسلامية قبل 1400 سنة من الضعف والهوان، كما هو حل المجتمعات الإسلامية اليوم، وأياً كانت طبيعة السلطة، دينية أو عسكرية، أم مزيج منهما، فإن المقارنة الموضوعية بين واقع الدولة الإسلامية، وواقع المجتمعات الإسلامية اليوم، كاف لنفي الفساد عنها، وإعادة التفكير مرة أخرى، بأن فساد السلطة سابق على فساد الإسلام .
والفساد لن تنتهي مفاعيله من حياة المجتمعات الإسلامية، ما لم توضع ضوابط ناظمة في إطار القانون، وتسن التشريعات التي تخفف من غلوائه، وهنا تنبع المشكلة مع أصحاب المؤسستين الدينية والسياسية، فلا المؤسسة الدينية مستقلة في قراراتها عن المؤسسة السياسية، ولا الأخيرة تستطيع مزاولة مهامها دون الحصول على الغطاء الشرعي، كبديل عن الغطاء الشعبي .
إن التداخل بين عمل المؤسستين السياسية والدينية، لا يبرئ ساحة الأخيرة من الفساد الراهن في واقع المجتمعات الإسلامية، لطالما كانت المؤسسة الدينية جزءاً من منظومة السلطة، إن أفراداً أو جماعات، فهي أيضاً، جزء أصيل من منظومة الفساد، وبالتالي هل ينحصر تمثليها للإسلام بنفسها وحسب، أم بسائر المسلمين ؟ .
إذا كانت المؤسسة الدينية بشقيها ( الشيعي والسني ) تدعي تمثيل الإسلام، فهو تمثيل لمصالحها المتركزة على دوائر السلطة، قبل أن يكون في سبيل مصالح العامة، وهو ما يعيد كرة الفساد إلى ملعبها، قبل أن يعيدها إلى ملعب المؤسسة السياسية.
ما يجب التأكيد عليه والقطع في صحته، أن إسلام اليوم بكل مظاهره ومذاهبه وحتى فساده، ليس مرتبطاً بإسلام الأمس، بل لا علاقة تجمع بينهما، سوى القرآن، ويظل الأخير تشريعاً لزمن الأمس، وكتاباً لزمن اليوم.
أما نقطة الالتقاء الوحيدة بين المؤسستين الدينية والسياسية والتي تشكل الأرضية الخصبة لاستشراء الفساد، تتمثل برفضهما المطلق للقانون، سواء كان قانوناً وضعياً من صنع العقل البشري، وهذا ما ترفضه المؤسسة الدينية على اختلاف اتجاهاتها بذريعة مناقضته للتشريعات السماوية ولحاكمية الشريعة، أو كان قانوناً إلهياً، وهو ما ترفضه المؤسسة السياسية، بداعي التوازن بين مكونات المجتمع والحافظ عليها بالقوة .
إن المزواجة بين القانونين تزيد من حدة الفساد، من دون أن تحد منه، فالفصل الذي تتبناه العلمانية، بغرض تحقيق التقدم، ينبغي أن يبدأ من القانون كجزء من السلطة، وصولاً إلى الدولة ومؤسساتها المتعددة، وما المزاوجة بين القانونين المدني - الوضعي، وبين الإلهي - الشرعي، إلا إخفاء وتستراً على الفساد بمشاركة الدين والسلطة معاً .
وعندما يسود إحدى القانونين على الآخر، سيختفي الفساد كلياً من حياة المجتمع، كما كان معمولاً بالقانون الشرعي دون المدني، إبان عهد الدولة الإسلامية الراشدية، وكما هو معمول الآن بالقانون المدني في الدول الغربية، التي ينعدم فيها الفساد .
كاتب سوري
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1277 الاثنين 04/01/2010)