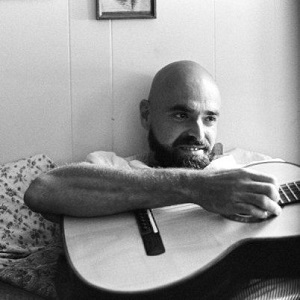نصوص أدبية
رائحة الشرطي
تأففت من رائحة خطوته السرية تلك، ولم أجد للفعل هذا سبباً، يفسر لي تلك الخطى التي تراقبني، وهي تدون صوتي، وانزياح نفسي، وتتمنى أن تردم حرفي، وترسم العلامات الفارغة في شخصي، وهدمي، وتبحث في زيارتي، عدت بالزمن إلى أول خطوة وضعتها على أرض الأسكندرية، لم أجد في ديواني ماهو مؤلم لمصر، ولكني ومع هذا لم أكن مبالياً، إحساس في داخلي يقول لي: ستهزم هذا الشرطي بحبك لناس مصر الحلوة، وقتها كنت عائداً إلى القاهرة بعد زيارة إلى الأسكندرية الأنيقة، مع أني كنت مستأنساً بأوقاتي التي عشقت معها المكان وأهله، حتى أنني قلت في ذات نفسي: سأهجر أوروبا وأقيم بقية أيام حياتي في الأسكندرية، لما تمتلكه المدينة من جمال طبيعتها، وعسل كلام أهلها، كما يقول المصريون: "حضرتك عسل".
وجدتني أجلس على مقعد خشبي عتيق قد ثلمت بعض ضلوعه، شاركني المقعد شابٌ مصريٌ جامعيٌ مهذبٌ ومثقفٌ، وكلانا ينتظر القطار النازل إلى القاهرة، في محطة "سيدي جابر"، وقتها جاء الرجل ذاته الذي كان يشمشم سير خطوتي، يطلب السماح له بالجلوس بيننا، تململ الطالب الجامعي مستاءً من فضول الرجل، لكنه بالتالي إنزاح عن مكانه سامحاً للرجل بالجلوس، أما أنا كنت أجلس على حافة المقعد ونفسي تحدثني: ماذا يريد هذا المعتوه؟ لم يلاحقني؟ وباستياء وجدت الدخيل يراقبني عن كثب، لم أستغرب من هذا الفعل، فقد أعتدت عليه في الأماكن العربية، مال برأسه الثقيل متوتراً ومنفعلاً إلى اليمين وإلى الشمال، معبراً عن انزعاجه من الحميمية التي نشأت بيني وبين الشاب الجامعي، وكأنه لا يريد للناس أن يتحابوا فيما بينهم، وحاله البغيض عبر عن توتره وانفعاله، رأيته يميل برأسه الثقيل منزعجاً، وقد ثخن جسده تأففاً، وانتفخت العينان في وجهه، حك جبهته العريضة الكحلاء باظافره المتسخة، كوّر شفتيه السمينتين دافعا بالسفلى إلى الأمام، بينما ترك العنان لأصبعه من اليد الثانية ينقب في داخل أنفه ذات الفتحتين العريضتين عن زبالة ما، نظر بوجهي كارهاً وجودي، ونفسي تستزيد شكوى من رائحة عطنة أخذت تستفز المكان حين تثاءب، أشبه برائحة الثوم الخاثر قد غطت الجو المحيط، وحين صمت فاه العريض سألني:
- هل أنت عراقي؟
وباستحسان تصاحبه ابتسامة رسمتها على وجهي، لحَنتَ الفرح على سحنتي الفلاحية العراقية معبراً عن اللامبالاة وأجبت:
- نعم أنا من أرض السواد، من مدينة البصرة، ثغر العراق الباسم.
مال برأسه المحمل بالظنون، وحاله يرسمُ ثقلَ دائرةٍ منفعلة من سوسةٍ جَعَدَتْ وجهه الخشن، وبها تورمت شفتاه ورجفتا، وبدا جدياً ومتوتراً، وهو ينظر لي باستغراب خبيث لا افهمه، والغضب يملأ لونه، وحال عضلات وجهه أخذت ترتجف، وهو يلقي عليّ سؤالاً آخر، تفوح منه رائحة تستفزني، قال.
- هل أنت من محبين الرئيس "البطل" صدام حسين رحمه الله، واسكنه جنات النعيم!؟
قالها بفخر دافعاً صدره المخسوف إلى الأمام، لاوياً شفتيه السمينتين على بعضهما البعض، وقد رفع وجهه إلى الأعلى، وحاله يعكس بهجة السؤال على منظره، وجدت الطالب الجامعي يطأطىء رأسه محتجاً على صيغة السؤال، يهز يده اليمنى باسماً بسخرية شديدة البلاغة، ويتمتم شيئاً لم أسمعه، ومع هذا وجدتني مبتسماً باستخفاف بكلمة "البطل"، وقتها قفزت إلى ذاكرتي حفرة العار، وشكل صدام الياردنتالي عند إلقاء القبض عليه، وهو مرعوبٌ متوسلٌ الجندي الأمريكي، بعد هروب "البطل" من المعركة.
في الحقيقة درست الرد في ذات نفسي من مبدأ: لا أريد أن تلصق بي تهمة عميل لدولة يصنفونها معادية للعرب، وهي التهمة الجاهزة والمعيبة بآن لكل من يقع في قبضة مخالبهم، مع أني كنت أشتم رائحة المخابراتية تفوح من بين حروف المتحدث، وهو المنفوخ جدية وعلياء، ولكني المتمرد والغير آبه في مثل هكذا مواقف أذقته مرارة سؤاله فصرخت بوجهه:
- لالالالالالالالالالالالا، لا لست محباً لصدام الجبان.
أبتسم الطالب الجامعي مستحسناً الرد، وهو يضع يده على فمه، لاصقاً نظرة على وجه الدخيل فيها ما يكفي من السخرية. بينما وقع جوابي على الشرطي أشبه بالزلزال، فقد تشوهت عيناه غضباً، وبان في رمادها وباء الحقد والذل والانكسار، وجدته يفغر فاه متعجباً، فبانت الأسنان طويلة صفراء يحيط بكل ضرس منها حزام كلسي أسود، وهو يهز بدنه السمين غيضاً، فيتحرك كرشه المنفوخ كتلة واحدة صاعداً نازلاً مع أنفاسه الثقيلة والسريعة بآن، وحال عينيه وجدتهما تتوعداني بحدث ولا حرج. ولكني واصلت عنادي معه، ثابتاً على موقفي، محباً لمصر "أم الدنيا"، كارهاً الجلاد، حينها أحسست بالعطف عليه، وأنا أتمتم قولاً يحاصرني في ذات نفسي:
- خلِّ الشموخ يا نفسي وتألقي .. أن الجناة لا يقيمون للضحية قبر
طوحت رأسي هادئاً، وابتسمت بين شفتيّ عنيداً. نظر بوجهي مستغرباً عدم مبالاتي فاحتال في قوله وحينها سألني بصوت أجش عالٍ ومتوتر:
- هل ترضى بالأمريكان يحكمون العراق بدلاً من صدام؟
قلت ضاحكاً مستعجلاً موهبتي وسخريتي في مثل هكذا مواقف، وكأن الأمريكان موجودون في العراق وحده:
- لست وحدي، بل العراق كلهً لا نقيم للأمريكان موطناً في أرضنا، وما الأمريكان إلا أداة استخدمها العراقيون بذكاء لاسقاط المصدوم في حفرة العار الشهيرة، وبهدوء تصاحبه ابتسامة خفيفة سألته:
- هل تقبل أن يحكمك رئيساً يهرب من أرض المعركة، ليختبىء في حفرة قذرة تمثله هو وبعثه؟
حينها وجدته وقد نفخ الدم وجهه، وتجعدت جبهته، واحتقنت ملامحه، ورجفت شفتاه، مطوحاً رأسه الثقيل، وهو يهذي بكلمات نابية يتمتمها مترنحاً من غيض ألمَ به. ومع هذا كنت عطوفاً عليه، أحترم أفكاره وآرائه وطريقة حديثه، لأنها بالأساس لا تعنيني، نهض مغادراً جلستنا غير الحميمية، دون أن يجيب على سؤالي، وهو يحدق بي بنظرات معادية، يهز بذراعيه منفعلاً يلوحها في الجو المحيط به، ورأسه يتمايل من ثقل ألمَ به.
وبينما كنت أنا والطالب الجامعي نستعرض ما سبق من حديث، وصل القطار وكأنه الجبل يترنح ويعوي.
وجدتني أجلس بالقاطرة رقم 7 ، كرسي رقم 2، كنت سعيدا ومرحاً برحلتي تلك، وقد نسيت الشرطي عاشق المصدوم، ولكني فوجئت بأحدهم يقف قبالتي في الفسحة ما بين القاطرتين، خلف باب القاطرة الزجاجي يراقبني ويزأرني بخبث، حينها تذكرت ذلك الشرطي، كان قد القي نظرة على تذكرتي، وقتها كنت أحسب الزمن مع الساعة المعلقة في المحطة، والوقت المخصص في التذكرة، وهذا ما يفسر مراقبة الشرطي الجديد لي، ومع هذا الحصار تجاهلته بنجاعتي المعهودة.
شغلت وقتي بالحديث مع جاري الجالس على يميني هادئاً، يشغل الكرسي رقم 1 وهالة وقار تميزه، كان يشرح لي عن طبيعة الأماكن التي نجتازها، تاريخها واقتصادها ما مر عليها من ويلات أو خيرات، في حين كان يجلس إلى يساري رجل كهل كنت قد أعنته على الصعود إلى العربة، وخلفي تجلس فتاة ناعمة كأنها النبع المنقى بحلاوته.
حينها كنت منشداً ومنشغلاً بروعة الطبيعة الخلابة، والقطار يستولي شيئا فشيئا على المسافات، ويستعجل الوصول إلى القاهرة، في حين بقيّ الشرطي مركوناً خلف الباب، لا يزيح عينيه عن شخصي، وحاله يتمنى أن اخطىء تجاهلته تماماً، وقد حرصت على أن أفهمه أنني غير منتبهٍ لوجودهِ، حتى أن الفتاة التي كانت تجلس خلفي، استشعرت نظراته تحرثني بصمت، مدت رأسها إلى أذني بسرية ذكية، سمعتها تقول لي، ورائحة أنفاسها شممتها تفوح زكيةً تطيّب أنفاسي:
- أستاذ لا تعر أهمية لذالك الغبي، كلنا نعاني من هؤلاء.
وفعلاً نسيت كل شيء بعد أن غادرت القطار.
وجدتني أعبر الرصيف إلى الطرف الثاني من الأتجاه الأول للشارع، والفتاة ذاتها بجانبي تحرث الأرض مرحاً لتلحق بخطوتي العريضة، وهي تحتك بي بين الفينة والأخرى، معبرة عن ودادٍ ما، ترسمُ على وجهي نظرة مرحة، وتغنج قليلاً، بعد أن وَجَدَتْني رسمياً معها، أخذت تسمعني قولاً:
- كلنا أبناء حوى وآدم.
وأردفت بعد صمت قصير لبيان قولها:
- صح؟
هززتُ لها رأسي مبتسماً، ورسمتُ نظرةَ إعجابٍ على وجهِها الحنطي الناعم، أرخت العينين العسليتين حياءً، وشفتاها دائمتا الابتسام. مشينا إلى الطرف الآخر من الحياة الذي لابد منه، وبقيّ حرف الواو بيننا.
جعفر كمال
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1223 الاثنين 09/11/2009)