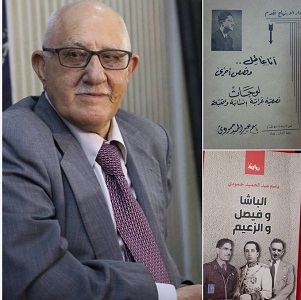قضايا وآراء
فلسفة الموت والحياة انطلاقاً من فلسفة الإمام الحسين
بالمبتدأ والمآل بالنسبة إلى كلِّ ما يغلِّف وجوده الشبحيَّ المتردِّد بين التحقُّق والعدم، من التفاصيل الصغيرة، والجزئيات الدقيقة، ممّا هو ذو علاقةٍ وطيدةٍ بالمصير، أقول: بما أنه الكائن الحيُّ الوحيد الذي هو على هذه الصفة، فلا بدَّ أن يكون موقفه من الحياة المؤقَّتة القصيرة المليئة بمختلف أصناف المتاعب والمصاعب والكدورات موقفاً ينبئ عن وجود ثلاثٍ مجموعاتٍ من البشر، تتخذ كلُّ مجموعةٍ منها موقفاً فرعياً لا بدَّ أن يكون مندرجاً آخر الأمر في الموقف الرئيس الشامل لكلِّ تلك المواقف الفرعية الثلاثة، وما يمكن أن يتفرَّع عنها أيضاً من المواقف الفرعية الأصغر منها، والتي لن نتحدَّث عنها بالتفصيل في هذه المقاربة الفلسفية الخاصَّة بالإمام الحسين عليه السلام.
ليس ذلك الموقف الرئيس الشامل من الحياة المؤقَّتة المحصورة بين العدم السابق والعدم اللاحق إلا الشعور العامَّ بأنَّ المأساة الوجودية التي تغلِّف حياة الإنسان لا بدَّ – بوصفها إشكاليةً فلسفيةً معقَّدةً بحاجةٍ إلى الحلّ- أن تجد طريقها وهي آخذةٌ بيد هذا الإنسان إلى الشعور النهائيِّ – سواءٌ أكان حقيقياً أم مزيَّفاً- بالخلاص.
الموقف الرئيس الشامل
يتمثَّل هذا الموقف الذي يشكِّل أسّاً لكلِّ المواقف الفرعية الأخرى في هذا المبدأ الذي يقضي بأن يحقِّق الإنسان حرِّيَّته، أي أن يجد لنفسه موقعاً خارج نطاق الحتمية أو الجبرية البايلوجية التي حكمت على نفسه بالوجود المؤقَّت بين فنائين اثنين، فناء ما قبل الولادة وفناء ما بعدها، ولا ضير في أن تكون تلك الحرِّيَّة المكتسبة واقعيةً موضوعيةً منطلقةً من الفهم المعمَّق لناموس الوجود، المبنيِّ على أساس أنَّ الضرورة أو الحتمية التي تغلِّف العالم مجوَّفةٌ من الداخل بما يسمح بوجود أصنافٍ لا ناهية لها من الحريات المنشودة، أم كانت حريةً مكتسبةً على الصعيد الطوبائيِّ أو السيكولوجيِّ الذي ربما اعتُبر في عرف المجموعات الكبيرة من البشر هو الأهمّ، بل قل هو الوحيد الذي يستحقُّ من الإنسان التفضيل والإهتمام، فإذا ما شعر المرء - ولو خداعاً- بأنه حرٌّ فهذا وحده يكفي، حتى لو كان واقع الحال يشير بحسب الدراسة والتحليل إلى النقيض تماماً من هذه النتيجة.
المجموعات الثلاث من المواقف المحتملة المنضوية تحت الموقف الرئيس الشامل
الأوَّل: الموقف الفلسفيُّ العقليّ: في هذا الموقف يقطع المرء خطواتٍ في التفكير حول معنى الحياة وفلسفتها، حتى إذا ما اكتشف حقيقة أنها مؤقتةٌ فعلاً، وأنها بناءً على هذا لا يمكن أن تكون مصدر سعادةٍ واقعيةٍ للإنسان، أو كما قال ميرلوبونتي"إنَّ عمل الإنسان الوحيد هو بناء الموت" نحو أخلاق وجودية ص6 فإنه ينتقل إلى المرحلة الثانية التي يفكِّر فيها بنفسه، فلا يمكن له الإستمرار بالحياة طبقاً لهذا المعنى من جهةٍ، ولا يمكن له أن يقلب نظام العالم، إذ هو نظامٌ مصمَّمٌ طبقاً لجبريةٍ لا دخل للإنسان فيها، فالموت هو طرفا المعادلة التي تنتج العالم كلَّه، بما فيه الكائنات الحيَّة جميعها، بل حتى الجمادات تحيى وتموت حياةً وموتاً مناسباً لتركيبها ونظامها الداخليِّ الذي يحكم وجودها كلَّه، فلا بدَّ إذاً من التفكير في قلب معنى الفناء إلى ضدِّه من جهةٍ، ولا بدَّ أيضاً من التفكير في اجتراح الطريقة الناجعة التي تجعل الحياة مشحونةً بالمعنى المضادِّ لمعنى الفناء، فلا تكفي الرغبة وحدها في تحويل معنى الفناء إلى ما يضادُّه من معاني ودلالات الخلود كما هو واضح.
من هنا تبدأ رحلة العقل الإنسانيِّ في سبر أغوار العالم لاستخلاص المعنى، ومن هنا تكون مهمَّة البحث عن هذا المعنى الغامض والمعقَّد في غاية الصعوبة، إلى حدِّ الإرتقاء بها إلى معنى المغامرة، وأيَّة مغامرةٍ أصعب من هذه، وأية رحلةٍ في خبايا العالم أحفل بالمخاطر والإخفاقات المتوالية قبل التوصُّل إلى بارقة أملٍ في النجاح من هذه الرحلة التي استغرقت أعمار الفلاسفة والحكماء والمتصوِّفة، فضلاً عن كافَّة من اشتغل بأمر المصير من كلِّ أصناف ومجموعات البشر.
لكنَّ العقل يتعثَّر، كما إنه يخطئ كثيراً بالرغم من أنه قادرٌ على تصحيح أخطائه في النهاية، لكن ليس بلا ثمنٍ طبعاً، بل الثمن باهضٌ غالباً، لأنه يتطلَّب منه أن ينزل بالكثير من أحكامه الخاطئة إلى الواقع، سواءٌ كان على مستوى عالم التصوُّر والذهن، أم على مستوى عالم التصديق والخارج، فيطبِّقها عليه، وإذ ينتج الخطأ الواحد أخطاء أخرى مشابهةً تتأسَّس على ذلك الخطأ الأوَّل، وكلُّ واحدٍ من هذه الأخطاء المتولِّدة الجديدة ينتج أخطاء من فصيلته وسنخه، حتى تتراكم الأخطاء، فتتحوَّل إلى حجبٍ كثيفةٍ تجعل من رغبة العقل في تصحيح أحكامه الخاطئة عمليةً صعبةً للغاية إن لم تكن مستحيلةً، لأنَّ الأخطاء ذاتها تتحوَّل إلى بنيةٍ راسخةٍ يؤطَّر بها عقل الإنسان، فلا يعود من السهل عليه النظر إلى هذا الإطار الذي يفرض حصاراً على العقل من كلِّ الجهات، بوصفه خطأً يجب أن يُصحَّحَ أو أن يزول.
ومن هنا حاجة العقل إلى الإستعانة بمددٍ آخر من أصله الذي انبثق منه، أي أنه بحاجةٍ إلى مددٍ من الله الذي يستطيع العقل أن يهتدي إلى ضرورة وجوده بالنسبة لهذا العالم، وبما أنَّ الله لا يمكن أن يتَّصف بما يضادُّ اللطف المطلق، فإنَّ المتوقَّع منه في كلِّ حينٍ أن يفيض على العقل بحسب استعداده اللائق من جوده وكرمه، وستكون النبوَّة هي أجلى مصاديق هذا اللطف بطبيعة الحال.
ها هنا سيجد العقل راحته، ومن هاهنا سيحقِّق أمنيته في أن تنقلب العبثية والعدمية اللتان يفرضهما الشعور بالفناء إلى نظامٍ إلهيٍّ محكمٍ ذي مغزىً، فليس في الكون سنتمترٌ واحدٌ خالٍ من حكمة الله، كما إنَّ وجود الإنسان محكومٌ من النشأة إلى نهاية الحياة بما يجعل الإنسان أمام مسؤوليته الكبرى في الوجود، والتي لا تندُّ عن التناغم الكامل مع ذلك النظام الذي يحكم العالم بأسره، بذلك المضمون الدقيق الذي أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: أتحسب أنَّك جرمٌ صغيرٌ وفيك انطوى العالم الأكبرُ؟!
العالم كلُّه مرآة الله، والإنسان أيضاً مرآة الله، فهل هناك من مكانٍ للعبث بالنسبة إلى أيِّما شيءٍ يكون مرآة الربِّ سبحانه وتعالى، ناهيك عن أن تكون المرآة إنما هي ذلك الكائن الذي أسجد الله سبحانه له الملائكة، وعاقب مخلوقاً عبد الله آلاف السنين لا يُدرى أمن سنيِّ الدنيا هي أم من سنيِّ الآخرة، لأنه استكبر في لحظةٍ فشعر بأفضليَّته عليه، فكان مصيرَه اللعن الأبديُّ والخلود في جهنَّم في نهاية المطاف.
إنَّ هذا السبيل المنطلق من خطوةٍ عقليةٍ أولى استعانت بلطف الله، وانتهى إلى غايته في أن يكون الإنسان والعالم معه مرآة الله سبحانه وتعالى هو السبيل الوحيد الذي ينجي الإنسان من الشعور بالعدمية والعبث، ويجعل مجريات العالم والتأريخ كلَّها تبدو في عين الإنسان مظهراً من مظاهر الحكمة الإلهية التي لا يمكن أن يكون أيُّ جزءٍ منها خالياً من المعنى الكبير في كلِّ الأحوال.
الثاني: الموقفُ السيكلوجيّ
إنَّ البعد السيكلوجيَّ بعدٌ هامٌّ وأصيلٌ في الذات الإنسانية، فليس الإنسان مكوَّناً من عقلٍ فقط، بل ربما كان جزءٌ كبيرٌ من العقل مكوَّنٌ من تلك المادَّة السيكلوجية، وإن لم يشعر الإنسان بذلك، ولهذا فإنَّ العقل غالباً ما يكون مجرَّد قالبٍ تتأطَّر فيها المادَّة السيكلوجية، أي أنَّ العقل يقوم بمنهجة المادَّة الملقاة في قالبه بغضِّ النظر عن نوعها أو صنفها أو جنسها، ولهذا السبب أيضاً تجد أنَّ أحكام الناس تختلف من شخصٍ إلى آخر بشأن العديد من الموضوعات المشتركة، فبالرغم من أنَّ موضوعات الحكم واحدةٌ بين أفراد طائفةٍ من البشر، ترى أنَّ أحكامهم متنوِّعةٌ، أو متضاربةٌ، أو متناقضةٌ، وإنَّ هذا لهو الدليل الناصع على صحَّة استنتاجنا السابق، إذ تكون للأحكام المسبقة المتأثِّرة بالعديد من الجوانب السيكلوجية، الأثر الأكبر في تكوين أحكام البشر.
من هنا فإنَّ عدداً كبيراً من المفكرين الغرب، وتبعتهم طائفةٌ كبيرةٌ من المثقفين في الشرق الإسلاميّ، لم يكن همُّهم أن تكون أفكارهم عن الحياة والموت والسعادة والشقاوة وسائر المعاني التي لها ارتباطٌ بالنفس مطابقةً للواقع الموضوعيِّ لها، بل ربما قالوا بفقدان الواقع الموضوعيِّ بالنسبة إلى هذه المعاني من الأساس.
ليس المهمُّ إلا شيئاً واحداً لا غير، وهو الإنعكاس الموجود في النفس عن هذه المعاني، فإذا تصوَّرت النفس وجود السعادة في عملٍ معينٍ كان مبعثاً للسعادة بالفعل، وما شعرت به النفس شعوراً ينمُّ عن وجود الشقاوة فيه كان مصدراً للشقاء بالفعل، وهكذا. من دون أن يكون للتفكير الموضوعيِّ دخلٌ في حسم التنوُّع والإختلاف في الحالات الشعورية المختلفة الموجودة في نفوس الأفراد المختلفين، وبناءً على هذا فإنَّ الموقف من الحياة ووجود المغزى فيها متوقِّفٌ على الحالة السيكلوجية للفرد، فهي المرجعية الوحيدة التي تقرِّر أنَّ العمل الفلانيَّ عملٌ ذو مغزى، وأنَّ نمط الحياة المعيَّن جديرٌ بالإهتمام، وأنَّ أسلوب الموت المشار إليه في الموقف الإنسانيِّ المعين لا يستحقُّ أن يكون أسلوباً يحتذى وهكذا.ولهذا فإنَّ الفلاسفة الوجوديين اشتهروا بهذه المواقف التي نمَّت عن شعورهم العبثيِّ بالحياة، حتى أنَّ عدداً كبيراً قرَّر أن يموت انتحاراً في نهاية الأمر، ليحسم هذه الدورة الكئيبة للحياة الإنسانية الخالية في رأيهم من أيِّ مغزىً معقولٍ، كما إنها فاقدةٌ للهدف حتى النخاع.
عندما يكون الموقف السكلوجيُّ هو المحدِّد الأوَّل والأخير لمعنى الحياة والموت والسعادة والشقاء والخير والشرِّ وما إلى ذلك من الأمور، من دون أن تكون هناك مرجعيةٌ أخلاقيةٌ أو فلسفيةٌ أو دينيةٌ أخرى يتأطر به أوَّلاً، ويبرمج نفسه على أساسه، فإنَّ النتائج ستكون كارثيةً على هذا الصعيد، بمعنى أنَّ الحياة ستبدو كما لو أنها شيءٌ ما فائضٌ عن حاجة هذا الشعور السيكلوجيِّ ذاته، وسيكون من الصواب تبعاً لهذه النتيجة أن تكون الحياة محفوفةً بأصنافٍ شتى من المآسي والملذات، إلا أنها تتتابع على الإنسان من دون أن تكون منتظمةً في سلكٍ ما من المعقولية أو الهدفية أو الغائية التي تبرِّر كلَّ ذلك، وتجعله محتملاً ومقبولاً في نظر الذات، وسيكون الموقف المعقول اتخاذه في هذه الحالة هو وضع نهايةٍ سريعةٍ لهذا الوضع السيكلوجيِّ المتأزم بطريقةٍ مسانخةٍ له من جهة عبثيتها ولامسؤوليتها وعدميتها المطلقة، ولن تكون هذه الطريقة التي تتمتَّع بكلِّ هذه المواصفات إلا الإنتحار.
الثالث: الموقف الأبيقوريُّ البيوهيميُّ العابث
هذا الموقف هو موقفٌ هاربٌ في الحقيقة، أي إنه لا يشاء أن يواجه المشكل بالتفكير الفلسفيِّ الصبور على طرح الإشكاليات الأنطلوجية والإجابة عليها، بل هو يكتفي بمشاهدة ظاهر الأمر، حيث يعيش الناس حياةً مؤقتةً ثمَّ سرعان ما يختفون عن مشهد العالم بالموت، وهم يتألمون لهذه الحالة بالطبع، إلا أنهم لا يشعرون بأنَّ الوجود الإنسانيَّ في الحياة هو محض مأساةٍ لأنه مغلَّفٌ بالعدمية والعبث نتيجة فقدان المعنى كما هو الموقف الفلسفيُّ العابث لأصحاب الموقف الثاني، بل هم ينظرون إلى الأمر بانتهازيةٍ مطلقةٍ، فإذ تكون الحياة فاقدةً للمعنى بسب شيءٍ واحدٍ، وهو أنها توجد وجوداً مؤقتاً سريعاً ثمَّ تضمحلُّ فتزول، فإنهم يقرِّرون أن يعيشوا هذا الجزء اليسير من الحياة ويملأوه بأعلى مقدارٍ ممكنٍ من الملذات، فلو كانت الحياة مستمرَّةً مثلاً لما كان لها من مبرِّرٍ إلا أن تكون وجوداً مبهجاً بوجود هذه الملذات والشهوات الحسية والمادية، فليكن الحلُّ إذن متمثلاً في أن يركزالمرء تركيزاً أكبر على أن يحيى حياةً مفعمةً بالملذات والشهوات إلى أقصى حدّ، كما لو أنه عاش حياةً كاملةً أطول بأضعاف المرات من مدَّة الحياة المحدودة هذه، فإذا نجح في تحقيق هذا المسعى نجح باقتناص معنى الحياة أيضاً، وليأتِ الموت بعد ذلك، فليختم هذا الوجود المبهج بنهايته المأساوية المرعبة.
إنَّ كثيراً من الفنانين والشعراء على وجه الخصوص عاشوا هذا النمط من الحياة وعدوه حلاً لشعورهم بمأساة الحياة نتيجة وجودها القصير المؤقَّت، وهم لا يختلفون عن الأعداد الغفيرة من الناس ذوي التفكير السطحيِّ الساذج إلا بكونهم حاملين لمواهب تمنحهم القدرة على الصياغات الفنية لذات الموقف التافه، لأنَّ هؤلاء لا يحملون قدرة الفلاسفة على الإحساس المنطقيِّ والفلسفيِّ بالعالم ولو بمستوى أصحاب الموقف الثاني، بل هم ذوو إمكانياتٍ فلسفيةٍ ومنطقيةٍ وعقليةٍ محدودةٍ كما تخبرنا العديد من الوقائع، مضافاً إلى أنهم متقلِّبون في أمزجتهم ومقارباتهم للعالم بحسب اللحظة الشعورية والوجدانية التي تحكمهم أثناء ممارسة مواهبهم في صياغة الأعمال الفنية والشعرية.
الخلاصة من المواقف الثلاثة:
من خلال ما ذكرناه آنفاً تتضح الحقيقة التي مفادها أنَّ الإنسان كائنٌ شقيٌّ بالموت من جهةٍ، وسعيدٌ به من جهةٍ أخرى، فإذا أفلح في أن يجد منهجاً عقلياً أو فلسفياً يستبطن به معنى الموت ومعنى الحياة، ويعرف حقيقتهما، وأنهما إنما وجدا لتكون معادلة الكمال الإنسانيِّ متحقِّقةً، فإنه من الذين سيسعدون بتأمُّل معنى الموت، وسيجتهد كثيراً حتى يهتدي إلى أسلوبٍ للموت يكون أقرب شيءٍ إلى المعنى الجوهريِّ المركَّز للحياة، وسيكون الموت هو الكفّ الكريمة المعطاء التي تمنح الحياة الأبدية الخالدة، وإن كان العكس، فليس الموت وحده هو ما يكون بغيضاً عند الإنسان في هذه الحالة، بل الغريب أنَّ الحياة نفسها تتبغَّض للإنسان حتى يمقتها ويراها مجالاً للشعور بالعدمية والعبث لا غير، وها هنا بالضبط يكمن معنى المفارقة.
كلُّ إنسانٍ إنما هو ساعٍ إلى مطلبه الوحيد في تحقيق الخلود، "لكنَّ انحدار المجتمع وعاتيات الثقافة ورياح الحضارات المنحرفة قد تقتل عقله، وتبطل تفكيره، فتشغله بأمورٍ تمنع عليه رؤية جمال الوجود، وضرورات الفقه والتفكير بعالم المسيرة ومأوى الجسد والروح بعد طيِّ المسافة في دهر الدنيا" فلسفة الحياة الشيخ جعفر حسن عتريسي.
الإمام الحسين في الميزان الفلسفيِّ للشهادة
تطرَّقنا إلى المواقف الثلاثة السابقة، وخرجنا بهذه النتيجة، وهي أنَّ للموت فلسفةً في الإسلام، وأنَّ للحياة فلسفةً كذلك، وأنَّ فلسفة الموت لا تتقاطع مع فلسفة الحياة في الرؤية القرآنية المباركة، آية ذلك أنَّ الله سبحانه يقول:(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ(1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ(2) سورة االملك فالموت والحياة كلاهما واقعان في مسيرة الإختبار للإنسان، حتى تظهر مكنوناته الإلهية العظيمة التي جعلها الله موجودةً فيه بوصفها استعداداتٍ أو وجوداتٍ بالقوَّة، تحتاج منه جهداً وبذلاً للطاقة المعنوية والروحية الكبيرة حتى تظهر وتتنجَّز وتصبح واقعاً، فإذا ما وصل الإنسان إلى مرتبةٍ من هذه المراتب العالية أصبح جزءاً لا يتجزَّأ من صيرورة العالم المعنوية والروحية السائرة نحو الله سبحانه، وهو بهذا السلوك وحده يحقِّق المقدار اللازم من الإنسجام مع النظام العامِّ للكون والوجودات أجمع، فإذا ما أصبح الإنسان بهذا المستوى من الإندماج بالنظام الكونيِّ العامّ، لم يعد بالإمكان مقاربة معناه بالوسائل المعروفة بالنسبة لذوي المراتب المعنوية الدنيا، إلا بأن يقال لهم ما جاء في الآيتين بعد الآيتين السابقتين: (الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ(3) ثُمَّ ارْجِعْ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ).
الموت شقيق الحياة في الإسلام، بل قل هو وجهها الآخر، أو قل إنَّ للموت وجوداً مرآتياً بالنسبة للحياة، أي إنَّ الحياة ترى ذاتها في الموت، أو تنبع منه في بعض الأحيان بشكلٍ مباشر، فلا تحتاج إلى واسطةٍ في البين، أو يكونان معاً بمعنىً واحدٍ، إذ يكون المركَّب منهما حياةً من نمطٍ غير مألوفٍ بالنسبة إلى أغلب البشر، إلا أن يكونوا من الأنبياء أو الأوصياء أو الصديقين الكبار.
هل كان الحسين يخاطب خصومه في يوم عاشوراء وهو خائفٌ على نفسه وعياله مثلاً، بالرغم من أنه بشرٌ بالتأكيد، ولا يتجرَّد من حبِّ نفسه وحبِّ عياله وسائر ذويه قطعاً، لكنَّ قائمة الأولويات لدى الحسين تختلف في ترتيبها ونظامها عن قائمة أولوياتنا نحن وترتيبها، ولهذا فإنه قادرٌ على أن يعيش الحالة الشعورية العليا المختلفة عن حالاتنا الشعورية كلِّها، فهو يقدر أن ينظر إلى رأسه المقطوع المعلَّق على قناة الرمح ويبتسم، لأنه يشاهد الحقيقة الغائبة عنا حين نتخيَّل رؤوسنا المقطوعة وهي معلَّقةٌ على الرماح، وقل الشيء نفسه عن مشاهداته الأخرى للمآسي التي تكتنف أبناءه ونساءه وإخوانه وأصحابه وكلَّ من يمتُّ إليه بصلةٍ على الإطلاق، فهو يهنِّئهم في مقامٍ نتعجَّب نحن من أنه يقدِّم التهنئات للصرعى والأسارى فيه، لأنه يشاهد ما لا نقدر نحن أن نكوِّن عنه صورةً في الخيال حسب، ولأنه يعيش العالم بوصفه وجهاً آخر لهذا العالم، هو الوجه المعنويُّ والروحيّ، أو هو الوجه الإلهيُّ بأدقِّ وصفٍ، وإنَّ هذه هي حقيقة العالم في نظر شخصٍ إلهيٍّ مثل الحسين، أما نحن فواحسرتاه على أنفسنا، إذ لا نشاهد إلا هذا الوجه الماديَّ المحدود الموصوف بأبشع الأوصاف وأدناها وأحقرها على لسان الأناس الإلهيين من طراز الحسين: "أيها الناس إنَّ الله تعالى خلق الدنيا فجعلها دار فناءٍ وزوالٍ متصرِّفةً بأهلها حالاً بعد حالٍ، فالمغرور من غرَّته، والشقيُّ من فتنته، فلا تغرَّنَّكم هذه الدنيا، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها، وتخيِّب طمع من طمع فيها، وأراكم قد اجتمعتم على أمرٍ قد أسخطتم الله فيه عليكم، وأعرض بوجهه الكريم عنكم، وأحلَّ بكم نقمته، فنعم الربُّ ربُّنا، وبئس العبيد أنتم" زهر الآداب للحصري ج1 ص62.
كم كان الموقف محرجاً للتأريخ، ليس التأريخ المنظور فحسب، بل أعتقد أنه كان محرجاً للتأريخ غير المنظور أيضاً، أي أنَّ موقف الحسين من القتل كان محرجاً حتى بالنسبة للذين لم يشاركوا فيه، ولم يكونوا حاضرين في ذلك الزمان الذي قتل فيه، فمن آدم إلى آخر إنسانٍ يوجد على هذه الأرض لا يمكن أن يوجد أحدٌ منهم بمنجىً عن الشعور بهذا الحرج، ليس لأنَّ الحسين قتل وكفى، فإنَّ حوادث القتل تجري في العالم بشكلٍ دوريٍّ متَّصلٍ، بل إنَّ القتل في زمننا الحديث هذا لتزداد بشاعةً وكثافةً وخروجاً على الأنساق المألوفة للقتل في كلِّ يومٍ، ومع ذلك، فإنَّ الحرج الأكبر الذي لا يدانيه في التصوُّر حرجٌ آخر أكبر منه هو قتل الحسين، فلنا أن نتساءل إذاً عن السبب الذي من أجله أصبح قتل الحسين محرجاً للإنسان في التأريخ بشكلٍ عامٍّ إلى هذا الحدّ، بحيث لم يعد ممكناً لذاكرة الإنسان أن يغادرها قتل الحسين في لحظةٍ من لحظات الزمان.
أعتقد أنَّ السبب هو أنَّ الحسين رسم خطاً بيانياً تصاعدياً للموت نحو جوهر الحياة بقتله في كربلاء، أي أنه لم يُبقِ على الموت موتاً، بل سار به حثيثاً نحو الحياة، فوحَّد بينهما في صيرورةٍ أبديةٍ لا تقبل التفكيك، لأنهما أصبحا بمثابة مركَّبٍ كيمياويٍّ واحدٍ مؤلَّفٍ من عنصرين، عنصر الحياة في سبيل الموت الأكثر تعلُّقاً بحياة الإنسان، وعنصر الموت في سبيل الحياة الأشدِّ تمسُّكاً بنجاة الإنسان من أسباب الدناءة والإنحطاط.
ليس هذا فقط، فما أكثر من يقومون بهذا العمل على قلَّتهم في كلِّ زمانٍ على حدةٍ، لكنهم يبلغون كثرةً عدديةً لا بأس بها خلال الحركة العامَّة للتأريخ الإنسانيِّ الطويل، لكنَّ الحسين لم يكن معترضاً على أن يقوم بهذه التضحية في سبيل هذا المعنى بأقلِّ اعتراضٍ، بل كان خائفاً على مصير قاتليه، وحريصاً على نجاتهم من هاوية الإنحطاط أكثر من حرصهم على مصالحهم الدنيوية الخاصَّة التي هي قصيرة الأمد مع ما تنطوي عليه من أسباب الهلاك الأبديِّ بالنسبة إليهم، فكان أباً مشفقاً على الخصوم أنفسهم، فتصرَّف معهم كما لو أنهم أبناء عاقّون متمرِّدون، وليس كما لو أنهم أعداء يستحقون منه تمنيات الهلاك والقضاء التامِّ عليهم، مع أنهم مستحقون لكلِّ هذا لو عاد الأمر إلى تحكيم معايير الحقِّ والباطل، فهم قتلةٌ مجرمون طامحون إلى رضا السلطان الجائر ولو بقتل الأوصياء من أولاد الأنبياء في نهاية المطاف.
عندما عزم القوم على سفك دم الحسين في العاشر من محرَّم، ركب الحسين راحلته وخطب فيهم قائلاً: "أيها الناس انسبوني من أنا ثمَّ ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها وانظروا هل يحلُّ لكم قتلي وانتهاك حرمتي" مقتل الحسين ص237 فتخيَّل معي أيها القارئ أنك في ذلك الموقف، حيث تشاهد الحسين يخطب على الخصوم بهذا الكلام، فهل تحسُّ أنَّ في هذا الأسلوب خوفاً على الذات من القتل، كلا طبعاً، بمساعدة العديد من القرائن التي سترد خلال البحث، بل إنَّ الحسين خائفٌ على مصائر القوم لا غير، فهو يتكلَّم لا كلاماً مطلقاً بدوافع البشر العاديين، بل بدوافع الإمام المكلَّف بإنقاذ البشر من موارد الهلكة الحقيقية بالذهاب إلى نار جهنَّم، فليس المهمُّ في نظره أن يموت أو أن يعيش هو بالذات، ولكنَّ المهمَّ أن لا يرتكبوا الجريمة الكبرى في قتل شخصٍ وصيٍّ من نسل نبيٍّ مثله، فيكونون مستحقين لعذاب الله الخالد في جهنَّم، وهذا واضحٌ من قوله"ألست ابن بنت نبيِّكم وابن وصيِّه وابن عمِّه وأوَّل المؤمنين بالله والمصدِّق لرسوله بما جاء من عند ربِّه؟ أوَ ليس حمزة سيِّد الشهداء عمَّ أبي، أوَ ليس جعفر الطيار عمِّي، أوَ لم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي: هذان سيِّدا شباب أهل الجنة؟" مقتل الحسين ص237. فمن كان منحدراً من سلالة المؤسسين الأوائل لدين الإسلام، ومن كان حائزاً على أفضل الأوصاف على لسان صاحب الرسالة، بل من كان سيداً لكلِّ أهل الجنة بلا استثناءٍ بإمضاءٍ من النبيِّ الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى كيف يحلُّ قتله، وهتك حرمه، ودوس جسده الشريف بسنابك الخيل، وليس هذا مهمّاً في جنب دين الله طبعاً، لكنَّ المشكلة تتمثَّل في أنَّ من يشهدون بأنَّ هذا الدين حقٌّ بألسنتهم هم من يقومون بهذا العمل الشنيع، وهم يزعمون إنما ينفِّذون تعاليم الإسلام، الإسلام الذي يُعدُّ الإيمان بالحسين واحداً من أركانه الرئيسية، تلك هي المفارقة.
كان الحسين حزيناً للغاية على مصير الأعداء، أسِفاً على أنهم ذاهبون إلى جهنَّم بوزر دمه، ومع ذلك، لم يشملهم بدعاء جدِّه النبيِّ "اللهمَّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون" فالمحنة الحقيقية تتمثَّل في أنهم يعلمون حجم الكارثة في قتل الحسين، ولكنهم طامعون برضا السلطان الجائر، ومنفِّذون لأوامره على حساب الأمر الإلهيِّ بأن يطيعوا الحسين، أو أن يحجموا عن قتله وانتهاك حرماته على الأقلّ، وإلا فماذا يقال عن ذلك الشقيِّ الذي يفتخر بأنه ساهم في قتل الحسين أمام عدوِّه اللدود: إملأ ركابي فضَّةً أو ذهبا فقد قتلتُ الملكَ المحجَّبا قتلتُ خيرَ الناسِ أمّاً وأبا
ها هنا تكمن المحنة الحقيقية في تفكير أهل ذلك العصر، فما زال هذا الرجل الذي يمثِّل عيِّنةً مهمَّةً تعكس طراز التفكير في رؤوس الجماعات التي اعتنقت الإسلام ظاهراً ولم يتغلغل الإيمان في قلوب أفرادها، فأيُّ فرقٍ بين نمط التفكير الجاهليِّ القبليِّ المتعجرف وبين هذا النمط من التفكير في رأس هذا الإنسان الذي ينطق لسانه بالشهادتين حتماً، فالحسين ملكٌ له حُجّابٌ لا أكثر ولا أقلّ، ما شاء الله على هذا التصوُّر الذي يتخيَّل الأوصياء إن هم إلا ملوكٌ كسائر الأكاسرة والقياصرة، وليت شعري هل رأى الحسين جالساً على عرش ملكٍ في بلاطٍ فخمٍ، أم هل رآه سائراً في موكبٍ وخلفه القيان والعبيد كما هو حال الملوك الذين استعمروا لقب الخلافة في التأريخ الإسلاميِّ المزيَّف، لكنها الأطر الذهنية الضيِّقة والأنفس المريضة التي لم تشأ أن تتخلَّص من ترسُّبات التفكير الجاهليِّ المقيت، بالرغم من أنها زامنت الوحي وعاشت التفاصيل الأولى للرسالة، فبقيت على حالها تحسب الأنبياء أكاسرةً والأوصياء ملوكاً محجَّبين بلا أدنى فرقٍ بين أولئك وهؤلاء.
لكنَّ هذا الرجل الذي تركَّزت في نفسه أمراض العصر الذي عاش الحسين فيه لم يكن مجرَّداً من الشعور الغامض بموجبات الشرف، فهو يعترف بجرأةٍ أمام الحاكم الغاشم بأنَّ من أقدم على قتله إنما هو خير الناس من جهة الأمِّ والأب معاً، لكنه لا يخرجه عن دائرة الملوك الدنيويين بالطبع، فالإطار الذهنيُّ العامُّ لهذا الرجل وأمثاله وهم أغلب أهل ذلك الزمان يقضي بأنَّ ذا الحقِّ في الطاعة كالحسين وإن كان وصياً لا يمكن أن يُعامل إلا معاملة الملوك، فلو فرضنا أنَّ الحسين مارس دوره الإلهيَّ في الخلافة الزمنية لكان هذا الرجل متملِّقاً للخليفة الذي هو الحسين ليس إلا، من منطلق أنه الملك الحاكم، وليس من منطلق أنه الخليفة الإلهيُّ الذي أوجب الله طاعته بمنطق الأوصياء المعصومين، وليس بمنطق الملوك الدنيويين المستبدِّين في الغالب.
ثمَّ إنه يطالب بالثمن، يطالب بأن يملأ ابن زيادٍ ركابه فضَّةً أو ذهباً، فما أغباه من بائعٍ لدينه بدنيا غيره، وما أحفل ابن زيادٍ بذكاء عقله وإن كان مجرماً، إذ أمر بقطع الذي فيه عيناه، لأنه إن كان يعلم أنَّ من أقدم على قتله هو خير الناس أماً وأباً، فلماذا قتله إذن، ولماذا يفتخر الآن أمامه بقتله.
لكن بربِّك يا ابن زيادٍ، أليس حالك مثل حال هذا الرجل القاتل في الباطن، أوَ لستَ تعلم علم اليقين أنك سيَّرت الجيش العرمرم لقتل من تؤمن أنه خير الأوَّلين والآخرين في زمانه، أم أنك تحاول أن تقنع نفسك بسفسطةٍ واضحةٍ أنك لا تعلم بهذه الحقيقة البيِّنة الجليَّة.
الحسين رحمةٌ للناس ومجالٌ واسعٌ للمغفرة، فهو لا يريد للناس إلا النجاة، النجاة على صعيدين، صعيد الحياة الدنيا وصعيد الآخرة، أما النجاة في الدنيا فمن المؤكَّد أنَّ الحياة الدنيوية الوبيلة إنما هي مع الظلمة وأعوانهم "لا أرى الحياة مع الظالمين إلا برماً" الحسين يشاهد المصدر، وأما على صعيد الآخرة، فأيَّة سعادةٍ أكبر من أن يُقتل المرء مع وصيٍّ معصومٍ كالحسين، ومن قدَّم دمه مع الحسين وبين يديه برهن بشكلٍ قاطعٍ على أنَّ ذنوبه مهما بلغت كثرةً لم تكن عن إصرارٍ واستهانةٍ بشرع الله، لأنه تائبٌ عنها راغبٌ بأن يسود منهجٌ للحياة لا على أساس تلك الذنوب بل على أساس ما يرسمه المعصوم من منهج الخير والعصمة للناس، وفي هذا وحده ما فيه من البرهان على أنه يستحقُّ غفران الخطايا وشموله بالرحمة الإلهية الواسعة.
أنظرْ إلى الحسين وهو في مسيره إلى كربلاء كيف يلتقي ببعض الناس ممن عرفوا حقَّ الحسين ومنزلته الرفيعة في الإسلام، فيحدِّثهم عن عزمه، ويعرض عليهم نصرته، ليس من أجل شيءٍ شخصيٍّ خاصٍّ به طبعاً، لكن من أجل شيءٍ آخر متعلِّقٍ بهم هم، شيءٍ له علاقةٌ وطيدةٌ بنجاتهم الأخروية وغفران خطاياهم وذنوبهم التي ارتكبوها بضعف نفوسهم في آنات حياتهم التي لم تمتلئ بخشية الله، فإن نصروه استحقوا عفران كلِّ ذلك، بوصف الحسين منهج الله الخالص من كلِّ شوائب المشاريع الشخصانية والأنانية والإنتهازية الضيِّقة، مما يسعى إليه الناس ويقتتلون من أجله، فإذ يلتقي بشخصٍ اسمه عبيد الله بن الحرِّ يحدِّثه: "يا ابن الحرِّ إنَّ أهل مصركم"يقصد الكوفة" كتبوا إليَّ أنهم مجتمعون على نصرتي وسألوني القدوم عليهم وليس الأمر على ما زعموا، وإن عليك ذنوباً كثيرةً، فهل لك من توبةٍ تمحو بها ذنوبك" فهذا هو الهدف إذن، أن يحصل هذا الشخص الذي لا يعدم نوايا الخير على المستوى النفسيِّ العميق على فرصةٍ لغفران خطاياه ليس إلا، فإنَّ الحسين مقتولٌ لا محالة، وهم يعلم بهذه النتيجة بغضِّ النظر عن القول بعلمه بوسائل العلم الخاصَّة بالأئمة المعصومين حتى، يعلم هذه النتيجة من خلال القرائن العديدة التي عرف الناس العاديون أنَّ الحسين مقتولٌ لا محالة بناءً على تتبُّعها وقراءتها، بل إنَّ هذا الرجل المرتكب للذنوب في حياته بشهادة نصِّ الحسين يعلم ذلك، وهو واثقٌ من هذه النتيجة التي سينتهي إليها الحسين في رحلته، كما يتَّضح من تضاعيف القصَّة، فهل يجوز لنا أن نقول إنَّ هدف الحسين هو أن يحصل على مزيدٍ من الأنصار من أجل الحفاظ على حياته والإنتصار العسكريِّ على الجيش اللجب للطغاة.
"وما هي يا ابن رسول الله" سأل الرجل.
فأجاب الحسين: "تنصر ابن بنت نبيِّك وتقاتل معه".
هذا هو ثمن غفران الخطايا، وإياك أن تخلط الأمور حابلها بنابلها فتقول: إنَّ أسلوب الحسين هو عينه أسلوب رجال الدين في المسيحية أو في الإسلام، حيث يطابقون بين مراداتهم الشخصية ومراد الله، لأنَّ الحسين ليس كرجال الدين العاديين في كلِّ الأحوال، بل هو رجل الدين الحقيقيُّ المعيَّن من الله، وبنصِّ رسول الله، فهو معصومٌ بهذا المعنى، فرغبته لا يُتصوَّر أن تكون نابعةً من هوىً شخصيٍّ على الإطلاق، إنها بالفعل تعبِّر عن مراد الله ولا تنحرف عنه مليمتراً واحداً ولا أكثر من ذلك ولا أقلّ، هذا بالنسبة لمن يؤمن بالإسلام بوصفه ديناً إلهياً واقعياً، أما من لا يؤمن بالدين، ولا يعتقد أنَّ الله أنزل شيئاً بوحيه في يومٍ من الأيام، فمن الطبيعيِّ أن لا يعنيه هذا الإستنتاج، فالكلام معه على صعيدٍ آخر، وليس على هذا الصعيد بالقطع.
قال الرجل: "والله إني لأعلم أنَّ من شايعك كان السعيد في الآخرة، ولكن ما عسى أن أغني عنك ولم أخلِّف لك بالكوفة ناصراً، فأنشدك الله أن تحملني على هذه الخطَّة، فإنَّ نفسي لا تسمح بالموت! ولكن فرسي هذه ((المحلقة)) والله ما طلبت عليها شيئاً إلا لحقته، ولا طلبني أحدٌ وأنا عليها إلا سبقته فخذها فهي لك".
إنَّ هذه الإجابة تعكس الإستراتيجية المتأرجحة بين الرغبة بالحياة تحت أيِّ شرطٍ كان، وبين الرغبة بالمساهمة في وضع لبنةٍ من اللبنات في بناء صرح الخير، وبحكم أنها متأرجحةٌ فإنها تنزاح نحو الموقف المتهاون دائماً.
إنَّ الرجل لم ينتبه إلى حقيقة أنَّ الحسين ليس بحاجةٍ إلى مثل هذا التبرير منه، فكونه لم يخلِّف له في الكوفة ناصراً متضمَّنٌ في عبارة الحسين الآنفة، إذ قال له عن الموقف في الكوفة "وليس الأمر كما زعموا" فكان عليه أن يرتقي قليلاً إلى الأفق الكبير الذي يتحدَّث به الحسين، لكنَّ رغبته بالحياة تحت أيِّ شرطٍ كان حجبت عنه الإنتباه إلى هذه الحقيقة.
لقد كان الحسين يتحدَّث بمنطق الأوصياء، أما الرجل فقد كان يتحدَّث بمنطق الدبلماسيين الضعفاء.
أما فرسه، فقد كانت أحقَّ منه بما ألحق بها من الأوصاف، لكن ما الفائدة، فكان الأفضل أن يكون الفارس فوق الفرس هو من يتَّصف بتلك الأوصاف أوَّلاً، كي تكون قيمتها متحققةً فعلاً في الفرس بعد ذلك.
قال الحسين: أما إذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجة لنا في فرسك ولا فيك.
لكنَّ الحسين لا يتخلّى عن شعور الأوصياء في هذه اللحظة، فيقدِّم نصحه للرجل، وإن كان مقصِّراً، فهو يريد له النجاة من النار على كلِّ حال، فواصل كلامه: "وإني أنصحك كما نصحتني، إن استطعت أن لا تسمع صراخنا ولا تشهد وقعتنا فافعل، فوالله لا يسمع واعيتنا أحدٌ ولا ينصرنا إلا أكبَّه الله في نار جهنَّم" امالي الصدوق ص94 عبد الرزاق المقرم مقتل الحسين ص93-95.
لم يكن الحسين قاصداً لنوعٍ من الأهداف التي يتوخّاها الثائرون عادةً، أي نه ثائرٌ من طرازٍ خاصٍّ جداً، فلم يحفظ التأريخ لنا مشهداً ثورياً كمشهد الحسين من جهتين، إحداهما تناقض الأخرى تناقضاً ظاهرياً بحسب التصوُّر الإنسانيِّ البسيط الذي لم يرقَ بعدُ إلى مستوى ما يفكِّر به الأنبياء والأوصياء، وهما:
الجهة الأولى: إصرار الحسين على المضيِّ بالثورة ووضع خطَّتها وهندسة أحداثها كما لو أنه طالبٌ لقلب نظام الحكم الأمويِّ بهذه القدرة العسكرية البسيطة، وتلك حماقةٌ لو فكَّر بها إنسانٌ عاديٌّ لكان موضع السخرية والإستهزاء من الجميع، فما بالك بوصيٍّ ألمعيٍّ مثل الحسين، أو كما لو أنه طالبٌ للإنتحار، وتلك فكرةٌ لا يمكن أن تطرق ذهن الحسين، وإن كان ممكناً أن تطرق أذهان غيره من ذوي الأنفة والعزَّة والشعور بعلوِّ النفس، لأنَّ الحسين رجلٌ ربانيٌّ من طراز الأوصياء الإستثنائيين في تأريخ الديانات، ومن كان هذا شأنه لا يمكن أن ينظر إلى الأمور من زاويتها الضيِّقة هذه، كما أنَّ قرائن عديدةً لا تُحصى كثرةً تقف بالضدِّ من هذا الإستنتاج الذي لا يصحّ، منها:
أوَّلاً: إنَّ الحسين عاش فترةً طويلةً قبل النهضة قاربت العشرين عاماً كان فيها ملتزماً بقرارٍ إلهيٍّ آخر، وقد عاش حياةً عاديةً بكلِّ المقاييس، ولم يُؤثر عنه أنه تحرَّك تحرُّكاً عسكرياً أو أنه فكَّر بالتحرُّك العسكريِّ مع أنه كان إلى سنِّ الشباب أقرب، ومع أنَّ الدواعي النفسية التي تحرِّض ذوي الشعور بالأنفة العادية كانت موجودةً بصورةٍ أقوى، فما باله لم يفكِّر بالإنقلاب على الحكومة في تلك الفترة ولو من باب الخلاص من هذه الحياة التي أجبرته على أن يكون في موقعٍ دون ما يستحقُّ بكثير؟.
ثانياً: إنَّ الحسين كان ربانياً وإلهياً أكثر من أيِّ شخصٍ آخر في زمانه، وهذا هو القدر المتيقَّن الذي يمكن تحصيله بحسب القاسم الإعتقاديِّ المشترك بين المذاهب الإسلامية وغيرها، فكيف يصحُّ أن يُقال عن غيره من ذوي التفكير الإلهيِّ من الصحابة وغيرهم أنهم تجنَّبوا التفكير المخالف لمقتضى الشريعة الإسلامية في حين يُقال بشأن الحسين عكس ذلك؟.
إنَّ تلك فكرةٌ غير معقولةٍ بالمرَّة، خاصَّةً مع علوِّ شأن الحسين، والمكانة الكبيرة التي كان يحظى بها في المجتمع الإسلاميّ، كونه يمثِّل الإمتداد الوحيد الباقي للرسول الأعظم في ذلك الزمان.
ثالثاً: إنَّ كلمات الحسين العديدة في المناسبات التي جمعته بأهل بيته وبأصحابه وبالآخرين ممن تصوَّروا أنَّ الحسين غافلٌ عما هو موجودٌ في أذهانهم حول عدم تمكُّنه من قلب نظام الحكم، وعدم وفاء من بايعه على النصرة إلخ، تبيِّن بوضوحٍ أنه كان يقصد شيئاً آخر لا يمكن لهم أن يستوعبوه حالياً فضلاً عن أن يكون موجوداً في أذهانهم بالمرَّة، ولذلك فإنه اكتفى بأن تكلَّم معهم بعباراتٍ موحيةٍ مكثفةٍ تكتنز المعنى للتأريخ وتجعل الألمعيَّ منهم يفهم المغزى الحسينيَّ ولو بصورةٍ شاحبةٍ، إلا أهل بيته وأصحابه طبعاً، فقد استطاعوا أن يرتقوا إلى أفق الحسين ولو بصورةٍ إجماليةٍ غير مفصَّلةٍ، لأنهم تخلَّصوا من حجاب الأنا أوَّلاً، ولأنهم وطَّنوا أنفسهم على طاعة الحسين وعدم التخلِّي عنه إلى النهاية.
ثمَّ إنَّ الحسين اختار أن يعمِّد أبناءه وأبناء أخوته وذويه وأبناء أصحابه الصغار بكلمات الرضا والحبِّ والدعاء قبل أن يأذن لأيٍّ منهم بالخروج للقتال، وكان الجميع مطمئناً إلى درجةٍ عجيبة. الحسين مطمئنٌّ إلى أنه يقوم بأضخم عملٍ إلهيٍّ في التأريخ الماضي والحاضر والمستقبل، والأطراف الأخرى بمن فيهم الأطفال الصغار هم على هذه الدرجة من الطمأنينة كذلك، فتكاد تسمع من جميعهم أشعاراً وعباراتٍ تنمُّ عن هذا الإدراك اللاإعتياديِّ طبقاً لكلِّ المعايير التي تحكم الطفل الصغير مهما كان ألمعياً وتلوح على سيمائه أمارات العبقرية.
بل إنَّ الأمر ليبدو مسانخاً لما نسمع عنه أو نقرأ من الأحداث الأسطورية في أشعار أصحاب الملاحم، مما يتخيَّله الشعراء العظام عادةً ولا يكون ضرورياً أن يوجد في الواقع من وجهة نظرٍ فنيةٍ، وإلا فأيُّ قلبٍ مطمئنٍّ صبورٍ هذا الذي تحمله السيدة زينب، وهي التي هامت بحبِّ أخيها الحسين إلى درجة أنها تفضِّل طاعته على حياة بنيها وحياتها هي بشكلٍ خاصّ، فتراها قد وقفت على عرصات كربلاء في اللحظات الأولى لمصرع الحسين، فتدنو من جثمانه الشريف، وترفعه قليلاً عن سطح الأرض، لتقول في دعائها: اللهمَّ تقبَّل منا هذا القربان القليل.
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1399 الاثنين 10/05/2010)