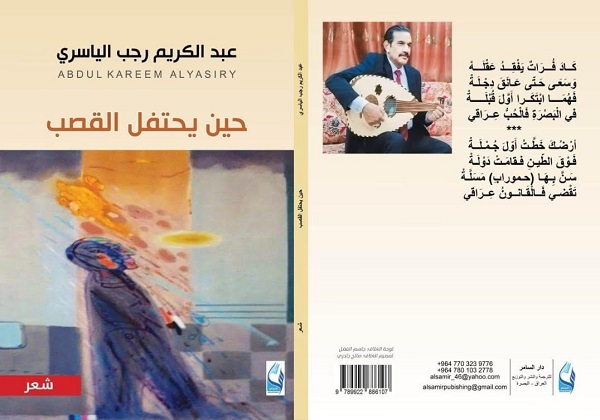قضايا وآراء
دين بلا ثقافة وتقديس الجهل / زهير الخويلدي
إذا كانت الفلسفة منذ الإغريق تعني دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة تفسيرا عقليا وتهتم بعلم الموجود بماهو موجود وتمثل العلم بالأسباب الأولى والعلل القصوى وتنقسم إلى نظر وعمل والى منطق وفيزياء وأخلاق فإن حكماء العرب تفلسفوا في هذا التعريف وغيروه قليلا بأن انتصروا إلى الجانب العملي على حساب الجانب النظري وجعلوا الثاني في خدمة الأول وفي هذا المقام ذكر الكندي بأن الفلسفة تشبه بالإله على قدر طاقة الإنسان وميز الفارابي بعد ذلك بين الفلسفة البتراء والفلسفة بإطلاق ورأي ابن سينا أنها وقوف على حقائق الأشياء كلها على قدر ما يمكن الإنسان أن يقف عليه وقسمها إلى قسمين اثنين: قسم نظري يضم الرياضيات والإلهيات والطبيعة وقسم عملي ويضم تدبير المدينة وتدبير المنزل والأخلاق وتمت إضافة العمران البشري والتاريخ والاقتصاد مع ابن خلدون.
إذا قمنا بمقارنة حول هذا المفهوم بين الفلاسفة والعلماء والعامة فإننا نجد أن المعرفة العامية هي تجارب عفوية مشتتة وأن المعرفة العلمية هي موحدة بشكل جزئي في حين أن الفلسفة هي معرفة تامة التوحيد ترتكز على الدراسة العقلية المنهجية وتحاول التكيف مع الطبيعة واستخراج نواميس الكون وقد شبهها ديكارت بالشجرة جذورها الميتافيزيقا وجذعها الفيزياء وفروعها العلوم الأخرى وهي الطب والميكانيكا والأخلاق واختصت بالبحث في أصل المعرفة وقيمتها وفي مبادئ اليقين وأسباب حدوث الأشياء ومعايير الفعل وغايات العمل.
من هذا المنطلق يمكن أن نميز الفلسفة الأولى التي تبحث في الأسباب القصوى والعلل الأولى والمبادئ النهائية والموجودات المفارقة والربوبية والإلهيات مثل الله والنفس والحقائق الأبدية والموجودات السرمدية والكائنات الأزلية وتشتغل على الخالد والمطلق والثابت وكل المبادئ الصورية التي نجدها عند مجموع العلوم وبين الفلسفة الثانية التي تدرس الطبيعة والتغير والزمانية والتاريخ والمجتمع والتجربة والواقع. كما يمكن التفريق بين الفلسفة الدائمة التي تبحث في عمل البشرية جمعاء والقواسم المشتركة والمطالب المتفقة التي نعثر عليها عند كل الاتجاهات والمذاهب المختلفة وبين الفلسفة العامة التي تهتم بالمرتكزات العامة التي تستند إليها العلوم مثل طبيعة المعرفة والعالم والإنسان والشعور والمادة والحياة والتقدم.
لكن الربط بين الفلسفة والعلم ودمج فلسفة العلوم في نظرية المناهج وميلاد الإبستيمولوجيا التي تهتم بالأسس المنطقية للعلوم وترصد القواعد الكلية للغة العلمية قد أدى إلى تعويض التصورات الفلسفية بعبارات علمية مصاغة بطريقة رمزية وجعل البون يتسع ويتعقد بين الجمهور وفلسفة العلوم ومهد الطريق نحو تشكل الفلسفة الشعبية التي نذرت نفسها من أجل تقريب المسافات بين القول الفلسفي المعقد والفهم العامي البسيط وحاولت الإنعتاق من القوالب الجامدة واللغة الصعبة وانجاز دراسات سهلة العبارة وتتناسب مع وعي الجمهور وانتظاره. ولعل أهم التحديات التي عهدتها الفلسفة الشعبية إلى نفسها هو وصف التجربة الدينية والاشتغال على معتقدات الجمهور من جهة العقلنة والتصدي إلى الجهل والارتقاء بالوعي ومخاطبة الناس على قدر عقولهم ومحاربة الخرافة والدجل الفكري والغباء المبرمج. لكن ما المقصود بالجهل؟ وما هو الجهل المقدس؟ وكيف تعمل الفلسفة على مقاومته؟
الجهل هو عدم المعرفة ويوجد في صورة مقابلة للخطأ لكون الجهل يخلو من الإثبات بينما الخطأ إثبات منحرف. أما الجهل المقدس فهو الاعتقاد بأن المرء لا يحتاج إلى معرفة لكي يحقق الخلاص والنظر إلى تحصيل المعرفة على أنه يحرف الإيمان الحقيقي والقول بأن كلام الله يمكن أن يمر مباشرة إلى النوع الإنسي من الخلق دون وساطة المعرفة والعقل والانطلاق من أن العثور على الحقيقة في النص الديني لا يتطلب الإبحار والتعمق وإنما البقاء عند الظاهر وتبني المعنى الحرفي دون تأو تحصيل أو مرور إلى الباطن، والانتباه إلى أن كمال التقوى والاحتذاء التام بالنموذج القطب هو أفضل من المعرفة اللاهوتية المستفيضة.
أما النتيجة التي تبرز في نهاية المطاف فهو حاجة المؤمن إلى مرشد ينير له طريق الهداية وعدم قدرته بنفسه على التمييز بين الطريق المستقيم والزلل في السراب. هكذا يكمن الجهل المقدس في نقل الرسالة دون نقل المعرفة وفي التلفظ بالكلام دون السكن في لغة الثقافة.
ما نلاحظه هو الزيادة في الممارسة الدينية والإقبال الشديد على دور العبادة وتزايد عدد المشاركين في الطقوس الجماعية وحضور لافت للفتاوي الدينية في وسائل الإعلام واحتلال الدعاة الجدد الساحة الاجتماعية واستمالتهم لعدد كبير من المستمعين وإمكانية الرؤية المتنامية للديني ولكن يقابل ذلك فتور في الاجتهاد الديني وانحسار في العلوم الدينية والنقاشات اللاهوتية التي يظهر فيها إعمال العقل وحب الحكمة وفن المناظرة وعلم الكلام.
ويا المفارقة أن الذين يعودون إلى الدين أو المتحولون والمولودون الجدد الذين تعودوا سابقا على اعتماد التعليم الدنيوي والعلماني للواقع الديني يفعلون ذلك على جهل تام بالمعرفة الدينية، ولذلك نراهم يتبنون النظرة الأصولية للدين بحذافيره وينزعون الدين عن سياقه الثقافي والاجتماعي. لذلك " إن تقهقر المعرفة الدينية لأمر مدهش في الأوساط الأصولية"، والغريب أن بعض الشكوكيين يبدون تفهما وتسامحا تجاه الاعتقاد الديني ودراية بشؤون تصريف المقدس ويكرسون حياتهم من أجل احترام القناعات الدينية للأغيار أكثر منهم.
إن تمجيد الجهل المقدس يظهر في اعتبار الاشتغال بالعقل وممارسة التأويل نوع من إضاعة الوقت والتطبيق التام للنص والعناية بالتجربة الوجدانية بالنسبة للفرد أو الجماعة والضياع في الغرور الديني وإعطاء أولوية لأمور الآخرة والغيب على حساب أمور الدنيا والشهادة. والقول بأن حفظ الوحي عن ظهر قلب لا يحتاج إلى تعلم قواعد اللغة التي كتب بها لأنه يخترق القلوب وينفذ إلى النفوس ولأن القداسة لا تحتاج إلى معرفة لكي ترسخها في العقول.
هناك أيضا جهل بالمقدس في حد ذاته من قبل المنتسبين إليه اسميا وعن طريق الوراثة ولذلك ازدادت الحركات الدينية التي تعمل على هداية من فقدوا المعرفة الدينية إلى الطريق المستقيم محاولة إعادة ربط الانتماء الأصلي بالممارسة الحقيقية للمتدين على وجه التعيين.
"إن المجتمعات التي تبتغي أن تكون دينية في المقام الأول تقرر تقليص الهوامش والانحرافات فهي إذن محكومة بعدم استقرار دائم، لأن مطلب الطهارة يضع كل إنسان في موقف مشكوك فيه ولا يحتمل." على هذا النحو نلاحظ نزاع بين اتجاهين متناقضين في اللحظة الراهنة: النزعة الأولى تحيي عودة الديني وتعتبرها ظاهرة صحية واحتجاجا على الحداثة المعطوبة ومحاولة للعصرنة بالمرور من طريق الأصالة، والنزعة الثانية ترى في مواصلة العلمنة قدر محتوم ومسار ينبغي أن يتم إكماله من أجل التخلص من الميراث.
غير أن النتيجة الحاصلة من العلمنة هي فصل الدين عن الثقافة التي أنتجته وإظهاره كديني محض واعتبار الدين نفسه مستقلا عن السياسي وقادرا على إعادة بناء ذاته وامتلاك شروط توسعه من خلال استثماره لفضائه الخاص ورمزيته وقوى إنتاج خطابه وحقوقه في تصريف شؤون المقدس. بيد أن الجهل المقدس هو الاعتقاد في الديني المحض الذي ينبني خارج الثقافات. هذا الجهل يحرك الأصوليات الحديثة المتنافسة في سوق الأديان يفاقم اختلافاتها ويوحد أنماط ممارستها. كما أن ظاهرة الانتعاش الديني التي تعم الكوكب وتشمل جميع الأديان ليست تعبيرا عن هويات ثقافية تقليدية وإنها هي نتيجة العولمة ولأزمة الثقافات.
كما" أن الديني السياسي محصور بكل بساطة في أمرين ملزمين: إن عدم الإيمان فضيحة لكن الإيمان لا يكون إلا فرديا ولا يعمل هذا الديني السياسي إلا على المبدأ القائل بأن الجميع يجب أن يكونوا مؤمنين ، لكنه لا يستطيع أن يضمن هذا الإيمان وعليه إذن يفرض التقيد بالمظهر". لكن إذا كان الإنسان مطبوع على الزلل ويتميز بالتناهي والهشاشة ولا يستطيع تفادي الوقوع في الخطأ فإن العامة يتمسكون به نتيجة العادة والتقليد والجهل وان نظرتهم إلى الدين سطحية وتخلط الاعتقاد بالخرافة والخوارق وكثيرا ما يقعون فريسة الخداع والاستغلال من قبل تجار الدين. ولعل آفة التدين ثلاثة أشياء: جاهل به ومغال فيه وشخص امتزج حبه بقلبه ولكن ضاقت سعة عقله حتى يصرفه تصريف الأنبياء. فكيف نفسر عودة الديني؟ وهل هي إحياء القديم أم تحول في الظهور؟ والديني يورث أم يولد على نحو مختلف؟
ان ما نلاحظه هو عولمة الديني وإعادة صياغته بحيث يحقق الرغبة في أوسع إمكانية رؤية في الفضاء العام وزوال الصفة الإقليمية والانتقال خارج نظام الهيمنة السياسية وفقدان الهوية الثقافية وانحسار البداهة الاجتماعية للدين وليس إعادة إنتاج التقاليد الدينية القديمة واستنساخ الموروث وإعادة نشره كما هو . لكن "الأصولية هي شكل الديني الأفضل تكيف مع العولمة ، لأنه يضطلع بإزالة هويته الثقافية الخاصة ويتخذ من ذلك أداة لطموحه نحو العالمية."
إن الحداثة الدينية هي استقلالية فضاء المقدس وتناغمه مع المايحدث وإعادة الاتصال به من جديد من قبل عامة الناس والنخب المثقفة وتفضيله على المعرفة والعلم والثقافة والسياسة. كما أن الأديان اتجهت إلى اصطياد معالم ثقافية جديدة وقيم اجتماعية مستحدثة من الفئات الشابة والأقليات وصارت توظف الحفلات الفنية والجلسات الأدبية من أجل اجتذاب الأتباع.
إن العلمنة ليست نزاعا وانفصالا عنيفا عن الديني ولا طلاقا معه وإنما هي خلق عوامل داخل الحقل الديني تحوله إلى ثقافة وتدفعه إلى خلق القيم الدنيوية الخاصة بالمجتمع.
لقد أصبحت المعمورة سوقا دينية حقيقية يحكمها المبدأ الرأسمالي وليس التثاقف وصارت خيارات التحول من دائرة مذهبية إلى أخرى متاحة ومتنوعة وصارت الحرية الدينية موجودة في كل مكان وفي متناول جميع الناس وزالت الروابط التقليدية بين الدين والثقافة. لكن الأديان هي القادرة على صنع ثقافة دنيوية وخلق أدوات تعمل لفائدة الإنسان بصفة عامة، غير أن انزلاق الديني إلى الثقافي وانبثاق الديني في الفضاء السياسي هو نوع من التدجين والأداتية ويحدث نوع من التوتر والصراع بين المشروعيات وحول امتلاك السلطة.
إن المشكلة بين الديني والعلماني قد تنجم عندما يكون الدين بلا ثقافة وتكون الثقافة بلا دين ويحدث انقطاع في الحركة الجدلية بينهما وضمور في أفق المعاني ويصبح معيار التطبيق غير واضح ومؤجل وتنسى الثقافة جذورها الدينية وتظهر عراقيل أمام تحول الدين إلى معرفة ثقافية. من هذا المنطلق إن " انسحاب الديني من الثقافة هذا يعمل في الاتجاهين: يفقد الديني مرساه الثقافي وتنسى الثقافة مصادرها الدينية وكل معرفة دنيوية بالديني".
الكارثة تحل بالمجتمع إذا خلقت الثقافة تحت هيمنة العلمنة وضعية معادية للدين ومشككة في الإيمان وحصرت المعرفة الدنيوية بالدين في تعليم أركان العقيدة وأهملت الكلام عن الإيمان وإذا خلق الدين بحكم الكهنوت والتعصب وسياسة الأقلية في العناية بشؤون العقيدة وضعية منافية للثقافة وإذا وصفتها بالثقافة الوثنية والخارجة عن الضوابط والتقاليد واعتبرت الإنسان غير المتدين أو غير الملتزم بالدين على مستوى المظهر والسلوك بالمارق أو المرتد.
غير أن الطرفين قد نسيا أن " هذا الحيز الانتقالي بين عدم الإيمان وجماعة الإيمان يؤلف من حيث التعريف أيضا حيز الثقافة الدينية". وأن الريبة من كل نظام متعال أخروي أو دنيوي والتطرق إلى قضايا المرأة والزواج والإنجاب والدفاع عن الحرية والمساحة المعطاة إلى الفرد لا يعني حديث وثني جديد في الثقافة بقدر ما يمثل نقطة الالتقاء بين الثقافي والديني.
" هذا الجدل دليل على قطيعة أخرى جوهرية هي: هي القطيعة بين الدين والعلم، لا من حيث أن الأديان أصبحت ظلامية على نحو مفاجئ ، ولكن بمنتهى البساطة لأن الدين لم يعد يعتبر إثباتات العلم موضوعية ومحايدة. إن القطيعة تذهب إلى أبعد مدى من الثقافة: إنها تستند إلى العلاقة بين العلم والإيمان." هكذا لم تعد الثقافة تعني رؤية أخرى للعالم مغايرة للرؤية الدينية بل إعادة صياغة الدين ضمن مقولات كلية منفصلة عن كل سياق ثقافي ومتعالية على التاريخ وصار الدفاع عن الدين هو الدفاع عن الهوية والتنازل عن القيم يعني التنازل عنه.
هكذا يجد المتدين نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الانسحاب واثبات الانفصال عن المجتمع والقطيعة مع الثقافة والاحتماء بالجماعة وإما إعادة الفتح والتدرج في الهداية ونشر الدين في المجتمع عن طريق اللين والانتقال من الانتماء الاسمي البسيط إلى الإيمان الفعال.
" لا يتعلق الأمر بمعارضة ثقافة جيدة بثقافة رديئة ولكن المقصود هو بكل بساطة معارضة الإيمان بالثقافة: لكي نعيش في الحب علينا أن نرفض بصورة ما أن نعيش خائفين في ثقافة تضعنا على الدوام أمام مخاطر مدعاة بلا انقطاع." ربما أزمة الإيمان ناتجة عن عولمة الديني وفصله عن الثقافي وربما أيضا تعود إلى حصر الديني في زاوية الأقلية والانزواء به في ركن الهوياتي وافقاره من خاصية التعددية والاختلاف التي هي مصدر نموه وتوسعه.
زد على ذلك صار الحديث عن الدين بضاعة رائجة اليوم وصرنا نتحدث عن سوق الديني وعن المتدين باعتباره مستهلك للبضاعة الدينية المعروضة من طرف الفضائيات بكثافة، والغريب إن هذه السوق الدينية تستفيد من جو الحريات العامة وتغلب عليها الفوضى والارتجال حيث سطع نجم رجال الدين كمنتجين للفتاوي دون تكوين علمي مرموق في المعرفة الدينية وبرز المتدينون بوصفهم مستهلكون أوفياء لهذه البضاعة دون تمحيص. "إن إنشاء سوق متجانس للديني يفترض فقدان الهوية الثقافية للديني أي الفصل بين المعلمين. والحال أن السوق والحركية يفرضان ذلك الفصل. لأن المستهلك يمكنه أن يختار ويفترض السوق تخفيف الضغط الاجتماعي وحتى فقدان البداهة الاجتماعية للدين وهو يجعل الإنسان حرا في اختياره ويتصرف بحيث تعجز السلطات الدينية عن فرض خياراتها ما لم تجازف بخسارة مواليها. إن "عودة الديني" المعاصرة ليست عودة في شيء بل نتيجة للعولمة."
إن عولمة الأديان تعني إخضاعها إلى منطق التداول والتعامل معها على أنها معدة للتصدير بعد إزالة الصفة الإقليمية عن المحلي واستهواء الذاتيات ونزعة الصفة العرقية عن الديني. تظهر عولمة الديني في توحيد نمط التدين الذي يشجع عليه التبادل والسوق وإيجاد نوع من التشاكل بين المعلم الديني والمعلم الثقافي واستخدام مظاهر الاندماج والتناغم بين المعالم من أجل المحافظة على الأصالة وتحقيق التفاعل والتعديل المتبادل وخلق توافق بين المعايير.
ما يوفره السوق من خلال التبادل هو توحيد الديني وذلك من خلال " تقارب في أشكال التدين أي في تعريف الإيمان، وفي علاقة المؤمن بدينه، المعبر عنها بمفردات البحث الروحي."
فصل المقال أن المعيار الديني لا ينبغي أن يساهم في تجفيف منابع الثقافة ويسهم في اختفائها من الفضاء العام بل على خلاف ذلك يجب على الديني الواضح أن يقدم المعيار الثقافي. وان التفكير في عالم ما بعد ديني لا يعني إيجاد عالم خال من الأديان أو إفراغه من كل معلم ديني وإنما الإيمان بأن العلمنة حتمية ايجابية تجعل المؤمن الجديد يتعقد في أهمية الحياة الدنيا ويتخذ من المعلم الديني الذي يحتمي به فرصة للاندماج في المجتمع والتواصل مع الغير.
من هذا المنطلق " يغدو مفهوم الدين نموذجا معياريا بلا مضمون محدد. وهذا نتيجة إطلاق اسم الدين على أي نظام مهما كان دون التدقيق في مضمونه الذي يجعل منه دينا".
علاوة على ذلك ظهر توافق مؤسساتي بين الأديان ووقع تبني استراتيجيات المشاكلة من خلال مقياس مقبولية متفاوض عليها بعد سيرورة حوارية وحركة تفاعل واتفاق على معايير تساكن واندماج واضحة في فضاء مشترك وتعددي يتم فيه تبادل الاعتراف وتشريع حق التغاير. غني عن البيان أن المطلوب من هذه العودة للديني ومن هذه المشكلة بين الدين والثقافة هو التجذر في الوطني وذلك بجعل" مجانسة الديني هذه تسمح بإدارة سياسية فضلى للديني. وتتيح خصوصا استخدام الدين كأداة مجانسة لصالح مشروع وطني". في المقابل ان المزايا التي ينبغي أن تمنحها الدولة إلى الديني هي ضمان الممارسة الحرية وبراءة المشروعية الاعتقادية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للأقليات والاعتراف بها والكف عن الاشتغال بضبط شروط المعتقد القويم والإقرار بنسبية الرؤية الدينية للعالم وقابليتها للتجدد.
كما أن تزايد النظريات الكلامية والتأويلية داخل كل دين ينبغي أن تساير التوحيد العام للديني والمشاكلة مع الثقافة والايمان باللاتمايزية في الاجتهادات والاتفاق حول المقاصد والغايات.
على هذا النحو "لا يكف الديني عن التركب مجددا وان كان غلب الظن أنه فقد صلته الأصلية مع الثقافة. إن أزمة الديني هي أيضا أزمة الثقافة. غير أن هذه قصة أخرى. سيكون للجهل المقدس متسع من الوقت ليتسع ويزدهر." لكن ما السبيل الى تفكيك الجهل المقدس وتجديد الدين؟ ولماذا لا تعمل الفلسفة الشعبية على إعادة الثقافة إلى الدين وتحقيق مصالحة بين الفكر والجمهور وانسجام بين العقل واللغة؟ وكيف تحل التوافقية التي ترى تجسد الديني في ثقافة هو شرط حضوره في العالم مكان الأصولية التي تضطلع بالقطيعة مع الثقافة وتدعو إلى انفصال المعالم الدينية عن المعالم الثقافية؟ وكيف تتشابه أشكال التدين وتتعارض الهويات الدينية؟ وهل من المشروع أن توظف الحرية الدينية من أجل التضييق على حرية التفكير؟
كاتب فلسفي
...............
المرجع:
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ترجمة صالح الأشمر، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 2012.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ترجمة صالح الأشمر، دار الساقي، بيروت، الطبعة الأولى، 2012. ص.214..
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.192.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.180.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.21.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.27.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.192.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.197.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.213.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.218.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.ص.251-252.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.287.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.287.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.297.
أوليفييه روا، الجهل المقدس، زمن دين بلا ثقافة، ص.327.
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2040 الجمعة 24 / 02 / 2012)