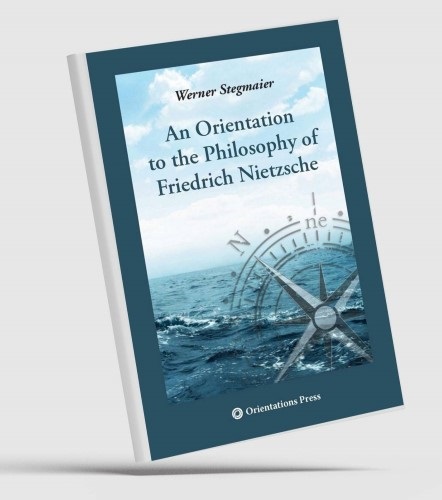تكوّنت تكوّناً تاريخيّاً كان يتيح للمواطنين أن يتشاركوا في ممارسة السلطة
غالباً ما يستغرب الناس العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والتمدّن الإغريقيّ. أعظمُ فلاسفة الألمان، في مقدّمتهم هيغل وهايدغر، أثبتوا الحقيقة الحضاريّة هذه. أمّا الوقائع فتدلّنا على أنّ التفلسف الحقّ لم ينشأ عند العرب أو الفرس أو سكّان الهند أو الصين أو أفريقيا أو مجتمعات السكّان الأصليّين في القارّة الأمِيركيّة أو الأستراليّة. ومن ثمّ، يجدر بنا أن نستفسر عن العوامل الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة التي جعلت المدينة الإغريقيّة الناشئة في القرن الثامن ق. م تساهم مساهمةً جليلةً في ولادة الفكر الفلسفيّ المحض. أعرف أنّ جميع الحضارات الإنسانيّة اختبرت ضروباً شتّى من التأمّل الوجدانيّ النفيس. غير أنّ استخدام العقل في بناء قواعد المنطق واستخراج أحكام النظر الموضوعيّ في الحياة ظاهرةٌ ثقافيّةٌ خطيرةٌ اقترنت بما انعقدت عليه المدينة الإغريقيّة القديمة من خصائص بنيويّة انفردت بها انفراداً استثنائيّاً.
إذا كانت المدينة الإغريقيّة قد استهلّت زمناً حضاريّاً جديداً في مَسار التاريخ البشريّ، فذلك لأنّها انطبعت بثلاث سماتٍ جوهريّةٍ بالغةِ الأثر. تجلّت السمة الأولى في مقام كلام التخاطب، وقد أولاه سكّانُ المدينة الإغريقيّة الصدارةَ المطلقةَ على جميع وسائل النفوذ والسلطان المستخدَمة عصرَذاك. من جرّاء الانتظام الاجتماعيّ في المدينة، أضحى كلامُ التخاطب الوسيلة السياسيّة البارزة، وباب السلطة في الدولة وسبيلها الأفعل والأخطر، وأداة الحكم وواسطة السيطرة على الآخرين. لا بدّ في هذا السياق من التذكير بـ«إلهة الإقناع» عند الإغريق القدماء، وقد أطلقوا عليها اسم «الإلهة بيثو» (Peitho) تُسعفهم في إتقان فنّ المحاجّة العقليّة القادرة على استقطاب تأييد الشعب. لا ريب في أنّ صورة «إلهة الإقناع» مستخرجةٌ من الشعائر الدِّينيّة التي كانت تفترض في الأقوال الابتهاليّة المنطوقة قدرةً خارقةً على الاستجابة للدعوة وتحقيق الأمنية. وما لبث سلاطين الممالك والإمبراطوريّات القديمة أن استأثروا بهذا السلطان، فغدت أقوالُهم محلَّ إكرامٍ وتبجيلٍ لما انطوت عليه من قيمةٍ إنفاذيّةٍ خطيرةٍ.
بيد أنّ أهل المدينة الإغريقيّة لم يقلّدوا القدماء، بل أعادوا تعريف كلام التخاطب، فجرّدوه من صفاته الشعائريّة التعظيميّة ومن سلطانه الملوكيّ القاهر، ونسبوا إليه مقاماً تداوليّاً جعله ينبسط في صورة المباحثة الحرّة والمناقشة المفتوحة والمحاجّة البرهانيّة الموضوعيّة. من جرّاء التحوّل الخطير هذا، أصبح الكلام التخاطبيّ النشاطَ الاجتماعيَّ الثقافيَّ الأبرزَ في حياة أهل المدينة، إذ أخذ الناس يعاينون في الجماعة الملتئمة جمهوراً مُصغياً قادراً على التمييز والحُكم على مضامين المناقشة العلنيّة المحتدمة. كذلك اكتسب القاطنون في المدينة الإغريقيّة صفة المرجعيّة القضائيّة التي تَنظر في القضايا المتناقضة المطروحة على بساط البحث، وتقرّر أيّها الأقدرُ على الإقناع والأنفعُ لمدينتهم.
اعتلنت السمة الثانية في عَلانية المباحثة المنعقدة بين أصحاب الرؤى المتباينة والقضايا المتناقضة. ذلك بأنّ المدينة الإغريقيّة أتاحت للحياة الإنسانيّة أن تحظى بمنظوريّتها الاجتماعيّة في المجال العامّ أو العموميّ، بحيث أجمع أهلُها على البحث عن أسباب المنفعة العامّة المشتركة وصونها من هيمنة المصالح الذاتيّة الخاصّة. في قرائن هذا التحوّل، اضطرّ أهل السلطان إلى تقليص دائرة الممارسات الأرستقراطيّة النخبويّة التواطئيّة السرّيّة، والإفصاح العلنيّ عن عمليّات التفاوض المفضية إلى استخراج القرارات السياسيّة والاقتصاديّة. من البديهيّ، والحال هذه، أن يجرّد الناسُ أصحابَ السلطة من هيمنتهم على مصادر المعرفة حتّى يتسنّى للجميع أن يطّلعوا على المعلومات الضروريّة التي تؤهّلهم للحُكم الموضوعيّ على القضايا المصيريّة المشتركة. بعد أن كانت المعرفة محصورةً في دائرة السلطان الحاكم، شاعت شيوعَ المساواة في الاطّلاع والاستعلام. فنشأ من جرّاء هذا كلّه تحريضٌ حميدٌ على إعمال الفكر في شؤون الحياة المدنيّة العامّة، فنهض الناسُ إلى الاعتناء بتهذيب عقولهم حتّى يستطيعوا أن يواكبوا الحدث ويضطلعوا بمسؤوليّة الوعي النقديّ المستجدّ.
أمّا السمة الثالثة فظهرت في خضوع الشأن السياسيّ كلّه لسلطان الكلام التخاطبيّ التداوليّ. ذلك بأنّ المناقشة والمحاجّة والجدل أعمالٌ أمست تضبط مَسار النشاط الفكريّ والحركة السياسيّة. أمّا الجماعة الناظرة في القضايا العامّة فتحوّلت إلى رقيبٍ يدقّق في إنتاجات الفكر وأعماله، وفي اجتهادات الدولة وقراراتها. فما لبث هذا التحوّل أن أفضى إلى تغيير ناموس المدينة الإغريقيّة، بحيث نبذ الناسُ الحُكمَ الاستبداديَّ المطلق، وآثروا نظام الانتخاب المباشر والمواكبة الساهرة والمحاسبة الصارمة. ومن ثمّ، لم يَعد في مقدور السلطان السياسيّ أو الدِّينيّ أن يفرض أحكامه بالقوّة، بل اضطرّ إلى الاستعانة بالدليل الواضح والبرهان الجليّ من أجل إقناع الناس بصوابيّة السبيل الإقراريّ الذي أفضى إلى مثل هذا التدبير أو ذاك.
لا ريب إذن في أنّ التحوّل الثقافيّ الذي أصاب المدينة الإغريقيّة أتاح انبثاقَ نمطٍ جديدٍ من التفكّر المبنيّ على النظر العقليّ الموضوعيّ المجرّد. فإذا بالفكر الفلسفيّ يولَد في معترك التحوّلات البنيويّة الذهنيّة الثقافيّة الاجتماعيّة هذه، فيحرّر رويداً رويداً الوعي الإنسانيّ من تصوّراته اللاهوتيّة الميتولوجيّة الأسطوريّة، ويساهم مساهمةً حاسمةً في تجلّي زمن العقل. في سياق هذا المنعطف، يمكن القول إنّ الفلسفة الإغريقيّة لم تشهد ولادة العقل، بل بَنت بنفسها العقل، أي أنشأت الشكل الأوّل من العقلانيّة الغربيّة. ذلك بأنّ العقل الإغريقيّ، في اعتلانه الأوّل، اضطلع بمسؤوليّةٍ جليلةٍ على قدر ما أكبّ ينظر في الأمور نظرةً منهجيّةً موضوعيّةً مجرّدةً أتاحت له التأثير في عقول الناس، قبل أن يتمكّن لاحقاً من تغيير مسار الطبيعة. وعليه، يصحّ القول إنّ العقل هذا، في طاقاته الاستكشافيّة وفي حدود إمكاناته، إنّما هو ابن المدينة الإغريقيّة القديمة.
لا بدّ هنا من التذكير بأنّ هذه المدينة تكوّنت تكوّناً تاريخيّاً أفضى إلى قيامها على هيئة الانتظام الاجتماعيّ الذي كان يتيح للمواطنين أن يتشاركوا تشاركاً عادلاً في ممارسة السلطة، بحيث إنّ القوانين لم تَعد تَتنزّل عليهم من سماء التعالي الإلهيّ أو من دائرة السلطان القاهرة، بل أضحت تنبثق من صميم مباحثاتهم المستندة إلى مراعاة مصالح المدينة المشتركة. بفضل التحوّل الخطير في البنية السياسيّة هذه، استطاعت المدينة الإغريقيّة أن تستولد ضروباً جليلةً من التغيير الثقافيّ الاجتماعيّ البالغ. إذا أراد المرء أن يستجلي طبيعة هذا التغيير، أمكنه أن يحصيه في أربعة حقول أساسيّة من حياة الناس في المدينة. تجلّى التغيير أوّلاً في حقل الاجتهاد القانونيّ، إذ انبرى المشرّع الإغريقيّ الشهير سولون (حوالى 640 ق.م - حوالى 558 ق.م) يصوغ دستور المدينة الأوّل، وقد عزَّز فيه سلطة الشعب. لذلك عاين فيه أفلاطون وأرسطو مثالَ المجتهد المصلِح الجريء الذي جدّد الحياة السياسيّة الإغريقيّة. تحقّق التغييرُ ثانياً في انتقاد التقليد الثقافيّ السائد، لا سيّما في البنى السياسيّة والاجتماعيّة، بحيث عكف العقلاءُ على تعطيل القرارات التي كانت الأريستوقراطيا الإغريقيّة تستأثر بها وتُبرمها سرّاً وتفرضها على الناس. كذلك طفق الفلاسفة ينتقدون المنهج التربويّ القائم على الذهنيّة العسكريّة القتاليّة والائتمار الإذعانيّ الذي لا يبيح الشورى. أمّا موضع الانتقاد الأخطر فأصاب مقام الكلام الذي كان مقتصراً على تلاوة القصائد وحفظ الملاحم الشعريّة المبنيّة على تعظيم أصول المدينة الأسطوريّة.
تجلّى التغيير أوّلاً في حقل الاجتهاد القانونيّ، إذ انبرى المشرّع الإغريقيّ الشهير سولون بصوغ دستور المدينة الأوّل وقد عزَّز فيه سلطة الشعب.
لا عجب، من ثمّ، في أن ينعقد التغيير الثالث على ابتكار النظام الدِّموقراطيّ الذي أفضى إلى تدبير الحياة السياسيّة بالاستناد إلى مباحثات الساحة العامّة العلنيّة (الأغورا) ومجادلات الناس الملتئمين فيها التئامَ التمثيل الانتخابيّ العادل. أمّا السبيل الوحيد الذي كان يتيح تقلُّد المناصب التشريعيّة والتنفيذيّة، فالكلام التخاطبيّ التحاوريّ القادر على إقناع عقول الناس وإرشادهم إلى القرار السياسيّ الأنسب. من جرّاء الضروب الثلاثة الخطيرة هذه من التغيير البنيويّ العميق، انبثق التغيير الفكريّ الأخطر الذي أصاب الذهنيّة السائدة، إذ انصرف الناس إلى ممارسة الفعل الفلسفيّ، فالتأموا في مدارس محبّي الحكمة الذين شرعوا يحرّضونهم على ترك التفاسير اللاهوتيّة الأسطوريّة والاعتصام بالتحليل العقليّ الموضوعيّ. من أعظم هؤلاء الحكماء كان المعلّم سقراط (حوالى 470 ق.م-399 ق.م) الذي انتهج في المحاورة الفلسفيّة الحرّة سبيلَ التفكّر العقلانيّ الجريء. ولشدّة الإقبال على مزاولة المحاجّة الفلسفيّة، انبرت فرقةٌ من حكماء الدهاء البرهانيّ عُرِفوا بالسوفسطائيّين، ومنهم بروتاغوراس (490 ق.م - حوالى 420 ق.م) الذي رسم أنّ الإنسان مقياسُ كلِّ حقيقة ومرجعها، فطفقت تحثّ الناس على تعلُّم فنّ الكلام وأساليبه وإتقان لغة البلاغة والإحكام البيانيّ الساحر. أمّا أفلاطون فجسّد مثال الفيلسوف القادر على انتزاع نفسه من قرائن الخضوع لأحكام التقاليد، والارتقاء إلى مستوى النظر في عالم المثُل السامية. لذلك استهلّت كتاباتُه زمنَ الفلسفة الأصيلة التي استثمرت تحوّلات المدينة الإغريقيّة، فأخذت تسائل الوجود الإنسانيّ وتستفسره عن معناه الأعمق والأرحب. إذا كانت الفلسفة بنتَ العقل النظيف الحرّ، فإنّ الاستبداد يخنقها ويُجهِض ولادتها.
***
مشير باسيل عون
عن صحيفة الشرق الاوسط اللندنية، يوم: 13 مارس 2024 م ـ 03 رَمضان 1445 هـ