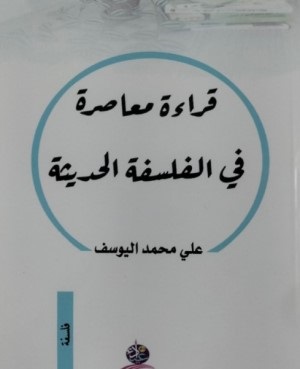أقلام حرة
القصيدة الحياتية والقصيدة المعرفية / باسم فرات
وأن من الأمور التي أصبحت هاجسي الأكبر، هو أن لا أنافس سوى نفسي، وأجعل منها في ذات الوقت أستاذًا ومعلمًا وشيخًا، هو أن أتجاوزها وأن أغار مما تكتب لكي أكتب أفضلَ منه، وأن أقرأ وأحلل وأناقش وأتأمل أكثر منها، فمنافسة الآخرين لعبة فاشلة بل وخطيرة تؤدي إلى ضياع مَن يلعبها، هل لهذا السبب نجد عشرات إن لم يكن المئات من المبدعين ما إن انتفت أسباب المنافسة لديهم حتى خَفَتَ جمر إبداعِهم؟.
لم أتمرّد على عروض الخليل لأقع فريسة لعروض أخرى أو قواعد أخرى، ينصبها لي هذا الناقد أو ذاك الشاعر، فالشعر عالم لا حدود له، بل هو الحياة بما تعنيه من معارف وتجارب، وحين تكون قصيدتي نتاج تجربة حياتية فلا بدّ لقراءاتي أن تتغلغل رويدًا رويدًا وبشكل تلقائي لا أحسه أحيانًا في القصيدة، وكنت أكتشف هذا التغلغل ونشاط اللاوعي في القراءة الثانية، وهو غالبًا ما يحدث أثناء النشاطات الشعرية التي أشارك بها، ولكن محاولة إعداد ديواني "بلوغ النهر" للنشر كشفت لي أن هَوَسي بقراءة التاريخ العراقي وامتداداته ثقافيًّا تجلّى في هذا الديوان بلا قصد، بل إنني تذكرت تلك الجملة الشهيرة التي قالها خلف الأحمر لأبي نؤاس "انْسَ كل ما حفظت"، والتي قرأتها في بواكير حياتي حيث كنت بالمتوسطة إن لم أكن بالابتدائية، وكانت درسًا مهمًّا تعلمته في بداياتي أن القراءة يجب أن تكون هضمًا وليس حفظًا، حيث الحفظ يحول الشخص إلى ببغاء، بينما الهضم هو إعادة خلق بإضافات يحتمها الوعي والتجربة والزمن.
حين تكون بين إغوائين فما عليك سوى أن تمزجهما وتصهرهما لتخلق مثالك الذي تبغي، ولأني لا أجيد فن التقليد والإشاعة، وأجهل عملية المشي على قياسات (مقاسات) النقاد والمنظرين ومن سبقني أو زاملني من الشعراء، فلست أستسيغ مَن يدعي الحداثة ويلومني كيف أختار مناطق نائية، ولماذا لا أتخذ من لندن أو باريس أو غيرهما من عواصم الثقافة والفن والإعلام مستقرًّا لي، أو يستغرب كيف أخلط بين الحياتي والمعرفي في قصائدي، ولأني عرفت من أبي نؤاس أنه كان مثقف عصره، ولا علاقة تربطني بأبي نؤاس الخمار والسكّير كما هو شائع عنه، ولأن المتنبي أذهلني بسعة اطلاعه وتمكنه من معارف عصره، وأرفض أن أتقمص الصورة التي حيكت له بعد وفاته استنادًا على علوّ الأنا وضخامتها في شعره، وشغلني من السيّاب حلمه بقراءة الفلسفة، وليس قوله إنه مدمن قراءة روايات، وعليه كانت المعرفة ومثال الشاعر المثقف هو ما يشغلني ليس تباهيًا وإنما أجد نفسي في هذه الكتب أكثر مما أجدها في قراءة الأدب وخصوصًا الإبداع، فكانت مؤلفات طه باقر وأحمد سوسة ونائل حنون وفاضل عبد الواحد علي ويوسف حَبّي وألبير أبونا وجواد علي وعبد العزيز الدوري وفيصل السامر وعلي الوردي وعبد الرزاق الحسني وعباس العزاوي وصديق الدملوجي وطه حسين وأسد حيدر وحسين مروّة ومحمد عابد الجابري وجورج طرابيشي وفاطمة المرنيسي وهشام جعيط ومحمد حسين كاشف الغطاء ومحمد جواد مغنية وباقر شريف القرشي ومحمد مهدي شمس الدين ومحمد حسن آل ياسين وفاضل حسين ... إلخ، إضافة إلى عشرات الباحثين من عراقيين وعرب وأجانب ممن تصدوا لما يثير فضولي وأعني تحليل وتفكيك التاريخ الثقافي للعراق وجذور العرب والإسلام والتنوع اللغوي والديني والمذهبي في العراق خصوصًا والمنطقة عمومًا، وقراءتنا بكل أطيافنا لتراثنا وتاريخنا وقراءة الآخر له. ثمة ما هو مكمل لهذا وهو فضولي المعرفي ليس من الكتب وحدها بل من الناس، كنت ومازلت أستفسر عن الكثير من الأمور حتى يُخيّل للبعض أنني في صدد كتابة بحث أو رواية.
كان السفر نحو مناطق مزدحمة بتنوعها الإثني والعقائدي قد أضاف لي الكثير، كما وسعت البيئات الجغرافية مخيلتي البصرية بل ووعيي الفكري، وكم وجدتُ تشابهًا بين ما هو موجود في تراث العراق والمنطقة وبين تراث البلدان التي شربتُ نشوانًا من عذوبة ثقافاتها وتوغلت في حياتها اليومية، حتى راحت تتسرب إلى وعيي ولا وعيي على حد سواء بعض المؤثرات من تلك المجتمعات، كما تسللت قراءاتي الكثيرة لتاريخ العراق فكان من نتاج هذه المؤثرات المجتمعية والقرائية أن توضحت أكثر ما توضحت في ديواني "بلوغ النهر"، فكانت نصوصه حياتية بقدر ما هي معرفية، لأن ما تحقق لي نادرًا ما تحقق لغيري من ظروف معيشية مختلفة تمامًا عن الآخرين.
كثيرًا ما قرأنا أو عرفنا رجالاً هم في النهار يتقيدون بواجباتهم الاجتماعية والدينية ويعدون مثالاً بحسن السيرة والسلوك كما حددها مجتمعهم، لكنهم حين يختلون بأنفسهم يفعلون ما يُعدّ حسب عاداتهم وتقاليدهم خفّةً وفسقًا وفجورًا، ولنا في شخصية سي السيد بطل ثلاثية نجيب محفوظ خير شاهد، شخصيًّا أشبه هذه الشخصية ولكن من منظار مختلف، فأنا أقضي نهاري في السوق مع الكَسَبَة وأطرب لمناداة الباعة فهي أنغام تلامس روحي، أنغمس مع الباعة والكادحين وحين أختلي يكون ندمائي والمقربون مني أولئك الذين لهم حفريات معرفية تشبع فضولي المعرفي الرافض لثقافة الإشاعة وتراكمات التاريخ الأسطورية. مع الكسبة لا أختلف عني حين عملتُ خبازًا في مخبز للتموين وعمري سبع سنوات، أو في صناعة الأحذية وبيع المسابح ولوازم العبادة أو صناعة التحف النحاسية حين كنتُ في العاشرة من عمري، بصحبة النحاس وماء النار والتيزاب ومواد أخرى كلها محرمة من الناحية القانونية على من عمره دون الخامسة عشرة أن يقترب منها ويعمل فيها، وفي خلوتي مهموم بشرب كأس المعرفة وموسيقى الجمال وإغواءات الفكر ونبش المسلمات التي تحولت إلى عقائد عند الناس وما هي بعقائد.
لست غجريًّا ولكني أستطيع القول إن تشابهًا بيني وبين حياة الغجر تمثل بعدم الاستقرار في مكان واحد وعشق السفر والتنقل وغرامي بالطبيعة لدرجة التمدد على عشب أو في نهر أو بحر أو تسلق الأشجار وصعود الجبال والتوغل في الغابات، ودهشتي أمام الألوان بحيث إن جميع الألوان هي المفضلة تقريبًا وخصوصًا ألوان قوس قزح. لدرجة أن دهشتي أمام ما أعتقده جمالاً توحي لمن لا يعرفني أنني ساذج، حيث دهشتي لا تختلف عن دهشة طفلٍ أمام محركات مخيلته ومغريات طفولته.
أدهشتني تجارب كبار الشعراء، ومازلت أتذكر حديثي بالأمر مع أصدقاء لي في ثمانينيات القرن العشرين في كربلاء، ولكني لم أحلم أو أحاول أن أتتبع خطاهم وقع الحافر على الحافر، من خلال زيارة بيوتهم والمدن التي نشأوا فيها أو عاشوا أو زاروها، بل أردت ومازلت أن أعيش وأترعرع وأزور مدنًا وأماكنَ بكرًا، لم يفضّ بكارتها الشعراء قبلي، أنا عريس صباها وأول مَن غَرَفَ من معين حيواتها، وذات الشيء ينطبق على قراءاتي التي لم تتبع الإشاعة وتكون أسيرة لها، ما إن تَحَدّثَ البعض عن رواية ما حتى همّ الكثيرون لقراءتها بل أصبح عيبًا في عُرف هذا البعض أنك لم تقرأ الرواية تلك، وطالما قرأت وسمعت أن قراءة التاريخ والفكر تبعد الشاعر عن التلقائية وتتحول قصيدته إلى حرفة أو كما قال القدماء شعر علماء، لأن التلقائية ضرورية لمنح النص تدفقًا يشبه تدفق الماء، وإلاّ فما يكتبه كمن يجدف بنهر جاف، فلم ألتفت لكل هذا وذاك وواصلت الإنصات إلى حدسي ورغبتي وما يريده باسم فرات وليس ما يريده الآخرون.
ثمة فَهمٌ شاع عند البعض من الشعراء والنقاد، وهو أن القصيدة الحياتية تختلف تمامًا عن القصيدة المعرفية، وراح هذا البعض يبني جدارًا سميكًا وشاهقًا للفصل بين الاثنين، وكأنما الشعر ليس حرية وابتكاراً وتمرداً وتجريباً، واستأنسوا بالاتهامات، فالحياتي يرى في المعرفي غامضًا ويجلس في برجه العاجي يكتب شعرًا يخلو من الحياة ونبضها، جملاً شعرية لا روح فيها تغرف من تهويمات اللغة وتظنّ أنها البديل عن الفلسفة، بل جلب الفلسفة للشعر مع عدم وعي باشتراطات الشعر الفرنسي التاريخية، بينما يسخر المعرفي من الحياتي متهمًا إياه بالسذاجة والمباشرة والنزول إلى رغبة القرّاء، وسوى ذلك من الاتهامات التي يتناولها الطرفان ضد بعضهما البعض، متناسين أن الشعر هو تجربة ومعرفة وتأمل وهضم ثقافات وعملية خلق مبنية على المغايرة والاختلاف والتأويل على شرطي التلقائية والصدق لإحداث الدهشة عند المتلقي.
بعد كل هذا ألا يحق لقصيدتي أن تكون مترعة بالحياة والمعرفة معًا، أن تكون طائرًا جناحاه التجربة الحياتية وعصارة ثقافتي القرائية، مع التذكير أن بعض القصائد كانت التجربة الآسيوية فيها وعاءً ومؤثرات هويتي العراقية العربية الإسلامية ما يحويه هذا الوعاء، غير متجاهل لموضوعة مهمة توشّت بها نصوص ديوان بلوغ النهر أكثر من سواه، ألا وهي التزاوج الثقافي الذي أعترف أنه كان تلقائيًّا حيث لم أنتبه له وإنما نبهني عليه الأصدقاء من المتابعين لتجربتي. ربما يعتبر البعض أن اعترافي بعدم انتباهي لما أكتب هو مثلبة ضدي، ولكني أرى أن إحدى أهم مميزات الشعر هي التلقائية، وفهم نصيحة خلف الأحمر لأبي نؤاس فهمًا صحيحًا لدرجة دخولها في اللاوعي لدينا، مما يجعل القارئ لا يشعر بتكلّف المعرفي في القصيدة، فهضم الحياتي والمعرفي يمنحنا قصيدة فيها طراوة وندى الحياتي وعمق وسعة وتأويلية المعرفي، والحياتي يُرَطّب من صلابة المعرفي التي ينفر منها الكثير من القرّاء.
كيتو – الاكوادور
12 حزيران 2012
تابع موضوعك على الفيس بوك وفي تويتر المثقف
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2179 الخميس 12/ 07 / 2012)