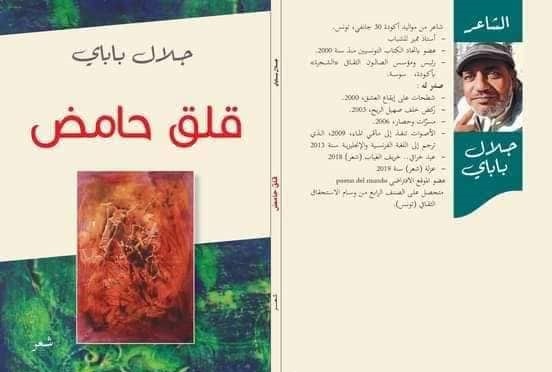حوارات عامة
الباحث محمد المزوغي: الإسلاميّون لا يملكون فكراً متيناً.. ويُعاكسون العقلَ النقدي
فالإسلاميون لا شكّ بأنهم لن يرتاحوا لأفكاره وآرائه، كما أن جزءاً من المفكرين العصريين سيجدونه مفارقاً لهم. لا يجد المزوغي بدّاً من التصريح بالفكرة، بدل المواربة وتأجيل البوح بها، ومن هنا يطرح نقديّاته في هذا الحوار للإسلاميين وللظاهرة الدينية بكلّ وضوح. بلا تردّد؛ يذهب المزوغي إلى أن ‘’البرجوازية الكومبرادورية المحلية، والأغنياء الجدد، المستفيدين من العولمة الإمبريالية الحالية يدعمون الإسلام السياسي بسخاء، وهذا تخلى عن المنظور المعادي للإمبريالية، واستبدله بالموقف ‘’المعادي للغرب’’ (تقريباً ‘’المعادي للمسيحية’’)، الذي لا يفعل بداهة سوى أن يقود المجتمعات ذات العلاقة إلى مأزق ولا يؤلف بالتالي عائقاً لنشر السيطرة الإمبريالية على النظام العالمي’’، ويضيف بأن ‘’الإسلام السياسي ليس فقط رجعياً في بعض المسائل ‘’ولاسيما فيما يتعلق بوضع المرأة’’، وربما هو مسؤول عن التعصب المتطرف الموجه ضد المواطنين غير المسلمين ‘’مثل الأقباط في مصر’’، إنه رجعي بأساسه، ومن الواضح بالتالي أنه لا يستطيع المساهمة في التقدم في تحرير الشعب’’. أصدر المزوغي عدداً من المؤلفات، وهذا العام صدر له كتاب ‘’في نقد ما بعد الحداثة’’ من جزئين، الأول حول نيتشه والفلسفة، والثاني حول فوكو والجنون الغربي.
* نرحّب بكم أولاً في هذا الحوار، ونشكر لكم قبول الإجابة على الأسئلة، ولنبدأ الحوار بسؤال حول قراءتك للإنتاج الفكري الإسلامي في الوقت الحاضر؟ هل استطاع أن يتجاوز الأسئلة ‘’الإشكالات’’ الأولى التي رافقت بدايات التأسيس الأيديولوجي للحركة الإسلاميّة؟
- في البداية أودّ أن أشكرك على تفضلك بدعوتي لإجراء هذا الحوار وعلى الثقة التي وضعتها بشخصي، وأشكر أيضاً جريدة ‘’الوقت’’ وجميع العاملين عليها للمجهودات الكبيرة التي يبذلونها من أجل صحافةٍ عربية تنويرية وحرّة. بخصوص سؤالك؛ لا أستطيع أن أعطيك إجابة محدّدة ونهائية، لأنني لا أدري منْ الممثّل الحقيقي لهذا الفكر، لا أدري منْ الذي يتكلّم باسمه، هل القرضاوي، أم البوطي، أم طه عبد الرحمن أم رضوان السيّد.. والقائمة طويلة. ثم إن المفكرين الإسلاميين المحدثين ليس لديهم من جديدٍ يُضيفونه في ميدان الفكر البحت، وخصوصاً في ميدان الفلسفة. لقد اطلعتُ على مجموعةٍ من الدّراسات أصدرتها دارُ الفكر ‘’دمشق ـ بيروت’’ على شكل سلسلةٍ بعنوان ‘’حوارات لقرن جديد’’، حيث تقابَلَ مفكرون إسلاميون مع مفكرين علمانيين وفلاسفة، فأصابني الذهول من السّطحية والخواء الذي يلعب على أطروحات الإسلاميين. النبرة هي هي، مستقرّة منذ بروزهم على السّاحة الثقافية العربيّة، والمشروع أيضا ثابت لم يتغيّر: ‘’الإسلام أفضل وأحسن الأديان وهو الحلّ..’’ وإلى غير ذلك من الأشياء المعروفة على مدى عقود، والتي من الأفضل الإطلاع عليها من الينابع الأولى، أعني من حَسن البنا وسيد قطب والمودودي. ويبدو أن اللاحقين لم يضيفوا شيئاً جديداً عن السّابقين، ما عدا بعض الألفاظ المزركشة بمصطلحات العلوم الحديثة. الإسلاميون ليس لديهم ما يطرحونه من زادٍ فكري متين، فهم لا يُعلّمون أشياء فذة وفريدة من نوعها، لا بل هم لا يساعدون بيداغوجيا المتعلّمين على اكتساب عقل نقدي تحليلي. وأرى أنهم لا يستطيعون ذلك، على عكس المفكرين العقلانيين، من علماء وفلاسفة ومؤرّخين، لأنهم يملكون مقدّسات، وتلك المقدّسات التي تخصّهم هم فحسب، تمنعهم من تفعيل طاقتهم الذهنية بحرّية، وترسم أمامهم خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها اطلاقاً. لو أن الفلاسفة والعلماء انتهجوا هذا النهج، لما تقدّمت البشرية في العلم أبداً، ولمكثنا في عصر فلاسفة ما قبل سقراط، نقرأ كتبهم على ضوء قنديل!
أقسام المفكرين العرب في الوقت الحاضر
* هل يمكنك اقتراح تصنيف للمفكرين العرب المعاصرين وفي أي إطار يكون فيه الإسلاميون؟
- أنا أقسّم المفكرين العرب الحاليين إلى ثلاث فرق، لكلٍّ منها مواصفاتها الخاصة ومجال تحرّكها: الفرقة الأولى تضمّ أطياف المفكرين الإسلاميين الذين يدافعون عن الدين الإسلامي بالشكل الكلاسيكي، أعني باعتباره خاتم الأديان وأفضلها، ويرون أن الأديان الأخرى محرّفة وقد تجاوزها الإسلامُ لأنه دين الفطرة. هؤلاء كما هو معلوم همومهم الأولى والأخيرة هي هموم إيديولوجية تخدم نوعاً من الإسلام السّياسي الحركي الذي يهدف في نهاية المطاف إلى أسلمة المجتمع بالكامل وتطبيق الشريعة بحذافيرها. المجموعة الثانية هم المفكرون الذين يشتغلون على الفكر الإسلامي من الداخل دون أن يكونوا مؤمنين بجميع ما جاء به التراثُ المتأخّر أو متمسّكين بحرفية النصوص، وهم يركنون إلى التحليل العلمي التاريخي، ويحاولون إعطاء نظرةٍ بديلة للبضاعة التي يروّج له الإسلاميون. ومع ذلك فليست لديهم مواقف معادية للدين بما هو كذلك؛ ولكن يعارضون فكرة الانغلاق والتزمّت وخصوصاً الإسلام الشرائعي ذي البعد الواحد الذي يحاول أصحابُ الفرقة الأولى تفعيله في الواقع الحديث. الفرقة الثالثة هي الفرقة التي حسمت مع الدين نهائياً، يعني أنها الفرقة الملحدة التي لا ترى في الدين إلاّ هوساً نفسانياً، أو بلغة ماركس ‘’أفيوناً’’ لتسكين جراحات الطبقة المسحوقة. فالدين، بالنسبة إليهم، لا يمثل عامل رفعة أخلاقية ولا يساهم في تغذية الروح، ولا يحرّر الإنسان من أيّ شيء، بل هو عامل عرقلة للتقدّم، وسقوط في أحلك عصور الظلمات. هؤلاء هم الفرقة الأكثر تهميشاً في العالم العربي، لا بل حتى في الغرب، بعد الهجمة الشّرسة التي يشهدها العالم الآن، حيث إن التيارات التدينية البارزة، تحاول سدّ الفراغ الذي أحدثه توقّف المدّ اليساري، وتقديم نفسها بالتالي بديلاً سياسيّاً اجتماعياً عنه.
* وأيّ من هذه التيارات الدينيّة قادرة على تقديم مشروع حضاري منتِج؟
- كما قلت، لا التيارات المسيحية ولا اليهودية أو الإسلامية بقادرة على تقديم مشروع حضاري محرّر للإنسانية جمعاء، هذا إنْ اعترفت بالإنسانية بوصفها قيمةً كلية ينضوي تحتها الجميع بغضّ النظر عن العقيدة الخاصة. الإنسانية السوية، عند المؤمن، تنتهي في مجال الاشتراك في المعتقد فقط، أما البقية الباقية فهي في ضلال. إنه تصوّر حربي عنيف لمصائر البشرية، ولو كُتب له الدوام والرسوخ فإنّ دمار الإنسانية يغدو محققا والمسألة مسألة وقت.
تحليل ظاهرة التديّن المعاصر
* ما هو التشخيص الذي تقدّمه لظاهرة التديّن المعاصر في العالم الإسلامي اليوم؟
- وهل اختفى التدين من العالم الإسلامي يوماً ما؟ مظاهر التديّن مبثوثة في كلّ مكان، وحيث ولّيت وجهك تجد الآثار والرّموز الدينية قائمة وبارزة في كلّ مكان، بل هي ازدادت منذ العشريّة الأخيرة وأصبحت طاغية على مجتمعاتنا العربية. وأجلى دليل على ذلك عودة ظاهرة النقاب والحجاب واللحي والعمائم بكثافة وعنف لا مثيل لهما. كان هناك في فترةٍ ما، بعد الاستقلال، نوعٌ من العلمانية المحتشمة التي انتهجتها الدولُ العربية، حيث إن الحكومات لم تركّز كثيراً على الجانب الدّيني نظراً إلى أن مشاغلها الأهم هي اللحاق بالركب الحضاري ورفع التحديات التنموية. لكن عوامل داخلية وخارجية جعلتها تتراجع عن ذاك النزر القليل من المكتسبات العلمانية، وأخذت هي نفسها تنحاز إلى نظرةٍ دينية للمجتمع، وربما تتنازل للإسلاميين عن كثيرٍ من صلوحياتها. نحن نرى أن في كلّ مرةٍ تحدث فيها أزمة شاملة وحادّة إلاّ وازداد التديّن، إلاّ ورفع رجال الدين أصواتهم للتنبيه على أن سبب ما يحدث في المجتمع ‘’يسمّونه أمّة’’ هو الابتعاد عن الدين، وأن النهج القويم هو العودة إلى الله والتمسّك بتعاليم الإسلام وتطبيق الشريعة. لقد حدث هذا في الثلاثينات من القرن المنصرم، ثم بعد هزيمة ,67 ولكن بأكثر حدّة نراه الآن، منذ أن تفاقمت أزمة الرأسمالية العالمية، وترسانة الليبرالية، بما فيها الخصخصة التي أخذت تعصف بالمكاسب الاجتماعية من تعليمٍ وصحّة وضمان اجتماعي. هذا بالإضافة إلى الشعور بالإهانة والضيم من الهجمة الشرسة التي يقودها المحافظون الجدد والصهاينة على العالم الإسلامي من محيطه إلى خليجه.
العلاقة الملتبسة بين الإسلاميين والسّلطة
* كيف يُقارب التيارُ التنويري العربي هذه العلاقة بين السلطة والإسلاميين؟
- المفكرون المتنورون يرون أن التنازلات والصفقات السرية التي بدأ يعمد إليها الحكّام في العالم العربي تمثل إجهاضاً للمشروع التنموي وإيقافاً لمسار المجتمعات العربية نحو الديمقراطية والتحرّر. هناك خطأ إستراتيجي خطير اقترفته الحكوماتُ، وخصوصا السّاسة المتربعين على كراسي السلطة منذ عقود، وهو أنهم حينما وجدوا أنفسهم في مأزق لفقدانهم المشروعية ولخلوّ ممارستهم السياسية من أبسط مقومات الديمقراطية والحرية، وبعد أن حطموا القطب اليساري الذي كان فاعلا في الساحة الثقافية والعمالية، أخذوا يغازلون الإسلاميين المتسيّسين الذين بقوا هم الوحيدين المعارضين للأنظمة. ولكنهم أخطؤوا في الحسبان، لأنهم مهما تنازلوا عن مقومات العلمانية، ومهما عملوا لأسلمة المجتمع ‘’بما يتضمنه من هضم لحقوق الأقليات الدينية الأخرى’’ فهم لا يقدرون على امتصاص غضبهم. فالإسلاميون لا يرضون بتلك التنازلات حتى وإنْ كانت كبيرة في الكمّ والكيف، غايتهم ومنتهى أملهم هو الاستيلاء على السلطة كلّها وعلى جميع مستوياتها وتمظهراتها، مباشرة ودون واسطة لكي يتسنى لهم تطبيق الشريعة كاملة كما يزعمون أنها كانت مطبّقة في عهد الإسلام الأوّل. ولذلك فإن الحكام العرب لم يَكسبوا شيئا ولم يُكسِبوا مواطنيهم شيئا لا من جانب التطور الاجتماعي، ولا من جانب معارضة تحركات الإسلاميين. ففشلهم التنموي بادٍ للعيان، والكل يرى بأم عينه الحالة المادية المزرية التي يعيشها الإنسان العربي، ولم يحققوا ولو بندا واحدا من بنود التحرر والديمقراطية الموعودة، ولذلك لا نعجب إن لاقى الإسلاميون تعاطفاً متنامياً من طرف الطبقات المسحوقة، رغم أنهم لا يقدمون لهم أية حلول جدية لرفع حالة البؤس عنهم. الوضعية، في نهاية المطاف، بقيت كما هي إن لم تزدد توتّرا وسوءا، لأن دخول الحركات الإسلامية في اللعبة السياسية وتغيير وجهة الإشكاليات المطروحة من مطلب التقدم المعرفي والنهوض الاقتصادي، إلى مطالب دينية صرفة وتطبيق للشريعة، هو ليس فقط تهميشاً لقضايا الأمة العربية بل إجهاضاً لتطلعاتها التحررية ووأدا لها في الصميم.
أسطورة الإعجاز العلمي
* ما الذي يجعل مقاربتك على هذا النّحو بخصوص طروحات الإسلاميين؟
- تصوّر أن المشاكل الراهنة والملحّة المطروحة على طاولة الإسلاميين في جميع بلدان العالم العربي هي اللباس الشرعي للمرأة، أهو النقاب أم الحجاب؟ في الوقت الذي يعمد فيه الآخرون إلى اكتشاف مكنونات المادّة وإعادة تجربة بداية الكون في المخابر. وفي الوقت الذي يتمترس فيه الأمريكان والصهاينة بترسانتهم الحربية لكي يقضوا على جيوب المقاومة وينهوها! أبهكذا عقول يمكننا أن نحقق التقدّم المرجوّ؟ أإذا وضعنا المرأة تحت ستار وقيّدنا حريّة تحرّكها وقطعنا الأيدي والأرجل ورجمنا الناس في الساحة العامة سنحقق مبتغانا النهضوي؟ لا أدري ما الذي أصاب العرب منذ أكثر من نصف قرن وما الذي يعتمل في أذهانهم، وما الرسالة التي يرغبون في تأديتها للعالم؟ لقد تابعتُ بشيء من الإستياء على إحدى الفضائيات العربية خبراً ما انفك المذيعون يرددونه باستمرار، ألا وهو اكتشاف أركيولوجي باهر، زعم أصحابه أنهم فنّدوا نظرية داروين التطورية مرة واحدة وإلى الأبد. وقد عملت الفضائية إلى الترويج إليه لمدّة يومين متتاليين كي تجذّر فكرة أن الإنسان هو إنسان منذ النشأة الأولى ولم يمرّ بأية مرحلة تطوّر من القردة العليا إلى الوضع الحالي. لكنني انبهرتُ أكثر حينما رأيت أن كلّ هذه الدعاية غائبة كلياً عن وسائل الإعلام الغربية ولم تُحظ بأية التفاتة جدية من طرف العلماء. وهذا دليل على أن العالم العربي ما زال يلتقط إلى حدّ الآن، ومن أية جهة أتت، كل ما يدعّم أساطير العهد القديم، ولكن يدير ظهره ويُعرض بشدّة عن روح العقلانية. وما أسطورة الإعجاز العلمي في القرآن التي شهدت أوجها في الثمانينات من القرن المنصرم بالتزامن مع الإعجاز العلمي في الكتب المقدسة للمسيحيين واليهود (التوافق ليس من سبيل الصدفة) لهي خير دليل على ذلك.
تناقض المتدينين المعاصرين
* في هذا الإطار، على أي نحو يمكن تفسير ظاهرة التناقض في حياة المتدينين المعاصرين، حيث الجمع بين الطقس الديني التقليدي، والحفاوة بمظاهر الحياة المدنية؟
- التناقض يعيشه المتديّن المعاصر ليس فقط من هذه الجهة التي ذكرتَ بل في مجالات أخرى، والتي تصل في بعض الأحيان إلى حدّ الفصام النفسي. انظر مثلاً إلى المأساة التي يعيشها المتديّنون في الغرب الذين يؤمنون بحرفية الكتاب المقدّس: لقد أثبتت الحفريات وعلم الجينات والبيولوجيا الخلوية صحة نظرية التطوّر، وأن الإنسان ينتمي عن جدارة إلى مملكة الحيوان، ولا يوجد فارق جيني كبير بينه وبين القردة العليا. المتديّن المعاصر في الوقت الذي يعترف فيه بإنجازات العلوم ويتمتّع برفاهيتها فإنه ينكر حقائقها العينية واستتباعاتها الأنثربولوجية لا لشيء إلاّ لأنها تتضارب مع حرفية النص المقدّس. لكن في حقيقة الأمر كلّ الكتب المقدسة تتضارب رأساً مع العلوم الحديثة وإنْ أخذت على حرفيتها، ولم تُجْر عليها كل أصناف التأويلات الخيالية كما يعمد البعض الآن، فإن المرء سيعيش فعلا في حالة انفصام عقلي، بحيث إنه يعتقد في أساطير جدّ بدائية من جهة، ومن جهة أخرى يستخدم أحدث ما توصّل إليه العقل البشري من تقنيات وعلوم. ولكن لو استنفد التناقض إمكاناته هنا فلا ضير فيه رغم إننا ننعى على أناس مثلنا عيشهم في شرخ نفسي خطير، ولكن هذا الهوس يحاول الإسلاميون ‘’والمسيحيون واليهود المتعصبون’’ تعميمه على الجميع وإنتاج مجتمع فصامي، يعيش فيه المرء مشتتا ذهنه بين أساطير الفجة لقرون غابرة بدائية ‘’تصوّر أن العهد القديم كتب في العصر البرونزي’’، وبين عالم تكنولوجي مادي علمي عقلاني. الإسلاميون يضيفون إلى هذا المجتمع الفصامي، مجتمع رعب، حيث تقطّع فيه الأيدي والأرجل، وتُرجم النساء والرجال، وتُقطَع الرؤوس بحدّ السيف في الساحة العامة. إنها البربرية بأم عينها، وأتحدى أي مجتمع ينوي النهوض واستشراف مستقبل زاهر أن ينتهج هذا النهج. إنه الدمار الشامل لمكوّنات أي مجموعة بشرية على وجه الأرض ولأبسط مقوماتها الإنسانية.
الإسلام السياسي متحالف مع الإمبريالية
وماذا بشأن ظاهرة التناقض في المجال السياسي وانخراط الإسلاميين فيه؟
- إن الكثير من المحللين والدارسين الذين انتهجوا نهج المقاربة العلمية للظاهرة الدينية الحديثة تفطنوا إلى أن الإسلاميين السياسيين لا يختلفون في شيء عن الرجعيين الأوروبيين سواء في القرن التاسع عشر أو الحاليين. وقد كتب سمير أمين مقالا معبّرا عنوانه فقط ‘’الإسلام السياسي في خدمة الإمبريالية’’، برهن فيه على أن الإسلام السّياسي، وهو المهيمن الآن على الساحة العربية، ‘’ يُبرّر استراتيجية الإمبريالية في إحلال ما يسمى بصراع الحضارات بديلاً للصراع بين المراكز الإمبريالية والأطراف المهيمن عليها. إن التشديد الوحيد على الحضارة ‘’الثقافة’’ يسمح للإسلام السياسي بأن يحذف من كلّ مجالات الحياة المواجهات الاجتماعية الواقعية بين الطبقات الشعبية والنظام الرأسمالي العالمي الذي يضطهدهم ويستغلهم. مناضلو الإسلام السياسي لا وجود حقيقياً لهم في المجالات التي تجري فيها صراعات اجتماعية واقعية، وقادتهم يكرّرون باستمرار أن مثل تلك الصراعات لا أهمية لها. الإسلاميون موجودون فقط في مجالات المدارس المفتوحة والمستوصفات الصحية، ولكن ليست هذه سوى أعمال إحسان، وسوى وسيلة للتخريب. إنها ليست وسيلة لدعم كفاح الطبقات الشعبية ضد النظام المسؤول عن فقرهم. على أرض المسائل الاجتماعية الحقيقية يقف الإسلام السياسي في خندق الرأسمالية والإمبريالية المهيمنة، إنه يدافع عن مبدأ الطبيعة المقدسة للملكية، ويجيز عدم المساواة وكل متطلبات إعادة الإنتاج الرأسمالي، ودعم الإخوان المسلمين في البرلمان المصري للقوانين الرجعية الحديثة التي تعزز حقوق ملكية المالكين على حساب حقوق المزارعين المستأجرين ‘’ويؤلفون أغلبية الفلاحين الصغار’’ ليس سوى مثال بين فئات أخرى. لا يوجد مثال ولو قانون رجعي واحد، مقرّ في أي بلد إسلامي عارضته الحركات الإسلامية. زيادة على ذلك، مثل تلك القوانين تقر وتنشر بموافقة قادة النظام الإمبريالي. الإسلام السياسي ليس ضد الإمبريالية، حتى ولو ظن مناضلوه عكس ذلك! إنه حليف ثمين للإمبريالية، وهذه تعرف ذلك، ومن السهل أن يفهم المرء والحالة هذه، أن الإسلام السياسي بقي دوماً في صف الطبقة الحاكمة السعودية والباكستانية، عدا عن ذلك كانت تلك الطبقات منذ البداية الأولى من بين أنشط المشجعين له.
قراءة في أفكار مارسيل غوشيه
* ما تعليقك على ما يذهب إليه بعض الباحثين ‘’أمثال المفكر الفرنسي مارسيل غوشيه’’ من أنّ التديّن ‘’ومطلق الدين’’ يمكنه أن ينتعش في ظل سياقات لا دينية، وعالية الحداثة؟
- أنْ ينتعش التديّن في ظلّ سياقات لا دينية وعالية الحداثة فهذه ظاهرة تاريخية اجتماعية معاينة ومعاشة حالياً في العالم أجمع. وربّما تنمّ عن مفارقة تاريخية رهيبة، لأن العكس غير صحيح، لا يمكن للفكر الإلحادي أن ينتعش ويعبّر عن نفسه بحرية في مجتمع ثيوقراطي وفي سياق ديني. المفارقة الأخرى التي استرعت انتباه الفلاسفة العقلانيين، وربما ولّدت فيهم نوعا من الاستياء، هو أن الاعتقاد أو التنبؤ بأن عهد الأساطير والخرافات، مع مرور الزمن وإثر اكتساب الإنسان وعي علمي تاريخي ستؤول إلى الزوال والاندثار؛ لم يحدث كلّيا، أو ربما حدث ولكن في نطاق ضيّق ومحدود. إلاّ أن تواصل الظاهرة الدينية في المجتمعات الحديثة لا يضفي عليها أية حقيقة أنطولوجية؛ لا يجعل منها واقعاً مُثبّتاً، كما يزعم أصحابه، في غريزة الإنسان وجبلّته. فالمجتمعات الغربية المعاصرة التي كانت مهداً للاكتشافات العلمية والثورات النظرية، لم تخل يوماً ما من التديّن. وربما وجد الدين فيها نوعاً من حرية التحرّك وقد تكون راجعة لأسباب سياسية أو حتى انتهازية. حقيقة الدين في تاريخه فقط، وخارج هذا المجال الزمني فإن الدين بصفة عامة فاقد للأرضية الأنطولوجية التي تجعله متعالياً على الزمن. هذا التعالي هو من مشمولات العلم والفلسفة فقط. لأن الدين بما هو كذلك، أعني بما هو منظومة أسطورية لا يستطيع أن يولّد أو يضمن أو يُوصل أية حقيقة شاملة وكلية. والدليل على ذلك اختلاف الملل والنحل، وتناقضاتها وتكذيبها لبعضها البعض، وتناحرها المستمرّ في ما بينها. وقد نسلّم بأن الاختلاف والمغايرة هما ثراء للفكر الإنساني، وتدعيم لروح التسامح والديمقراطية، لكن المتدينين يعترفون بالاختلاف ‘’عن مضض’’ في صلب منظومتهم فحسب ‘’فرق أو مذاهب’’، أما المنظومات الأخرى فهي مرفوضة ومدانة، ولن تجد أي دين يُنسّب حقائقه ومعتقداته كي تستجيب لمطلب التسامح الكلي وتقبّل الآخر كما هو. هذا الموقف لا يمكن إطلاقا أن ينبع من فكر أسطوري ديني.
دين الخروج من الدين
* يذهب ‘’غوشيه’’ إلى اعتبار المسيحية ‘’دين الخروج من الدين’’. ما الذي توحي به هذه العبارة؟
- القول بأن المسيحية، وفقط المسيحية هي دين الخروج من الدين فهذه أطروحة تذكّرني بما قاله الفيلسوف الألماني شلينغ في كتابه ‘’فلسفة الوحي’’ من أن ‘’المسيح هو نهاية الوحي، كما أنه نهاية الوثنية؛ بحيث أنه يعطي ختما للوحي’’. وهناك صيغة إسلامية حديثة لهذه الفكرة، أعني فكرة ختم الوحي ونهاية الدين التي دشنها الإسلام. انظر مثلا إلى قولة لمحمد اقبال استشهد بها هشام جعيّط في كتاب الفتنة الكبرى لكي يدعّم بها أطروحة نهاية التاريخ الخلاصي: ‘’فبَعد محمد لا دين عالمي، وبالطريقة ذاتها وَجد فيه التراث التوحيدي خاتم الأنبياء حقا، كما جاء في القرآن، وهذا معناه أن كل وحي قد انقطع بعد محمد، وأن صلة الله بالإنسان قد اكتملت، وأن دين إسلام الإنسان لله قد دشن عصر نهاية الحوار بين السماء والأرض، أو حتى كما كان يقول إقبال إنه افتتح عصر نهاية وصاية الإلهي على البشري، وبالتالي انعتاق الإنسان’’. أنا أرى أن هذه الأطروحة هي آخر ملاذ للمتديّنين أو أشباههم أمام انتقادات المفكرين العقلانين للأنساق الدينية ولركائزها الأسطورية. المتديّنون، أو المفكرون المؤمنون، أو حتى التوفيقيّون لم يجدوا أمامهم من مفرّ إلاّ الزعم بأن دينهم استبق خيبة العالم الحديثة، على حدّ قول ماكس فيبر، وربما هو المؤسس لفكرة الحداثة ذاتها. الإسلاميون، من جهتهم، يقولون بأن القرآن استبق كل الاكتشافات العلمية الحديثة وربما المستقبلية منها، وإلى الأبد، ولكنهم لم يفعلوا شيئا إلاّ أنهم يلهثون وراء الغرب الذي يعادونه ليل نهار، كي يمدّهم بانتاجاته العلمية والتقنية ولكي يبرهنوا له بأن دينهم هو الأصح، لأن جميع جهوده تلك موجودة منذ 1500 سنة في كتاب عربي اسمه القرآن. إن لم تكن هذه مهزلة، فلا أدري ما هي بالتحديد! ولا تقلّ عنها هزلا الأطروحة التي ذكرتها سابقا ، لكن هؤلاء المفكرين الغربيين، وجلهم من اليمينيين المتعاطفين مع الإكليروس، يتناقضون في العمق نظرا إلى أنهم لا ينوون بهكذا إشارة فسخ الدين عامة، بل هم يرجعونه إلى هيكله الأولي، أو يجعلون منه غريزة محايثة لا تختفي أبدا ولا يمكن التملّص منها. ولذلك فإن هذا الإدعاء هو شكلاني فقط ولا يمسّ هيكل القضية، لأننا إذا أردنا التقيّد بالمعاني الواقعية للكلمات فإن ‘’الخروج من الدين’’ يعني ترك الدين نهائيا واعتباره موروثا قديما غير ملائم للعصر ومبنياً على قصر من الاستيهامات، يعني في نهاية المطاف نكران الدين ورفض ترسانته الإيمانية برمّتها. لكن ليس هذا مقصد شلّينغ و غوشييه، ولا مقصد إقبال أو جعيّط وأمثالهم.
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1246 الجمعة 04/12/2009)