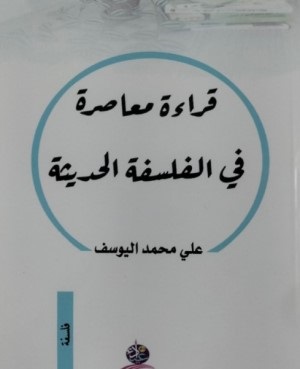شهادات ومذكرات
السهروردي المقتول.. فيلسوف الإشراق (4)
 في هذا المقال الرابع والأخير نحاول أن نبرز قضية أخري مهمة عند السهروردي، وهي قضية توافق العقل مع الذوق، حيث يدعو السُّهْرُوَرْدِىّ في مذهبه الإشراقي إلى ضرورة توافق الذوق مع العقل أو المنطق . فالعقل الذى يرى ويفكر وحده دون أن يكون له مؤيد له من الذوق، ليس من الثقة فيه والاطمئنان إليه، بحيث ينتفى كل شك فيه، وتزول كل شبهة، ولا بد من ازدواجية أداة المعرفة التى تعتمد على الحكمة البحثية المعتمدة على التحليل والتركيب والاستدلال البرهانى وهى حكمة الفلاسفة المشائية، والحكمة الذوقية التى هى ثمرة مذاق روحى، وهى حكمة يحياها الإنسان . ولا يستطيع التعبير عنها، وهى حكمة الفلاسفة الإشراقيين، وليس ثمة تعارض حقيقى بين الحكمتين، وإنما هو تعارض ظاهرى لأن الفيلسوف الإشراقى الحقيقى هو الذى يتقن الحكمة البحثية وينفذ في نفس الوقت إلى أسرار الحكمة الذوقية .
في هذا المقال الرابع والأخير نحاول أن نبرز قضية أخري مهمة عند السهروردي، وهي قضية توافق العقل مع الذوق، حيث يدعو السُّهْرُوَرْدِىّ في مذهبه الإشراقي إلى ضرورة توافق الذوق مع العقل أو المنطق . فالعقل الذى يرى ويفكر وحده دون أن يكون له مؤيد له من الذوق، ليس من الثقة فيه والاطمئنان إليه، بحيث ينتفى كل شك فيه، وتزول كل شبهة، ولا بد من ازدواجية أداة المعرفة التى تعتمد على الحكمة البحثية المعتمدة على التحليل والتركيب والاستدلال البرهانى وهى حكمة الفلاسفة المشائية، والحكمة الذوقية التى هى ثمرة مذاق روحى، وهى حكمة يحياها الإنسان . ولا يستطيع التعبير عنها، وهى حكمة الفلاسفة الإشراقيين، وليس ثمة تعارض حقيقى بين الحكمتين، وإنما هو تعارض ظاهرى لأن الفيلسوف الإشراقى الحقيقى هو الذى يتقن الحكمة البحثية وينفذ في نفس الوقت إلى أسرار الحكمة الذوقية .
ويعطينا الشهرزورى تلميذ السُّهْرُوَرْدِىّ صورة واضحة لهاتين الحكمتين، فيقول: "جمع السُّهْرُوَرْدِىّ بين الحكمتين، أعنى الذوقية والبحثية. أما الذوقية فشهد له بالتبريز فيها كل من سلك سبيل الله عز وجل وراضى نفسه التشاغل بالعالم الظلمانى، طالباً بهمته العالمية مشاهدة العالم الروحانى . فإذا استقر قراره وتهتك بالسير الحثيث إلى معاينة المجردات أستاره، حتى ظفر بمعرفته ونظر بعقله إلى ربه، ثم وقف بعد هذا على كلامه. فلنعلم حينئذ أنه كان فى المكاشفات الربانية آية والمشاهدات الروحانية نهاية، لا يعرف غوره إلا الأقلون، ولا ينال شأوه إلا الراسخون . وأما الحكمة البحثية فإنه أحكم شأنها وشيد أركانها، وعبر عن المعاني الصحيحة اللطيفة بالعبارات الرشيقة الوجيزة، وأتقنها إتقاناً لا غاية وراءه لا سيما في كتابة المعروف " بالمشارع والمطارحات " فإنه إستوفى فيه بحوث المتقدمين والمتأخرين، ونقض فيه أصول مذاهب المشائين وشيد فيه معتقد الحكماء الأقدمين، وأكثر تلك البحوث والمتناقضات، وذلك على قوته فى الفن البحثى والعلم الرسمى .
ويستطرد الشهرزورى فيقول: " واعلم أنه لم يتسير لأحد من الحكماء والعلماء والأولياء ما تيسر لهذا الشيخ من إتقان الحكمتن المذكورتين، بل بعضهم يسر له الكشف، ولم ينظر في البحث كأبى يزيد البسطامى و" الحلاج " ونظرائهما، وأما إتقان البحث الصحيح بحيث يكون مطابقاً للوجود من غير سلوك وذوق فلا يمكن وجميع الحكماء المقتصرين على مجرد البحث الصرف مخطئون في عقائدهم . فإن أردت حقيقة الحكمة وكنت مستعداً لها، فأخلص لله تعالى وأنسلخ عن الدنيا انسلاخ الحية من جلدها عساك تظفر بها، وذلك لأن الحكمة الإشراقية كما يري السُّهْرُوَرْدِىّ لا يمكن تعلمها لا بفكر ولا بنظم دليل قياسى أو نصب تعريف حدى أو رسمى، بل بأنوار إشراقية متناوبة، وتشاهدها فوقها على العناية الإلهية، وهذه الحكمة الذوقية قَل من يصل إليها من الحكماء ولا يحصل إلا للأفراد أو الحكماء المتألهين كأنباذوقليس وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون وغيرهم من الأفاضل الأقدمين الذى شهدت الأمم المختلفة بفضلهم وتقدمهم .
وإذا كان السُّهْرُوَرْدِىّ قد جمع بين الحكمتين الذوقية والبحثية . فيمكن تلمس هاتين الحكمتين عند الفيلسوف الإنجليزي " برتراند راسل " Bertrand Russell، حيث كتب رسالة في غاية الروعة عن العلاقة بين المنطق والتصوف، حيث عقد فصلاً هو من أجود ما كتب في حياتة الفلسفية، أراد أن يميز بين قطبى الرحى في حياة الإنسان الثقافية الذين هما بصورة مجملة التصوف في ناحية، ومنطق العقل في ناحية أخرى، ففى الحالة الأولى يكون الإدراك مباشراً وبغير مقومات، وفى الحالة الثانية على " التحليل "، بينما يرفض أصحاب الحالة الأولى كل ضروب " التحليل "، وأطلق "راسل" على بحثه ذاك عنوان " المنطق والتصوف " Mysticism & Logic، ثم جعل العنوان نفسه عنواناً لكتاب يضم ذلك الفصل من فصول أخرى، وإنه لما يفيدنا في هذا الموضوع أن نوجز ما قاله " راسل " فى العلاقة بين المنطق والتصوف "، يقول "رسل": لقد سار الإنسان في محاولته أن يتصور العالم من حيث هو كل واحد مدفوعاً بدافعين مختلفين كل الاختلاف، وقد يتلاقى هذان الدافعان معا في إنسان واحد، وقد لا يتلاقيان، فأولهما هو الذى يحفز الإنسان إلى النظر إلى الوجود نظرة المتصوف، وأما الثانى فيحفزه إلى النظر بوسيلة العقل نظرة العلماء، ولقد استطاع أعظم الرجال أن يبلغوا قمة العبقرية بالدافع الأول وحده . كما استطاع أيضاً أعظم الرجال أن يبلغوا قمة العبقرية بالدافع الثانى وحده . ولكن أعظمهم جميعاً هم أولئك الذين اجتمعت لهم عناصر المعرفة العقلية، وعناصر الإدراك الصوفي في آناً معاً .
ويوضح برتراندراسل ذلك قائلاً:" تطورت الميتافيزيقيا، أو محاولة إدراك العالم ككل بوسائل الفكر، منذ البدء عبر وحدة وتصارع دافعين إنسانيين، أولهما يحث الناس على التصوف، فيما يحثهم الثاني على العلم . لقد حقق بعض الأفراد ما هو عظيم ضمن الدافع الأول وحده، فيما حققه البعض الآخر عبر الدافع الثاني وحسب: فإذا أخذنا " ديفيد هيوم" مثلاً، كان الدافع العلمي عنده هو الغالب دون منازع، فيما نجد عند " بليك " العداء حيال العلم يتعايش مع رؤية صوفية عميقة . لكن الأفراد الأكثر عظمة والذين هم الفلاسفة كانوا يشعرون بحاجة لكل من العلم والتصوف: فمحاولة خلق تناغم مّا بين الاثنين ـ التي وسمت حياتهم، والتي يجب أن تكون دائماً كذلك، بما فيها من توقد غير مستقرـ هي التي جعلت الفلسفة تبدو، بالنسبة لبعض العقول شيئاً يفوق بعظمته العلم والتصوف" .
ثم يعطينا برتراندراسل أمثلة للخصائص التي تميز دافِعيْ العلم والتصوف مأخوذة من حياة فيلسوفين عظيمين إمتزجت حياة كل منهما بقوة بما أنجزه . هذان الفيلسوفان هما هيرقليطس وأفلاطون، حيث يقول ": لقد كان هيرقليطس، كما يعرف الجميع، يؤمن بمقولة التدفق الشامل: الزمن يبني جميع الأشياء ويحطمها. ومع أنه ليس من السهل معرفة كيف توصل إلى آرائه، إذ لم يبق لدينا منه سوى شذرات، يمكننا القول إن بعض ما قاله يوحي بأن المراقبة العلمية كانت ينبوع آرائه. يقول: " الأشياء التي يمكن أن تُرى، أو أن تُسمع، أو يتم تعلمها هي التي أُثمنها أكثر" إن لغة كهذه هي لغة أمبيريقية، تشكل فيها المراقبة الضمان الوحيد للحقيقة. وكذلك قوله إن " الشمس جديدة في كل يوم"، واحدة من تلك الشذرات، تكشف بوضوح، رغم طابعها المُتناقض، أنها كانت تستلهم التفكير العلمي، فمما لا شك فيه أن هيرقليطس، عبر ذلك الحكم، كان يحاول تحاشي صعوبة فهم كيف أن الشمس بمقدورها التحرك من الشرق إلى الغرب. ولا بد أن تكون المراقبة العيانية أيضاً هي ما أوحى له بنظريته المركزية، القائلة بأن النار هي الجوهر الوحيد الثابت والذي تمر بفضله جميع الأشياء المرئية عبر مراحل. ففي الاحتراق نرى تحول الأشياء التام، فيما يتصاعد اللهب والحرارة في الهواء ثم يتلاشيان. يقول "هذا العالم، والذي هو واحد بالنسبة للجميع لم يصنعه أي من الآلهة أومن البشر، لكنه كان دائماً، وهو الآن، كما سيكون دائماً، من صنع النار الحية، ثمة مكيال يُضئ، فيما يخمد مكيال آخر. تحولات النار هي، قبل أي شئ آخر، بحر؛ ونصف البحر أرض، ونصفه الآخر زوبعة تبقى هذه النظرية، رغم أنها قد أصبحت مرفوضة من قبل كل العلوم، علمية في روحها. كذلك يبقى علمياً حكمه الشهير الذي يستشهد به أفلاطون " لا يمكننا النزول مرتين في النهر الواحد؛ لأننا ننزل دائماً في مياه جديدة" . غير أننا نعثر أيضاً على حكم آخر ضمن تلك الشذرات " نحن نهبط في النهر الواحد ولا نهبط، لأننا موجودون وغير موجودين".
ويري راسل أن مقارنة هذه العبارة الصوفية، بتلك التي يذكرها أفلاطون، العلمية، تظهر إلى أي حد يتزاوج فيه الدافع الصوفي بالدافع العلمي في نظام هيرقليطس. فالتصوف، في جوهره، شئ أكثر من محض توتر أوسع وأعمق في الإحساس حيال الطريقة التي يجري بها فهم الكون؛ وهذا الإحساس قد أدى بهرقليطس، على أسس علمه، إلى ذلك النوع من الأقوال الغريبة والمؤثرة عن الحياة والعالم، كقوله: الزمن طفل يلعب بالنرد، القوة الملكية هي قوة الطفل. فالمخيلة الشعرية، لا العلمية، هي من يقدم الزمن باعتباره سيداً طاغياً يتحكم في العالم، بكل ما ينطوي عليه الطفل من طيش ولا مسؤولية . والتصوف أيضاً هو ما جعل هيرقليطس يؤكد على وحدة المتناقضات: " واحد هما الخير والشر"، كما يقول: كل الأشياء عند الرب لطيفة وخيرة وعادلة، لكن البشر يحسب البعض منها خاطئاً والبعض الآخر صحيحاً. ترتكز أخلاقية "بيليك وهيرقليطس " على الكثير من التصوف. صحيح إن التحديد العلمي هو الذي ألهم حكمه التالي: طبع الإنسان هو مصيره، بيد أن المتصوف وحده منْ يمكنه القول: "تساق كل بهيمة بالصفعات إلى المرعى، وكذلك: يصعب نزاع المرء مع رغبة قلبه. كل ما يُرغب الحصول عليه، يتم شراؤه على حساب الروح، وأيضاً: "الحكمة واحدة. إنها معرفة الفكرة التي تُرَص فيها الأشياء بعضها ببعض
ويزيد راسل في مضاعفة الأمثلة، فيقول:" ثمة مقاطع عند أفلاطون –من بين تلك التي تُبين الجانب العلمي من عقله- تشير إلى معرفته الواضحة بذلك الأمر. أكثر تلك المقاطع أهمية هو ذلك المقطع الذي يشرح فيه سقراط، الذي كان شاباً، نظرية الأفكار لبارمنيدس. فبعدما أوضح سقراط أن هناك فكرة للخير، لكن ليس ثمة من فكرة لأشياء كالشعر أو الطين أو القذارة، ينصحه بارمنيدس بالمضي وأن لا يزدري حتى بالأشياء الوضيعة. وقد كشفت تلك النصيحة عن الطبع العلمي الأصيل. إذ لا بد من تركيب الرؤية الصوفية للواقع السامي للخير مع هذا الطبع اللامتحيز، إذا ما كانت الفلسفة تطمح في تحقيق أعظم ممكناتها. بيد أن إخفاقها على هذا الصعيد هو ما جعل الفلسفة المثالية هزيلة، فاقدة للحياة، وبلا مادة. فعن طريق التزاوج مع العالم يمكن لمُثلنا جلب ثمارها: لكن إذا ما انفصلت عنه، فستظل تلك المُثل عارية. غير أن التزاوج مع العالم لا يعني القيام به عبر مثالية تهرب من الواقع، أو تعلن بدءًا بأن على العالم التطابق مع رغباتها .
ثم يدلل " راسل " على ذلك ببارمنيدس الايلى الذى يصف تصوفه بأنه تصوف منطقى ظهر عند كثير من المتصوفه الميتافيزيقيين من يوم " بارمنيدس " إلى " هيجل " وتلاميذه المحدثين وأساسه هو أننا لا نعرف اللاوجود وما لا نعرفه ليس موجوداً، يقول رسل:" كذلك فإن لبارمنيدس نفسه نوعاً من التصوف الخاص، المُثير للاهتمام، والذي كان يستولي على فكر أفلاطون، أي التصوف الذي يمكننا تسميته بـ " المنطقي"، ما دام يتجسد عبر نظريات في المنطق. فكما هو واضح يجد هذا الشكل من التصوف، بالقدر الذي يتعلق فيه الأمر بالغرب، جذوره عند بارمنيدس، كما أنه يستحوذ على طرق تفكير المتصوفة الميتافيزيقيين الكبار منذ أيامه وحتى هيجل ومريديه المعاصرين. فالواقع، مثلما يقول، لم يُخلق، ولا يمكن تحطيمه، ولا تغييره، أو تجزئته؛ فهو مُثبت ضمن حدود سلاسل كاملة القدرة، لا بداية له ولا نهاية؛ ما دام المجئ إلى الوجود والخروج منه قد تم إبعادهما عنه، وأزالهما عنه الإيمان الحقيقي. فالمبدأ الجذري الذي يوجه بحثه قد عبر عنه بحكم يمكن أن يجد مكانته عند هيجل: “لا يمكنك معرفة ما هو غير قائم -أمر مستحيل- وليس بمقدورك النطق به؛ ذلك لأنه شئ واحد ذلك الذي يمكنه الوجود وما يمكن التفكير به أيضاً لا بد من أن يكون ما يُقال وما يفكر به موجوداً، ذلك لأنه قادر على أن يكون، وليس من الممكن لما هو غير كائن أن يكون”. تنتج عن هذا المبدأ استحالة التغيير، لأن ما جرى في الماضي يمكن قوله، وهو ما زال قائماً تبعاً لذات المبدأ "
ويستطرد راسل قائلاً:" إن أحد الجوانب الأكثر إقناعاً في التجلي الصوفي هو الوحي الظاهري بوحدة جميع الأشياء، وذلك ما ولد مذهب وحدة الوجود في الدين والتوحيد في الفلسفة. ثمة منطق متقن، كان قد بدأ مع بيرمنيدس وبلغ ذروته عند هيغل وأتباعه، قد تطور تدريجياً، للبرهنة على أن الكون هو كلية واحدة لا تتجزأ، وما يظهر وكأنه أجزاء له، إذا ما تم التعامل معه باعتباره جوهراً يتمتع بالوجود الذاتي، ما هو إلا وهم. فالإيمان بوجود واقع يختلف تماماً عن عالم الظاهر، واقع واحد، لا ينقسم ولا يتغير كان قد أُدخلَ على الفلسفة الغربية من قبل بارمنيدس ليس لأسباب صوفية أو دينية، على الأقل اسمياً، ولكن على أسس الحجة المنطقية القائمة على استحالة اللا-وجود، وبأن غالبية النظم الميتافيزيقية اللاحقة كانت حصيلة لتلك الفكرة "
ثم يؤكد رسل أن:" المنطق الذي تم استخدامه للدفاع عن التصوف يظهر بأنه خطأ في المنطق، وهو معرض للنقود التقنوية، وذلك ما قمت بشرحه في مكان آخر. لن أكرر هنا تلك النقود، ما دامت طويلة ومعقدة، لكني سأحاول القيام بتحليل للحالة الذهنية التي تولد عنها ذلك المنطق الصوفي. يتولد الإيمان بواقع مختلف تماماً عمّا يظهر للحواس بقوة لا تقاوم في بعض الأمزجة، والتي هي مصدر غالبية التصوف والميتافيزيقيات. فحينما يتغلب مزاج كهذا، ينتفي الشعور بالمنطق، وبالتالي فإن أكثر المتصوفة إندفاعاً لا يستخدم المنطق، بل يسعى مباشرة للكشف عن رؤيته الداخلية. غير أن التصوف المدفوع إلى هذا الحد قلما نعثر عليه في الغرب. فعندما تتواصل قناعة بمثل هذه القوة الانفعالية، يبحث الفرد المُمارس للتفكير عن أسس منطقية لصالح الإيمان الذي يجده في نفسه. لكن عندما يكون ذلك الإيمان قائماً سلفاً، سيكون هذا الفرد منفتحاً حيال أية أرضية توحي بنفسها ".
وأخيراً يري رسل أن:"... المتناقضات المُبرهن عليها بصورة واضحة ضمن منطقه هي في الحقيقة متناقضات التصوف، وتشكل الهدف الذي يعتقد بأن على منطقه بلوغه، إذا ما أراد له أن يكون منسجماً مع رؤيته الداخلية. وقد كان الناتج المنطقي هذا سبباً في جعل غالبية الفلاسفة عاجزين عن وضع العالم العلمي والحياة اليومية ضمن اعتباراتهم. فلو كانوا مهتمين بأخذ ذلك في نظر الاعتبار، لكان في مقدورهم، ربما الكشف عن الأخطاء التي يتضمنها منطقهم، غير أن غالبيتهم لا تعير اهتماماً لفهم عالم العلم والحياة اليومية، بل تدينه باعتباره غير واقعي لصالح عالم “حقيقي” يقع فيما وراء الحواس. بمثل هذه الطريقة تمت مواصلة المنطق من قبل أولئك الفلاسفة الكبار والذين كانوا من المتصوفة. لكن ما دام التعامل مع المألوف قد أُخذَ كونه ضامناً لتلك الرؤية المُفترضة للانفعال الصوفي، فقد جرى تقديم عقائدهم المنطقية بنوع من الجفاف، وتم احتسابها من قبل مريديهم وكأنها مستقلة عن أي تجلّ مُفاجئ كانت قد إنبثقت عنه. ورغم ذلك ظل أصلهم مُلتصقاً بهم وبقوا، لكي أستعير كلمة نافعة من “سانتيانا”، “خبثاء” إزاء عالم العلم والحس العام. بهذه الطريقة وحسب يمكننا التعامل مع ذلك الرضا الذي قبل بموجبه الفلاسفة تناقض عقائدهم مع جميع الحقائق العلمية العامة التي تبدو أكثر استقامة وجدارة بالإيمان. يُظهر المنطق الصوفي، كما هو الأمر في الطبيعة، حالات الخلل المُتأصلة في كل ما هو خبيث. إن الدافع المنطقي، الذي لا يمكن الشعور به عندما يهيمن المزاج الصوفي، يعاود التأكيد على نفسه ما إن يتلاشى ذلك المزاج، ولكن مع الرغبة في الاحتفاظ بتلك الرؤية المُضمحلةِ، أو على الأقل البرهنة على أنها لم تكن سوى رؤية داخلية، وبأن ما يناقض ذلك الدافع ما هو إلا وهم. إن نشوء منطق كهذا لا يخلو من المصلحة، فهو يستلهم كراهية معينة حيال العالم اليومي الذي يسعى لتطبيق نفسه فيه. من الطبيعي أن لا يؤدي موقف كهذا إلى الوصول لأفضل النتائج. فكل واحد يعرف أن قراءة مؤلف ما من أجل دحضه وحسب ليست بالطريقة الصحيحة لفهمه؛ كما أن قراءة كتاب الطبيعة ضمن الاعتقاد بأن كل شيء فيها وهمي هي بالدقة ما لا يوصل إلى الفهم. فإذا كان منطقنا يجد العالم اليومي مفهوماً، لا ينبغي أن يكون عدائياً، بل يجب عليه استلهام قبول أصيل له، بطريقة لا نعثر عليها عادة عند الميتافيزيقيين ".
من كل ما سبق يتضح لنا أن هناك فلاسفة قد أخذوا بالمنهج العقلى الاستدلالى فحصرهم الجدل العقلى الجاف في دائرة مغلقة، ولكنهم برغم هذا وصلوا إلى قمة العبقرية، ولكن هناك فلاسفة جمعوا بين المنهجين، أى تجاوزوا مرحلة الفكر الاستدلالى إلى مقام الرؤية المباشرة أو الكشف . وهؤلاء أعظمهم لأنهم هم الذين اجتمعت لهم عناصر المعرفة العقلية وعناصر الإدراك الصوفى في آناً واحدة معا كما يقول " راسل ".
والسُّهْرُوَرْدِىّ خير من جمع بين عناصر المعرفة العقلية وعناصر الإدراك الصوفى، وذلك في منطقة الإشراقى القائم على الحكمة البحثية والحكمة الذوقية، وهو بهذا يظل ثنائياً كابن سينا، فهو منطقى فيلسوف من ناحية، يعتمد على العقل والبرهان في نقده للمنطق الأرسطى بصرف النظر عن دوافع هذا النقد وهى دوافع إشراقية، ثم هو إشراقي من ناحية يعطينا تصوراً للعالم كنور ولدرجات، العالم كدرجات من النور، فهو يمثل الفيلسوف المنطقى الإشراقى، أى الحكيم البحاث المتأله .
ويعطينا السُّهْرُوَرْدِىّ تصوراً لهذا الحكيم البحاث المتأله، وذلك في إطار تصنيفه لدرجات الحكماء فيقول: " العالم ما خلا قط عن الحكمة وعن شخص قائم بها عنده الحجج والبينات مصداقاً للآية الكريمة: " إنى جاعل في الأرض خليفة " .
ويصنف السُّهْرُوَرْدِىّ الحكماء إلى حكماء بحثيين وحكماء إشراقيين، ثم حكماء يجمعون بين الحكمتين البحثية والإشراقية، ويرتب الدرجات لكل طائفة، وقد جعلها على أربع درجات، التوغل والتوسط والضعف والعدم، ومن ثم يكن لدينا حسابياً درجات ثلاثة رئيسية وأربعة فرعية، والثلاث الأولى بين التوغل " التأله مثل أكثر الأنبياء " و" الأولياء " والثلاث الأولى بين التوغل والعدم وهى:
1- حكيم عديم البحث متوغل في التأله، مثل أكثر الأنبياء والأولياء .
2- حكيم إلهى متوغل في البحث عديم التأله، مثل كثير من الفلاسفة .
3- حكيم إلهى متوغل في البحث والتأله، وهذه درجة نادرة لم يبلغها إلا السُّهْرُوَرْدِىّ كما يذكر الشارح.
أما الدرجات الفرعية، فهى تتفاوت بين التوغل والوسط والضعف وهى: .
أ- حكيم إلهى متوسط في البحث متوغل في التأله .
ب- حكيم إلهى متوغل في البحث متوسط في التأله .
ج- حكيم إلهى متوغل في البحث ضعيف في التأله .
كما يصنف السُّهْرُوَرْدِىّ طلاب الحكمة على درجات متفاوتة تقابل درجات الحكماء الثلاث وهى:
- طالب البحث والتأله، وهو يطابق الحكيم الإشراقى المتوغل في البحث والتأله.
- طالب التأله فحسب، وهو يطابق الصوفى عديم البحث المتوغل في التأله .
- طالب البحث فحسب، وهو يطابق الفيلسوف المتوغل في البحث عديم التأله .
والأفضل عند السُّهْرُوَرْدِىّ الحكيم البحاث المتأله، ثم الحكيم المتأله، ثم الحكيم البحاث، يقول السُّهْرُوَرْدِىّ: " وكتابنا هذا يعنى حكمة الإشراق " لطالبى التأله وليس للباحث الذى لم يتأله أو لم يطلب التأله فيه نصيب " .
ويعلق قطب الدين الشيرازى على هذا فيقول: " بأن المتوغل في البحث والتأله له الرياسة، أى رياسة العالم العنصرى لكماله في الحكمتين وإحرازه للشريفين وهو خليفة الله، لأنه أقرب الخالق منه تعالى، وإن لم يتفق أى لندرته وعزته، فالمتوغل في التأله، المتوسط في الباحث لا يسلم من الشك بخلاف الحاصل من التأله، وإن لم يتفق فالحكيم المتوغل في التأله عديم البحث وهو خليفة الله الذى يهدى به صراطاً مستقيماً لا أن يقتله ضلالاً مبيناً فصار وروده ملكة له، بحيث تلحظ النفس متى شاءت من استبيانه ليمكن أن يبنى عليه ما يحتاج إليه من الأحكام هذه أقل الدرجات وأعظمها ان يصل له الملكة الثانية الطامسة وهى آخر المراتب .
د. محمود محمد علي
رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط