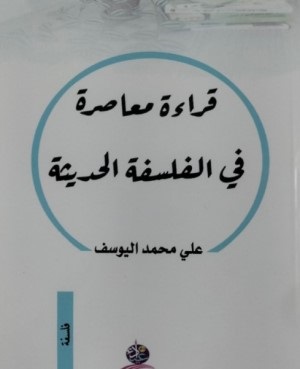قضايا وآراء
الفكتوريون الانكليز والعلم (1)
أهمها وأبعدها تأثيرا النظرية الدارونية، فنجد بفعل ذلك أن علاقة الشاعر بالعلم شهدت هي الأخرى تحولاً كبيرا واتخذت اتجاهاً جديداً لتضع الشاعر في موقف جديد تماماً. فإلى جانب علوم قديمة ومعروفة كعلم الفلك وعلم النبات والفيزياء، ظهرت في العصر الفكتوري علوم جديدة ذات تأثير كبير مثل علم الأرض وعلم الأحياء. والى جانب النظرة الميكانيكية إلى العالم والتي تركت أثرها على مدى قرنين من الزمان، ظهر ذلك الكائن الميكانيكي الذي يجسد هذه النظرة تجسيدا حيا، ألا وهو الآلة.
لقد غير علم الأرض الجديد مثلا نظرة الإنسان إلى مكانته في الكون. ففضلاً عن النظريات الفلكية القديمة عن فضاء واسع لا متناه، أصبح الإنسان الآن يواجه نظرية جديدة عن الزمن وعن الخليقة وأصل الأرض، لتأتي بعد ذلك النظرية التي أثارت القلق الأكبر وهي النظرية التطورية لتشارلز دارون (1809 – 1882) التي تضمنها كتابه الرائد (أصل الأنواع) ( 1859)، لتغير فكرة الإنسان عن نفسه تغييراً جذرياً ولتوجه تحدياً كبيراً إلى معتقداته الأساسية الدينية والأخلاقية. من جهة أخرى كانت الثورة التكنولوجية للعصر الفكتوري حدثاً تاريخياً عظيماً على صعد عديدة كالتصنيع وطرق ووسائل المواصلات. فالمخترعات التكنولوجية الجديدة مثل تعبيد الطرق وشق القنوات وغيرها، ووسائل النقل الجديدة كالسيارة والقاطرة البخارية والمحركات الثابتة والبخارية والكهربائية وغيرها، غيرت شكل العالم المرئي ذاته وطرق العيش فضلاً عن تغييرها نظرة الإنسان إلى الكون والحياة والى نفسه، لكونها كانت كلها جديدة على التجربة البشرية. يوجز المفكر الفكتوري توماس كارلايل هذه الحقيقة في كتابه (علامات العصر) في وقت مبكر من القرن التاسع عشر، أي عام 1829 ، بقوله:
لو طلب منا أن نشخص عصرنا هذا بعبارة معبرة
واحدة فلن نميل إلى تسميته بالعصر البطــولي ولا
الدينـي ولا الفلســـفي ولا الأخلاقي بل الميكانيكي.
انه عصر الماكنة بكل ما في تلك الكلمة من معنى. 1
ارتكزت علاقة الشاعر الفكتوري بالعلم نتيجة لذلك على هذه النظريات الجديدة حول الأرض وعلى النظرية التطورية والتكنولوجيا، فكان عليه أن يواجه القضايا التي أفرزتها تلك التغيرات وان يعبر عنها فيما يكتب من قصائد شعرية وعن موقفه تجاه المشكلات التي تمخض عنها الواقع الجديد.
يعد الشاعر آلفرد لورد تنيسون ( 1809 – 1892 ) اكبر شعراء العصر الفكتوري ومن بين أكثرهم تمثيلاً لموضوعنا الحالي. تعود جذور اهتمام تنيسون بالعلم إلى مثاليته المبكرة وميله نحو الحقيقة العلمية. كان تنيسون متحمساً للعلم ومدركاً لأهميته وأهمية مكتشفاته، مستوعباً لمضامينه التي استخدم الكثير منها في العديد من قصائده كما في قصيدته الكبرى (إحياء الذكرى) (1850) التي كتبها على اثر الموت المفاجئ والمفجع لأعز أصدقائه الأديب الواعد آرثر هالم. تعد (إحياء الذكرى) إحدى أهم قصائد القرن والقصيدة المركزية فيما يخص علاقة الشاعر الفكتوري بالعلم. كتب تنيسون قصيدته هذه قبل ظهور مؤلف دارون (أصل الأنواع) ألا انه كان مطلعاً على كتب باتت شائعة وذات تأثير مثل كتاب (خطاب ابتدائي حول دراسة الفلسفة الطبيعية) (1831) لجون هرشل وكتاب (مبادئ الجيولوجيا) ( 1830 – 1833 ) لتشارلز لايل وكتاب (آثار التاريخ الطبيعي للخليقة) (1844) لروبرت تشيمبرز. لقد تأثر تنيسون تأثراً عميقاً بما تضمنته تلك الكتب من أفكار أُعتقد أنها تقلل من شأن الجنس البشري بضوء ما تطرحه من نظريات تناقض قصة الخليقة التي وردت في الكتاب المقدس، مما جعله يعبر بشيء من الصوفية عن إحساسه بالوحدة واليأس التي فرضتهما عليه النظرة العلمية الجديدة إلى العالم:
أتعثر حيث تطأ قدمي بثبات
وأنوء تحت همومي
على سلم العالم العظيم
الذي ينحدر عبر الظلمة نحو الرب
أمد يدي إيماني المعطوبتين، أمسك
وألمّ التراب وسقط المتاع وأنادي
على من اشعر انه رب الجميع
واثقا ثقة مترددة بالأمل الأكبر. (إحياء الذكرى، المقطع 55 )
تنطلق (إحياء الذكرى) من إمكانية الاعتقاد بوجود العناية الإلهية في عالم تحكمه قوة القوانين الميكانيكية أو الفوضى العبثية التي من دلائلها موت آرثر هالم . وتصبح هذه الموضوعة اشد وطأة في المقاطع التي يعبر فيها الشاعر عن إدراكه للصراع بين الاعتقاد بنظام إلهي وإرادة إلهية وفناء بشري وبين قبوله من جهة أخرى بالحقيقة التي تضمنتها نظريات العصر العلمية والتي تؤكد عدم اكتراث الطبيعة ببني البشر لا كأفراد ولا كنوع:
هل الرب والطبيعة إذاً في صراع
بحيث تعير الطبيعة هكذا أحلام شريرة؟
تبدو حريصة جداً على النوع
ومهملة لحياة الفرد. ( المقطع 55 )
وفي المقطع التالي:
"حريصة جداً على النوع"؟ ولكن لا.
ومن المنحدرات الصخرية الوعرة ومقالع الحجر
تصرخ (الطبيعة): "ألف نوع مضى
لا شيء يهمني، كل شيء سيمضي ..." ( المقطع 56 )
يتذبذب موقف تنيسون في مقاطع قصيدته بين التفاؤل المفرط بالخلود البشري وبين اليأس التام والإحساس الرهيب بظلام وعزلة في عالم عبثي لا معنى له يكون الإنسان فيه مجرد شيء تافه زائل في خضم عملية تحول كائناتي وفريسة لقوى الطبيعة الخفية والقاسية:
وسوف يكون الإنسان
آخر أعمالها، الذي كان يبدو جميلاً
ونصب عينيه الغاية السامية،
هل سيرمى في غبار الصحراء
أو يحبس في تلال حديدية؟ ( المقطع 56 )
في هذه المقاطع ومقاطع أخرى من القصيدة (مثل المقطعين 123 و125) يكشف تنيسون عن قلق وردة فعل اتجاه المكتشفات الجيولوجية ونظرية التطور لعصره. فالطبيعة "ذات الناب والمخلب الأحمرين" كانت بالنسبة له وللعديد من معاصريه مختلفة تماماً عن الطبيعة السابقة التي كانت تشكل بيئة نافعة وجد فيها بنو البشر وطناً ومأوى آمنا.
إلا أن ثمة جانبا ايجابيا في موقف تنيسون من العلم وخصوصاً في تلك اللحظات الصوفية – كما في المقطع (95) من القصيدة وكذلك في القسم الختامي منها – والتي تظهر تفاعلاً بين المشهد العدائي والمرعب الذي ترسمه علوم كعلم الأرض وعلم الإحاثة من جهة، وبين المفهوم الفلكي لـ "الكون الحاضن" من جهة أخرى. أما اليأس الذي زرعته هذه الأفكار العلمية في نفس تنيسون فتقابله تطلعاته المتفائلة إلى مستقبل يظهر فيه عنصر بشري أرقى، "عنصر متوج"، ويقابله أيضا إيمانه المسيحي الذي عبر عنه في تصريحاته الخطابية عالية النبرة في خاتمة القصيدة:
الرب الحي المحب
رب واحد، قانون واحد، جوهر واحد
وحدث الهي بعيد واحد
تسير نحوه الخليقة جمعاء. ( الأبيات 141 – 144 )
إن تفاؤل تنيسون هو انعكاس لموضوعة شائعة في ثقافة القرن التاسع عشر وهي محاولة الكتاب التوفيق بين العلم والمعتقد الديني. فمؤلف هرشل (خطاب ابتدائي)، مثلاً، مبني، شأنه شأن الكثير من المؤلفات، على الاعتقاد القائل بان العلم يظهر لنا "قوتنا وكرامتنا الفطرية" كجنس بشري وذلك من خلال استنفار قدرات وقوى "تشكل... رابطاً بيننا وبين أخيار جنسنا البشري الأفضل والأنبل والذين نتشارك معهم في الأفكار والمشاعر وفي الاكتشافات التي رفعتهم إلى مراتب أعلى من بني جنسهم الفانين وجعلتهم أقرب إلى خالقهم."2 تعبر خاتمة قصيدة تنيسون تعبيراً واضحاً ومؤثراً عن هذه التطلعات.
إن تأملات تنيسون عن نظرية التطور في قصيدته سبقت مؤلف دارون (أصل الأنواع) بتسع سنين مما جعله مهيأ لقبول النظرية على الرغم من اعتراضه الشديد على ما كانت تحمله من مضامين طبيعية. لم تكن فكرة التطور، على أية حال، جديدة تماماً، بل كانت معروفة في القرن الثامن عشر وهي تعود في جذورها إلى زمن الإغريق.3 إلا انه، كما يشير بونامي دوبريه، فمثلما كان لفكرة اتساع الكون تأثير ضئيل على المخيلة حتى جاءت فيزياء نيوتن لتقدم تفسيرها للكون الميكانيكي، كذلك لم يكن تأثير النظرية التطويرية عميقاً حتى جاء دارون ليشرحها.4
دشن مؤلف دارون (أصل الأنواع) ومن بعده مؤلفه الآخر(هبوط الإنسان) ( 1871) طريقة تفكير غير مسبوقة غيرت نظرة الناس إلى الحياة والطبيعة والكون وكان لها مضامين أخلاقية ودينية ولدت مخاوف لدى بعض الناس الذين تكونت لديهم هذه النظرة الجديدة، وولدت آمالا كبارا لدى البعض الآخر. المخاوف عبر عنها احد معاصري دارون الشديدي المعارضة لنظريته التطورية خير تعبير عندما كتب إلى دارون معبراً عن احتجاجه على النظرية على أساس كونها محاولة لتوثيق الصلة بين ما هو مادي من جهة وبين ما هو أخلاقي وديني من جهة أخرى. ثم يستدرك:
لو كان ممكناً ( وهو حمدا الله ليس ممكنا ) تحطيم هذه
الصلة، فان الإنسانية، باعتقادي، ستعاني ضـرراً يزيد
من وحشيتها ويهبط بالجنس البشري إلى حضيض لم
ينحدر إليه قط طوال تاريخه المدون.5
أما الأمل والتفاؤل اللذان رافقا هذه النظريات الجديدة فقد استندا إلى فكرة الكمال البشري والتقدم ويوتوبيات العلم فضـلا عن الفلســفة الوضعية التي طورها الفيلسوف الفرنسي اوغسـت كومته ( 1798 – 1859 ) وروج لها في انكلترة الفيلسوفان جون ستيوارت مل (1806 – 1873 ) وج .هـ. لويس ( 1778 – 1817 ). نجد خير مثال للإيمان المتحمس بالعلم والتقدم في كتاب لويس المعنون (التاريخ الســِيَري للفلسفة) ( 1845 – 1846 ). في القسم الأخير من الكتاب والمعنون (الفلسفة تتخلى أخيرا عن موقعها لصالح العلم الوضعي) ينظر إلى العلم بوصفه في حالة تقدم باتجاه خطي. فخلافا لحركة الفلسفة الدائرية، "يجد العلم نفسه، عاماً بعد عام، بل نكاد إن نقول يوماً بعد يوم، يتقدم خطوة خطوة ... (إلى الإمام، دائماً إلى الإمام، بمزيد من القوة، دائماً بمزيد من القوة تتدحرج أمواج الاكتشاف المدهشة، وأفكار البشر تتسع بفعل مسيرة الشموس).6
من الشيق جداً أن الاقتباس في نهاية عبارة لويس مأخوذ من قصيدة تنيسون المعنونة (لوكسلي هول) (1842). في هذه القصيدة، وهي محاولة للتعبيرعن عواطف وانفعالات نابعة من تجربة حب محبط عانى منها الشاعر، يحاول تنيسون التخفيف من مزاج الاكتئاب والإحباط من خلال الانغماس في حياة نشيطة مكرسة لقضية التقدم الإنساني. يعبر تنيسون عن إيمانه بالتقدم العلمي مشيرا إلى العديد من الاكتشافات التي حصلت في عصره في مجالي علم الفلك والكهربائية:
ليس عبثاً أن يضيء الأفق كالمنارة. إلى الإمام، فلننطلق إلى الإمام
وليدُر العالم الكبير أبدا في أخاديد التغيير المدوية. (الأبيات 181 -182)
إلا أن الشاعر مع ذلك أصيب بخيبة أمل كبيرة تجاه العلم والتقدم العلمي فيما بعد، أي بعد ستين عاما، كما يحدد ذلك في قصيدة تنسج على منوال قصيدة (لوكسلي هول) وضع لها تنيسون عنوان (لوكسلي هول بعد ستين عاما)، فيقول:
لقد ذهبت صيحة "إلى الأمام، إلى الأمام"، ضاعت في خضم ظلام متزايد،
ضاعت، أو إنها لا تسمع إلا بصمت من صمت آت من قبر. (الأبيات 73 – 74)
ويقول في مواضع أخرى من القصيدة إن " التقدم يقف بقدمين مشلولتين" وان "العلم يتزايد والجمال يتضاءل."
----------------------------------------------
هوامش:
Thomas Carlyle, “Signs of the Time” (1829), in Essays, 2, p. 59. Cited in Boris Ford (ed.) The Pelican Guide to English Literature, Vol. 6, From Dickens to Hardy (Baltimore: Penguin Books, 1958), p. 19.
2 John Herschel, A Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy, 1832 edn, pp. 16-17. Cited in Chapple, Science and Literature in the Twentieth Century, p. 71.
3 In Darwin’s grandfather, Erasmus Darwin’s embryonic evolutionary theory which appeared in his long poem The Botanic Garden (1791) and his prose Zoonomia (1794-6)
4 Bonamy Dobrée, The Broken Cistern (London: Cohen and West Ltd., 1954), p. 93.
5 Quoted by Douglas Bush, Science and English Poetry, (Oxford: Oxford University Press, 1967), p. 133.
6 Cited in Walter E. Houghton, The Victorian Frame of Mind (New Haven and London: Yale University Press, 1957), p. 34.
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1362 الجمعة 02/04/2010)