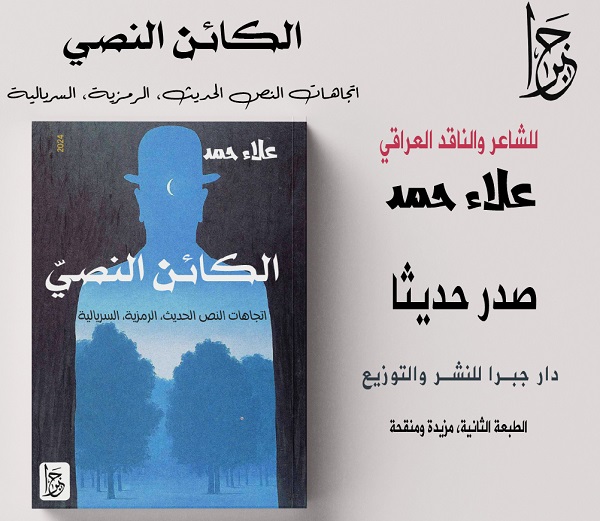قضايا وآراء
قصيدة النثر حقيقة نثرية ثاقبة أم أكذوبة شعرية باهتة
وأمام روادها بل خاضوا معركة شرسة لاثبات وجودهم والتدليل على جدوى هذا الوجود ليغدو حضورا يشار إليه بالبنان، ولا نريد أن نخوض بالتفاصيل المعروفة عن نشوئها ولكن إشكالية قصيدة النثر مرتبطة بالتسمية أولا، شعريتها ثانيا، وأقصد بالشعرية مجموعة القوانين التي تنظم عملها، إن ما يؤاخذ عليها اتكاءها بصورة مزرية وفضولية على الشعر، ومعظم حروبها وعدم تقبل الجمهور لها لحد الآن هو عنادها وإخفاء هويتها بالرغم من أن الكثير من روادها قالوا بأنهم يكتبون شعرا ولكنه بعيدا عن العروض وقوانينه وما يتبعه من إيقاع وموسيقى القوافي، وقالوا إنهم يمكن أن يكتبوا شعرا بعيدا عن العروض وهم يكتفون بالمنظومات البلاغية المعروفة من تشبيهات واستعارة وكناية معززة بالصورة الشعرية وتثوير اللغة واستخدام الايقاع الداخلي وغيرها، ولكن كل هذه التنظيرات لم تستطع إقناع الجمهور العربي الذي لم يستطع تقبل هذه المقولات وهو جمهور متعصب ما انفك يحن للمنبرية ولقصيدة العمود وهوالذي تقبل قصيدة التفعيلة على مضض. وقد أشار الأستاذ الناقد "د.حاتم الصكر" في كتابه الحديث(في غيبوبة الذكرى) إلى بعض الأخطاء التي ارتكبها رواد هذه القصيدة مما نفر منهم الشعراء والجمهور ولكنه بالحقيقة لا يزال يتعامل معها بكونها شعرا وليس نثرا وهو ما لا أتفق معه حوله.
ما يعاب على قصيدة النثر أنها اليوم غدت مركزا طاردا لفنون القول الأخرى وهذا ما لم تكن لتحلم به يوما، وبالتالي فقد كشفت عن وجهها بصورة مزرية مؤكدة ما كان قد قيل بحقها وبالتالي فقد تحققت نبوءة "نازك الملائكة " بشأنها قبل أربعة عقود عندما قالت إن هذا النوع من الكتابة خطير على الشعر وكانت خائفة من إنكفاء الشعر وتحرر الشعراء كليا من العروض العربي، إن الخطورة باتت متمثلة فعلا بانكفاء الشعر وانفضاض الجمهور عنه، كما أن كتابها (أي قصيدة النثر) اليوم أكثر من جمهورها وقرائها، وهذا شيء ليس في صالحها بالمرة، أنا متشائم من مستقبلها فقد لا تعمر طويلا بعد موت روادها أطال الله في عمرهم، وهي بالرغم من أنها غدت قوية ومتكاملة الأدوات وكسرت حتى القوانين التي جاءت بها عرابة القصيدة "سوزان برنار" ألا أنها ما زالت تتمسك برقبة الشعر إلى درجة أنها على وشك أن تغرقه وتغرق نفسها معه، نحن على يقين أن الشعر سينهض عاجلا أو آجلا، وإذا كان الشعر الحر أو التفعيلة على وشك الانقراض بعد نماذج شعرية رائعة للسياب ونازك، فأننا لغاية اليوم لم نقرأ نصا كبيرا لأي شاعر قصيدة نثر بمستوى أنشودة المطر أو النهر والموت أو حتى كوليرا نازك الملائكة، بل نكاد لا نميز بين كتاب قصيدة النثر ذاتهم ولا نجد إلا تعظيما يكيله أحدهم للآخر وكأننا أمام حزب سياسي له رئيس وفيه نظام هرمي يقدم فيه الأعضاء ولاء الطاعة لقادتهم. كما بدأنا نسمع بمؤتمرات خاصة بها وبكتابها مما يؤكد تمركزها وبالتالي إقصائها للشعر العمودي والتفعيلة بالرغم من ادعائها بأنها منتمية للشعر لا للنثر.
لقد أخرجنا هذا المولود الجميل والمدلل من القوانين إلى الفوضى، وقد ضاق عليه الثوب الآن ولا بد له من أن يلبس ثوبا آخر فمزق ثوبه القديم ثوب "بودلير" و "رامبو" متجها إلى ما يعرف بالنص المفتوح، حيث ترك التكثيف والمفارقة والمجانية (اللازمنية) لأنها أصلا تمثل جزءا يسيرا من الشعرية في الشعر ولن تكون الشعر كله بل هي أدوات نثرية في الأصل استعان بها الشعر ليبني إهراماته الخالدة، إن النثر هو نثر ولن يكون شعرا أبدا، مهما نظـّر وقعــّد لنفسه ومهما ألح على الشعر فهو سيبقى له شخصيته وقوانينه البعيدة عن الشعر، على النثر أن يعترف وبكل شجاعة أنه نثر واتجاهه الطبيعي نحو النص المفتوح يدل بدون مواربة أنه نثر ليس إلا، عليه أن يرفع القناع ويرينا وجهه الحقيقي ويقول لنا بكل شجاعة أنا نثر ولست شعرا وعليه أن يطبق البيت الخالد للامام علي بن أبي طالب (ع) حين قال:-
ليس الفتى من قال كان أبي إن الفتى من قال ها أنذا
لن يضير النثر أنه نثر ولن يزيده رفعة إدعاؤه أنه شعر، بل اعترافه سيزيده قوة واطمئنانا، عليه ألا يطرح ذاته بديلا عن فنون القول الأخرى، فالغرور قاتل، عليه ألا يكون الفارس الوحيد أوالقائد الضرورة الذي ابتليت أمتنا به كأي دكتاتور عربي أو فحل شعري، عليه أن يكون نثرا وسيكفيه شرفا ووقارا وحكمة أن يكون نثرا ونثرا فقط، فالشعر لن يكون بأي حال من الأحوال أشرف من النثر وكذلك النثر فهو ليس أشرف حسبا ونسبا من الشعر بل أن جدهما واحد، وجدهما المشترك هو اللغة المنزاحة لا اللغة القاموسية ولكن أميهما مختلفتان (وسيكون صعبا على البعض أن يستسيغ ما أقصده بل ربما سيكون مضحكا لدى البعض الآخر)، ما أريد أن أقوله إن الشعر والنثر هما الذراعان الحارسان للجسد الأدبي، فإذا كان أحدهما يمينا فالآخر سيكون الشمال والعكس صحيح أيضا. وإذا كان الشعر والنثر يساند أحدهما الآخر منذ القدم لأنهما قد شقا طريقين منفصلين ليحتازا شخصيتيهما المتميزتين والمغايرتين، فعليهما ألا يحلقا عاليا ويعتقدان أن أحدهما سيقضي على الآخر، فهذا وهم لن يحدث أبدا.
والآن سيسأل أحدهم إذن ما الشعر؟ وما النثر؟ إذا كان كل منهما يمثل نهرا بذاته، أو هما خطان متوازايان ولن يلتقيا أبدا، يرى العرب أن النثر يعني الكلام ويعني الكتابة أيضا ، ويستعين الأستاذ "زكي مبارك" بمقولة "لبديع الزمان" للادلال على أن النثر يسمى كلاما عند العرب حين قال :- ( البليغ من لم يقصرْ نظمه على نثره، ولم يزرِ كلامه بشعره) (النثر الفني- ص17)
وهذا يعني لديهم أن النثر والكلام واحد والنظم مرتبط بالشعر، كما أن البليغ من يتساوى فيه النظم والنثر سوية ولا يقصر أحدهما دون الآخر، ولارتباط النثر بفنون القول السردية وجدنا في العصر الحديث "رولان بارت" يعرّف الأسطورة بأنها كلام في كتابه أسطوريات، ولا ندري إن كان قد قرأ كتاب زكي مبارك" وهو أصلا منشور بالفرنسية قبل أن يعرّب وينشر في العام 1934 م. "
كان "الثعالبي" يفضل النثر على الشعر ويرى أن الكتـّاب ألسنة الملوك ويتعاملون بجلائل الأمور وهم أكثر منزلة من منزلة الشعراء، وأن الشعر تصوّن عنه الأنبياء والملوك، أما ابن رشيق فقد فضل المنظوم على المنثور لأنه كان يرى اللفظ كالدر فعندما ينظّم تزداد قيمته ولكنه يتشتت عندما ينثر وتتبدد قيمته، ويقول الكاتب المفكر مسكويه:
( فكذلك النظم والنثر يشتركان في الكلام الذي هو جنس لهما، ثم ينفصل النظم عن النثر بفضل الوزن الذي به صار المنظوم منظوما. ولما كان الوزن حلية زائدة وصور فاضلة على النثر صار الشعر أفضل من النثر من جهة الوزن. فإن اعتبرت المعاني كانت المعاني مشتركة بين النظم والنثر. وليس من هذه الجهة تميز أحدهما من الآخر..)
ويرى "أبو هلال العسكري" أن الخطباء والكتاب تتشاكل ألفاظهما من حيث السهولة والعذوبة وكذلك من حيث الفواصل، ويرى أن الخطبة تكون منبرية والرسالة للكتابة أي لكي تكتب ويمكن أن يتحول كل منهما للآخر، ولكن الشعر لا يمكن إحالته للرسالة إلآ بتكلف، وكذلك لا يمكن شعرنة الخطبة والرسالة، وهذا برأينا فهم متطور للكتابة وللشفاهية، فالخطابة والشعر منبريان ولكن الرسالة غير ذلك وكأن الخيط الذي يجمع بين الخطبة والشعر غير متحقق إلا من خلال الرسالة (المكتوبة)، وقد ظن المستشرق الفرنسي" المسيو مرسيه" أن العرب في الجاهلية لم تكن تعرف سوى الخطابة والشعر لكنهم لم يعرفوا النثر لأنه قسّم فنون القول إلى شعر وخطابة ونثر وقد انتقده الأستاذ "زكي مبارك "محقا على تقسيمه الخاطئ ذاك لأن فن الخطابة والرسائل ينطويان تحت يافطة النثر، والعرب كانت تعرف الخطباء الذين يأتون أسواقها في الجاهلية أما الرسائل فليس لها صدى لأنها تتنقل من خلال الرسل بين القبائل متكتمة.
إذن لتعريف كل من النثر والشعر سيكون الجواب مختصرا ولا يتعدى عدة كلمات وبمنتهى التجريد، حيث أن الشعر هو الانزياح الموزون، أما النثر فهو الانزياح الموازن، وهنا سيكون لملفوظ الانزياح دلالاته العميقة والمتنوعة ليكون شموليا، كما أن دلالات ملفوظي موزون و موازن ستكون متعددة أيضا، سيقول لنا أحدهم إن الشعر خارج عن التقنين والقوننة ولن يستوعبه قانون، ونحن نقول بكل بساطة إننا لا نضع القوانين بل ان القوانين موجودة بصورة طبيعية ولا يستطيع أياَ منا الافلات منها والنصوص لها قوانينها واشتراطاتها ولكننا نؤشر القوانين والأنظمة وهذا هو ديدن البشرية منذ الأزل، فالناس مثلا نضع الأسماء للأمكنة ويتعارف بعضهم على البعض الآخر من خلال تلك الأسماء الموضوعة، يعني سيكون مريعا لو كان البشر جميعا أسمهم "زيد مثلا" فإسم واحد يقود للفوضى ولن يعرف أي زيد هو المقصود ويختلط الحابل بالنابل ولكن ملايين الأسماء تخلق نظاما ومعرفة ولا تقود للفوضى ويمكن معرفة كل مسمى باسمه.
وربما سيقول أحدهم إن الشاعر لا يمكن أن يكون سوى ذاته وعليه أن يكتب ما يشاء وبحسب هذه الذات، وعليه أن يكسر ما يجده أمامه من قوانين ومقدسات ،عليه ألا ينصت إلا إلى إيقاعه الداخلي، وهنا نقول له كسّرْ ما شئت ولكن عليك أن تسمي الأشياء بأسمائها وعندما تقول إني أكتب بإيقاعي الخاص، نقول لك كفى ،ها أنك سجنت نفسك ضمن قانونك الخاص وهو قابل لللإنكسار لأن قانون الذات مرتبط بقانون أشمل ينتمي لقانون الكون والكون لا تحكمه الفوضى أوالعشوائية.
ولكن ما الانزياح؟، نقول إنه معنى المعنى الذي جاء به "عبد القاهر الجرجاني" في كتابه" دلائل الاعجاز" ونظريته في النظم، وهو المعنى ذاته الذي قال به(جان كوهن) في كتابه اللغة العليا، وهو يعني المرحلة الثانية من الدلالة التي يحيل عليها الدال، يعني هنالك معنى قاموسي للملفوظ، وهو لا يخلق شعرا ولا يخلق نثرا فنيا ، بل الاستخدام الأعمق (اللغة العليا) هو الذي يولد معنى مغايرا ومنزاحا عن المعنى الأصلي وهذا يتأتى من خلال النظم وبنية التعليق حسب الجرجاني، أو من استخدام المدلول ليكون دالا لمدلول مغاير حسب ما جاء به جان كوهن، وكلا الخيارين تم استخدامهما من قبل الشعر والنثر الفني في نقطة الصفر الخاصة بكل منهما، أي استخدام اللغة استخداما حسيا غير الاستخدام النفعي البراغماتي المرتبط بالحاجات الانسانية، أي أن اللغة الشعرية هي اللغة المرتبطة بالأهواء والأحاسيس لا بالحاجات، وهذه اللغة هي التي نشأت أولا بحسب "جان جاك روسو"، لأن اللغة الأولى حسبما يراه كانت لغة أحاسيس وليست لغة أهواء، وروسو ينظر إلى هذه اللغة بوصفها شعرا، ولكننا ننظر إليها بوصفها نثرا لأنها لم تكن مموسقة، ولكنها عندما تموسقت ووقعت(من الإيقاع) صارت شعرا، الشعر والنثر يستخدمان اللغة العليا ذاتها ولكنهما يتمايزان بوجود الموسيقى في الشعر ضمن القوانين العروضية والتشكيلات الإيقاعية المصاحبة والناتجة جرائها، وكذلك عن طريق قمع الموسيقى والايقاع لتغدو صامتة في النثر، وصامتة هنا تعبير مجازي أي أنها غير موزونة بل موازنة.
يمكن أن نوضح الكلام أعلاه بطريقة أخرى وهي قناعتنا الشخصية ليس إلا، وهي أن اللغة ينتجها الاحساس والعقل، كما أن الاشارة اللغوية تجمع بين الاحساس والعقل عن طريق الدال الصوتي والمدلول الذهني، هنالك شد متبادل بين الدال والمدلول يظهر في الكلام، يعني هنالك تأثير صوتي وتأثير ذهني على الملفوظ، يجعل الاستخدام يتعمق ويتجذر من خلال التراكيب الجملية، عندما يكون التأثير الصوتي(أي الدال اللغوي) هو الغالب يكون الكلام موزونا، وعندما يكون تأثير المعنى(المدلول الذهني) هو الغالب يكون الكلام غير موزون بل موازن، إن لغة الأدب تعني دلال اللغة وجمالها، فقد يكون هذا الدلال راقصا وصادحا لارتباطه بالدال اللغوي الذي يكون متأثرا بقوانين علم الصوت، لينتج الشعر، أو يكون هذا الدلال صامتا وساكتا لأنه يعمل ضمن القوانين الذهنية المرتبطة بالمدلول (المعنى) لينتج النثر، وبالتالي فثنائية الإشارة تقود إلى ثنائية الاستخدام شئنا ذلك أم أبينا، يعني سيبقى هنالك شعردائما وسيبقى دائما هنالك نثر، وهما طريقان للغة يضطر مستخدموها لسلوكهما ، ومن هنا نستطيع أن نفهم الفرق بين الكتابة الموزونة بوصفها شعرا والكتابة الموازنة بوصفها نثرا فنيا.
يقول ابن خلدون في معرض تمييزه بين الفنيين (المقدمة – ص 585):-
إعلم أن لسان العرب وكلامهم على فنين في الشعر المنظوم، وهو الكلام الموزون المقفى ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي واحد وهو القافية. وفي النثر وهو الكلام غير الموزون، وكل واحد من الفنين يشتمل على فنون ومذاهب في الكلام، فأما الشعر فمنه المدح والهجاء والرثاء. وأما النثر فمنه السجع الذي يؤتى به قطعا، ويلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة يسمى سجعا، ومنه المرسل وهوالذي يطلق الكلام إطلاقا ولا يقطع أجزاء، بل يرسل إرسالا من غير تقييد بقافية ولا غيرها ويستعمل في الخطب والدعاء وترغيب الجمهور وترهيبهم .
ويبدو واضحا في أعلاه أن "ابن خلدون" يفرق بين نوعين من النثر ، هما النثر المسجوع والمرسل، ويؤكد أن للنثر أغراضه المغايرة عن أغراض الشعر ويستخدم في الخطب والدعاء وغيرها، ويشير ابن خلدون إلى أن النثر يستخدم في ترغيب وترهيب الجمهور ولا ندري ما المقصود بذلك، أيقصد القوانين والفرمانات التي كان يصدرها الولاة ورجال الدين في ذلك الوقت أم غيرها ، وهنا ربما سيأتي ناثر ويقول لنا هل تريد أن تحيي الشعر بعد أن أمتناه، وهنا سأقول له إذا كان الشعر قد مات فإنه سينبعث من جديد فهي ليست المرة الأولى التي يموت الشعر فيها وينبعث، فالشعر كطائر العنقاء يموت ويبعث من جديد وهذا قدره، ولكن أبشع الأقدار إذا مات على يد أخيه غير الشقيق النثر، ولأنه سينبعث ثانية فأنا أشك بقدرة النثر على إماتة الشعر نهائيا وهو قانون يجب أن يتعلمه كل ناثر عنيد ومكابر. يمكننا التشديد وباختصارشديد، إن درجة صفر اللغة هي غيردرجة صفر الكتابة الأدبية، هنالك زاوية بين اللغتين، وهذه الزاوية مهمة لنشوء لغة الكتابة إبداعيا، وهذه الزاوية هي التي تولد الانزياح والاختلاف بين اللغتين، وكل من الشعر والنثر يشتغل ضمن الخارطة المتعالية لهذه اللغة، ولكن كل من لغة الشعر أو لغة النثر تنتقل إلى نظام إحداثي وإبداعي آخر أكثر تعاليا من هذه اللغة العليا وهنا تتجلى خطورتهما، إننا أمام نظامين متباينين إبداعيا ولكل منهما ديوانه أي هناك ديوان للشعر وآخر للنثر، والقصيد مرتبط بالشعر وبالنظم حصرا، والمنثور مرتبط بالنثر واللامنظوم، ولو تجاوزنا العصر الجاهلي وأطلعنا على كتابات الامام علي في وصف ابتداء خلق السماء والأرض سنقرأ لغة نثرية متعالية ذات قدرة تخيلية بارعة(نهج البلاغة- ص18) :-
أنشأ الخلق إنشاءً، وابتدأه ابتداءً، بلا روية أجالها، ولا تجربةٍ استفادها،ولا حركةٍ أحدثها، ولا همامةِ نفسٍ اضطرب فيها، أحال الأشياء لأوقاتها. ولأم بين مختلفاتها. وغرّز غرائزها وألزمها أشباحها عالما بها قبل ابتدائها محيطا بحدودها وانتهائها. عارفا بقرائنها وأحنائها. ثم أنشأ سبحانه فتْق الأجواء وشقَّ الأرجاء وسكائك الهواء. فأجرى فيها ماءً متلاطما تيارهُ متراكما زخّارهُ. حمله على متن الريح العاصفةِ. والزعزع القاصفةِ. فأمرها بردهِ وسلّطها على شدِّهِ، وقرنها إلى حدّه. الهواءُ من تحتها فتيقٌ، والماء من فوقها دفيقٌ. ثم أنشأ سبحانه ريحاً اعتقم مهبها وأدام مربًّها. وأعصفَ مجراها. وأبعد منشاها. فأمرها بتصفيق الماء الزخّارِ، وإثارةِ موجِ البحار. فمخضتهُ مخض السقاء، وعصفت به عصفها بالفضاء. تردُّ أولهُ إلى آخرهِ، وساجيهِ إلى مائره . حتى عبَّ عبابهُ. ورمى بالزبد ركامهُ فرفعهُ في هواءٍ منفتقٍ. وجوٍّ منفهقٍ . فسوّى منهُ سبعَ سمواتٍ جعل سفلاهن موجا مكفوفاً وعلياهنَّ سقفاً محفوظاً. وسمكا مرفوعا. بغير عمدٍ يدعمُها، ولا دِسارٍ ينْظمُها. ثم زينها بزينة الكواكب، وضياء الثواقب.
نلا حظ من النص أعلاه أنه ينطوي على جمل مكثفة وقصيرة لا يتجاوز طولها الأربع أو الخمس كلمات وينظمها السجع، تتشابه فيه كل جملتين متعاقبتين وتحكم جمله الموازنة. إن النص أعلاه يمثل نموذجا متقدما للنثر العربي لم نستورده من الفرس ولا اليونان، كما تصوره أستاذنا الكبير" طه حسين" أو بعض المستشرقين الفرنسيين، ليس ذلك فقط بل انه يكشف عن تقاليد جمالية متعالية وخيال جامح،
وهنالك رأي للجاحظ مهم وخطير يشير إلى أن ما موجود في تراث الأمم الأخرى من فرس وعجم وهنود موجود أغلبه عند العرب حيث يقول (الحيوان ج1 ص 75):-
( وقد نُقلتُ كتبَ الهند، وتُرجمتُ حكمَ اليونانية، وحُولتُ آداب الفرس، فبعضها ازداد حسنا، وبعضها ما انتقص شيئا؛ ولو حُوّلت حكمة العرب لم يجدوا في معانيها شيئا لم تذكره العجم في كتبهم التي وضعت لمعاشهم وحكمهم، ولبطل ذلك المعجز، وقد نقلت هذه الكتب من أمة إلى أمة ، ومن قرن إلى قرن، ومن لسان إلى لسان حتى انتهت إلينا، وكنا آخر من ورثها ونظر فيها، فقد صح أن الكتب ( أي كتب النثر) أبلغ في تقييد المآثر من الشعر.)
الفرق بين الشعر والنثرالفني هو النظم، ولكن ليس كل ناظم شاعرا ولكن كل شاعر سيكون ناظما بالتأكيد، الناثر هو الذي ينثر القول كما ينثر الفلاح بذوره في الحقل، النثيرة ليست القصيدة ولن تكونها، النظم مرتبط بالشعرومقتصر عليه، لكن النثر مرتبط بالرسالة والخطابة وهو ما لمح له "أبو تمام" حين قال :-
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطبِ
إذن فالنثر ينتمي للخطابة وكذلك لفن كتابة الرسائل كما أسلفنا سابقا، وأبلغ الخطباء هو "قس بن ساعدة الأيادي" حكيم العرب وفصيحهم، وإذا كان النثر ينتمي عموديا (زمانيا) لهذا الموحد الذي كان الرسول (ص) معجبا به أيما إعجاب حتى أنه قال عنه إنه سيبعث لوحده أمة يوم القيامة، فأي شرف ناله النثر عند العرب قبل الاسلام وأية رفعة من يستطيع أن ينسى تلك الكلمات الخالدة التي قالها قس بن ساعدة:-
آيات محكمات، مطر ونبات، وآباء وأمهات، وذاهب وآت. ضوء وظلام، وبر وآثام، ولباس ومركب، ومطعم ومشرب. ونجوم تمور، وبحور لا تغور، وسقف مرفوع، ومهاد موضوع، وليل داج، وسماء ذات أبراج. مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون. أرضوا فأقاموا أم تركوا فناموا
وكذلك قوله:-
أيها الناس ،اسمعوا وعوا، وإذا سمعتم شيئا فانتفعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا. ليل داج، ونهار ساج، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج. ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون؟ أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا هناك فناموا؟ تبا لأرباب الغفلة والأمم الخالية والقرون الماضية.
يا معشر إياد، أين الآباء والاجداد؟ وأين المريض والعواد؟ وأين الفلاعنة الشداد؟ أين من بنى وشيد وزخرف ونجد؟ أين من بغى وطغى، وجمع فأوعى، وقال أنا ربكم الأعلى؟ ألم يكونوا أكثر منكم أموالا، وأطول منكم آجالا؟طحنهم الثرى بكلكله، ومزقهم الدهر بطوله، فتلك عظامهم بالية، وبيوتهم خاوية، عمرتها الذئاب العاوية. كلا بل هو الله الواحد المعبود، ليس بوالد ولا مولود.
يقال إن الرسول الكريم كان قد رآى (قس بن ساعدة) على جمل أحمر، في عكاظ واستمع لخطبته تلك، أي أن الشعراء والخطباء كانوا يحضرون عكاظ معا، وهذا يعني أن الشعر والنثر يحضران معا في أسواق العرب الشهيرة، والمنابر لا تتخلى عن الخطيب وتكتفي بالشاعر فلكل منهما شأنه، ولكل منهما مكانه.
ويقول الجاحظ عن الخطباء
وفي الخطباء من يكون شاعرا ويكون إذا تحدث أو وصف أو احتج بليغا مفوها بينا، وربما كان خطيبا فقط وبيّن اللسان فقط . فمن الخطباء الشعراء الأبيناء الحكماء: قس بن ساعدة الإيادي، والخطباء كثير والشعراء أكثر منهم، ومن يجمع الشعر والخطابة قليل
. وقد نقل الجاحظ عن "عمرو بن العلاء" قوله إن النثر بات أكبر منزلة ورفعة في نهاية العصر الجاهلي حيث نقرأ:-
كان الشاعر في الجاهلية يقدم على الخطيب لفرط حاجتهم إلى الشعر الذي كان يقيد عليهم مآثرهم، ويفخم شأنهم، ويهول على عدوهم ومن غزاهم، ويهيب من فرسانهم ويخوف من كثرة عددهم، ويهابهم شاعر غيرهم فيراقب شاعرهم. فلما كثر الشعر والشعراء، واتخدوا الشعر مكسبة، ورحلوا إلى السوقة، وتسرعوا إلى أعراض الناس، صار الخطيب عندهم فوق الشاعر. ولذلك قال الأول :"الشعر أدنى مروءة السري وأسرى مروءة الدني."
لذلك قلل الشعر من قدر "النابغة الذبياني" لديهم، ولو كان قد ظهر في البداية لكان أكثر رفعة. وقد قلل أيضا من منزلة "النابغة الجعدي" بالرغم من كونه شيخ قبيلته وزعيمها. وهنا نتساءل هل هذه هي من حصيلة الأسباب التي ساهمت في نزول القرآن نثرا أي تأثر الرسول بمنزلة "قس بن ساعدة" وفصاحته فضلا عن علو شأن الخطيب وإنخفاض منزلة الشاعر في نهاية العصر الجاهلي.
النثيرة أو المنثورة بوصفها الحالة المعاصرة في كل زمن للنثر الفني لم تدرّس جيدا ولم يحدث أن قــُعّد لها نظريا وهذا شيء مستغرب بل ومستنكر إذا كان ذلك حقا هو الذي حصل، فتراث كالتراث العربي يغص بالنثر الفني لا نعرف عنه إلا النزر اليسير ولا ندري كيف تطورت النثيرة حتى وصلتنا إلى اليوم حتى أن المستشرقين لم يعترفوا بأن للعرب نثرا فنيا قبل الاسلام، وهم كانوا يعتقدون بوفوده إلينا من الفرس أواليونان بعد الاسلام، وهذا خطأ فاضح تلقفه "طه حسين" وأخذ يدرسه لطلبته، ولكن" زكي مبارك" قد دحض هذا الرأي قائلا لو لم يكن للعرب نثر فني فعلا حسب ما أفتى به المستشرقون، ولو فرضنا جدلا أن كل ما وردنا من نثر قبل الاسلام منحولا ومنها خطبة" قس بن ساعدة" ، إذن كيف نزل القرآن نثرا وتقبلته العرب ألا يعني ذلك أن للعرب تقاليد نثرية ناضجة ومتطورة ساعدتهم بأن يفهموا ويتذوقوا ما قد جاء في القرآن من نصوص في مستوياتها النثرية من سجع وجناس وطباق وموازنة وتورية وغيرها من البديع، بالطبع هذا لم يستطع دفعه المستشرقون أما الدكتور" طه حسين" فعندما أسقط في يده خرج بمقولة مائعة ورجراجة هي أن القرآن ليس شعرا ولا نثرا إنما هو قرآن وهو ما ينطبق عليه القول (قد فسر الماء بعد الجهد بالماء). وهنا لا بد من إيراد رأي ابن خلدون حول القرآن الكريم حين قال(المقدمة –ص586):-
(أما القرآن وإن كان من المنثور إلا أنه خارج عن الوصفين وليس يسمى مرسلا مطلقا ولا مسجعا. بل تفصيل آيات ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها. ثم يعاد الكلام في الآية الأخرى بعدها. ويثنى من غير التزام حرف يكون سجعا ولا قافية وتسمى أخر الآيات فواصل إذ ليست أسجاعا ولا التزم فيها ما يلتزم في السجع، ولا هي أيضا قواف.)
وهذا يعني أن "ابن خلدون" عكس "طه حسين" يقر أن القرآن نثرا لكنه لم يلتزم فيه قوانين النثر المتعارف عليها عند العرب أي أنه لم يكن نثرا مرسلا ولا مسجوعا لذا أطلقت على آياته اسم المثاني. وهذا يقودنا للقول إن الرأي الأنضج والمسلم به هو أن العرب كانت لهم نصوص نثرية من خطب ومراسلات ولكنها ضاعت لضعف وسائل التدوين أولا وعدم اهتمام العرب بتدوين نثرهم كما أن الشفاهية لم تكن بقادرة على نقل هذه النصوص لصعوبة حفظها عكس الشعر فموازينه وقوافيه كانت سهلة الحفظ على العربي من النثر.
ولكي لا نظلم الباحثين العرب فإنه يجب الاقرار بأنهم لم يذكروا الشعر إلا والنثر معه، ولكن نجد بعض الباحثين يذكرون عن الشعر أنه قد تم الاهتمام نقديا به على حساب النثر، فلو حدث فيه أي تغيير أو أي تجديد في مستوى القصيدة تقوم الدنيا ولا تقعد، بالتالي فنحن نعرف قائمة طويلة من الشعراء العرب المجددين والمثقفين، من أمثال بشار وأبو نؤاس وأبو تمام وابن المعتز والمتنبي والسياب ونازك، ولكننا لا نكاد نعرف ناثرا مجددا واحدا منذ عبد الحميد الكاتب لحد اليوم، وبالتأكيد لو درس المنثور العربي ابتداء من "قس بن ساعدة" مرورا "بعبد الحميد الكاتب" ثم "ابن العميد" و "التوحيدي" وانتهاء بجبران وميخائيل نعيمة ومحمد فارس الشدياق وصولا إلى أدونيس وأنسي الحاج والماغوط وسركون بولص لوجدنا فيه مكامن وأسرار قد لا نجدها حتى عند الأمم الأخرى أو على الأقل توازي ما كان عندهم، وقد نبه لهذه الحقيقة (حقيقة تغافل النقد عن النثر)الأستاذ زكي مبارك حين قال:-
(والنثر مهما احتفل أصحابه باتقانه وتجويده لم ينل من أنفس النقاد منزلة الشعر.لذلك قلت العناية بتقييد أوابده والنص على ما فيه من ضروب الابداع والابتكار أو دلائل الضعف والجمود ،وليس في العربية كتاب منثور شغل به النقاد غير القرآن).(النثر الفني- ص 17) .
ولكن يبدو أن المفارقة حدثت في العصر الحديث عندما قال الناثرون بأنهم يكتبون نثرهم شعرا، عندها تهافت عليهم النقد ، وكأن تغييرتسمية نثيرة النثر إلى قصيدة النثر قد رفعت اللعنة عنه وفتحت الأبواب المغلقة أمامه، وبات لزاما أن يتناوله النقاد بوصفه شعرا وليس نثرا، وهنا هي مأساة النثر الحقيقية فقد أطلقت الكذبة وانطلت على الجميع حيث أقتنع الكتبة والنقاد والقراء أن ما ينشر هو شعر وليس نثرا فأي جريمة ارتكبت بحق النثر وكذلك بحق الشعر .
إن أسوأ الناثرين حظا وأعظمهم شأنا هو الفيلسوف "أبو حيان التوحيدي" ،فلقد هـُمـِّش وظلم في حياته ولم ينصفه أحد في عصره، وبالطبع هذا هو حال المبدعين العرب في كل زمكان عربي بائس، حتى وصل به الأمر في أواخر حياته إلى أن يحرق كتبه، عاش ومات وحيدا حتى قال عن وحدته تلك:
(فلقد فقدت كل مؤنس وصاحب، ومرافق ومشفق، ووالله لربما صليت في الجامع، فلا أرى جنبي من يصلي معي، فإن اتفق فبقال أو عصار، أو نداف أو قصاب، ومن إذا وقف إلى جانبي أسدرني بصنانه، وأسكرني بنتنه، فقد أمسيت غريب الحال، غريب اللفظ، غريب النحلة، غريب الخلق، مستأنساً بالوحشة، قانعاً بالوحدة، معتاداً للصمت، ملازماً للحيرة، محتملاً للأذى، يائساً من جميع من ترى).
ومن مقابساته حول كون العلم حياة الحي في حياته نقرأ (المقابسات- ص 201):-
العلم قوام المعقول، والعمل قوام المحسوس، ولولا المحسّ لاستغنى عن العمل، لأن العمل إنما هو رياضة النفسين اللتين تعاندان النفس الناطقة، أعني الشهوية والغاضبة، فأما العلم فهو كله تقديس المعقول بالعقل والتشوق إليه، وطلب الاتصال به، والغرق في بحره، والوصول إلى وحدته، والعمل مقوم للقوى التي تريع كثيرا بالزيادة والنقصان، وبالخمود والهيجان، والعلم مبلغ إلى الغاية التي لا مطلوب ورائها، والعمل مهيئ لك نحو المسلك إلى سعادتك، والعلم مشرق بك على سعادتك والعمل يوصل، والعلم موصول، والعمل حق عليك لا بد من أدائه، والعلم حق لك لا بد من اقتضائه، والعلم كله نور وأنوره ما أضاءك وسطع عليك وأسفر بك وجلاّ عن حقيقتك ، وتحلى بعقيدتك ونحّى قشورك عنك، وأبرز لبك منك، وصقلك وصفاك وزينك، وأبهجك ونورك، وأهـّلكَ لدرِّك حدِّك، وأحلّك لدر كرامتك وقرارك، وصار ألصق بك من شعارك ودثارك، هناك تبقى ولا تبلى، وتغنى ولا تضنى، هناك الواصل والموصول، والعالم والمعلوم، والعاقل والمعقول، في فضاء الوحدة، ومغاني القدس، وخطة الراحة، ومراد الطمأنينة، والجدة والثقة والسكينة، وعرصة إلهية لا تفرقة ولا تمييز، ولا كثرة ولا اختلاط، ولا تمازج ولا اختلاف؛ حال تجل عن أمارات الحال، وأمر يلطف عن رسوم الأمر، على هذا سكبت العبرات، وطالت الزفرات، أتظن أن الرقيّ في سلاليم المعرفة، والتناهي في غايات التوحيد، هين سهل، وقريب ممكن؟ هيهات أن يكون ذلك كذلك، ولكن لواحد بعد واحد، يخص به الواحد، في عالم بعد عالم، وفي دور بعد دور.
وبالرغم من أن "التوحيدي" يشرح ويفسر ولكنه يستخدم لغة نثرية راقية وملهمة تفيض إشراقا ورؤيا، وهل نجد في نصوص قصيدة النثر الحديثة ما يشاكل هذه اللغة الباهرة، لغة معافة وعميقة ومرسلة حينا مسجوعة حينا آخر، التوحيدي يتكلم عن العلم مستخدما نثرا فنيا ملهما يهز القارئ من الأعماق وهو ما لانجده في كثير من نصوص قصيدة النثر المعاقة لغويا والمريضة إشراقيا ورؤيويا،
وهنا لا بد أن نشير إلى ما قاله" أنسي الحاج" في مقدمة ديوانه (لن) مبشرا بقصيدة النثر ومتسائلا سؤاله الغريب (هل يمكن أن يخرج من النثر قصيدة؟) ونحن نسأله بعد أربعين عاما من ولادة ما يسمى قصيدة النثر هل هناك شعر في قصيدة النثر، فالذين سألوا سؤالنا اتهموا بالرجعية واتهموا بأنهم سد وعائق يكبح جماح الشعراء من تطوير أدواتهم وكتابة القصيدة التي لا ينتظرها أحد، وهو ما جاء في قول أنسي الحاج في مقدمة ديوانه (لن):-
(أي نهضة؟ نهضة العقل، الحس، الوجدان. ألف عام من الضغط، ألف عام ونحن عبيد وجهلاء وسطحيون. لكي يتم لنا خلاص علينا- يا للواجب المسكر!- أن نقف أمام هذا السد، ونبجه.
بين القارئ الرجعي والشاعر الرجعي حلف مصيري. هناك إنسان عربي غالب يرفض النهضة والتحرر النفسي والفكري من الإهتراء والعفن، وإنسان عربي أقلية يرفض الرجعة والخمول والتعصب الديني والعنصري، ويجد نفسه بين محيطيه غريبا، مقاتلا، ضحية الإرهاب وسيطرة الجهل وغوغائية "النخبة" والرعاع على السواء. لدى هذا التشبث بالتراث "الرسمي" ووسط نار الرجعة المندلعة، الصارخة، الضاربة في البلاد العربية والمدارس العربية والكتاب العرب، أمام أمواج السم التي تغرق كل محاولة خروج، وتكسر كل محاولة لكسر هذه الأطواق العريقة لجذور في السخف، أمام بعث روح التعصب والانغلاق بعثا منظما شاملا، هل يمكن محاولة أدبية طرية أن تتنفس؟ إنني أجيب: كلا، إن أمام هذه المحاولة مكانين، فأما الاختناق أو الجنون. بالجنون ينتصر المتمرد ويفسح المجال لصوته كي يسمع. ينبغي أن يقف في الشارع ويشتم بصوت عال، يلعن، وينبئ. هذه البلاد، وكل بلاد متعصبة لرجعتها وجهلها، لا تقاوم إلا بالجنون. حتى تقف أي محاولة انتفاضية في وجه الذين يقاتلونها بأسلحة سياسية وعنصرية ومذهبية، وفي وجه العبيد بالغريزة والعادة، لا تجدي غير الصراحة المطلقة، ونهب المسافات، والتعزيل المحموم، الهسترة المستميتة. على المحاولين، ليبجوا الألف عام، الهدم والهدم والهدم، إثارة الفضيحة والغضب والحقد؛ وقد يتعرضون للاغتيال، لكنهم يكونون قد لفظوا حقيقتهم على هذه القوافل التي تعيش لتتوارث الانحطاط، وها هي اليوم تطمح إلى تكريس الانحطاط وتمليكه على العالم.
أول الواجبات التدمير. الخلق الشعري الصافي سيتعطل أمره في هذا الجو العاصف، لكن لا بد. حتى يستريح لمتمرد إلى الخلق، لا يمكنه أن يقطن بركانا، سوف يضيع وقتا كثيرا، لكن التخريب حيوي ومقدس)
لا شك أن هذا الكلام الثوري أعلاه لم تكن له حاجة لو قال" أنسي الحاج" أن ما يكتبه نثرا، وأنه سليل الكتاب العظام من أمثال قس بن ساعدة وعبد الحميد الكاتب والتوحيدي والنفري وجبران وميخائيل نعيمة والشدياق ومحمد عبدة، ولكنه أن يأتي ويقول لنا أنا مجدد شعري وأمشي على خطى أبو نؤاس وأبوتمام والمتنبي وشوقي والجواهري والسياب ونازك، يبدو لي أن هذا الكلام سيمجه أي عاقل وسيكون قولا غير مقنع لنا أن نرضاه لمجرد أن بودلير ورامبو فعلا ذلك.
ولا شك أن أدونيس كان محقا عندما وجد لما يسمى بقصيدة النثر جذورا في النثر العربي وفي كتابات النفري وابن عربي، لأن هذا هو الصحيح وما يسمى بقصيدة النثر لا ينتمي للشعر بل هو منتم للنثر الفني والصوفي لغة ورؤيا ومن هنا تتأتى أهميته وليس من اتكائه على الشعر، ولكن يبدو أن أدونيس لم يكن مستعدا للتفريق بين النثر والشعر حيث كان يرى أن كلا منهما لباس للشعر وليس جسده الأصلي (الشعرية العربية – ص 94 ) حين قال:-
إن هؤلاء لا يؤكدون على جسد الشعر، بل بشكله الوزني أو النثري. غير أن الشعر لا يحدد بالوزن، وهو كذلك لا يحدد بالنثر، إن استخدام الشكل الوزني كمثل استخدام الشكل النثري لا يحقق بحد ذاته الشعرية ولا الشعر، ونعرف كتابة بالوزن لا شعر فيها، كذلك نعرف اليوم كتابة بالنثر لا شعر فيها.
بالطبع يتكلم أدونيس هنا عن التعريف الأولي لكل من الشعر والنثر وهما في درجة صفر اللغة وليس في درجة صفر الكتابة الأدبية، ومن هنا يظهر جدوى اختلافنا معه، نحن نتكلم عن الكلام المزاح وليس عن المعنى القاموسي ، نحن نتكلم عن معنى المعنى وليس عن ألفية ابن مالك أو عن الرسائل والاستخدام النثري للكلام في الشؤون العامة، يعني أن كلام أدونيس أعلاه يدور في فلك التعاريف القديمة لكل من الشعر(بوصفه لغة موزونة) والنثر بوصفه (لغة غير موزونة) ونحن لا نتكلم عن هذا بل نتكلم عن الكلام الأدبي عندما يستخدم اللغة المزاحة ليكون شعرا (حين يتجه لجماليات الصوت في الدال) وكذلك عن النثر الفني حينما يستخدم اللغة المزاحة ليكون نثرا فنيا متعاليا(حين يتجه لجماليات المعنى ذهنيا المتركزة في المدلول).
لنقرأ هذا النثيرة لأدونيس(تنبأ أيها الأعمى- ص54) حين يقول:-
هي ذي أكوانٌ
تدخل في ثقوب الإبر التي تخيط ثياب النوافذ-
فيهن سفنٌ وأعناق أيائل
فيهن صهوات،علــوْتُ إحداهن
وهززت نخيل المسافات
لم أعرف لماذا كانت تلك النافذة تبكي
مع أنني رأيتُ الفضاء يقدم لها منديله الأزرق
وتروي هذه النافذة
أن القمر في الحمراء يصنع الأعاجيب
عندما يتغطى بالغيم
نوافذ كمثل بحيرات
لا تتسع إلا لمراكب الحلم
نوافذ ـ أقراط في آذان النجوم.
الفراغ لفظة لا تليق بأبجدية الحمراء
يبدو لي أن هذه النثيرة لو كانت موزونة لفقدت الكثير من جمالياتها وقوتها المستمدة من النثر حصرا، وهي تحتاز وجودها الأدبي والفني بكونها نثرا وليست شعرا، وانتمائها لقوة المدلول لا لقوة الدال، وهذا الكلام ينطبق أيضا على هذه النثيرة الصوفية للنفري (المواقف والمخاطبات – ص51 ):-
أوقفني وقال لي إن عبدتني لأجل شيء أشركت بي
وقال لي كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة
وقال لي العبارة سترٌ فكيف ما ندبت اليه
وقال لي إذا لم أسو وصفك وقلبك إلا على رؤيتي فما تصنع بالمسئلة، أتسألني أن أسفر وقد أسفرت أم تسألني أن أحتجب فإلى من تفيض.
وقال لي اذا رأيتني لم يبق لك إلا مسئلتان تسألني في غيبتي حفظك على رؤيتي وتسألني في الرؤية أن تقول للشيء كن فيكون.
وقال لي لا ثالثة لهما إلا من العدو.
وقال لي أبحتك قصد مسئألتي في غيبتي وحرمت عليك مسئلتي مع رؤيتي في حال رؤيتي
وقال لي إن كنت حاسبا فاحسب الرؤية من الغيبة فأيهما غلبت حكّمه في المسئلة
وقال لي إذا لم أغب في أكلك قطعتك عن السعي له، وإذا لم أغبْ في نومك لم أغبْ في يقظتك. إن النص أعلاه لو قلنا عنه إنه شعر سيكون مهينا لكل من الشعر والنثر، ولو كتب بصورة موزونة سيتحول لكلام عادي، جماله أنه نثر وليس شعرا، أما أن يقال لنا إنه طريقة أخرى لكتابة الشعر نثرا فسيكون كلاما مريعا يفقدنا حتى متعة التلقي بوصفنا قراء نقرأ الجمال في مكامنه الطبيعية، فليس من الضروري أن نقول إن هذه البرتقالة تفاحة صفراء كي نحس بطعمها اللذيذ فالتفاحة هي تفاحة والبرتقالة هي برتقالة ولكل منهما طعمه الخاص بالرغم من كونهما ينتميان لصنف الفاكهة الذي يضم الكثير من الأصناف.
لا يضير الناثر الحديث أن ينتمي لميخائيل نعيمة عندما يقول:-
ربي ما فتئت تقرع بابي حتى فتحت لك، وكان بيتي بغير ترتيب، فيه الغبار وفيه العناكب، فما أنفت من الدخول، ولا أنّبت ، ولا صبغت وجنتي بحمرة الخجل منك. وهأنذا منذ دخلت بيتي دائب في تنظيفه وترتيبه. والغريب أنني ما بقيت أذكر زمانا كنت فيه وحدي؛ فكأنك كنت دائما معي وداخل بيتي
أو لما قاله جبران خليل جبران:-
(أيها الكون العاقل المحجوب بظواهر الكائنات، الموجود بالكائنات وفي الكائنات وللكائنات! أنت تسمعني لأنك حاضري ذاتي. وإنك تراني لأنك بصيرة كل شئ حي. ألق في روحي بذرة من بذور كلمتك، لتنبت قصبة في غابتك، وتعطي ثمرا من أثمارك. آمين)
في نهاية مبحثنا نعتقد أن مسمى قصيدة النثر مسمى غير واقعي ويسبب إرباكا يفقدنا متعة تلقيها، وهي أرقى ما وصل إليه فن النثر في العصر الحديث، وأعتقد أن نصوص أدونيس النثرية تمثل قمة ما وصل إليه هذا الفن الرفيع، إنها منتمية للنثر جسدا وثوبا، ولا يربطها بالشعر أي شيء سوى انتمائهما معا لفنون القول بوصفهما فنيين راقيين مختلفين أداء ونكهة وتقنية، كما أننا نعتقد أننا بحاجة لأن نهتم بالنثر نقديا بوصفه نثرا وليس شعرا ودراسته تقنيا والكشف عن مكامن جماله ، علينا أن نكون منصفين مع النثر لكي لا يشعر بالغبن كاهتمامنا بالشعر والعناية به ووضع رموزه في المكانة التي يستحقونها، والمبادرة الأولى بيد كتاب النثر حيث نتمنى عليهم أن يقروا أن ما يكتبونه نثرا وليس شعرا وبالتالي يفكون ارتباطهم الواهن بالشعر كي يستطيع النقاد التعامل مع ما يكتبونه ضمن الجماليات النثرية وقوانينها القارة المعروفة التي نظمت كتابة النثر العربي من بداية نشوئه لحد الآن، إن هكذا اعتراف سيجعل من النثر والشعر يتعايشان معا ويتعاضدان بدون الاعتداء على حقوق أي منهما وعدم تهميش أحدهما على حساب الآخر إذ إن فقدان أحدهما سيكون خسارة كبيرة لأية لغة وأمة وخصوصا أمتنا بوصفها أمة ذات تقاليد عريقة في كتابة كلا الفنيين منذ آلاف السنين.
ذياب شاهين/أبو ظبي
الإثنين، 12 نيسان، 2010
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1382 الخميس 22/04/2010)