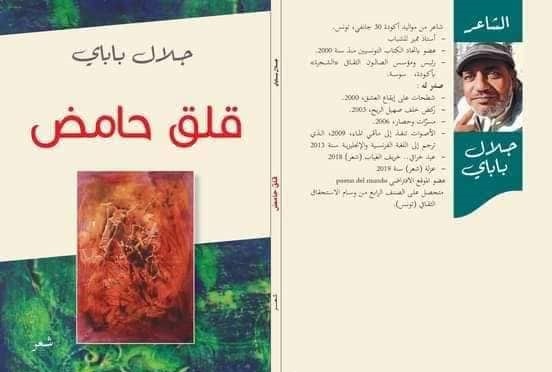قضايا وآراء
(أوراق جبلية) لـزهيـر الجـزائري .. تجربة ذاتية وكوابيس / جاسم العايف
عند التحاقه بفصائل (الأنصار) في كردستان / العراق /، ونزعة رواية التجربة، بعد معايشتها ومعاينتها بكل التباساتها وخساراتها ودمويتها، وفحصها، من وجهة نظره، ومن ثم تدوين مجرياتها، التي يرى (الجزائري)، انه لابد من سردها لتكون شهادة موثقة لزمن كان فيه مشاركاً ومراقباً وشاهداً على عقودٍ دامية من حياة العراقيين. إن بين أدب السيرة الذاتية والتاريخ صلة وثيقة،لأنها تُصور مختلف البيئات، وأحداثها المعززة بالوقائع والأحلام والرؤى، وكذلك الحالات النفسية. لذا يتميز هذا الجنس بان مادته التجربة الحياتية المرتبطة بالسيرة الشخصية، فللكاتب سيرته الذاتية وتجربته التي يروي فيها مرحلة ما في حياته، وقد سردها (الجزائري )بلغة أدبية، ذات الاتجاه والمنحى التوثيقي. ولكن،السارد/ الراوي الذي هو الجزائري/ بالضرورة/ وفي أوراقه التي هي بمثابة / اليوميات / ومشاركته الفعلية فيها، وقدم الأشخاص المرافقين لتجربته بمثابة (الملائكة) المطهرة من كل آثام أو أنانية أو أحقاد أو منافع ومشاكسات ينطوي عليها الأشخاص وفي تلك الظروف اليومية الصعبة المحيطة بهم . لأن السارد/ الجزائري/ كان في توجهه الكتابي – السياسي يمثل صوت وصورة المحيطين به، والمشاركين معه في الإعراب عن وجهة نظره، لذا أبعدهم عن كل ما سبق." وفي الظن أن هذا الجانب، أسهم على نحو ما، في تقليل فرص التنويع على المنظورات الإدراكية وأفقد السرد (اليومي) مرونة التحرك بين المواقع المتبدلة للأصوات أو الشخصيات المشاركة. ربما يتطلب فن محاكاة الواقع، المرتبط بالمكان والزمن الراهن، هكذا نوع من الخطاب، انه لصيق حدث يجعل قدرة التحكم بباطنية إشارته وتضاربها صعب التحقق"- د. فاطمة المحسن. في تلك العقود، وما حصل فيها لم تكن القسوة / بحدها الأقصى/ نتاجاً عرضياً لعقاب،بل كانت تلك القسوة المترافقة بالبشاعة مطلوبةً (سلطوياً) وقد كان تصميمها وصورتها وتنفيذها كامناً في خيال صاحب القرار، وبما إن الوسائل متوفرة، فأوقات التنفيذ وأشكاله تتوقف على القرارات من الأعلى، ولا تقتضي هذه القرارات حججاً، وغالباً ما تجد السبيل للتنفيذ، ومُهيئاً بعد إصدار الأوامر. فالعقاب جاهز قبل التيقن من ذلك، انه إنهاء نشاط ووجود ما يسمى بمنطق السلطة الغاشم،دائماً، التي توصفه وتدمغه بـ (المُخربين)، حسب منطقها، ويعني ذلك واقعياً، تحويل الأرض في بعض مناطق كردستان إلى فراغٍ خالٍ من البشر، ومحيط مسموم وملوث بما يمكن ويقود لان يقضي على الحياة والطبيعة في تلك الأرض، أي حياة كانت، سواء كانت حياة الإنسان والحيوان والأشجار. انه أمر واضح وقرار لا تراجع عنه لسلطة تقاتل حتى الأشباح، لغرض ديمومتها واستمرارها في منهجها، والذي يعني في توجهها النسقي والعمودي (كل شيء عدو) طالما لا ينسجم معها وتوجهاتها ويغدو أليفاً وطيعاً في حظيرتها. أذن في عرفها لابد من (الفناء) لكل ما تتصوره أوتراه أو يكمن في مخيالها، بصفته (عدو) ويجب إفنائه تماماً، ولا يمكن ولا يجوز في عرِفها التحاور معه. فهذا الـ(كل شيء) لا يقع (هناك) الذي هو (المجرد) بل انه الـ(هناك) المشخص العيني، انه الـ(هناك) المعادي/ العدو/ لها بالضرورة. يبدأ (الجزائري) كتابه من خلال عودته إلى أوراقه القديمة، والتي يعيد كتابتها،أو ينقحها ويضيف إليها، بعد أكثر من عشرين عاماً على صدورها عن دار نشر (جبلية وهمية) اختفت من الوجود تماماً، وهو يؤكد انه لا يملك نسخة واحدة منها، حتى أهداه احد رفاق الجبل النسخة الوحيدة والتي احتفظ بها لمواجهة الإنكار؟. تُرى إنكار مَنْ؟ أهو إنكار الزمن وجهل التاريخ أو الحاضر بالوقائع والحيوات الماضية؟. أم الأجيال الشابة التي لم تفتح عينيها على تلك الوقائع القاسية، ولا تهتم بها، لهذا يستعيد (الجزائري) هذه الأوراق لإعادة طرحها للجيل الذي لا يعرف، وربما لا يريد أن يعرف، عن الماضي وآثامه وانتصاراته أو هزائمه، وأفراحه وأحزانه ونكوصه وخسائره الفادحة المتواصلة، ولا يهمه ذلك الماضي، كما في موقف مرافقته الشابة، في مدينة السليمانية، التي لم تهتم بما أسَرها به عن مرافقته للبيشمركة، ومعرفته هذه الجبال وحياته فيها ثلاث سنوات!؟ ولم تتوقف تلك الشابة أمام هذه المعلومة وتسأله عن تلك السنوات، حتى : لماذا.. وكيفَ..!؟. بل تركته وحيداً مخذولاً، لتدخل إلى محلٍ يبيع أقراص الأغاني والموسيقى الحديثة، وبعد خروجها تعلن له: إن أغاني البيشمركه عن شهدائهم تأتي في الدرجة العاشرة من اهتمام الأجيال الجديدة !!. إنهم مشغولين بأغاني نانسي عجرم واليسا وكاظم الساهر. فالماضي لاعلاقة لهم به، والدماء التي أريقت خلاله، لم تعد ساخنة ولامعة بل جافة،أو إنها ليست سوى ماء مبدد ويبدو لا قيمة له الآن..!؟. و(الجزائري) يعيد كتابة هذه الأوراق ليثَبتَ ذاك التاريخ، بوجه النسيان، فمن ينسى الماضي محكوم عليه بتكراره حسب ما يقوله"جورج سانتايانا". كما انه يكتبه ويوثقه للذين قاتل معهم السلطة، وصاروا رجال السلطة البديلة، وما أن يدخل دوائرهم ومؤسساتهم، يخرجون له من وراء طاولات السلطة وبذخها بالبدلات الرسمية المزررة ومعها ربطات العنق المستوردة، وهم يقعون في منطقة حائرة بين الود والابتسام من لقاء التضاد هذا، وبين الواقع الذي يفرضه الموقع (الرسمي) الجديد !؟. إنهم يمدون أيديهم وكأنهم يعلنون الحرج والاعتذار لـ(تغيرهم الضروري)، حيث ربما خَذلوا بمواقعهم الحالية، والدهم (الجبل) الذي بقي مكانه بينما غادره الأبناء ليكونوا: أبناء لسلطة حاربوها، ثم استبدلوها!؟. ولكن هل عمدوا لقتل أباهم (الجبل) في مواقعهم الحالية؟. أم كانوا أوفياء لكرمه الذي منحهم الجاه والشهرة، ونعيم السلطة، وقسوتها كذلك، فلا سلطة أبداً بلا قوة وقسوة، وبلا ضحايا.. وضحايا لعل الزمن القادم، سيثبت أنهم كانوا أبرياء، لكن بعد فوات الأوان. كما انه يعيد كتابته للذين دوت القذائف في آذانهم ولعلع الرصاص قربهم وترك جروحاً أو عوقاً على أجسادهم، ومزق أرواحهم معنوياً، وبعضهم بات جثثاً غرقى محنطة في متاهات الثلوج إلى الأبد، ولتلك (المدن الفاضلة) ومعها حشد من شهداء وأعزاء مفقودين، لم تُعَرف مصائرهم حتى اللحظة !؟.أنه خطاب للذين اجتازوا المحنة، وكأنه يطالبهم بعدم النسيان، وجمع بيانات الضحايا، لأن الماضي بات ذكرى، وان كل الضحايا كانوا بشراً لهم أسماء وقسمات وآمال وتطلعات. ولعل لا أحد فكر، مجرد جمع بياناتهم !؟. يستدعي (الجزائري) محطات الحدود التي يأتي إليها المقاتلون من كردستان،جرحى، مرضى، مجازين، وهاربين من جحيم الحياة في وطن اسمه رسمياً (العراق) وكم خذل هذا (العراق) الأبناء بتحولاته القاسية الصاخبة والعنيفة والمريرة، وبما يتجاوز حتى الزلزال، طوال تاريخه الموغل في القدم. هناك في (محطات الحدود) يحدث ما يشبه العمل في (المسرح)،عند تبادل الأدوار، الصاعدون للجبل يتركون القمصان المنقطة المخططة والأحذية الحديثة اللامعة، ويرتدون ما يتركه النازلون منه. يلتقط (الجزائري) من بوابات منزل في إحدى القرى الكردية المحترقة، نداء الاستغاثة الذي يوثقه المجهول، صورة وشخصاً، والمعلوم اسماً فقط، وساقه قدره المتلبس بواجب (خدمة العلم الإلزامية) التي لا تنتهي ولا حد أو حدود زمنية لها.انه يحفر على البوابة الخشبية لذلك البيت المحترق، ما يلي:"تذكروا الجندي المكلف..علي الساعدي- من العمارة..!". ويواصل الحفر لمغالبة النسيان:"علي الساعدي- بارزان 1978". ويعود ليعلن ثانية، وبما يشبه الصراخ : "هنا عاش الجندي المكلف علي الساعدي..". ويَصّر على مواصلة الإجهار عن ذاته المحترقة أيضاً:" تذكروا علي السا...!". دون أن يكمل كتابته.. التي فيها وعبرها صار معلوماً، أو ضحية بقسمات مجهولةٍ..و لم يكّشفَ شيئاً ابعد من هذا، ولم يُعرف لمن وجه خطابه،معلناً فيه عن اسمٍ ومدينةٍ ولد فيها،ونائية عنه وعن مكانه الحالي، ولم يذكر أو يبرر، لماذا لم يكمل لقبه ثانيةً..!؟. ربما مزقت حياته وأحلامه وتطلعاته، رصاصة ما، دون أن يعلمَ مُطلقها، أن الفتى (على السا...) هذا، يغالب قهر السلطة التي ستقوده لمحارق الفناء، ومعه أجيالاً كاملة ومتعاقبة من شباب العراق، وهو بهذا الإعلان عن اسمه ولقبه كاملاً تارةً، وناقصاً تارةً أخرى، ينتصر على محوها المتواصل والدائم، له ولإقرانه وشبابهم الجامح المتسرب منهم عنوة.. انه ليس سوى محاولة انتصار المغلوب والمقهور والمُستباح ومسلوب الإرادة، وهو ليس انتصاراً واقعياً، لكنه انتصار (الرمز) على غول السلطة البربرية، الذي يتهدد الجميع بالفناء. يستدعي الجندي المكلف (علي الساعدي)،ذلك العسكري المجهول أيضاً، والذي وبعد أن استدارت السلطة، نحو (الكويت) لتحتلها وتستبيحها، فلعله (علي الساعدي) ذاته، فيما إذا قد بقي حياً، أو قرينه المجهول، والذي استدار وعيه أيضاً، وبحدة هذه المرة، ليكتب على جدران بيت كويتي عبث به أعوان السلطة وسرقوا ما شاء لهم، وكتبوا على جدرانه ما رغبوا، من تهديدات وتوعدات للكويتيين. ربما هو (علي السا...) ذاته أو قرينه المجهول، مَنْ كتبَ إلى جوار كتاباتهم، بارتجاف وخشية، وفي غفلة منهم، وفي البيت الكويتي المستباح ذاته، وعلى الجدار نفسه، العبارة الصارخة والفاضحة عن كل ما حدث وجرى في العراق ولشعبه، والتي يوردها (كنعان مكية) في كتابه (القسوة والصمت):" يا ليتني لم تلدني أمي..لأعيش في هذا الزمان.."!؟. هذه العبارة، التي كُتبت بتحدٍ، يتلبس قناع المجهول، خوف الوشاية وما ترتبه من عقاب، في بيت كويتي منهوب، وذلك الاسم الذي حُفر سابقاً، على باب خشبي، في بيت كردي محترق، والذي لم يكمل لقبه ثانية، وما خلفهما من انتهاكات وعذابات، أنتجت تمردات صغيرة في البداية، واختمرت ثم تمددت طولاً وعرضاً وعمقاً، في غالبية مدن العراق، وأصبحت خلف خلخلة أركان النظام وهيبته، وكان يمكن أن تطيح به في ربيع 2 آذار 1991 المغدور. كما تتنفس الصخور والجبال وتتبرعم الغابات، بفعل بشائر قدوم الربيع، يتغير حال الرجال عندما يعلمون أن (سبع) فتيات عراقيات، قطع بعضهن دراسته في أوربا وجئن، سراً، إلى (عراق) الضحية والجلاد، والقاتل والقتيل. ما أن وصلت أخبار (النصيرات)، تحركت العواطف الصلبة الجافة لرجال لم يروا خلال سنوات، غير الصخور والبرد والثلج وزمجرة الريح والقذائف والاختباء من طيارة مغيرة. لقد حدث تغيير أو ما يشبه الانقلاب الـ(آركيلوجي) في تلك الجبال وسلاسلها المتواصلة المتراصة الشاهقة، والتي ربما لم تصل لبعض كهوفها ومغاراتها الشمس منذ بدء الخليقة، وانعكس ذلك الانقلاب على سكان القرى الذين دهشوا من وجود نساء..نساء تركن البيت والمطبخ ومستلزماته، وامسكن بالبندقية، حتى إن بعضهم رفض دخولهن بيته أو الاقتراب من قريته، خوفاً في أن يصبن بعدواهن تلك نساء القرية، وشيئاً فشيئاً بات وجودهن طبيعياً خاصة بعد أن شاركن في عمليات الاقتحام، وقدن بعض أشرس رجال السلطة هناك، أسرى بنادقهن، وهم معفرين ومدموغين بعارهم الأبدي، وغابت وتقوضت سلطتهم وقوتها، وبعد أن استعرضن أسراهن في بعض شوارع تلك القرى التي أشرعت أبواب مساكنها مذ تلك اللحظة للنصيرات المقاتلات. ينهي (الجزائري) كتابه متتبعاً "خطوات الضحايا" خلال مرحلة اختفى فيها، من الوجود، في ساعات، الآلاف من العراقيين الأكراد، بمختلف الأعمار وسُلموا واستسلموا لمصائر مجهولة. ولن ينسى الذين عاشوا تجربة (الأنفال) ثلاثة أماكن ممهورة في ذاكرة مَنْ بقى حياً منهم صدفة. إنها: (معسكر الجيش الشعبي في طوابزة) القريب من كركوك. (سجن النساء في دوبز) الواقع عند ملتقى، كركوك- الموصل. (نقرة السلمان) المعروفة جيداً للعراقيين. من هذه الأماكن- المعسكرات- اقتيد الرجال القادرين على حمل السلاح مربوطين مع بعضهم بحبال، وبعد مهانات عدة وتعذيب دامٍ متواصلٍ، أوقفوا على حافات حفر شقية طويلة، عيون مكممة، ووجوه قلقة، وأرواح هائمة، وأطلقت النيران عليهم.. ثم غطتهم الجرافات بالتراب، وما أن غادر (القتلة)، شمل الصمت كل شيء، وغدا سيداً للهواء والفضاء الصحراوي وحتى التاريخ العراقي. الشيوخ اقتيدوا إلى (سجن نقرة السلمان) ليموتوا هناك. أما النساء فعشن عذاباً، يبدو انقضاض طائر الموت تجاهه، كرماً ورحمة ونعمة ومغفرة. وكان الأطفال يذوون من شحة الحليب في صدورهن، ويُنتزعون من صدور الأمهات ويلقون في الحفر حتى قبل موتهم.. إنها قيامة (الطاعون العراقي/ السلطوي) بامتياز وهي.. ليست الأولى..ولا الأخيرة. يذكر (الجزائري) أنه، خلال محاكمة المتهمين بما سمي بمجازر (الأنفال) ومن موقعه الإعلامي، طلب من مراسليه ومندوبيه، في عدد من المدن العراقية، أن يسألوا أجيالاً من العراقيين :- إن كان قد سمعوا بـ(الأنفال) حينها!؟. فكانت الأجوبة:
- لا
- أبداً
- إنها قصة مختلقة.
أما في المناطق الكردستانية :
- سمعنا..ولكن ليس بالتفاصيل !؟.
يرتفع صوت الجزائري/ في نهاية/ أوراقه الجبلية / معلناً بعذاب الشاهد والمراقب والمجرب:" عجبت كيف تمر الجريمة بهذا الصمت..182 ألف إنسان.. أزيلوا من الوجود.. كما في روايةٍ لـ"ماركيز"..مجزرة طوقها الصمت..حتى أوشك الضحايا أن يحيلوها إلى الكوابيس".
....................
*/أوراق جبلية/ ط 2/ 2011/ أربيل/ دار آراس/ الغلاف: مريم متقيّان
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها: (العدد :2023 الثلاثاء 07 / 02 / 2012)