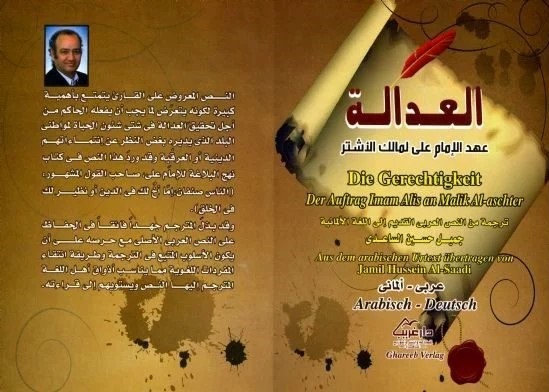قضايا وآراء
تداعيات التنوع الإبداعي العراقي في مواطن الغربة (2)
بفنيتها وذائقتها ونكهتها، تجده فاعلاً بآثاره على الصفحة الشعرية العالمية. ففي هذا الإيقاع الشعري المدور جاء المكان مبتدئاً القصيدة، فاختار جبال الابنين الايطالية المكان المادي الذي هو الوجود الموضوعي، ومحور علاقة الشاعر بنصه المستمد منه، أي المرتبط به، فالوحي التشخيصي المرتبط بالرؤية الوجدانية جعلت من هذه القصيدة ذات النفس النثري، عفوية شفافة قريبة لمشاعر المتلقي، "أرضي الأولى" الزمكاني "السماء الأولى"، العراق / ايطاليا، وكيف تميزت بنظر الشاعر، الحنين إلى السماء الأولى، والجمال إلى الثانية أي جمال الطبيعة، وموسوعة الحرية، إذن هي صورة الوفاء للوطن النابضة في تداعيات الروح، عبر متعة النظر في جبال الابنين الايطالية، وبعدها يبدأ التشريح مابين العالمين، في قوله: " إذا كان الأمر محدداً بالجغرافيا". وقوله: "أعليَّ أن أنتظرَ مُطْلَقَ الزمانِ، ابتغاءَ المكانِ ؟" هذه التقليبات الفنية التي تنظم العلاقة بين الصوت والكلمة، تقود الرؤية المكانية لأن تجعل من التفكيك العاطفي غاية في التركيب الشعري الدقيق، ومهارة كلماته باحتراف يجمع التشكيل النثري، مع خلق صورة شعرية تلبس أبهى ثيابها في حفل اسمه القصيدة المكانية، والمكان هنا كونه المحور الدلالي، يعوم شفافاً في خلجات الرهص الداخلي، بانسيابية محكمة ودقيقة في إيصال التعابير الحسية التي تحكم المعنى، وتبسط حرية منابع الألفاظ.
والسؤال هنا كيف للمكان قد أشتغل على صياغة المنتج الخيالي؟ وكيف تفاعل معه؟ في حين نجده قد ترك للزمن الخطابي عامل الربط بين المكانين، العراق/ أبو الخصيب. وايطاليا/ جبال الابنين. والحاضن في لغة التوقيت الدلالي هو: بنيوية جسدت الأمر المشترك الذي يجمع المحاكاة الممكنة للزمن، أن تتساوى في وحدة المعنى، في حضرة المقدس المكاني، ولكي نجيب نضع أمام أعيننا هذه المعادلة:
حدود الوعي عند الشاعر = أهمية المنتج.
الحواس، وأهمها البصر والخيال = تشكيل المنتج.
الخيال = طبيعة المكان.
اللغة = الانسجام البنائي للصوت الذي يحدد إيقاع الكلمة.
بتقديري المكان أولاً ثم الشاعر، وطبعا هذه المفاضلة تأتي بعد الولادة الشعرية، أي تقاطع الوعي الاحساسي في مكون الإدراك، عند هذا المبدع، بخلاف المبدع الآخر. فالمتنبي وامرؤ ألقيس قادتهما الطبيعة الصحراوية للروعة في بناء شعرهما عن الإطلال/ والفروسية/ والتغزل بالخيول/ وامتداد المدى المكشوف للناظر، والرحيل. وسعدي يوسف قادته خصوصيته المتفاعلة عبر وصفه التطويري عن جماليات الطبيعة، وقدرته المتواترة في الكشف عن خصوصية أسرار هذا المكان من ذاك، فأنتج شعراً حاور به السماء الثانية، بطبيعة ألوانها وخزينها الفكري والثقافي والانفتاحي الاجتماعي أي سلطة الطبيعة تلك. ومجانستها بالسماء الأولى، أي المكان الأول البصرة، وسلطة الشرطي، وتذمره من وجود الشاعر، الذي جاء يودع مسقط رأسه: قضاء أبي الخصيب، هو المكان السياحي النموذجي في بساتين محافظة البصرة. وطبيعة الشرطي ومهمته في البلدان الدكتاتورية القمعية يعني خنق الحريات، أي ممارسة هوية سلطة الاعتقال.
وعلى هذا فإنه من الناحية الفنية حقق المكان للشاعر طبيعة المُنتج، بأدوات الوعي أثناء الإلهام المجرد، وهذه الأدوات تختلف في خصائصها وجوهرها بين شاعر وآخر، وبين نص وآخر عند الشاعر ذاته، في بنية الموازين الاستحداثية لطبيعة النص، ولذلك فليس كل من كتب الشعر سميّ شاعراً، بل هناك المؤلف، والناسخ، والحافظ، وهؤلاء بإمكانهم بناء المكون الشعري الشكلي، لكنهم لم يبيحوا للضوء انتشاره في الأعماق المتحركة في جمالية بناء النص، هم يريدون فقط أن يشار على أنهم شعراء، وهي حالة مرضية، أشبه بصناعة الوهم للذات، إما لإثبات الوجود أو التحدي، أو أنه يزعم إنه يحمل هذه الموهبة التي منحتها الطبيعة للإنسان، لأن الموهبة هي العاطفة في أغلب تدفقاتها، والشعر مركب وجداني مجسي له نبضه الخاص في المتخيل العاطفي في الخيال، يتعامل تعاملا إيجابياً كهرومغناطيسيا مع حاسة النظر، وليس القلب كما تحدثوا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فالشعر أرقى من يحمل صفة كمال المعرفة الحسية، المتصلة والمنفصلة، من مفاهيم وقيم ونظرة تتخذ مساراً مغايراً عند الشاعر، هذا لأنه يستقبل مجسات الموجودات واحتمالات مقاديرها، عبر الرؤيا التي تجمع حواس إرهاصاتها في اليقين المنتج، وهو النص. ولذلك فالشاعر الحقيقي هو الذي يقيم حالة المجاذبة، بين صفوة إحساساته وشاعرية المكان، متأثراً بذروة الحدث، المعبر الجمالي الكمي للمعاني، دون أن يعددها، كما عبر العقاد عن مآخذه على شوقي قائلاً: " أعلم أيها الشاعر العظيم، أن الشاعر من يشعر بجوهر الأشياء، لا من يعددّها ويحصي ألوانها وأشكالها، وبقوة الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الأشياء."
إذن هذا رأى واحد من النقاد العرب المهمين، فلا بأس أن نعتبر قوله يتفق مع خاصيته النقدية، مع الأخذ بجلالية وأهمية شوقي العظيمة، مع أني اتفق معه على أن الشاعر يجب أن لا يعدد الأشياء بل يشعر بحوار شغفها الداخلي، وسعدي يوسف أدرك جوهر الإبداعية وكابدها تجربة شعورية صادقة، فجاءت نصوصه تمتاز بنغمة متفردة فيها ألم وشجن وخيبة أحياناً، وقد عودنا هذا الشاعر بتفرده بالجرأة وقوة الرأي دون مجاملة لأحد مهما كان، باستثناء بعض نصوصه المخيبة لآمال محبيه واصدقائه: خاصة في قصيدته الأخيرة عن الأرهابي "مرتضى الزيدي"، ومن خلال معرفتنا المحبة بالشاعر سعدي يوسف، كان أملنا أن لا ينحدر هذا الشاعر العظيم إلى مستوى هذا الفأر البعثي، لأن سعدي أكبر بكثير من حزب البعث نفسه بكل نظرياته وأعضائه.
وهكذا فالشاعر والمكان يوعزان للنص التلازم الذي يخلق مجساته الفنية، كونه المؤسس الإبداعي، والمؤرخ الزمني لطبيعة الفعل بالوقت ذاته، فالإبداع يتحد إيجاباً في المقام الأول مع المناخ الأدبي المتغير، وهو أيضا يشكل رد فعل وتمرد على ما هو سلفي متوارث، ولم يكن الشاعر يوماً اتباعيأ، لأن النظرية الاتباعية تتضاد بديهياً مع الإبداع، مع إنها أي الاتباعية كانت في الغرب مذهباً متبعاً في عصر النهضة الايطالي، في نهاية القرن السادس عشر، تلك الحقبة التاريخية التي أذنت بأفول العصر الإقطاعي، وظهور العهد الصناعي، وهكذا فإننا نرى اتساع دائرة أدب المهجر مع ظهور تعاظم الدكتاتورية، وخاصة في العراق بعد وصول الدموي صدام حسين إلى دفة الحكم، ومن نتائج وصول هذا الطاغية إلى كرسي الرئاسة بدأت هجرة العقول العبقرية المتميزة والمبدعة، ومنهم كبار الشعراء والسياسيين والأكاديميين، توزعوا في البدء على الدول العربية المجاورة، ثم انتقلوا بالتدريج إلى الدول الأوروبية.
ومن الشعراء من تغنت بهم جمالية الأنا المكانية، فكانت المؤدي إلى تجسيد متطلبات العامل الذهني والنفسي، المعبر الحقيقي عن الذات الزمنية عند سعدي يوسف، فآثرت وتأثرت بغنائياته، التي عكست المقاييس للتأكيد بأن الشعر هو تحرير العاطفة السجينة، في أعماق الذات الخصبة بنتاجها. يقول لامرتين في صراع جدلياته التنويرية التي قدسها الاوروييون.
" سيغدو الشعر ذاتياً، شخصياً، تأملياً، سيغدو صدى عميقاً، حقيقياً، صادقاً للانطباعات التي تظل أكثر سرية في النفس"
قد يصعب أن نضع للشعر تعريفاً جامعاً ودقيقاً، على الأخص في الإحساس، والبصيرة، والخواص، بيد أننا نستطيع أن نميز:
1- الفرق بين الإحساس الانفعالي المتوقد، من الإحساس الفاقد للحركة الداخلية، ومدى تأثير الإحساس الأول وانعكاسه على القاريء عند تحسس فاعلية النص عليه، ومدى شروق ملامسة النبض الخافق في أفراح الكلمات، وتجانس معانيها، وبسط حركتها الداخلية وتشاديها العميق مع القارئ. يقول الشاعر الانكليزي كيتس في الجانب المعبر عن الحس: "ليتني أظفر بحياة ملؤها الإحساس، فهي خير لي من حياة قوامها التفكير."
2- شخصية البناء الشعري البصري وأثره على المتلقي، من خلال موسوعته الإبداعية، وتفرده الذي يعكس قوة نشوء النص وحكمته، في أخذ مكانه بقوة بين الآداب العالمية.
3- التأكيد على أن الفطرة، والموهبة، اللتين تحاكيان الذات الشاعرة، هما المنبعان اللذان يحددان طرائق الخواص، ومدى تأثيرها على القارئ، من خلال تميز الشاعر لمنبعه الإبداعي، والخاصية في اختيار أدواته، التي تعبر عما هو أصلح للتعبير في تفرد أسلوبه، وقناعة التاريخ النقدي به، ابتداءً من القارئ الذي يمكنه أن يحل رموز الاستعارة، ومدى تآلفها مع الصورة الحسية، وضوابط السليقة، والخلق الإلهامي روحياً لوحدة القصيدة. يقول الشاعر الانكليزي "شيلي" : "أعترف بأني أحمل بين جوانحي شهوة عارمة لتغيير الشعر." وأنا الشاعر والقاص والناقد جعفر كمال أعترف بأني عندما اقرأ للشاعر سعدي يوسف، أحس بشعره يغطيني حتى هامتي، وكأني أغطس في زلال نهر شط العرب مغرماً.
وبهذا دعني أيها القارئ الكريم أن أبسط أمامك هذا التنويع البديع الذي تمناه الشاعر "شيلي" وحققه الشاعر العراقي سعدي يوسف:
كونشرتو للبيــانو والكْلارِيْـنَتْ
Concerto for Piano and Clarinet
?متدافِعٌ قصَبُ الـبُـحَــيرةِ
طائرٌ يختفي في ســماءٍ ســماويّــةٍ
طائرٌ يختفي في سماء
طائرٌ يختفي
طائرٌ
متدافعٌ قصبُ البُـحيرةِ
أهيَ ريحٌ من وراءِ البحرِ تدفعُــهُ
أَم السمَكُ الذي في القاعِ؟
هذهِ سِــدْرةُ الـمُـنتـهى، البيتُ
هل سِـدْرةُ المنتهى البيتُ ؟
هل سِـدْرةُ الـمنتهى ؟
سِــدرةُ الـ …
متدافعٌ قصبُ الـبُـحَـيرةِ
كانت الشمسُ الخفيفةُ أرسلتْ منديلَـها
ليدورَ? في الـــماءِ
نحن أولادُ بيتِ القصَبْ
نحن أولادُ غُصنِ الذّهَبْ
نحنُ أولادُ معبودةٍ خائبــةْ
نحنُ مَنْ؟ نحنُ مَن؟ نحنُ مَنْ ؟
متدافعٌ قصبُ البحيرةِ
في السقيفةِ زورقُ الصيّـادِ
يُطْـلى، مِـثلَـنا، بالقارِ
يُطلى، مثلَنا، بالنار
خَـلِّــني أغترِفْ ملءَ كَـفَّـيَّ
من مائكَ الـمستحيــل
خَـلِّـني أغترِفْ منكَ نارَ السبيل
خَـلِّـني أختـلِجْ
????????????????????????????????????????????????? خَـلِّـني أبتهِجْ بالقليل …
لندن 9/6/2005
النص إلى اليمين يعتمد الكاملَ وزناً،? كما هو واضحٌ?، وهــو للبيانـــو .
والنصّ إلى اليسار يعتمد المتدارَك وزناً، وهو للكلارِيـنَـت .
·قراءةُ النصّ الشعريّ يمكن?لها أن تكون متداخلةً?، أو متناوبةً??، أو بأيّ طريقةٍ يختارها القارئ.
هذه القصيدة من ديوان: "حفيد امرؤ ألقيس" ضمن القصائد الخمسين التي يحتويها الديوان كتبت في المنفى، وأغلبها في عام 2005، وهي تحمل معالجات منوعة في جديتها وأهميتها، ولأبدأ من الإشارة إلى الهامش الذي وضعه الشاعر لتبيان بناء قصيدته ذات المزيج ما بين الأوزان والتفاعيل الصوتية المعبرة عن الانسجام الذاتي للنص، حيث يدلنا: إلى أن العنوان الذي جاء باللغة الانكليزية، وهو من المفروض أن يكتب هكذا، لأنه إذا ترجم يكتب باسم العلم، كما تكتب الأسماء، فا Concerto الكورنشيرتو تعني: لحن. أي العزف على آلة منفردة وهو للبيانو، أو أكثر. ولكن الشاعر أرادها للبيانو. أما الاسم الثاني المرادف لتمام العنوان والذي هو: Clarinto كلارينت: هي آلة موسيقية تسمى المزمار، وتعزف من الفم وهو المتعارف عليه، ولكن العراقيون طوروا العزف فأصبح يعزف على المزمار من الفم والأنف، كما فعل به العازف العراقي البصري الشهير تومان.
أصبح واضحا أمامنا طريقة البناء الأسلوبي الأكثر معاصرة في القصيدة المدورة، والذي لجأ الشاعر بها إلى الوصف التطويري لبنية الكلمة، والتي أدت بالتالي إلى وحدة المصاهرة بين الصوت والمدلول، ولذا يفضل أن يقرأ النص متلاحقاً من اليمين إلى اليسار أفقياً، وتابعياً عمودياً على نفس الإيقاع، لأن الصور التي على اليسار تبين وتكشف عن ايعازات مضامين الصور التي على اليمين، وهي: "متدافعٌ قصبُ البحيرةِ"، كون التجانس الصوتي في مفردة "متدافعٌ" التيمة ذات الدلالات والمضامين الحسية المتعددة في بناء الجملة الشعرية، شكلت الحس المرتل نغمياً عبر تواصل المناجاة الروحية، معللاً إيقاعات سلطة الشريكين المتممين للإحاطة بإشراق وزني، وحبكة الألفاظ المنتقاة بدقة وحرص، فالظاهر والباطن هنا متناغمان لإتمام اليقين بين الشاعر وقارئه، وهو على تنوعه جاء أشبه باتفاق اللفظين في وجه من الوجوه، مع إشباع معانيهما بالوظيفة الإبلاغية، وهنا ننسب إلى الشاعر قوة محاكاته للأشياء، وظواهرها، وحركاتها، ولغتها المتحركة، وكأن شيئية الشعر تطلبت معماراً خاصاً متجانساً في محاكاة واحدة، لإظهار جمالية الصورة، ودقة بلاغة إيماءاتها، فالنداء الذي قادنا إليه الشاعر هو مستنبط من المكان، والمفردات التي تشكل المقطع الأول كلها مكانية:
البحيرة: مكان القصب
سماء: هجرة الطائر في المكان المتحرك، ولو قال الشاعر الفضاء لكان اللفظ معبراً أكثر، وأصح معنى ودلالة، لأنه في العرف العلمي لا توجد سماء، فالسماء كما هو معروف مجموعة من الغازات، لكل غاز لونه، فاللون الأزرق هو الأقوى في الألوان عامة، ولذلك أصبح البساط الذي فوق رؤوسنا بساطاً أزرقَ، والسماء مفهوماً قرآنيا، يميل إلى مفهوم الذات، والخوف، والآخرة.
وهنا تشكلت الصورة الشعرية مفتوحة على ضياع، ولكنها محسوسة بصرياً في المستعار الظاهر أي السماء، بدون الإشارة للزمن "طائر يختفي في سماء". وهنا ابتعد الشاعر عن المباشرة والتقريرية، فالاتصال بين السماء والطائر هو الاختفاء، إذ جاء الاستخدام كما لو أن الشاعر أراد لثيمة "الضياع"، أن يجعلها مفهوماً حسياً للدلالة، وهو أن تتفق الكلمتان "طائر، والسماء." في الوزن، والحركات، والسكنات، ولا يقع الاختلاف في المعاني، أما التحليل الدقيق لاستخدام ثيمة الطائر هي الذات التي ترمز لكينونتها بفعل الطيران، وهنا هل هذا الطائر اختفى في سماء ظلماء أم في الضياء؟ الجواب :الضياء. صيرورة الشاعر هي علاقة البحيرة بالطائر؟ والجواب: العودة إلى المكان، فالماء هو الحياة، كما عبر عن هذا الطوارق في ترحالاتهم الموسمية، حيث أن الشعور الواعي هنا لعب دوراً فسيولوجياً، وهي العودة الطبيعية للبحيرة، ولهذا نجد الشاعر قد بيّنَ المعرفة بوجودية الأشياء وأحداثها؟ في قوله: "أم السمك الذي في القاع؟" والعلاقة هنا مجازية بين الصورتين الشعريتين: "أهيَ ريحٌ من وراءِ البحرِ تدفعُــهُ؟ " الريح تدفع الطائر من وراء البحر، الصورة هنا دقيقة ومحكمة، لأنه أستخدم: "وراء: ولم يقل فوق، فالصورة أدت حكمتها، في هذا التشكيل الفني المحسوس، الذي أراد له الشاعر تأسيساً لتطور النمو الجيني للبذرة الإبداعية، كما أراد لها أيضاً أن تتآلف الكلمات بمعطيات الصوت لحناً على البيانو، وتنسجم إيقاعاً مع الناي، ليكون البناء عنده بمقدار، أي علاقة الكم بالبعد، فتميل الكتابة هنا ميلاً خاصاً إلى الكشف عن بينات التجنيس في المركب الداخلي، ومن جانب آخر، وفي نفس الصورة، نجده متنقلاً بالشعور الكلي إلى إيفاء عنصر المفاجأة في: "أهيَ ريحٌ من وراءِ البحرِ تدفعُــهُ". والسؤال افتراضي دال على بيان الكناية، لماذا؟ لأنه لا يذكره باللفظ المبني على الجناس، إنما يأتي بتاليه ألانسجامي، أما البيت الشعري هذا، فهو يدخل تحت باب المعرفة الجزئية، والمفاجئ فيه أراد له الشاعر التصنيف البحثي، لأنه خارج عن الكم المكاني والبصري: وهو الريح، أما البحر فهو تصنيف للأفعال، وآثارها على الحركة التصويرية لا غير، أما المجسم الذي يلي هذه الصورة الشعرية فقد تنوع في تملكه الذاتي، فاتحد ضمنا بالإيقاع التفسيري للمنجز الفني. أي كمال المعرفة بالشيء، وهو على الأغلب الأعم إنجاز الماهية الشعرية المجددة للأسلوب البنائي، الذي يميز سعدي يوسف عن غيره من شعراء العرب مثل أدو نيس، وشوقي أبي شقرا، وسميح القاسم. في سماته الإبداعية التي ابتعدت عن المنهجية، والوضعية، التي تقوم على لسان منشئها أي الشاعر، كما عبر عن هذا "أوغست كونت" فتكون اتباعية، أما المسوغ الجمالي في نبض القصيدة لم يكن: أما؟ أو! بقدر ما تلاقح لفظه طربا وإيعازا في وحدة البناء، ودقة الانسجام، وتدفقات الجزئيات الفنية في الملمس الشعري المحاور الذكي للقيمة الإدراكية للحس النوعي في تقليبات النظر، الذي يعكس حاضر الوعي المحسوس في الكم الإبداعي للصورة الشعرية، ويتجلى ذلك في أن المكان ليس السر العضوي المغلق، إنما هو التنوع الجمالي المفتوح على الحقيقة المجسمة في تنوع واقع الحال.
"الشمس الخفيفةُ أرسلت منديلها"
الشعر هو روعة الحسن اللفظي، وهو "الرسم بالكلمات" وهذه الصورة المكيفة بالذائقة الحسية أشاعت دورتها من خلال صلة الشاعر بالطبيعة، والتي أدت تقنية الأساليب الفنية المتعددة، التي يتخذها الشاعر للتعبير عن تجربته، ولي أن أقول أن هذه القصيدة بارعة الذكاء، وحالمة في دائرتها المتحركة، حتى أنني قرأتها مرات عديدة، والسؤال "نحن من؟" يتكرر ثلاثة مرات عن، من هم "نحن أولاد.” والتعليل هنا: "كانت الشمس الخفيفة أرسلت منديلها". الشمس الخفيفة استعارة، للضحى، أو العصر، أي قبل الغروب بقليل، إذن الشمس أرسلت منديلها إلى الماء ليدور في تساؤلاته "نحن أولاد.." "نحن من؟" والأسئلة لا تدور عن شعب بعينه، إنما عن الكائن الطبيعي، الذي سبق وأن بينه "بالضياع" وبه قد استخدم عناصر الطبيعة رموزاً ناطقة، وناشدها مطابقاً فكرة الذات على المشاهدة الموحية، التي تمنح حواسه انطباعات دلالية تكون شكوى حيناً، وحيناً أملاً في قوله:
خَـلِّــني أغترِفْ ملءَ كَـفَّـيَّ
من مائكَ الـمستحيــل
خلني أغترف منك نار السبيل
خلني أختلج
خلني ابتهج بالقليل.
وهكذا فهو يرضى أن يبتهج بالأمل القليل، ويتصافى مع أمنياته الشعرية النابعة من عصارة النفس، كونها دالة على ما وضع لها من أصل إحكام أزرار ألفاظها، والميل بها إلى إدراك طبيعة المكان الحسي. فالشاعرية تنبع من حساسية النظرة إلى المكون الجمالي لطبيعة المكان، ولهذا نجده تصافى مع التحريك العاطفي الهائل لعناصر التصاهر المشاعري مع تلك النظرة، فكانت: "نار السبيل" لنقل عابر سبيل، أو يطلب السبيل، أو يجلس على باب السبيل، كل هذه المعاني تؤدي إلى منفى الروح في ضياع معين، وهي تقريرية معروفة، لكنه أستخدم ثيمة "النار" المقدسة، والصورة: "خلني أغترف منك نار السبيل" ليخلق منها لغة فنية شعرية مطلقة العنان لتفسيراتها المعبرة عن الحزن الموضوعي، أو الشاعرية ذات الخفق النبيل، أي أن الطلب مناط بالتكليف، لأن الشاعر يطالب بالموهبة المقدسة من المادة الكونية الخالدة، "النار" ويعرج على حقيقة حياتية مجسمة بحقيقتين: "خذ ما أوهب، وامنحني ما أوجب"، والمعروف عن الشاعر سعدي يوسف يمتلك الروح المرحة الدائمة، والعينين ذات البريق الأخاذ بالذكاء، والحيوية والفرح، والثقة، كل هذه المواصفات تؤدي بالأديب إلى أن يبقى متحداً مع أفكاره ورؤيته التحليلية للأشياء، خاصة من خلال معالجاته التي يحدد من خلالها بنيته اللغوية والفنية، نستمع إلى الشاعرة نازك الملائكة تقول: "الشعر مأخوذ من لغتنا اليومية العادية، لكننا الشعراء نختار: الإحساس، والذائقة، والحركة الموحية، والشفافية، وما تعبر عنه الكلمة من معنى."
اليأس أم المعالجة؟
هنا يجب أن نميز إذا كان اليأس موعظة؟ فهذا = إيجاب. أما إذا كان اليأس = الفشل، فهذا لا يتحد مع عبقرية الشاعر سعدي يوسف، كون سعدي لا يتكلم بحال الأنا المغلقة المعظمة، بل يحرك الشفافية في الأنا الدلالية التي يتساوى بها الإحساس بالبهجة الموعظة لمطلق حرية المتناول الطبيعي بقوله: " خلني أختلج " وهذا يدخل في التحليل الدقيق للإحساس العالي عند الشاعر، وهو ليس قانوناً فرضياً يعمل بموجبه الوعي العامل، بل الوعي التفاعلي الذي هو أداة للمعرفة، خاصة عند الأفراد الذين يتعاملون مع معطيات الإبداع.
أما الاحتمال الثاني وهو المعالجة: من المعروف أن المجتمعات تقوم على أساس قوانين موضوعية، لا احتمالية، فالاحتمال قد يصيب وقد يخطئ، وهذا أمر لا يتساوى ويتحد مع الكمال الدلالي للأشياء، والنص الذي بين أيدينا نص يعبر عن مكونات أجناس الطبيعة المادية، فالثيمات التي استخدمها الشاعر كلها مكونات متحركة، كا البحيرة، القصب، الصياد، الريح، سدرة، السمك، القاع، الشمس، المنديل، الغصن، الماء، الزورق، القار، النار. أدوات الشاعر، فصلت معانيها إلى نسيج عاطفي، تعاطت مع ذات الشاعر، لأنه الوحيد القادر أن يتحسسها ويتفاعل معها، لذلك قال: "أهيَ ريحٌ من وراء البحر تدفعه؟" فقد أحال الصورة إلى بلاغتها الفنية، وعالجها بقدرته الواعية على أساس وزنها القيمي اللغوي وإيقاعها، الذي يمنح الحركة اللحنية تصرفاً موصولاً للقارئ بشفافية منعشة، وهذا النجاح معلق بالشرط البنائي الفني المؤثر. وقد تعمد أغلب الشعراء المنفيين السفر إلى أماكن فيها إثارة وتنوع طبيعي ومناخي، أي رشاقة المكان ورقة جماليته، وأسلوب الزمن وصيغ دوراته وتغيره السريع.
يتبع
جعفر كمال
............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1216 الاثنين 02/11/2009)