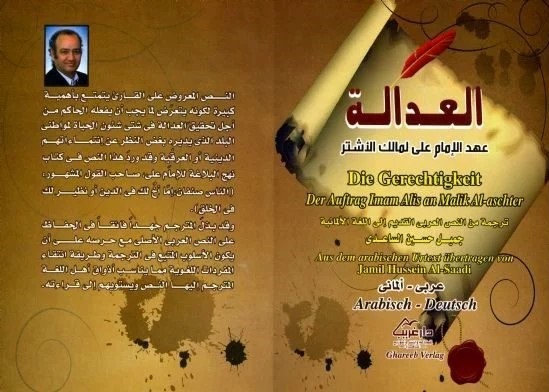قضايا وآراء
تداعيات التنوع الإبداعي العراقي في مواطن الغربة
والتعليم في مواطن الغربة، ومنهم من عمل في دور الطبع، والإعلام، ورؤساء للصفحات الثقافية في الصحافة العربية، ومنهم من أسس لأعمال مسرحية عظيمة، وترأس الأندية الثقافية، والعلمية، ومنهم من ترأس مؤسسات إنسانية، وصناعية، وثقافية، على مدار سجالٍ أدبي منوع وجديد في مختلف ترحالاته حول العالم، واستخدامه تقنيات أدبية جديدة أهلت اختلافه، إلى طفرات إبداعية تركز على الأساليب التنويرية، واهتم اهتماماً واسعاً في العلوم والبلاغة، سواء في مجاله الكتابي، أو في المجالات الاجتماعية والسياسية والأكاديمية الأخرى، فكان لكل ذلك انعكاس ايجابي على ثقافته وتفاعله مع المحسوس اليومي، مما دعاه أن يكتشف فضاءات إبداعية مضافة، تنوع في خلقها، وفصل ظروفها اللغوية، وأجاد فنونها، ووسع من مدركاتها الحداثية، بعيدا عن النظم والهواجس التدوينية، التي تصادر حرية الفكر والتعبير والخلق، وحرية الاجتماع والتنظيم.
ولهذا فقد توسعت ثقافات الأديب العراقي بعد أن ذاق طعم الحرية، فوجد نفسه أمام باب مفتوح على فضاءٍ جدلي واسع، في ما يختص بمعطيات جاذبية مشيئة الخلق الانفعالي، لمعطيات الجديد المكاني، والتشكيل المغاير في تجديد ثورة ما ذهب إليه الشعراء من حداثة تراتبية الموازنة، وسبر أنظمة الدلالة، وتفعيل معادلات الرمز، ومركباته التبادلية في تناسب السياقات وبنيتها، وآليات أدواتها التي تؤدي إلى متقابلات الحركة الداخلية للسمات الإبداعية الراقية، وتلازمها مع الواقعي وأنساقه، وانسجامه مع ديمومة المشهد الثقافي، عبر مكونات الأشكال الجديدة في أنماط الروابط الحرة في اختيارها لأنظمة البرهان، والجدل القائم بين الحداثة والتراث في الفضاء التحديثي المؤثر في معطيات الرؤى والأنساق الأدبية، لأن قوة الحقائق تكمن في أثر المنتج الإبداعي وتركيبة مفهومة إشراقه، وتدخله في لعبة خلق الإيماءة، وإفضاء بوح ثمرة الصورة بكل تجلياتها.
وعلى هذا المنحى الخلاق. ومن أجل معالجة أنماط الأساليب النقدية القديمة بشخصية جديدة، عمد الأديب العراقي المغترب على التفاعل مع المعطيات الإبداعية المعاصرة، في البلدان التي توطن فيها، من حيت تقنيات الصوت والاشارة واللون، في كل الفنون، ومنها مجال الرسم ومشتقاته، وخاصة عند الفنانين: ضياء العزاوي، وفيصل لعيبي، ويوسف الناصر، وكاظم خليفه، وعلاء السريح، وآخرين كثر، وفي مجال الموسيقى كما هو الحال عند منير بشير، وكاظم الساهر، والموسيقي المجدد في بنية العود نصير شمه، وأحمد مختار، وفي مجال المسرح تنوع المخرج المسرحي جواد الأسدي، إذ نقل المسرح العراقي من المحلية إلى العالمية، كما هو الحال مع الممثل المبدع والمخرج المتميز رسول الصغير، حيث شارك في أعمال مسرحية عظيمة على المسرح الهولندي، وذلك باجادة خلق الحافز التنويري الإدراكي لمعطيات التجديد، لأن كل مطلق إبداعي ممكن، إذا لم يخضع لعملية التكرار والتدوين الاتباعي. فيكون النص صافياً من الشوائب والأحكام والقوالب الأكاديمية، والمنهجية التي لا تقيم للأديب توازنه الاستقلالي، وبهذا يشكل الوعي التجديدي المستقل فهماً متطوراً للفنية الإبداعية، خارجاً عن أسلوب التصلب، والأنوية الحادة، والتقليدية للسلف الوضعي، الذي من شأنه أن لا يعيد التفاصيل، والمسالك، والبواعث ذاتها.
ومنذ ظهور هيدغر وفوكو، وهيغل، وماركس، بدأت اللغة الفلسفية تحدد القيمة الفنية لحركة المجتمع التي أخذت تتضح، في معالمها، وحواسها، وحتى إشكالات التأمل معها، اعتباراً من إلغاء مؤثرات الوسيط الروحي، في أوروبا، وحتى التغيير الحاصل في المفاهيم التي كانت سائدة في الوعي المغلق، كالخوف من الغيب وتقديسه، والأيمان المطلق بالرب، والجنة والآخرة، والمعالجة من الأمراض بدخول الأضرحة "المقدسة" عند الدول الإسلامية وهلمجراً. وخروجاً على كل هذه الأقاليم الاتباعية السائدة، توصل المثقف العراقي في المنفى، إلى خلق حالة نقدية تعتمد الاختصار السردي، وتكثف معطيات الإحساس بالنص المطلوب تناوله بالنقد والتأويل بخصوصية عراقية مختلفة، وبهذا فقد تميزت أحادية الأديب العراقي في خلق مساحات أوسع لجدلية المطابقة ونقيضها، عبر مؤديات الرؤيا الأوسع للجدلية الإبداعية، أمثال: الناقد فالح عبد الجبار، والناقد ياسين النصير، والباحث هادي العلوي، والناقدة فاطمة المحسن، والروائي والناقد سلام عبود، والشعراء، والقصاصين، ومن اتخذ للثقافة حضارة يأوي إليها.
صحيح أن بعض الشعراء الذاتيين، وشعراء الإنشاء الموسميين، وشعراء التأليف، منهم من وجد ضالته في التجديد "قصيدة النثر" من وحي إرهاصات تعبر عن قدراته الإنشائية الذاتية التي تؤدي إلى التلفيق والتكرار بدلا من الإبداع والابتكار، فجاءت كتاباتهم أقرب إلى السطحية الخالية من معالجة الأفكار المشخصة للأشياء، وقد عجز هؤلاء في البحث عن المفاهيم الناجعة الدالة على المحسوس التفاعلي مع ثقافات الشعوب ومستجداتها الفكرية المعاصرة، وقد وجد هؤلاء ضالتهم بنشر نصوصهم الفارغة جداً على صفحات المجلات الالكترونية ذات المنابع الركيكة والفاشلة، والتي أخذت تمنح الجوائز ذات الأسماء الكبيرة لمن هب ودب، ومع كل هذا الإرباك فقد برز من بين هؤلاء من برع في خلق صلة بين المدهش العاطفي للشاعر، وبين مألوف المعاصرة من منظور تجديدي يعبر عن مشروعيته، وإن كان يتسع بقدر كبير على الفوضى، لأنه تعبير لا ينم عن منتج حقائقه التعبيرية الداخلية، التي تؤسس للإحساس منابعه الإبداعية المؤثرة على الساحة الأدبية، عبر كل الأجناس الأدبية الخالصة. ومع هذا تبقى هذه الجماعة القليلة محدودة ومهمشة.
وفي منفى الأديب العراقي توسعت إمكاناته، فتعددت أساليب الكتابة وتنوعت، وصار يشار إلى هذا المبدع أو ذاك بالمتعدد المواهب، مستفيدا مما منح له من إمكانيات جديدة تبدلت معها علاقات التنوير المعرفي، في مجالات مجتمعية حياتية عدة، فأخذ يحث نشاطه الفكري بطريقة خلاقة، تعامل مع الفلسفة بوصفها تأسيساً انفعالياً لإنتاج تطور وتغيّر الصيرورة المنتجة للفعل الإبداعي، بمعطيات الجدل المادي المنطقي، وذلك في حث المفاهيم للبحث عن الماورائي في لغة الأدب وميتافيزيقيا الحياة والتكوين، متجاوزاً المفاهيم الجامدة، التي حاولت مطابقة رسالات المشيئة الظرفية المرتبطة بالتعاليم الغيبية، ومحاولة فرضها لمفاهيم حياة النعيم المحض في الحياة المؤجلة، على أن الحياة الدنيا، ما هي إلا تأسيس صناعي للفردوس المعني بعد قضاء الأجل، أي الحياة الأخرى كما يسمونها، وهذا الاتجاه الفكري لا يختلف كثيراً عن سياسات حزب البعث الإرهابي، ولكنْ كل يدلو بدلوه، فكلاهما سياستان متطرفتان تقمعان الحريات العامة، وتصادران حقوق الناس، وتمنعان إقامة منظومة علاقات حضارية، على أساس لغة أفكارهم وميولهم.
ومع هذه الكبوة التي أصابت المجتمع العراقي بطاعون الحاكم المعظم، إلا أن المثقف العراقي المتنور أزاح عن كاهله تلك الحتمية القاهرة للنفس، ولم يتعاط معها، بل تعامل معها على أساس الند، رافضاً كل تلك القوانين السادية المذلة، فأسهم في بناء ذاته، بعيدا عن عصا الجلاد الغبي، مما أتاح له القدرة على فض قوانين الحاكم الواحد الأوحد، فتنادى لأقامة منظومة علاقات متطورة تبدلت معها بنية التنوير الخلاق، الفاصل المادي بكل معطياته الايجابية، خاصة بعد أن بدأت الفلسفة الحياتية تأخذ مفاهيم وأشكالاً للوعي المختلف، في المجال الجدلي بين النسبي وايجابياته المادية، وبين المطلق وسلبياته المثالية. فأخذت بعض المنظومات الدكتاتورية بالانهيار والتلاشي، وحلت محلها في يومنا هذا، نظم اجتماعية متطورة، وخاصة في لبنان، والعراق، والجزائر، ودول شرق أوروبا. "الشيوعية منها سابقاً" كتلك التي بدأت في عصر النهضة الأوروبي، وقد تأثرت هذه الشعوب ايجابياً بالثورات التنويرية، ومنها إحياء الفلسفة الكنطية التي تعتبر واحدة من أهم الفلسفات التي تؤكد على تحرير العقل، منذ ظهورها أبان عام 1786 عصر الأقلام الواعدة الحرة في مفهوم النقد، وبهذا فقد أسس الفيلسوف عمانوئيل كانط، عبر نظرياته التي أصبحت تشكل آنذاك بحثاً قيمياً متوازناً في أصول الحداثة في كتابه: "نقد العقل المحض"، عن شروط كشف الحقيقة بتجاوز نقد المذاهب، والأفكار، وبناء علاقات حرة ومنفتحة على التجنيس البنيوي المعاصر خارج حدود نظريات السلف، وقد عبر عن مفاهيمه بحيادية لطبيعة منتجه الإبداعي، هذه هي لهجة كانط الجادة والرزينة والساخرة بآن، التي عودنا على قناعاته بها في كل مؤلفاته وبحوثه، وهو يطرح بثقة موصولة للقارئ أفكاره المعلنة، والتصرف بها على أن تكون مؤثرة وفاعلة. ولي أن أقول أن أفكار كانط بعكس ما عبرت عنه الشيوعية في زمن "الاتحاد السوفيتي" حين تعاملت مع الأفكار كأقاليم لاهوتية متحجرة، ولهذا جاء السقوط سريعاً كما هو الحال مع حزب البعث في العراق وطوباويته ذات النفس الدكتاتوري البشع. فالأدباء الذين شاركوا في تدمير العراق جنباً إلى جنب مع سلطة العائلة الواحدة أمثال: سامي مهدي، وطراد الكبيسي، وعبد الرحمن مجيد الربيعي، وساجدة الموسوي، وحميد سعيد، وغيرهم. فرغم أهمية هؤلاء الأدبية، إلا أنهم ساروا في ركب الدكتاتور، ولم يفلحوا في تقديم أعمال أدبية تضارع ما قدمه المبدعون العراقيون المعارضون لحزب البعث الفاشي، الذين اتخذوا من المنفى حماية لحياتهم من التصفيات الجسدية بكاتم الصوت، والتوابيت الدبلوماسية، وأحواض التيزاب، وطرق شنيعة أخرى، خوف المعارضة من أن هذا الحزب سيدمر العراق، وهذا ما حدث.
في حين أعلنت الثقافة العراقية في المنافي، عن هويتها العراقية الريادية، وقد تميزت بلونها، وبلاغتها بأولويتها الإبداعية، ومن بوح هذه الرؤية أسس الأدباء العراقيون المغتربون منتديات ثقافية، ودوراً للنشر، ومجلات وجرائد ثقافية وعلمية اهتمت بشؤون وثقافة المغترب العراقي. ولأجل هذه المؤثرات المكانية، تعامل المثقف بتفاعل وحيوية، وذلك بتطوير هذه العوامل الوجدانية المركبة من ثقافتين مهمتين هما: التراث الفكري والثقافي العربي، والحداثة الأوروبية المعاصرة، عن طريق سلامةَ وتحسين أدواته ومجازها، وكنياتها، ومحاكاة المكان وأثره الجمالي، إما بالاستعارة، أو بالمفاضلة، على كل متناول له تأثيره وفعله، يدرسه ويحاوره ويستمع إليه، فقد تكون هذه الأفكار تشكل في نظره حافزاً درامياً، تعبر عن المتعة والإثارة، فتأتي متممة ومحفزة للمكون الحسي الداخلي، المتفاعل مع بعض المكونات الحياتية.
ولهذا عندما يتحرر الأديب من الأفكار الموضوعة في قوالب متحجرة، تجده معنياً فقط بالإنتاج الموسوعي المؤسس لجمالية التعبير، المتعددة أذواقها الفنية، حيث تجده مطلقا في أساليبه التعبيرية، من خلال منظوره للحياة عبر ابتكاره المتجدد، وإبداعه المتنوع، مع تشذيب تقنية وسائط الاختلاف في البعد الكمي، والإحساس النوعي الايعازي بين هذا المشغل التنويري أو ذاك، على أساس لغة المعاصرة التي تكشف عن تحميل المفردة دلالاتها الشعرية، مع تداخل هيمنة اللغة الفنية الرصينة معها في المنتج الإلهامي الحسي الماورائي، في لغة الشاعر المهيمنة على مجسات خياله، لتكون الكتابة مُحكَمَةٍ بحريةٍ مطلقةٍ، وبتلقائية غايتها التحديث، غير المخطط له، متبرئاً من أي إحكام أكاديمي، وملتزماً بإشراقٍ تفكيكي مختلف، وفي الوقت ذاته تؤسس لحوارية مفردات المشغل الإبداعي التنويري، الذي يسهم في بناء نص مغاير بإرهاصات بنيته الرشيقة، وإيقاعاته المدورة، خارج شغلانية الذات، التي استخدمها المتصوفة في تطويق كتاباتهم بأفكار مغلقة، والغريب أن الكثير من أدباء عصرنا مازالوا يفكرون بالطريقة ذاتها، مع الاعتراف بأن: "طرائق الفنون لا زمن معينا لها". كما عبر عن ذلك أبن جني في "الخصائص". مع المصادقة على أن لكل زمن ذوقه وقارئه، هذا إذا اعتبرنا الإبداع هو المعبر الحقيقي عن جمال الموهبة، لأنه من المفترض أن لا يكون المبدع ناسخاً للأجناس الفنية التي سبقته، فيكون إتباعياً، ولهذا ومن أجله، يجب الابتعاد عن اللعب على أجنحة اللغة التي استحدثها واستخدمها ممن سبقوه، والإتيان بآليات وأدوات وأساليب جديدة تفجر الوسائط اللغوية والفنية، إلى معان ذات دلالات فيها من الحداثة ما هو متعلق بسلامة الألفاظ "ومعرفة أصلْيّها من زائدها، وصحيحها من عليلها،" كما عبر عن هذا الجرجاني في كتابه: "الإمام علي"، هذا كون الأساليب الصوفية كانت تجسد الباطن على أن هذا الشيء مكشوف عليهم ومرئي، وهذا خطاب يمتد إلى أنظمة الخوف ومؤسساتها الغيبية، وبهذا حتى لا نفقد هوية النص التجديدي الذي نشتغل عليه، وهو تنظيم العلاقة بين الكلمة وخصائصها الصوتية، خاصة ونحن أمام مد هائل من الحداثة الكبيرة والرائعة في صناعة المعاني وتركيبات ألفاظها، وتفجير إحساسات النص المبتكرة، والدراسات النقدية الشابة التي تحررت من مشغل المناهجية الأكاديمية، بعبارة أخرى أن تسفر لعبة أدواتنا عن تقديم إمكانات مغايرة تتميز بأسبقيتها الإبداعية.
البعض من "الأدباء" المروجين لسياسة حزب البعث الإجرامي في الزمن ألصدامي البشع، يعيبون على أدباء العراق في المهجر، أو ما سمي: "بأدباء الخارج"، الذين عارضوا تلك السياسة البعثية التي أصبحت في خبر كان، واتخذوا من مواطن الغربة القاسية مكانا آمناً للعيش، على أن هؤلاء لا يمكنهم الإسهام في بناء المنتج الأدبي العالمي، كونهم انسلخوا عن مواقعهم وأدواتهم الحقيقة التي هي منتج بيئتهم.
هذا كلام غير دقيق، لأن الإبداع لا يرتبط بالضرورة بمكان معين لكي يتفاعل ويجدد، إنما العكس هو الصحيح فالجديد المكاني يؤثر إيجابا على الأديب، ويجعله منشداً حسياً في الذوق والعاطفة مع السحرية المكانية، ومن هنا يأتي دور المبدع وآثاره التي يجب أن تكون واضحة على منتجه، الذي سيكون بالضرورة متغير الملامح والمضامين بهذا الفعل المكاني أو ذاك، سواء كان هذا المبدع شاعراً أو رساماً أو قاصاً أو مخرجاً مسرحياً أو روائياً أو حتى فيلسوفاً، وأراني أستشهد بكم هائل من الأدباء العالميين المغتربين أمثال: الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهري، الشاعر والروائي اللبناني جبران خليل جبران، والشاعر العراقي بدر شاكر السياب، والشاعر العراقي سعدي يوسف، والشاعر المثير للبهجة الراحل بلند الحيدري، والشاعر صادق الصائغ، والشاعر العراقي المجدد في القصيدة المدورة في إيقاعات الصوت عبد الكريم كاصد، والشاعر المتمرد على القوالب الجامدة حلمي سالم، والشاعر الثائر محمود درويش، والشاعر هاشم شفيق، والشاعر عواد ناصر: والعدد كثير من الأدباء العرب لا يحصى بهذه المساحة التي أحاول جاهدا أن أختصر فليعذروني أصدقائي الأدباء، ومن أوروبا الشاعر الفرنسي البلاغي رامبو/ عاش في اليمن، وناظم حكمت، وزايمو غلو/ تركيين وغيرهم كثر، الذين ازدادوا أنتاجا مميزا عن إنتاجهم في أوطانهم، ولا ننسى هجرة الأدباء والفنانين الألمان إلى هولندا، البلد المجاور، هروباً من المناخ النازي أبان الحرب العالمية الثانية، ومن ابرز هؤلاء: غيورغ هيرمان، وجوزيف روث، وارنست بوش، وغيرهم، وانطلاقاً من هذا الفهم أراني أتجاوز ما يسمى :" بالضرورة الخادعة" لنظرية أصول المكان، وخطابها المقيد، وأنانيتها الصارمة، كما أراد لها كارل ماركس في قوله المفتوح على جوانب فلسفية عديدة: "الإنسان ابن بيئته" التي تحتكم إلى وضع قوانين مشروطة وقاسية، ومقيدة للفكر والخيال المفتوح على بنيوية واسعة، وخاصة في المجال الشعري. حيث لا يتساوى الشعراء في التحليل والمعالجة في أخيلتهم فيما بينهم، التي تتأثر مباشرة بمنتجهم الشعري، الذي يشكله فضاؤه الخاص، منبثقاً من عين الشاعر لهذا الحس الداخلي، أو البصري، وهنا يتعرى خيال الشاعر العاطفي، فيكتب تجلياته وانسجامه وتوحده في صناعة النص، خارج القوانين الجامدة، والملازم التدريسية الصارمة، كما يحدث اليوم على ما ينشر في بعض المواقع من قصائد هزيلة، وتعليقات خالية من الجدية والصرامة من البعض، وهي أشبه بمجاملات غير مشخصة للنص الشعري، فتجد هذا المعلق أو ذاك في واد، والنص في واد آخر، مبتعداً عن واقعية التعليق متأبطاً انفجاراته العاطفية لهذه المرأة "الشاعرة" أو تلك، وكأنه يهم بذكورته لمغازلة هذه "الشاعرة" التي تكشف عن أعضاء حساسة من جسدها على بعض المواقع الهزيلة، كون المعلق الذي تشخصه الدوافع والحوافز الجنسية، لا يمكنه أن يلامس حساسية الملاقحة الفنية بين الشاعر والنص، وبين النص والمعلق، وللأسف البعض من هؤلاء "أدباء".
أما النص ذو البنية المكانية المتحركة عند الشعراء، الذين انسجمت ذاتيتهم وتكيفت، مع ثقافات شعوب اختلفت حضاراتها وعرفها وتقاليدها، وهو أن يحتفظ الأديب بالفعل المكاني الذي اعتاد عليه سابقاً، إلى التفاعل مع خصوصية مكانية جديدة نحو كونها أصبحت واقعاً، ينسجم مع تجربته التي أصبحت تميز مفهوم العلاقة بين المتغير والثابت، حسب تعاطي المنابع الجمالية عبر مؤثرات انزياح الرؤية الفنية، والهدف منها هو خلق الإيماءة وإحساساتها الملحة للكيفية التي يختار بها النص ولادته، لذا فتبصر قراءتنا التفكيكية للثقافة في تنوعها، وشموليتها لطبيعة الفنون، والتحولات الإدراكية للمنتج ما بعد الحداثي، هو التعاطي مع نصٍ له حقيقته ومنتجه من ايعازات الواقع المكاني الجديد.
من هنا تتوج نصوصنا بإقامة حوار ما بين ثقافتنا الخاصة، وثقافة الآخر في مواطن الغربة، وبقدر ما ننتج إبداعا تجديدياً، نجعل النص يستمتع بلذاته من روحانية توحده مع القارئ، هذا إذا كان الأديب يجعل النص راهناً يقيم علاقة حية متجددة تلعب رؤيتها على وجدانية الذات الخاصة، على سبيل المثال، في مقالة إدوارد سعيد المهمة والمستفيضة المسماة " انعكاسات على المنفى "، يقول: " المنفى يُجبر بشكل غريب على التفكير بشأنه ". وهي نظرة تجديدية تدخل في المجال الإبداعي أيضاً لما ننجزه وما نعمل على خلقه من رؤيتنا الخاصة، للشواهد من منتج نماذج الانفتاح على التجديد، ولنأخذ شاهداً معاصراً: الشاعر الكبير سعدي يوسف وقصائده التي تفاعلت مع إثارة الفعل المكاني، من مواقيت الحركة المدورة في بناء الجملة الشعرية، التي يقوم عليها المتغير بين نسبية الزمن المتحركة، وبين ماهية التعبير عن الأشياء، وربطها ربطاً إحداثيا بظواهر التعبير الوجداني، مع استمرار تدفق نبض الإيقاع المكاني بانتظام، وهو يولف الحس الشعري في المشهد التجديدي للبناء الداخلي في الجملة الشعرية وإثارة غاياتها، ومن منتج هذه الخاصية حقق الشاعر ما بلغ إليه المنجز التحديثي الأخير، لكونه في النهاية خلق إنتاجَ الروابط الحسية في النص الشعري، من نبض المشاهد الطبيعية، وتجاذب الروائع والآثار ذات الطفرة المعرفية وتمثيلها المعنوي، وهي تلامس تأبط حلاوة مشاعرها الفنية، في قوله:
في قرى جبال الابنين الإيطالية، حيث أقمتُ ما يقاربُ الشهرَ (مُعْظَم أكتوبر2008 هذا)، كنتُ مستغرقاً الاستغراقَ كلّه، في ما حولي، وفي ما ينعكسُ ممّا حولي على ما في دواخلي. لقد أردتُ أن أُعطيَ المكانَ حقّه ما دامَ هذا المكانُ متاحاً. هل من غرابةٍ في هذا الأمرِ؟ ليس من غرابةٍ لو كنتُ في أرضي الأولى، مع المشهد الأوّل. لكني منذ أواسط الستينياتِ كنتُ: بعيداً عن السماء الأولى...
وما زلتُ .
إذاً أين المكانُ ؟
ليس من مكانٍ، إنْ كان الأمرُ محدداً بالجغرافيا.
السماء الأولى إيّاها كانت ممنوعةً أو شِبْــهَ ممنوعةٍ. أتذكّرُ أنني أردتُ زيارة أبو الخصيب مودِّعاً وداعاً أخيراً، نهايةَ السبعينيات. استقللتُ سيارة أجرةٍ، وبلغتُ المكانَ، مقهىً عند مرآب السيارات. طلبتُ شاياً. لم أُتْمِمْ شُربَه. كان شرطيٌّ يقف بمواجهتي يسألُني لِمَ أنا هنا. ماذا أفعلُ في المكان. نصحَني بالعودة من حيث أتيتُ. وهذا ما حصلَ.
هل كان بإمكاني التأمُّلُ بأمواهِ دجلةَ؟
لم أعرف الفراتَ إلاّ حينَ سبحتُ في الرّقّةِ بأعالي سوريّا، متنعِّــماً بمائه، خيرِ ماءٍ .
سألتُ طالب عبد العزيز، الشاعر، مؤخراً، عن مدرسة المحمودية بأبي الخصيب حيث أتممتُ الابتدائية. قالَ: هُدِمَتْ.
إذاً، أين المكانُ ؟
والآن؟
إنْ كانت أسبابُ الذكرى مُـنْــبَـتّـةً، فعلى أيّ أرضٍ تتأسّسُ الذاكرةُ؟
العراقُ كان مُغَيَّباً عني.
وهو الآنَ ممعنٌ في الغياب.
لقد استولى عليه آخَرُ ثانٍ أو ثالثٌ بعد آخرَ ســالِفٍ.
هذا الآخَرُ سيظلُّ مستولياً، مُطْلقَ الزمانِ. والسببُ بسيطٌ: أنه إمبراطورية صناعيةٌ، وليسَ شخصاً.
العراقُ مُسِـخَ مســتعمَرةً .
هل أعتبرُ الأرضَ المغصوبةَ وطناً ؟
إنْ كانت الصلاةُ نفسُها لاتجوزُ في أرضٍ مغصوبةٍ، فكيفَ الـخَـلْقُ ؟
أعليَّ أن أنتظرَ مُطْلَقَ الزمانِ، ابتغاءَ المكانِ ؟
جســدي، الواهنُ مع ماراثونِ العذابِ المديدِ، لن يفعلَ ذلكَ حُكْماً.
إذاً، أين المكانُ؟
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1216 الاثنين 02/11/2009)