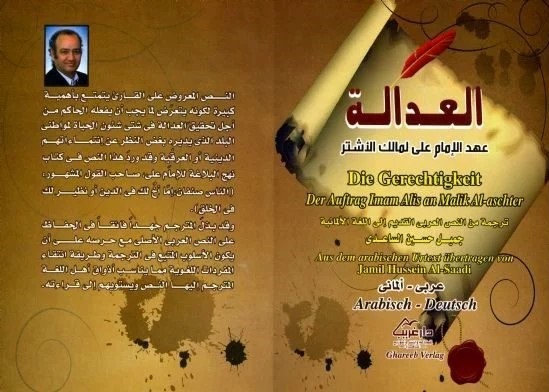قضايا وآراء
تداعيات التنوع الإبداعي العراق في مواطن الغربة (2)
وطموحنا في هذا الجزء محاولة الوصول إلى قراءة تفصيلية في القصيدة المكانية المدورة عند الشاعر عبدالكريم كاصد المجدد لبنية هذه القصيدة، كما أوضحنا سابقا، في جزئنا الأول، والذي تناولنا فيه الشاعر سعدي يوسف، نستطيع بواسطتها تلمس السبيل نحو نوع من التقنين الاجرائي لما توصل إليه هذا المشروع التجديدي من تأثير وقبول، أو رفض عند البعض متلقياً أديباً، أو متلقياً عادياً، وحتى لا يبقى هذا التجديد الخلاق، غير مفهوم لدى الكثيرمن الأدباء أنفسهم، وحتى لا تبقى مفردات مشروع هذه القصيدة عاصية على القراءة، أحاول أن أسلط الضوء على أهمية ركائزها الجادة وهي:
أولاً: أهمية مخارج صيغ أدواتها.
ثانياً: كيفية لعبة المدور البنائي بثنائيته المتكافئة شكلاً ومضموناً.
ثالثاً: تداعيات أسلوبية الإيقاع في صناعة التناسق اللغوي بين الألفاظ وملاقحة معانيها.
رابعاً: متداعيات الشاعر الإلهامية، والخصوصية البلاغية التي تحتدم اشتقاقاتها بين اللغة والبناء.
الإلهام هنا يعتبر متعاطياً إيجابياً مع ثقافة ووعي أدوات الشاعر، ونعني: التجاذب الكيفي الذي يحكم انتاج سعة التخيل، فالبناء الخارجي يعتمد الصياغة الذاتية للحركة التي تنمو بإعادة مفاهيم البنية الداخلية، بايحاءات متلاقية لاتضعف ولا تتشتت فيها الأدوات، إنما تبقى تدور بحيوية ببنى تفاصيل أدوات أوسع، يحكمها قانون تقابل الأشياء لا تجزئتها، كالتقابل الإلزامي بين الفكرة ومعانيها، وبين النص وأدواته.
ولكي نسلط الضوء أكثر على براهين ودقة متلاقيات مضامين البناء الداخلي في الجملة الشعرية عند كاصد، نكشف عن تلامح التواترات الحسية من عميق خلجات ذائقتها الصوتية، التي تؤدي إنسجامها التام مع المكون الحسي الباطني، حيث تتساوى المهارة البيانية واللغوية باقتصار نبضها الشعري المنتظم إلى الشكل، وبها يتصاعد الصوت ونغمية متقنة وهادئة إلى المتلقي. ولهذا ومن أجله سعيتُ لأن أدخلَ مباشرةً لمختاراته الشعرية الجديدة، وسأقصر هذه الدراسة على بعض قصائد هذه المجموعة الشعرية، وذلك بربط معرفة الوعي الواقعي ببنائها الفني ودقة أنسجة كيفيته، حيث الإضافة الأنموذجية لسمات إبداعية خاصة، من وحي العناصر المكونة لهذا التجديد على النحو التالي:
1- مكانية: مثل قصيدة :"الفصول ليست أربعة"*. "سيرة محلة صبخة العرب" كونها حكمت استدعاء الماضي بكل انفعالاته، من سلبيات سياسية واجتماعية. وإيجابيات فكرية تمثلت في وقوف الشاعر جنباً إلى جنب مع أبناء شعبه ضد الدكتاتورية البعثية المذهبية، وقد اقترن استقراء المكان بإطار متكامل غير قابل للبديل العاطفي بين الدال الإنساني، والمدلول غير الفاعل للتجزئة في المفهوم الإنتقائي لمصطلح فلسفة أفضلية المكان، وهذا يقودنا إلى أن الشاعر عندما سلط الضوء على مكان" محلة صبخة العرب" إنما أراد الكشف عن أهمية منتج هذا الحي لقامات ذات وزن معرفي وأدبي كبير من عائلة واحدة تميزت بمنتجها الإنساني الكبير، أي عائلة الشاعر وأخوته، وقامات أدبية واكاديمية أخرى أنتجها هذا الحي الشعبي البسيط، وهذا الرأي يصطلح مع فلسفة المثل الشعبي القائل "الكصب لو طال يرجع لأصوله". وهنا تكمن فصاحة الماهية الشعرية من خلال المنظور التأملي، باعتبار الرجوع إلى الماضي، يغذي الحسية المعنوية، كونها المحاور الأساسي والحيوي للتعبير عن منتج التلاقح الوجودي بالمكانية، ولهذا كشفت الملكة الشعرية عند الشاعر عن أصالة هويتها، و قد نسميها المعالجة بالمقدار الأسلوبي المعبر عن خصوصية التلاقح الإحساسي في ذات الشاعر، بمطاوعة المشاعرية الذاتية وارتباط حنينها بذكريات المكان، عندما استدعى التاريخ المتمثل بالاسطورة "آلهة سومر" كمشاهدة حية في عيون هؤلاء:
وقورون
كآلهة من سومر
تحفّ بهم النراجيل كالجواري
في مقاهي المدينة
بيوتهم قد تخلو من الخبز
ولكنّها نادراً ما تخلو من الضيوف
يتلخص هذا الاتجاه بالحنين إلى مسقط رأس الشاعر، ليسلط الضوء عليه ويذكي العلاقة بين ذاته، وذات المجتمع. إذ أننا نلمس في هذه القصيدة، عبر محاورها المنتظمة، بإيقاع نبض رشيق الحركة، يوعز إلى أن مصير الإنسان ليس منعزلاً، بل هو جزء من المجتمع والتاريخ.
فاللغة الشعرية المكانية تنتظمها معالجات خفية، تحاورها الخاطرية العاطفية حيث تعود به إلى اقتضاءات تعبيرية تنجسم مع المسوغ العقلي الذي يحتفظ في جانبه العاطفي بماضيه، وخاصة إذا كان ماضي المكان هو الذي وضع الشاعر على أول خطوات الإبداع، ومن جهة أخرى فالمكانية ملازمة لمشاعرية الإنسان مهما علت قدراته العلمية أو الأدبية، وبالتالي فهي منقولة بحواسه إلى حيث يستوطن، فالنظام العقلي الذي يجعل من النفس أن تناجي المكان الأول، لا يخضع للقوانين المجتمعية الانتقائية، بمدلولات الأفعال والأصوات التي تتقارب مخارجها في المكان البديل، لأنها لا يمكن أن تلغي حساسية استلهام معاني الطفولة والصبا والمراهقة.
2 - إشارية: مثل قصيدته: "نوافذ" المكتوبة حديثاً، والتي سميّت مختاراته الشعرية هذه بها. المعبرة عن تلازمية الشىء بإشاراته التعبيرية، وتحديث فعل الدلالات الإيعازية للرؤية الإبداعية المجددة، وقد ارتبط هذ الفعل بمحورين أراد لهما الشاعر النجاح:
- حسية، تثير للأشياء شهوتها الجمالية، لتعبر عن المنتج الداخلي للمقياس البحثي، في عموم المحاور التي طرقت القصيدة أبوابها.
- معنوية، تهتم بدراسة وظائف الأصوات المجردة من بصريتها، والمعلنة في أشياء أخرى، وهي الاطار المتمثل بالشكل في قوله:
أحبُ النافذة
تدير وجهها إليّ
وفي صورة أخرى تتضح عنده محاكاة اللابصري، فنجده محاوراً بصيغة السؤال في قوله:
لا أدري
لماذا تدخل الأشباح
من النافذة
ولا تدخل من الباب؟
ولي أن أتمنى على كل من يروم للأدب مسعى، أن يقرأ هذه القصيدة كونها تمنح الخيال، وتشد القارى إلى معالجات تحثه على الكتابة، أو الرسم أو حتى التغني بها.
فالموهبة ودافعها الإلهام هي ميزة الشاعر الحق، كونها أحد أهم محققات التمييز القائمة كمعطى أساسي في بنى القصيدة، يوعز لثقافةٍ تميزت بشموليتها الموضوعية بكافة الفنون والعلوم، فأصبح الشعر موسوعة يضم في ديوانه كل العناصر التي تطرح مشروعاً جامعاً، يمنح الصورة حقيقة المعبر الموضوعي عن الأشياء.
قلنا إن العلاقة العاطفية بين الشاعر والاشياء، جاء التعبير عنها بلغة شعرية تدور فيها المعاني على نسق واحد، في كثير من القصائد، إنما هي موحاة إليه من الخلية الإبداعية في العقل، والقرآن يقول: "أوحينا إليكَ روحاً" "الشورى 52 " والموحي هنا العقل الموعز لصاحبه بتنفيذ الأشياء. والقصيدة روح تحقق للدلالة نوعية الجدل، فهي تتكلم وتعني وتثقف وتمثل وتمتاز عن غيرها من المكونات الأدبية، وهي في الوقت ذاته تفرض قربها الروحي من الآخر من لدن إحساساتها ومعانيها. بهدف إحداث نقلة نوعية في بنية ثقافة القاريء، لأن الشعر مصب تنويري يفعل الإنسجام المشاعري لإنسانية الفرد.
وفي هذا المنحى يأخذنا إليوت إلى رأي: "إن الشاعر إذ يعبر عن ما يشعر به الآخرون، إنما يغير هذا الشعور بزيادة وعي الناس له، وهو يجعل الناس أكثر وعياً بما يشعرون به سلفاً، ولذلك فهو يعلمهم شيئاً عن أنفسهم".
وبهذا يمكن أن نقول أن الشاعر قد أضاف أشياء جميلة ومهمة أدت مهمتها، ما دامت كينونته المنتجة مرتبطة إلى حد بعيد بهذه الخصائص:
الخصوصية المنتجة لطبيعة خصوبة الخيال عند الشاعر.
القيمة التأويلية وتميزها
قوة مصادره.
وبذلك يصبح للوعي دورٌ فاعلٌ في تسيير مشيئة الإبداع، واخضاعها إلى كل ما هو متغير ومستحدث في الرؤى والتفاعلات التنويرية، التي ترتبط بين ماهو مقنع مطلق، وبين ما هو نسبي واقعي، عبر المؤثرالوجداني العاطفي. من خزين رؤى ومجسات المساحة التي تمتاز بها تجربته، المقرونة بالمعطيين التاليين:
- الوحي: هو المنتج العقلي، الذي يؤدي بدوره إلى تكامل البناء في وحدة النص، أي مستنتج القيمة.
- التجربة: هي النسبية الحياتية، التي تحتفظ بمقدار معين من الوعي التخصصي الذي يميز تجاربها، مقابل تجارب الآخرين من حيث منتجهم الإبداعي.
وهذان العاملان يعبران عن المنطلقات الملموسة، التي تؤسس علاقة نوعية بين الموسوعة الفكرية في ثقافة الشاعر، ومنتج أدواته، هذه من جهة، ومن جهة أخرى: احتدام التداعيات بين المعاني وألفاظها، ضمن النسق الحيوي الخلاق المتحد بملائمة كيفية البناء. وعلى هذا الأساس تمتاز القصيدة التي تولد من رحم الوحي والتجربة الناجحة، في الذوق والرقة والرشاقة، كما هو الحال في قصيدة "صبخة العرب". التي تعني للمشار المكاني دلالالته الأجتماعية العاطفية من رحم لغتها الفنية المدورة، كونه المكان الذي ترعرع ونما به الشاعر عبدالكريم كاصد، وهذه القصيدة تعبيرٌ عن وفاء الشاعر لمسقط رأسه، وما احتوى المكان من تداعيات ورؤى وسجال ثقافي وعاطفي، فقد سجلت هذه القصيدة توسعا معنويا في كيفية بسط معطيات الديباجة الشعرية، من منظور قدرة الشاعر على محاكاة المكان، وقد برع في الشعر المكاني أهم الشعراء العرب أمثال: امرىء القيس، والنابغة الذبياني، وزهير بن أبي سلمى، والشاعر سعدي يوسف، والشاعر أبو القاسم الشابي، والشاعر عباس بيضون، والشاعر الذي نحن في صدد دراسته في هذا الجزء عبدالكريم كاصد، وغيرهم. والشعر المكاني تناوله السياب في كثير من قصائده الخالدة ومنها: "غريب على الخليج، " كما هو الحال في قصيدة: "منزل الأقنان" وقصيدة: "جيكور والمدينة" وغيرهما من قصائده العظيمة.
كثير من الشعراء يحكمهم المزاج، مع أني ضد هذا العنوان، لأنه لا يتساولى مع المؤسس الإبداعي للذات المنتجة، فالمزاج منتج أناني يعبر عن: أنا ولا أحدً غيري، وفي الوقت ذاته تجده حسوداً مقولبا بالأنا المضخمة، لا الأنا الدالة على حكمة واستقلالية الذات المؤسسة لخصوصيتها، لأن الأنا الثانية تكشف عن الصورة غير الملحنة، كونها تشع من الماورائي التخيلي في قيمتها ونوعية المكون الإبداعي الإيجابي، حين تكشف عن إيعازات إنفصالها عن المكون التقريري، إلى مكون إنفعالي حسي تتجاذبه الإيماءات والنزوعات النفسية اللآهية مع الانفعال الحسي المكون الأساسي للعاطفة.
وقد أوردنا هذا الشرح من باب الاحتراز، لا أن نعني شخصاً بعينه، إنما هذه أزمة تطرح إشكالياتها على مستوى واسع، سواء أكانت في الجسد الأدبي العربي أم حتى في الأداب الأوروبية، والمطلوب إعادة النظر في كل النصوص وكشف صحيحها من رديئها، وهي دعوة لكل النقاد العرب أن يكشفوا عن الكتابة الرديئة، وعن العث، والسرقات، وغيرها. وفي الجانب الآخر أن يخصصوا للشعر النسائي قدراً كبيراً من المنطق والاستحسان القيمي بين الشاعرة الحقيقة، وبين أخرى بينها وبين الشعر فضاء لا محطة فيه، وتأكيدنا أخلاقي إنساني لتأكيد أهمية الشاعرة الحقيقة التي تمتلك القدر الكبير من الفصاحة اللفظية، وتميز أدواتها لما تنطق به من وحي شاعري بديع، وما تجمع من اصناف الكتابة الراقية. فهناك شواعر عربيات معاصرات على مستوى عال من الأهمية بمكان كا: الشاعرة العراقية لميعه عباس عماره، والشاعرة اللبنانية جومانة حداد، والشاعرة العراقية أمل الجبوري، والشاعرة المصرية فاطمة ناعوت، والشاعرة الكويتية سعاد الصباح، " وإن كان لنا مأخذ عليها، حين كتبت قصيدتها الشهيرة: "سيف العرب" لكن هذا جانب سياسي لسنا في صدد تناوله، والشاعرة العراقية الشابة ورود الموسوي ذات القصيدة النبيهة الخلاقة، وكأن شعرها تنساب خلجاته في روعة معانيه، وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى في الديباجة اللغوية. والشاعرة السعودية مي كتبي، والشاعرة حليمة مظفر، والشاعرة العراقية بلقيس حميد، والشاعرة المغربية فاطمة الزهراء بنيس، والشاعرة المغربية نجيبة العبدلاوي الحائزة على الجائزة الأولى للمساهمة الهولندية للشعر، والحائزة أيضا على جائزة أدب الهجرة لعام 2000، وعلى جائزة "كونسبيند" الهولندية، والشاعرة والمترجمة الجزائرية د. ربيعة جلطي، فكل واحدة من هؤلاء الشواعر تميزت بحس شعري فني أخاذ، مجدٍ للأساليب الكتابية المتطورة، ولا أنوي المفاضلة بين هؤلاء المبدعات والمتميزات حقاً، لأنه لا يوجد شاعر أو شاعرة يوصف بالمستوى العظيم، أو الأفضل، أو الأكبر، إنما هناك قصيدة عظيمة.
وعليه ومن أجل أن نستمتع بهذه القراءة ننظر بالشاعرية المحصنة والمتعافية من كل غثاثة، والخالية من العثرات، والصافي بيانها من المربكات غير المبنية بناء حسناً، كالأحرف المتماثلة، التي تتكرر في البيت الشعري الواحد أكثر من مرة، حيث تجد الحروف المتكررة أضاعت معاني الكلام، بل أضافت إليه ثقلاً وركة، مبتعدة به عن الفصاحة، فيضعف الغرض الفني، ويهد قوة الترابط الإيصالي اللغوي ببعضه، وفي الوقت ذاته يبعد القارىء عن النص. كما عبر عن هذا الوعي: قُدَامَةَ بن جعفر في كتابه "الخصائص" بقوله عن المعاظلة: " هو إدخالك فيه ما ليس من جنسه وإلزامه اياه ومثله. بقول أوس بن جعفر:
"وذاتِ هِدْمٍ عارٍ نواشرُها = = تُصْمِتُ بالماءِ توْلباً جدعاً". والمعاظلة تعني كل ما يكسب الكلام تسطيحاً فتهويماً وتداخلاً بلا إفادة، أي بُعد الكلام عن السلاسة، وعدم فهم طبيعة المفردات والجمل، مما يؤدي إلى عدم فهم المعنى. والدليل في هذا:
وأزور من كان له زائراً = = وعاف عافي العُرْفِ عرِفَانه
لاحظ تكرار الراء والفاء اللذين حمّلا البيت ثقلا، لأنني أعتقد أن الشعر، وخاصة العمودي يعتمد البناء وصولاً إلى كمال وحدة المتلاقيات الفنية واللغوية بموسقتها، على أساس إجادة استخدام الألفاظ على أحسن وجه، حتى تتصف قراءتها بالمعبر الحقيقي عن المتعة، أما إذا كانت الأدوات المؤسسة للشعر سليمة معافاة من كل رداءة، فهذه تأخذ القارىء وتشده إلى بلوغ معانيها، والاستمتاع بالذائقة الفطرية المتقنة في تشذيبها وتحصينها بالأدوات الناجعة. فالشعر مجسات نبض خفيف الإيقاع، حسن اللفظ، بليغ المعنى، رقيق السبك، ورشيق كقول الشاعر البليغ:
قالت بنات العم: ياسلمى، وإن = = كان فقيراً مُعدماُ؟ قالت: وإن.
لاحظ الجزالة والحنان والبلاغة والرشاقة في هذا البيت الشعري وأسلوبه البديع الذي لا تقاوم جمالية إشاراته وإيحاءاته.
وشاعرنا عبد الكريم كاصد يقودنا في متلاقياته الحريرية بالكثرة من الجزالة، وكأن لغة الكلام استسلمت لقدرته، للوصول بها إلى رقي مراتب الجمال، إشعاراً ببلاغتها، عبر دواونينه الشعرية الكثيرة ومنها: الحقائب، النقر على أبواب الطفولة، الشاهدة، وردة البيكاجي، نزهة الآلام، سراباد، دقات لا يبلغها الضوء، قفا نبك، زهيريات، ولائم الحداد، هجاء الحجر. وله في المسرح أيضاً: المجانين لا يتعبون، حكاية جندي. وفي الترجمة عن الفرنسية: كلمات جاك بريفير، أنا باز، سان جون بيرس، قصاصات، يانيس ريتسوس. وفي الترجمة عن الانكليزية: نكهة الجبل، سانتيوكا تانيدا، وفي الحوارات معه وأهمها الحوار: الشاعر خارج النص، مع الكاتب المبدع والمتميز الأستاذ عبد القادر الجموسي، والمقابلة هذه منحت الدلالات المعرفية قيمة تنويرية، حين أشارت إلى مساهمات الشاعر في الكثير من المجالات الأدبية، في أغلب المحافل الثقافية، والتي كان ومازال مساهما وفاعلا في رفد الثقافة العربية، موازينها وجمالياتها وتميزها، متنقلا بالتجديد إلى الضرورة الإبداعية أن تأخذ أولوياتها العربية مقابل الآداب العالمية، ولو تصفحنا قصيدته المعبرة في رؤيتها عن المأساة الكبيرة التي أوضحها الشاعر عبر متلاقيات الألم ومعانية المؤثرة في النفس البشرية، عن أولئك السياسين الذين هربوا من جحيم النظام العراقي السابق:
الغرف
في ظلام الغرفْ
تنهضُ الآن وحدك
تبحث عن علبةٍ للثقاب
تُراكَ نسيتَ ؟
عرضتَ ثيابكَ
كلَّ أثاثك للبيع
تذكر قرقعة العجلات
وهي تحملها، وسط همهة الشرفات
والصغار الذين يطلون فوق السلالم
ها أنت تبتعدُ الآن
تُسرعُ بين النوافذ
تُصغي لوقع خطاك الغرف
القيمة الاحتمالية لتغذية الطفرة الإبداعية لبلوغ سلم النجاح، تقوم على أساس إذكاء هَوَس المغايرة في المفاهيم، واللعب على مجانسة الأدوات وتشذيب قوانينها، إلى حيث الاستدلال الاستقرائي في عرض تميز الأدوات المكونة لهذا النص أو ذاك، باعتبار الاستقراء الإستنتاجي الأول للقصيدة يبوح عن كشفٍ احتماليٍ عند البعض، وفي الوقت ذاته ينتج عن وعي يحلل مدى قناعته بالمحتوى الدلالي لعموم البنية، بشقيها الداخلي والخارجي، ولكن ما أن تعير القراءة تركيزاً في البحث والتحليل تجد أن مفاتيح النص قد دارت دورتها الكاملة في الكشف عن القيمة الدالة على أهمية هذه الكتابة.
وفي هذا المقطع الذي يبتدىء ملهمة الشاعر "الغرف". اعمتدت القصيدة: بناء المشهد المسرحي، وحاله يستهوي عرضاً خاصاً للتعبير عن الحيرة البشرية ونواتها الشاعر، الذي أصبح المعمد الروحي لهذه الجماعة، لأنه يكشف عن الظروف الصعبة التي يعيشها صحبته في مواجهة منفى الروح عن الوطن، ويعالج الايضاح الذي يجب أن يؤدي إلى الخلاص من بنية الظلام في الغرف، ولذا صار يبحث عن ضوء ينير النفس المتمثل في عود الثقاب، ومثاله أراد لهذه الاستعارة أن تنتج دورتها المدورة، برفع الوهم المتمثل في ظلام الذات، والسياق العام هنا أن تكون ثيمة "علبة الثقاب" ظاهرها من الدلالة على الإيحاء بأن الذات هي المفعول به بالمطلق المادي، الذي ينتجه تمني الضياء، المنقذ المتمثل في قدسية عود الثقاب، ومن جهة أخرى أدى الشاعر مقابلاته الفنية التي تمثلت في: "ظلام الغرف،" والغرف دلالة مكانية استقرائية، يعود إليها الشاعر كون مضمونها الداخلي ينشر أجنحته الفنية على سهل المشهد بأجمعه، حيث تجده كلما ينتهي من بناء، يعوم بالدلالة على أن عطفها يعود إلى ما تقدم فيشركه في وحدة المفهوم الدائري التشكيلي للمجانسة الذاتية لبلوغ النص حكمته، والقصد أن يبقى الشاعر يقود رأس الخيط، إلى اكتمال نسيج وحدته، التي تعتمد اعتماداً بالغاً على أهمية البنية الحرفية، ولذلك جاء التدليل يوزن مرجعيته على الفعل الأول بحواراته بين الذات / والمكان، حيث يشير إلى الدقة في بنية المونولوج الذي يتصافى إيقاعه بين الخارج المتمثل في: " تُسرعُ بين النوافذ" وبين الداخل غير المكشوف على الآخرين الذين هو جزء منه في: "تصغي لوقع خطاك الغرف". والغرف هنا أصبحت تصغي، وهي معلومة مادية بحته، أنارت مشاركة الجامد بالحدث وهذا تميز بلاغي خصب. لأن الشعر منطق تأويلي بامتياز، ولي أن أشير إلى أن المعنى في مفردة "تُسرعُ" لا تشير إلى الوهم الإصطلاحي المسوغ في الروح، كالخوف من الظلمة، إنما هي على جهة المساءلة والذهول من ملاحقة الضياع له، في هذه الصورة المحكمة بالتناسق الموضوعي، التي مثلت الرخاء اللغوي في: "تنهضُ الآن وحدك" ويصافيها بالمتمم الدلالي: "تُراكَ نسيتَ؟" والنوافذ: أرادها أن تكون المقابل النفعي بمواجهة ظلام الغرف، فهي تمنح النفس شهيقاً صافي المتعة من بوح فضاء يأخذه إلى إطلالة على ضياء الحرية، لأن النوافذ واعز رمزي يمثل التضاد لمفهوم الظلام. وفي الوقت ذاته يأخذ بالدلالة لتكون معبراً حسياً ومشركاً لوظيفة المعنى، بنسيجها الداخلي المتوازي مع الشكل بهذه الصورة: "ها أنت تبتعدُ الآن" أن تكتمل قيمتها التي تحوم على كشف الدلالات إلى ثبوتيتها البينة، على نسق يبني الشمولية في وحدة ترتيبها المحكم. من صيغ لغوية تحكم إحاطة المعنى بمناقشة أحوال المكان ومؤثراته الكيفية على النفس، تنشدها الجملة: "تصغي لوقع خطالك الغرف". لأن هذه الحركة الشعورية المؤسسة للفن التصويري المدور في اللفظ المشترك، حققت إنجازاً لمعانيها على جهة التفضيل البنائي للنص، بما يحفظ للتقنية الفنية العودة إلى النواة، أي المركز. وهذا يعني أن الصورة كيان خاص واحد، والقصيدة بأكملها هي كل هذه الصور توحدت في الذات الشاعرة، فأصبحت المعبر الحقيقي عن كيان متماسك أدى إلى وحدة المضمون.
كيف تتخذ الكفُّ شكلَ المفاتيح مقطوعة
وتحدّقُ في الباب بالزائرين؟
كيف لم تبصر الزائرين؟
يعدّون في بيتك الشاي
يستقبلون النساء
ويقتسمون الغرف
إذن لابد من الملائمة لأجل تبيان المقصود من التوصيل الاستقرائي التأسيسي ، في بيان الغرض من التشبيه، لأن يصل التعبير إلى أهدافه الموحية، إلى أن: "الكف". المشبهُ به، أدت الإيجاز في الفعل المحقق للإيعاز: "المفاتيح". المشبّه بأحوالها، بحيث تتناسق في ذات الفعل التعبيري عن الشيء وأدائه، فكلاهما المحركان الأساسيان لمحورية "تتخذ"، فجاءت الجملة الشعرية تدور في قراراتها المبنية على الإيعاز بالشيْ في هاتين المعنين، ثيمتا: "الكف و المفاتيح". أما ما أوحت به المفاتيح للبلاغة من مسوغ مطلق الدلالات، فهو قدرة الشاعر على محكاة غير العاقل بإحياء مبتغاه، ليوميء إلى أن هذا الشيء يؤدي فعله الذاتي، وحال الشعر يتسامى بمكوناته على كل الجهات وجمعها بسلة تسمى القصيدة، وهذه قدرة ليس بالهين إحياؤها، لأن تتسامى اللغة باصطلاحها التعبيري كي تحقق للصورة الشعرية أهدافها في: "الكف تأخذ شكل المفاتيح" تحدق في الباب بالزائرين الذين، "يقتسمون الغرف". والغرف هي النواة المكانية التي تدور حولها الحياة، فإما تهجرها وإما تنتهي فيها. والسؤال: "كيف" دل اختيار الملائمة بين: الكف والمفاتيح، معنىً لا يخلو من تأويل المشاعرية الحسية التي لها القدرة على أن تكشف وتتلمس الأشياء ببياناتها؟ وهذا تفعيلٌ لمحاكاة المكان وإحياء عناصره الواقعية، أن يجعل من القارىء يتفطن لبراعة الترتيب، والتخصيص القيمي عبر معالجاته الفكرية لما يمنح الكلام إيضاحه الدلالي.
أنت حين طرقتَ الفنادق في الفجر
يقتادك النوم،
غادرت
عند الظهيرة يستيقظ النائمون
وعند الظهيرة
هل يصعد الماء؟
أنصتُ
أسمع وقع خطىّ في الممرات
يصطفق الباب ُ
تهتز منشفةٌ فوق حبل الغسيل
تلامس في الريح
سطَحَ الغرفْ
............................
الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1254 السبت 12/12/2009)