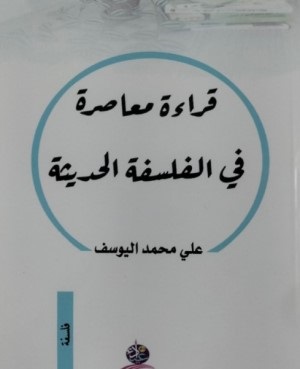قضايا
"الكاميرا" مرآة تضع فوضى الواقع في"مصفاة" وتنقل صورة صافية للأحداث
![]() "الفنُّ السَّابع" في الجزائر بين ما أُنْجِزَ وما يُنْتَظَرُ تَحْقِيقُهُ
"الفنُّ السَّابع" في الجزائر بين ما أُنْجِزَ وما يُنْتَظَرُ تَحْقِيقُهُ
(دخول المرأة قاعات السينما يعتبر طابو في المجتمع الجزائري)
الكثير من حوّل "الكاميرا" إلى مشروع اقتصادي، حيث أبدعوا وتفننوا في إنتاج الأفلام وابتعد فيها المتفرج عن حياته الشخصية إلى عالم آخر تدور فيه قصة تبدأ وتتعقد وتجعل المتفرج أسيرا لها، وقد لا تجد خاتمتها، وقد تتيح للمخرج أن يبدع أكثر ويختلق لها سيناريوهات جديدة، فالكاميرا تحمل المتفرج إلى عوالم لم يزرها، وتنقله من بيئته المحلية إلى بيئة أخرى، وتجعله ينخرط معها بكل جوارحه، ويمكن القول أن المعرض الذي أقيم بالمركز الثقافي أمحمد يزيد بقسنطينة نقل الجمهور إلى مرحلة هامة جدا من عمر الجزائر، ألا وهي مرحلة الثورة المسلحة وما قدمته "الكاميرا" والراديو" و"السينما" من أدوار قيّمة في تلك المرحلة التي وصفت بالذهبية
يقول خبراء في الفن السابع أن "الكاميرا" لا تعرف التجارة، وهي تصور حدثا ينمو، مضطرة دوما لأن تضع فوضى الواقع في مصفاة، وتقدم للمشاهد بانوراما للمرحلة التي يعيشها أو التي فاتته، أي المرحلة الثورية التي لم يعيشها، وهذه المرحلة بالذات تجعل المتفرج ينقطع عن حياته الخاصة طيلة عرض الفيلم، كما نراه في الأفلام التي تحكي عن الصورة الجزائرية، كما قد تجعله يعيش "الاغتراب" وهو ما أشار إليه "جان لوك غودار" مخرج سينمائي سويسري- فرنسي، عندما تحدث عن العلاقة التي تربط الجمهور بالسينما، ووضع "الكاميرا" وسط اللحظة التاريخية الحاضرة بكل محليتها وعالميتها، بكل تشابكها وغموضها، ويكشفها دون غش أو خداع، بحيث يعتبر السينما أداة تعبيرية، ولكن "الكاميرا" عنده ليست أداة معطاة سلفا، لكنها إمكانية غير محدودة تستجلي نفسها باستمرار، وهي تعكس نفسها كما يعكس المسرح نفسه في أغلب التيارات الجديدة.
يقول المخرجين السينمائيين إن السينما تتغذى من السينما بمعني أن ما عرض من أفلان قد تكون قد عرضت في أفلام أخرى، فقد تتشابه القصص لكن المشهد يختلف وهذا ما جعل المخرجين المحترفين أمثال غودار يباشرون أفلاما تتكون بالتجربة وتتوسع، إلا أنها تظل ناقصة، لأنه لا يوجد إعداد هيكلي سابق يحرك "الكاميرا"، ولذا يرى الخبراء السينمائيين ان الارتجال واستنطاق اللحظة هما الأسلوب وهما القاعدة، كما أـن هناك علاقة متينة تجمع بين المؤلف وكاتب السيناريو والمخرج، فالمؤلف يقول رؤياه في كتاب، وكاتب السيناريو يحول رؤيا المؤلف إلى حوار ومشاهد أي إلى تعبير سينمائي جاهز، والمخرج يهيئ الجوّ ويرسم الممثل الذي يحفظ الدور، ثم يأتي المصور "الكاميرا"، وهذا يعني أن العملية مترابطة وباستعمال الخدعات والحيل تتحول الفكرة أو المشروع إلى فيلم جاهز، غير أنها أي "الكاميرا" في ظل حركة "الرأسمال" وتكديس الأرباح، تحولت الكاميرا إلى مشروع اقتصادي يستنزف جيوب المشاهد كمستهلك للصورة، واستطاعت الكاميرا ان تشكل الذوق العام.
و"السينما" حسب المختصين نجحت إلى حد كبير في العديد من الدول العربية والإسلامية (مصر، تركيا، الهند وإيران وغيرها)، ليس لأن المخرجين شاركوا المتفرج في الموضوع، وأخلطوا السينما بالواقع، بل ان السينما أصبحت عندهم أداة " إيديولوجية"، وأصبحت هي التي تحدد ذوق الجمهور وفكره واتجاهاته فيما يخدم مصلحة النظام، ولهذا تمكنت بعض الدول من تحقيق صناعة سينمائية، تقدم بضاعة لها مقاساتها، عدا في الجزائر الذي تراجع فيها الفن السابع إلى الوراء، بشهادة الأخصائيين، من بينهم المخرج السينمائي أحمد بجاوي، الذي أشار أن السينما في الجزائر عرفت عصرها الذهبي خلال الثورة المسلحة، وتراجع دورها بعد الاستقلال، وقد استعاد أحمد بجاوي خلال توقيع كتابه " السينما وحرب التحرير" المرحلة التي عاشتها السينما الجزائرية أيام الاحتلال الفرنسي، حيث قال: كان لنا جمهور يعشق السينما وأعطى للسينما مكانتها، وأضاف: نحن نعيش معركة الصورة والصوت والاتصال " ليستطرد بقوله أن عودة قطاع السينما مرهون بوجود إرادة سياسية حتى تكون رائدة في النشاط الفني، مشيرا أن السينما الجزائرية لعبت دورا هاما أيام الثورة المسلحة وبلغت رسالة، لكنها اليوم هي في حاجة إلى دعم كبير، حيث أضاف قائلا: " لنا أرضية وخلفيات ثقافية لدعم وتغذية السينما الجزائرية".
ويلاحظ حسب المهتمين بالفن السابع أن كثير من الأفلام تلقى انتقادات، لأنها تفتقر إلى هذه التقنيات أو المقدمات، مثلما حدث مع فيلم آسيا جبار، الذي ركزت لفيه على الجانب السلبي للمرأة الجزائرية، بحيث لقي انتقادات البعض، ومنهم المؤرخ عبد الله حمادي، والحديث عن السينما في الجزائر حديث ذو شجون، فقاعات السينما التي ما تزال مغلقة إلى اليوم، فضحت عجز وزارة الثقافة بل عرّتها، وقتلت في نفس المتفرج أو المشاهد حب هذا الفن، فعن أيّ سينما يتكلم هؤلاء؟، فـ: "الكاميرا" في الجزائر اقتصر دورها في تصوير الطرقات المهترئة والبنايات الغير مكتملة والحركات الاحتجاجية، وبثها عبر القنوات الفضائية، ولم تعد كأداة لتصوير أفلام تنعش بها السينما، بل كشفت سطحية حامليها الذين فشلوا في تحقيق العلاقة بين المتفرج والسينما.
وبالوقوف على التجربة السينمائية في الجزائر نجد أنها قصيرة جدا، بالمقارنة مع المؤسسات السينمائية الأخرى، مثل هوليود وبوليود، ثم التجربة التركية المتمثلة في الأفلام المدبلجة، التي تكاد أن تحقق الرقم القياسي من حيث الأداء التمثيلي، والتي فاقت بدورها التجربة المصرية، ولو أن السينما المصرية لعبت دورا جليا في استقطاب الجمهور العربي والجزائري بصفة خاصة، لدرجة أن بعض الجزائريين في الوسط النسوي تأثرن بالمصريين وأصبحن يتكلمن بلهجتهم، ومن جانب آخر تجاهلت السينما الجزائرية حق "المرأة" في دخول قاعات السينما، ولو أن هذه الأخيرة كانت تدخلها في فترات ليست بالبعيدة، وربما الأوضاع السياسية التي عاشتها الجزائر في الفترة الأخيرة، أبعدت المرأة نوعا ما عن هذا المجال حتى مرحلة ما بعد "الإرهاب" أين بدأنا نسمع عن مخرجات سينمائيات، وظفن الكاميرا توظيفا جديدا يتماشى مع العصر وساهمن في معركة التغيير، رغم ذلك ما تزال المرأة في الجزائر محرومة من الذهاب إلى السينما، بحكم العادات والتقاليد التي تميز المجتمع الجزائري المحافظ، بحيث يرى أن ذهاب المرأة إلى السينما يعد تكسيرا للعادات والتقاليد، ويصف كل من تدخل السينما بالمسترجلة.
علجية عيش