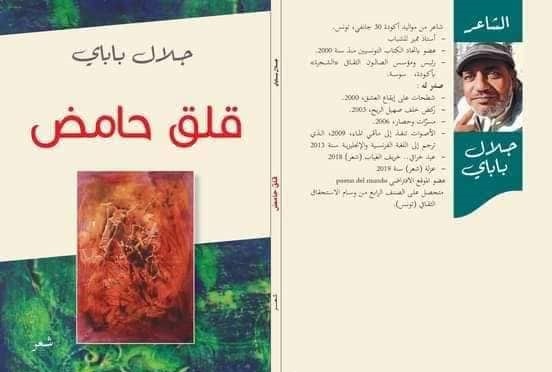قضايا
عن الأقصى والفيلسوف
في كثير من الأحيان، لا يمكن لأحد منا أن يدافع عما يؤمن به؛ لأن آبائنا ومن حولنا مثلنا تماما: أجهل من الدابة. وتمر الأيام والسنون حتى يواجه الواحد بعض أفكار مضادة لإيماناته فيضطرَّ لمراجعة كل ما قد سلّم به في صغره، وكبره، بلا تردد ولا نقد حقيقي. في هذه الفترات، التي نقوم فيها بفحص مسلماتنا، يخطلت الأمر على بعض الناس؛ فيترك بعضهم كلَّ ما قد آمن به، لأنهم لا يفحصون ما قد وجِّه من نقد، ويظنون النقد قد نقض كل شيء. وهناك من لا يهتم كثيرا بما قرع سمعه؛ لأن ما سمعه يخالف ما عَهِدَهُ، ولا يمكن، في ظنه، أن يشوب دين آبائه وعاداتهم أي شائبة. الفئة الأولى، في ظني، لم يكن عندهم إيمان حقيقي، أصلا، حتى يتم الدفاع عنه، فتركوا ما لم يقتنعوا به منذ البداية. أمّا الفئة الثانية، فهي لا تحب أن تتعب عقولها بالتفكير في مثل هذه الأشياء، والكاتب متعاطف معهم؛ لأن الإيمان أسهل مليون مرة من النقد، والتحقق، والتدبر. النقد يحتاج لقراءة ومذاكرة أعمال المفكرين، والفلاسفة، وعلماء البحث التاريخي، وعلماء الطبيعة. وعلى المرء أن يقرأ ما أرخه السابقون، وما عدله اللاحقون، ليفهم تسلسل الأحداث التاريخية، وسبب ظهور التصورات المعاصرة له.
كل هذا متعب جدا، وما على الإنسان القيام بكل هذا إلا إذا كان ممن يحبون القراءة والاطلاع، على كل أنواع الكتب والأبحاث، منذ الصغر. ولكن هناك فئة أخرى، تقوم بفحص مسلماتها، وعلى هذه الفئة أن تتحمل كل ما ستواجهه من شدائد إن أرادت الإعلان عما قد وصلوا إليه بعد عناء طويل. والغريب أن الناس، وخصوصا الفئة الثانية، ينسون أن الفئة الثالثة لم تختلف كثيرا عن سلفهم الذي ابتدع ما يؤمنوا به اليوم، وتراهم يقومون بنفس ما قام به أعداء سلفهم، فيحولون حياة المبتدع إلى جحيم على الأرض.
الحقيقة، كما يعلم الباحث، لا يصل إليها أحد، ولكن يصل الباحث إلى ما هو أقرب للحقيقة. فلا يمكن لباحث أن يترك عمله لصعوبة الوصول إلى الحقيقة، ولكنه يعلم أيضا أن آرائه، غالبا، قد تشذ عما وصل إليه باحثون معاصرون له، وهذا في نظره عادي جدا. الباحث الذي أقصده هو الباحث بالمعنى العام، ليس الباحث الأكاديمي فقط، وهو من يمثل الفئة الثالثة. هؤلاء الباحثون، بالطبع، هم من أندر الفئات التي تعيش بيننا، وذلك لصعوبة ما يتحملونه من أعباء، لا يتحملها إلا نفوس قد عرفت أن الحق لا يصل إليه إلا من قدت ملابسهم في البحث عن المعرفة.
كل هذا الكلام، لم يكن في سبيل تضييع وقت القارئ، بل كان تقدمة لموضوع مازال يتناوله بعض الناس بلا فهم حقيقي؛ فظلموا أولي الفضل منهم حتى صاروا كالغرباء في أوطانهم. والموضوع الذي لم أشرح معالمه وتفاصيله حتى الآن، والذي سبقه كل هذا الكلام، هو موضوع المسجد الأقصى وما كتبه وقاله الأستاذ يوسف زيدان. غضب الناس لإستاذنا الفاضل، مثلما غضبوا بمن أتوا قبله، مما قاله في حلقة مع الإعلامي عمرو أديب؛ لأنه قال إن الإسراء لم يكن إلى مسجد في فلسطين، وإن المعراج، في رأيه، لم يحدث. ووضح في إحدى مقالاته خطأ لغويا في استخدام لفظ المعراج، وفضل لفظ العروج، فقال: «قولهم (المعراج) هو خطأ من حيث فصيح اللغة، فهو اسم آلة مشتق من الفعل عرج، مثلما تشتق من الأفعال الأخرى أسماء آلات، فنقول (مفتاح) من الفعل (فتح) ومثقاب من الفعل (ثقب) ومحراث من الفعل (حرث) ومقياس.. ومهماز، وغير ذلك كثير من الأمثلة الدالة على خطأ لفظ (المعراج) مادمنا لا نقصد اسم إحدى الآلات!.. فالصواب: العروج». وشرح وجهة نظره في سبعة مقالات تم نشرهم في جريدة المصري اليوم. وبعدما قرأت مقالاته، وفرغت من إعادة قرائتها مرة أخرى؛ لأتأكد أني لم أسيء فهمه، أردت أن أكتب هذه المقالة دفاعا عن أستاذنا الجليل، وعن باحث لم يعد في زماننا مثله.
الحقائق التاريخية التي قد أوردها أستاذنا في مقالاته غير قابلة للشك، فقد ترجع إلى كتب المؤرخين باحثا عن ثغرات في ما أورده، ولكنك لن تظفر بشيء. لا تجرب الأستاذ من الناحية العلمية، وهو أعلم منا بأمور التاريخ، وأبحاثه ومنجزاته، وعكوفه على مخطوطاتنا وتراثنا، وفهرسته لها وتحقيقاته، تشهد له بذلك. فكلامه من الناحية الأكاديمية سليم، أمّا رأيه في أن «الربط بين الإسراء والمعراج كان حيلة دعائية سلطوية لترويج أكذوبة نشرها حكام الأمويين لخدمة مصالحهم الخاصة» ، قد تتفق أو تختلف معه فيه وهو يؤكد أنه مجرد رأي وقد يكون مخطئا. وشرح الأستاذ رأيه في مقالة «معضلات العروج وعدالة القضية الفلسطينية» شرحا مفصلا يغنيني عن إعادة شرحه.
ويستفسر من تابع هذه القضية من بعيد؛ فيسأل: «ما هو السبب الذي دفع الدكتور يوسف إلى فتح هذا الموضوع من أساسه، وما هو رأيه في حق الفلسطينيين؟»، وهو سؤال مهم، ورد الأستاذ كان الآتي: « عدالة القضية الفلسطينية تقوم على أسس إنسانية وحضارية، منها النفور من التمييز العنصرى الذى يعامل به اليهود العرب فى أرض فلسطين/ إسرائيل، بدلاً من العيش معاً فى سلام... إن الزعيق والادعاء العقائدى بالحق (الوحيد) فى الأرض، سواءً كان بحسن ظن أو بجهل أو بخبث سياسى، هو عامل تضييع لعدالة القضية الفلسطينية، وعنصر إهدار لحقوق الفلسطينيين الفعلية، وحديث مع العالم المعاصر بلغة لا يفهمها وبشعارات لا يعترف بها إلا الذين يستعملونها ويزعقون بها، قائلين: الأقصى الجريح، القدس الأسير... هذا كله عبث لا يقود إلا لمزيد من البؤس واليأس والمآسى، ولا يخدم إلا أصحاب السلطان وتجار الحرب التى وقودها الأبرياء من الناس... وحسبى أن أقول: علينا، وعلى اليهود والمسيحيين، أن نخرج من هذا النفق المظلم الذى أنفقنا فيه أجيالاً وأموالاً ومصائر ذهبت سُـدى.. علينا أن نشرح للعالم وجه المأساة الفلسطينية بلغة يفهمها، حتى نصل إلى حل نهائى لهذه المشكلة الوهمية.. علينا أن نؤكد المبدأ الإنسانى النبيل: الدين لله والأوطان للجميع».
ولهذا نكتب هذه المقالة، دفاعا عن أهل الفئة الثالثة من الناس، الذين لا يكتفون بما قيل لهم، وقرروا أن يضحوا براحة البال في سبيل توعية الناس، وحقن دماء الأبرياء، والتصدي لأصحاب المصالح والأهواء. نطق الأستاذ بالحق دفاعا عن حق الفلسطينيين ولم ينكره كما ادّعى الأغبياء، بل كان همه تحطيم الأوهام التي تسببت في ضياع القضية الفلسطينية ودعى لإعادة النظر فيها لعرضها بلغة يفهمها العالم المعاصر، لغة إنسانية يعبر فيها البريء عن حقه المسلوب في أرضه. فلا مسجد ولا قدس أقدس من دم البريء، وإن قدس الناس أسطورة، اختلقها السياسي لخدمة مصالحه، وصارت الآن حاجزا بين الحق وأصحابه، فعلى باحث من الفئة الثالثة أن يتكلم.
احمد محمد فرج