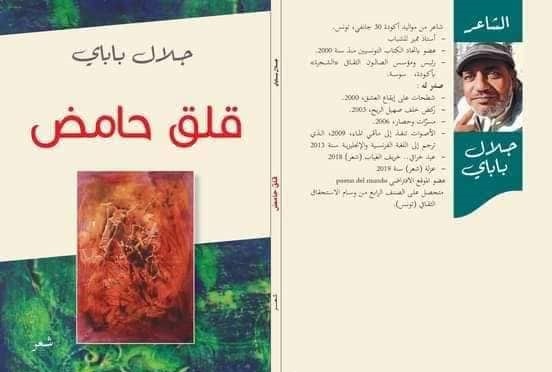قضايا
أسباب ودلالات وَصف يوسف زيدان لصلاح الدّين الأيُّوبي بالشخصية الحقيرة
 "صلاح الدين الأيوبي؛ أحقرُ شخصيةٍ عرفها التاريخ". هذه العبارة التي قالها يوسف زيدان قبل أسبوع؛ لها حمولةٌ سلبية جدا، وانفعالية كذلك، وتنِمُّ عن كُرْهٍ شديد ونِقمة وبُغض دفنيْن في نفسِ قائِلها، وإذا ما رجعنا للسياق الذي قيلتْ فيه، وربطنا مُبتدأ السياق بمستأنَفِه، يمكننا أن نقول بثقة؛ أن هذا الوصف ليس مُصطنعا، بل هو متعمدٌ من جهة، ونوع من التنفيس عن غصة قديمة عالقة وخانقة.
"صلاح الدين الأيوبي؛ أحقرُ شخصيةٍ عرفها التاريخ". هذه العبارة التي قالها يوسف زيدان قبل أسبوع؛ لها حمولةٌ سلبية جدا، وانفعالية كذلك، وتنِمُّ عن كُرْهٍ شديد ونِقمة وبُغض دفنيْن في نفسِ قائِلها، وإذا ما رجعنا للسياق الذي قيلتْ فيه، وربطنا مُبتدأ السياق بمستأنَفِه، يمكننا أن نقول بثقة؛ أن هذا الوصف ليس مُصطنعا، بل هو متعمدٌ من جهة، ونوع من التنفيس عن غصة قديمة عالقة وخانقة.
عندما تقرأ أو تسمع هذه العبارة؛ (صلاح الدين أحقر شخصية عرفها التاريخ) وتربطها بقائِلها؛ تتأكد أنك إزاء شطحة من تلك الشطحات التي يخرج بها علينا يوسف زيدان بين الفينة والأخرى لأغراض مختلفة ومعروفة للقاصي والداني. فزيدان لا يستهدف صلاح الدين الأيوبي في شخصِه؛ وإنما يستهدفه في رمزيَّتَه وقيمَته الاعتبارية لدى الأمة العربية والإسلامية.
فهذا التعبير الذي صدر من الروائي يوسف زيدان؛ ليس أمراً مفاجئا ولا صادما، بل هو تنفيس متدرج ومتباعد بعض الشيء؛ عن إشكالٍ دفين وأزمة تتعدى شخص يوسف زيدان إلى الشخصية المصرية النموذجية أو المثالية إن صحَّ التعبير. فالإشكال هنا يتمثل في اقتحام يوسف زيدان لمجالٍ ليس من تخصصِه؛ إن لم نقل لا يَفقه فيه، وهو التأريخ بمفهومِه العلمي، فيوسف زيدان روائي يقرأ التاريخ من الزاوية العاطفية التأثرية، التي تعينُه على فهم بعض السياقات وبعض الأحداث التاريخية ليوظفها في كتاباتِه الروائية، ويخلق منها أحداثا وشخصيات وحبكة. وللأمانة، فيوسف زيدان ورائي قدير ومُتميّز؛ بل ومتمكن في موضوع السرد، وذو حدس روائي فريد وأسلوب ماتع، ولكنه في المقابل؛ ليس مؤرخا. وهنا يكمن الإشكال، فالتصريحات التي يخرج بها زيدان بين الفينة والأخرى ثاوية في كتابتِها ومُضَمَّنة في ورواياته (النبطي / عزازيل)، ولكن الأدب يظل أدبا؛ وحدودُ تأثيرِه هو الوجدان والعاطفة والمشاعر، أما التاريخ والتأريخ فمبحث خاص، يمكن ليوسف زيدان أن يقتحمَه ويبدل فيه وُسعَه إن هو أراد أن يسوِّق لقناعاتِه وتأويلاتِه في هذا الباب؛ ويعيد قراءة التاريخ وفق تأويلات منطقية قابلة للهضم والاستيعاب، وتتفق مع العقل.
تمكن مشكلة يوسف زيدان وغيرِه من المصريين الحانقين تحديدا؛ في السيرورة التاريخية التي مرت بها مصر؛ خصوصا على المستوى السياسي. فمصر عبر التاريخ كانت محكومة من أقوام وأعراق وطوائفَ وافدة؛ آتية من خارج مصر، وهذا الأمر موجع للذين يتحسسون من هذه المسألة العادية والمتكررة في السيرورة التاريخية للأمم. فكُتُب التاريخ والشواهد الأثرية والحفريات، تكاد تتواطؤ كلُّها وتتفق في وُفُود الحُكم على مصر من الأقطار الخارجية المختلفة، فمنذ التاريخ القديم المرصود لمصر (الفراعنة) اختلفتْ المراجع والشواهد في أصل الفراعنة، فبعض المراجع تؤكد وِفادتهم على مصر من البحر الأبيض المتوسط، وأغلبُ الظن أنهم قدموا من الخط الساحلي الممتد من فلسطين جنوبا إلى لبنان شمالا. وبعض المصادر الأخرى تقول؛ إن النوبيين وفدوا على مصر وأسسوا الحضارة الفرعونية التي امتدت لـ30 أسرة، حكمتْ على مدى 3 ألاف سنة، تخللتْ هذه الفترة حُكم الهيكسوس الذين قدموا من آسيا، لكن حُكمَهم لم يُعمّر طويلا وانبعثَ الحكم الفرعوني من جديد، فيما سُميَّ بالعصر الإمبراطوري. ومع سقوط الإمبراطورية الفرعونية؛ جاء الحُكم الفارسي الأول الذي حوَّل مصر إلى مقاطعة تابعة للفرس، ثم تلاه الغزو الثاني لمصر (الإمبراطورية الساسانية). بعده جاء العصر الهيلينستي، بعد ضم الإسكندر المقدوني لمصر وإنشاء الإسكندرية عاصمة الرومان في مصر، أما الاحتلال الثالث للفُرس؛ فكان بهزيمة البيزنطيين واحتلال الإسكندرية عاصمة الرومان في أرض الكنانة على يد الساسانيين. بعدها بقليل استبدَّ الحكم مرة أخرى للبيزنطيين، وعيَّن هرقل زعيم الروم؛ المقوقسَ حاكما على مصر، ثم جاءت الحقبة الإسلامية وفتح عرب الجزيرة مصر على يدِ عمرِو بن العاص؛ وأنهوا حُكم الإمبراطورية البيزنطية. فأصبحتْ مصر ولاية تابعة لدار الإسلام (الجزيرة العربية)، وتوارث العرب حُكمَها بدءًا من يزيد بن معاوية في العصر الأموي مرورا بأبي العباس السفاح في العصر العباسي، ثم انتقل الحُكم إلى الأتراك بتولي محمد بن طولون حُكم الدولة الطولونية في مصر والشام؛ بعد انفصالِه عن الإمبراطورية العباسية. ثم انبعثتْ الخلافة العباسية الثانية؛ وعُيّن المكتفي بالله (عربي تركي) والياً على مصر، بعدَه؛ أسس محمد بن طغج التركي الإخشيدي الدولة الإخشيدية بمباركة الخليفة العباسي، لتعود مصر للحُكم التركي ما شاء الله أن تعود، ثم خلفَتْها الدولة الفاطمية بزعامة المعز لديني الله الفاطمي (من الجزيرة العربية) الذي أسس أول عاصمة عربية في مصر وهي مدينة القاهرة. ثم قيام الدولة الأيوبية التي نكأ مؤسسُها الناصر صلاح الدين الأيوبي الكُردي (1174/1193)؛ جُرحَ يوسف زيدان، الذي وصَفَه بأحقر شخصية عرفها التاريخ. وصلاح الدين لمن لا يعرفه هو: موحد مصر والشام والحجاز وتهامة واليمن؛ بعد أن أنهى الحُكم الفاطمي في مصر، وقاد صلاح الدين حملات عسكرية متوالية ضد الجيوش الصليبية، واستطاع استعادة القدس ولبنان وفلسطين التي استولوا عليها أواخر القرن الـ11م، وألحق بهم هزائم نكراء كان أشهرَها معركة حطين. وتحفظ كثيرٌ من المصادر الأدبية الأوروبية خصالَ هذا الفارس (صلاح الدين)، وتُمجد تسامحَه وإنسانيته في الأشعار والروايات والقصص والحكايات الشعبية، كما يحظى بتقدير واحترام كبيريْن لدى خصومِه في المعارك؛ وأشهرُهم ملك إنكلترا ريتشارد الأول، خصوصا بعد واقعة حصار قلعة الكرك، وظلتْ هذه الصورة الإيجابية مطبوعة وفي الوعي الجمعي المسيحي والأوروبي إلى اليوم، لكن يوسف زيدان يرى غير ذلك؛ ويصف صلاح الدين بالحقارة على إطلاقِها. وسنفصل القول في هذا بعد أن ننهي سرد وِفَادة الحُكم على مصر من الخارج، والتي نراها (في راينا المتواضع) أنها أهم عوامل نقمتْ زيدان على الرموز العربية والإسلامية بما فيها صلاح الدين الأيوبي.
فبعد الدولة الأيوبية؛ جات دولة المماليك بزعامة عز الدين أيبك؛ الذي تنازلت له شجر الدر (أرملة السلطان الأيوبي) عن الحكم بعد زواجه منها. ثم جاءت الخلافة العثمانية مع سليم الأول وسليمان القانوني؛ إلى حدود علي بيك الأكبر؛ الذي استقل عن الحكم العثماني (وكُلّهم أتراك). ثم انطلقت الحملة الفرنسية على مصر (1796/1801) وحكم نابليون مصر؛ لتعود بعدها الخلافة العثمانية على مصر مع عبد الحميد الأول (التركي).
حَكمتْ أسرة محمد علي باشا (من أصول ألبانية)، إلى حدود 1848م، ثم قامتْ بعدهُ السلطنة المصرية مع حسين كامل تحت إشراف الاحتلال البريطاني، ثم إعلان المملكة المصرية مع الملك فؤاد الأول إلى حدود 1952م؛ الذي شهدت فيه مصر انقلابا على النظام الملكي وبداية حُكم العسكر في مصر.
هذا السرد المقتضب للحُكم الوافد على مصر عبر تاريخها المدوَّن، وبالنسبة لشخص مثل يوسف زيدان الروائي والمهتم بالتاريخ والمخطوطات، يجد مصوغا موضعيا له في الرفض والحقد أو البغض الشديد الذي ينتابه من كل مؤثر خارجي، ولو رجعنا لرواياته سنجد هذا النقص مطروحا بشكل جلي وواضح، فيوسف زيدان يعاني من أزمة البطل في رواياتِه (البطل المصري)، وكلما تعمق في البحث والدراسة اتضح له أن مصر دولة كغيرِها من الدول، أو ربما أقل شأنا حسب الظروف والعوامل والأحداث التي تحكم كل مرحلة على امتداد تاريخ مصر. وأن ما يجول في الوعي الجمعي المصري من أن مصر أم الدنيا ومحورُ العالم؛ وأنها محطُّ أطماع الجميع، لا يجد له داعما أو سندا موضوعيا لا في التاريخ ولا في الواقع. فالبداهة تقول أن الدول القوية تهيمن على الدول الضعيفة أيًّا كانت وحيثما كانت، فانتقل هذا الانكشاف من بعده العاطفي الوجداني السردي (الرواية) إلى العلن؛ عن طريق صدام مباشر، فيوسف زيدان لا يكف عن طرح تفسيرات مختلفة وأحيانا غريبة وغير منطقية لأحداث ووقائع في السيرة والقرآن، يهدف من ورائها إعطاء قراءة مختلفة وتفسيرٍ آخر غير التفسير المشهور والمجمع عليه، لغايات في نفسِه؛ لعلَّ أوضحَها هو إيجاد مسوغ أو تبرير لأزمة البطل المصري الذي يعيشها يوسف زيدان. إلا أنه للأسف تنقصه الأدوات والوسائل لاقتحام هذا المجال، فيوسف زيدان ليس مؤرخا بالمفهومِ العلمي للكلمة؛ بالرغم من أن رواياتِه يغلب عليها السرد التاريخي، وتبدوا وكأنه مُلم بالتاريخ، كما أنه غير متخصص في العلوم الشريعة خاصة علم الحديث، بالإضافة إلى أنه غير متخصص في الأديان، وبالتالي فيوسف زيدان يبني عشَّ نظرياته من أنصاف المعلومات وأجزاء الأحداث؛ ويقمس من التاريخ ما يعتقد أنه يُعينُه على ما يصبوا إليه. وتظل أزمة البطل (الحاكِم) الوافد على مصر وليس المنبعث منها، مسألة مؤرقة ليوسف.
أما طريقة تهجمِه على صلاح الدين الأيوبي، فهو وإن كان مقصودا لأغراض أخرى؛ منها حوز نصيب من الشهرة؛ عملاً بالقولة المشهورة (خالف تُعرَف)، وكذا إلهاء المصريين عن مشاكلهم الكبرى التي تعيشها البلاد، مجاراةً للإعلام الرسمي والخاص في تخدير الرأي العام. وجرّ المجتمع إلى مناقشة هذه الخرجات والانشغال بها بعض الوقت، فإنه كذلك تنفيس عن غيظ وحنق دفين، هذا الغيظ يتعدى شخصية صلاح الدين إلى كلِّ أو أكثر الشخصيات الآتية من خارج أرض الكنانة، والوافدة على مصر لحُكمها وإخضاعِها، وبدرجة أكبر الكُرد والأتراك وبدو الجزيرة العربية. وتتمثل مشكلة زيدان الأكبر؛ فيما (يعتقدُهُ هو) أن الإسلام جرّأ هؤلاء على مصر. فزيدان قد يجد مصوّغا للبيزنطيين والفرنسيين والبريطانيين في حُكم وإخضاع وتطويع مصر؛ باعتبارِهم دولا لها حضارات ضاربة في التاريخ، وباعتبارِهم ملوكا وأباطرة أيضا، ولكن أن يحكُم مصر مغمورون آتون من الحجاز وبلاد كنعان والتركمان ومن مجاهل الصحراء؛ فهنا يمكن المشكل. ولمن أراد العودة لرواية النبطي سيكتشف هذا المعطى بجلاء حول تبادل وتناوب الحُكم على مصر من قوى خارجية، وتتبأر شخصية ماريةفي الرواية حول أرض مصر؛ مجسدة إياها بكل ما تعيشه هذه الشخصية من ارتدادات متتالية، إذ إن مارية القبطية تمثل رمز الامتهان والظلم والحرمان؛ لدرجة أنها تخلتْ عن اسمها في نهاية المطاف؛ ليصير ماوية بدل مارية، وتخضع لرجل عربي حجازي بدويّ قاسٍ؛ آتٍ من مجاهل الصحراء، كدلالة على ولادة حاكِم آخر جديد يفِدُ على مصر من خارج رحمِها، صحيح أن للقارئ هامشا كبير في تأويل النصوص الأدبية بحسب ما يتيسر له من أدوات التحليل والتأويل والقراءة، واعتبار مارية كناية عن مصر قراءةٌ معقولة؛ تتوافق مع سير الأحداث من بداية الرواية إلى نهايتِها، فالشخصيات في الرواية تحتمل أن تكون أنسنة للأحواز والنطاقات الجغرافية والأمصار (مصر/الجزيرة العربية / بلاد فارس/ بلاد القوقاز ..)
قد يقول البعض؛ لماذا هذا التمرد على الرموز العربية والإسلامية والأحداث والوقائع التاريخية التي لها اعتبار خاص في الوجدان العربي وفي وعيه الجمعي ؟؟. في حقيقة الأمر؛ إن أزمة البطل في وطننا العربي لاحت منذ سقوط القدس زمن النكبة، وحاولت كثير من الشخصيات ملء هذا الفراغ، وتسويق نفسِها على أنها البطل العربي والقومي الأوحد، حاول ذلك عبد الناصر والسادات والأسد وصدام و..؛ ولكن كل هذه الشخصيات كانت أبعد ما تكون عن شغل هذا الموقع وملء فراغه، وعجزت تماما عن تسويق نفسِها في ظل انقسام الدول العربية، وتضارب مصالِحها السياسية والاقتصادية. فلم يكن بداً من استدعاء البطل التاريخي ليملأ هذا الفراغ، فظلت شخصيات من أمثال عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد والقعقاع وصلاح الدين الأيوبي وعمر المختار وعبد الكريم الخطابي،... وغيرُهم. فكان لابد من تشويه صورة هؤلاء الرموز؛ وإعادة تشكيل بطل جديد في مخيلة ووعي الإنسان العربي. اعتمادا على تدني مستوى التعليم؛ وجهل الأجيال الناشئة بهؤلاء الأعلام والأبطال التاريخيين وانتصاراتهم. ومن الواضح أن يوسف زيدان قد كثم هذا الحنق مدة ليست بالقصيرة، فكانت كمن صمت دهرا ونطقا كفرا؛ وقد هيَّأت له الأوضاع المصرية الحالية الظروف المناسبة للانفجار والبوح.
من حق يوسف زيدان تقديم قراءته المخالفة للشخصيات والأحداث التاريخية، ولكن من باب البحث العلمي وبالوسائل الأكاديمية، عندها فقط يمكن ليوسف زيدان وغيرِه أن يضرب عصفورين بحجر واحد؛ أن يُقدم طرحه ورؤيتَه للنقاش والتداول من جهة، وأن يحوز نصيبا من الشهرة والإشهار لأعماله، وربما فتح له هذا بابا للحصول على إحدى الجوائز الوازنة. أما التعرض بالقذف للرموز التاريخية التي لها اعتبارات خاصة في وعي ووِجدان الإنسان العربي والمسلم، فما هكذا تُنال الشهرة يا يوسف.
الحسين بشوظ / كاتب من المغرب