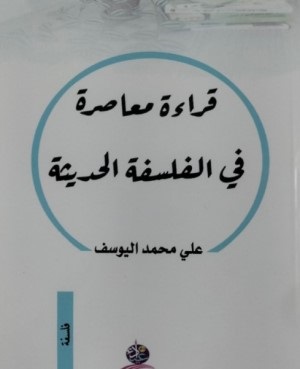قضايا
أوهام أيديولوجيا حركة التحرر العربية (2-4)
 دعونا ننظر الآن في أوهام هذه المشاريع الأيديولوجية كل على حدا متناولين بداية المشروع الاشتراكي.
دعونا ننظر الآن في أوهام هذه المشاريع الأيديولوجية كل على حدا متناولين بداية المشروع الاشتراكي.
أولاً: المشروع الاشتراكي:
قبل الخوض في مضمار هذا المشروع، لا بدنا لنا من الإشارة هنا إلى أن هذا المشروع قد مثل حَمَلَتُهُ أساساً بعض الأحزاب الشيوعية في عالمنا العربي، كما هو في تجربتي الحزب الشيوعي في العراق واليمن، وهما تجربتان لم تستمرا طويلاً في الحكم ليس هنا مجال بحثها. بيد أن الأهم في تناول هذا المشروع هو أنظمة الأحزاب التي ربطت النضال القومي بالنضال الاشتراكي في عالمنا العربي، والتي استمرت في حكمها عقود عدة. وإذا كنا قد فَصَلنَا معالجة المشروع الاشتراكي عن المشروع القومي في هذه الدراسة، فهذا يأتي من باب النمذجة النظرية لا أكثر.
على العموم، إن نظرة واقعية إلى سيرورة وصيرورة المجتمعات أو الدول أو الأحزاب التي تبنت المشروع الاشتراكي طريقاً للتنمية في عالمنا العربي، تُبين لنا وبكل وضوح أن هذه المجتمعات أو الدول لم تحقق شروط الانتقال من مرحلة ما قبل الاشتراكية إلى الاشتراكية وفقاً لجوهر مقولة ماركس في مقدمة كتاب (مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي) المشار إليها أعلاه، حيث تبين أن تبني شعار أو مبدأ (حرق المراحل) ومحاولة تطبيق الاشتراكية من خلاله لم يرتق أو يحقق في الواقع شروط تطبيق هذا الشعار أو المبدأ الذي اثبت فشله على مستوى المنظومة الاشتراكية برمتها. فعلى مستوى الداخل، تحول المشروع الاقتصادي الاشتراكي للدولة إلى مشروع (رأسمالية الدولة)، وهو المشروع الذي فقد منذ البداية قيادته الحقيقة، أي حوامله الاجتماعية ممثلة بـ (القوى العاملة) صاحبة المصلحة الحقيقية في قيادة هذا المشروع و تطبيق أهدافه التنموية في المجتمع، والسبب هو ضعف وجهل وانحراف الكثير من قيادات هذا المشروع من البرجوازية الصغيرة الممثلة لقوى الشعب العاملة، حيث استغلت هذه القوى مواقعها القيادية في الدولة والحزب لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصالح الشعب، وحولتها شهوة السلطة وغنائمها إلى برجوازية بيروقراطية وطفيلية. أما على المستوى السياسي، فقد تحولت الدولة الاشتراكية التي بشرت بالحرية والعدالة والمساواة ودولة القانون والتعددية السياسية وتطبيق الديمقراطية الشعبية والعلمانية، إلى دولة عشيرة وقبيلة وطائفة وقائد فرد، الأمر الذي حولها إلى دولة شمولية في أعمق صورها، راحت تمارس بإسم الحزب - الذي افتقد إلى الكثير من مقوماته الفكرية والتنظيمية الثورية إضافة لظلمها واستعبادها الجماهير الكادحة نفسها التي بشر المشروع الاشتراكي نفسه للنهوض بها وبعدالتها وانسانيتها، فبدلاً من أن تمارس هذه القوى المسحوقة دورها في قيادة الدولة والمجتمع وفرض رقابتها من خلال تنظيماتها النقابية ومنظماتها الشعبية والفسح لها في المجال واسعاً للممارسة الديمقراطية وتحمل المسؤولية في بناء الدولة والمجتمع، نرى العكس تماماً، حيت تحول الحزب الحاكم الممثل لهذه القوى ومنظماتها ونقاباتها ومؤسسات دولتها إلى حزام ناقل لخدمة القوى الحاكمة الفعلية من أجل استمراريتها في السلطة، وتحولها إلى قوى تمارس هي ذاتها أبشع انواع القهر والظلم والفساد والاقصاء للآخر المختلف معها كقوى حاكمة متفردة بالسلطة، أو مع توجهاتها السياسية والفكرية والاقتصادية داخل الدولة والمجتمع. أما على المستوى الاجتماعي فقد تم تجذير وبلورة كل البنى التقليدية من عشائرية وطائفية ومذهبية وقبلية، بدلاً من العمل على تخفيف حدتها أو تلافي تأثيرها على بنية الدولة والمجتمع، والسعي للعمل بجدية من أجل بناء المواطنة ودولة القانون والمؤسسات. وقد جاء هذا التجذير للبنى التقليدية تحت مظلة سياسات انتهازية ارضائية غلب عليها طابع التسويات مع زعماء أو ممثلي هذه القوى التقليدية، من أجل كسب ود رؤساء العشائر والقبائل ومشايخ الطرق الدينية وغيرهم لدعم السلطة القائمة، هذا في الوقت الذي تعمل فيه هذه (الأنظمة الشمولية) عبر سياساتها الانتهازية هذه على إظهار السلطات الحاكمة وأحزابها الاشتراكية من خلال إعلامها ومهرجاناتها ومؤتمراتها، بأنها حكومات ديمقراطية شعبية، علماً أن الانتخابات التي تجريها هذه الأنظمة بإسم أو تحت يافطة (الديمقراطية الشعبية) كانت شكلية أو صورية، وهي انتخابات يراعي فيها اختيار الممثلين الذين تريدهم القيادة ويكونوا محط ثقتها، ومن صفوف الانتماءات العشائرية والقبلية والدينية والمناطقية التي تشتغل على وترها السلطة الحاكمة، دون مراعاة لقدرات وإمكانيات ذوي الكفاءة من الشخصيات الحزبية وغير الحزبية التي ترشح نفسها، أو ترغب المساهمة في نشاط هذه المؤسسات الدستورية أو الحزبية أو النقابية. علماً أن هذه الانتخابات راحت تبهت صورتها وفعاليتها ولم يعد لها ذاك الدور الذي بشرت به عند وصولها إلى السلطة، لذلك لم تعد تلقى ذاك الاهتمام الجماهيري والحزبي وقد قاطعا اليمين واليسار والوسط معاً، مما اضطر القوى الحاكمة اللجوء إلى التزوير في هذه الانتخابات وإظهار النسب العالية للمنتخبين أمام الرأي العام العربي والدولي.
أما على مستوى معوقات الخارج فقد كان للقوى الامبريالية والرجعية العربية، الدور الكبير أيضاً في محاربة الأنظمة الاشتراكية ومحاصرتها على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد افلحت في ذلك الدول الامبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومن يساند سياستها من المركب الرجعي العربي، من خلال الحرب الباردة أو الساخنة لهذه الدولة أو تلك من دول المنظومة الاشتراكية في عالمنا العربي.
ملاك القول في هذا الاتجاه: إن القفز فوق الواقع وعدم البحث عن المخزون العقلاني في الاشتراكية ذاتها، ومحاولة استنباط وتطبيق ما يتفق أو يتطابق منها مع خصوصيات الواقع المعيوش من جهة، ثم تجيير هذا المشروع لمصلحة قوى سياسية حزبية أو عشائرية أو طائفية على حساب مصالح الشعب من جهة ثانية، وأخيراً الموقف المعادي للقوى الإمبريالية والرجعية العربية من جهة ثالثة ساهم في إسقاط هذا المشروع وحوله إلى يوتوبيا على يد حوامل اجتماعية هي ليست حوامله، لا من حيث الوعي بالمنهج العلمي الخاص به، ولا بالنظرية الاشتراكية ومسألة تطبيقها، ولا من حيث المسؤولية الأخلاقية والوطنية والتاريخية لدى الكثير من قيادة هذه المشروع.
إن هذا التشويه الحقيقي لفهم وتطبيق المشروع الاشتراكي في معظم الدول التي تبنت الطريق الاشتراكي في التنمية داخل عالمنا العربي، خلق أو أضاف معوقات تنموية أكثر تعقيدا في واقع هذه الدول، تمثلت في خلق أو وجود توجه سلطوي لا عقلاني عمل على إهدار الاستقلال والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي في الدول التي تبنت هذا الطريق في التنمية، وذلك من خلال منع التعددية السياسية، واتباع سياسات التطهير والتصفية الدموية أحياناً للمناوئين أو المختلفين سياسيا، وكذلك في احتكار السلطة، وعسكرتها، وإلغاء حرية الصحافة، وسيطرة نموذج القائد الكاريزمي في الدولة والحزب، وغير ذلك من ممارسات بعيدة كل البعد عن روح النظرية الاشتراكية، وما تمثله من مبادئ الديمقراطية والحرية والعدالة والعلمانية ودولة القانون والمواطنة التي رفعتها هذه الأحزاب الاشتراكية قبل وعند استلامها السلطة كما قلنا قبل قليل.
نقول: إذا كان هذا هو مصير المشروع الاشتراكي، فإن دراستنا التالية ستتناول المشروعين الاخرين وهما القومي والإسلامي، وتبيان أسباب فشلهما أيضا، ًلأنهما المشروعان الأكثر حضوراً وفعالية في الساحة الفكرية والعملية في عالمنا العربي، علماً أن حملة المشروع القومي هنا وأحزابه وتطبيقاته العملية قد شاركها في حمله حملة المشروع الاشتراكي من الأحزاب الديمقراطية الثورية، مع تأكيدنا بطبيعة الحال على الدور الكبير الذي لعبته الأحزاب الشيوعية وحتى الديمقراطية الثورية في نهوض حركة التحرر العربية على مستوى الفكر والممارسة إثناء الصراع مع المستعمر الأوربي والصهيوني، أو الصراع ضد القوى البرجوازية وبقايا الاقطاع الذين سيطروا على الحكم في العديد من الدول العربية بعد طرد المستعمر، وما حققه هذا الصراع من تأسيس لمفاهيم الحرية والعدالة ومصالح القوى العاملة وغير ذلك، ولكن ظلت لتلك الأحزاب أمراضها السياسية والتنظيمية والمنهجية أيضاً، ويأتي في مقدمتها: عبادة الفرد، وسيطرة المركزية على الديمقراطية، وتحول بعض هذه الأحزاب في بنيتها التنظيمية إلى أحزاب أثنية أو قبلية، وبالتالي تفجير تناقضات عميقة في داخلها ساهمت في تفتيتها وإضعافها.
قبل أن ندخل في نقدنا لمشروعي الأيديولوجيا القومية والإسلامية يمكننا القول إضافة لما جئنا عليه: إن الكثير من الكتاب والمفكرين النهضويين العرب، وكذلك سياسيي الأحزاب الديمقراطية الثورية، أو الإسلام السياسي، الذين تبنوا هذه المشاريع، غالباً ما تناولوها من منطلق أيديولوجي جمودي تشوبه أو تغلفه العاطفة والوجدانيات والحنين إلى الماضي الذي لم يدس بعد في أبعاده المختلفة دراسة موضوعية وعقلانية. أي لم تعاد كتابة ماضي هذه الأمة برؤية عقلانية، عدا محاولات فردية من قبل بعض المفكرين العرب الذين لم يصلوا رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها في هذا الاتجاه إلى قواسم مشتركة تجاه قضايا الماضي، بل على العكس كثيراً ما أدت هذه المحاولات إلى خلق صراعات فكرية بين طارحيها ظلت امتداداً لصراعات العصور الوسطى في عالنا العربي أثناء وجود الخلافة الإسلامية، ولا نبالغ إذا قلنا ان حالة الصراع هذه وصلت عند البعض إلى درجة الشخصنة كما هو الحال بين الجابري والتيزيني. وبتعبير آخر، أي اتخذوا من الأيديولوجيا في صيغتيها الواسعة (المادية والمثالية)، أو من العاطفة القومية أو الإسلامية منطلقاً في تحليل الأزمة و طرح حلول تجاوزها، وذلك يعود برأيي إلى جهل معرفي (ابستمولوجي) في طبيعة هذه الأزمة والظروف الحقيقة الداخلية والخارجية التي تكمن وراءها وكذلك معرفة آلية عملها، مع تأكيدنا على تلك الجهود الكبيرة التي بذات في هذا الاتجاه من قبل الجابري في (نقد العقل العربي)، والتيزيني في مشروعه (من التراث إلى الثورة)، وحسن حنفي في مشروعه الإسلامي (التراث والتجديد)، وحسين مروة في (نزعاته المادية في الفلسفة العربية الإسلامية)، وغير ذلك من مشاريع.
إن الأيديولوجيا على سبيل المثال عندما تُستخدم عتلة نهضوية في مجتمع لم يحوز بعد على الظروف الموضوعية والذاتية التي تستطيع استلهامها، أو تكون هذه الظروف ذاتها هي المنتجة لها، ستظل هذه الأيديولوجيا حكماً في حالة طيران أو مفارقة للواقع، أي تظل بعيدة عن متطلبات الواقع ومطابقة قضاياه، وهنا ستتحول المشاريع الفكرية من خلال حملة مشروعها السياسي إن كان عبر الأحزاب والتنظيمات السياسية، أو عبر الكتاب والمفكرين غير الحزبيين عند تطبيقها، إلى وسيلة نهضوية تستخدم قسراً لتغيير الواقع أو ليّ عنقه، وخاصة إذا كانت الحوامل الاجتماعية لهذا المشروع أو ذاك غير حوامله الحقيقيين المعبرين عن مصالح الجماهير الحقيقية في المرحلة التاريخية المعيوشة، الأمر الذي سيزيد من تعقيد هذا الواقع وتعميق أزمته بدلاً من إفراجها. وهذا ما تجلى بكل وضوح في محاولات التطبيق العملي القسري لهذه الأيديولوجيات على الواقع العربي وفقاً لمبدأ (سرير بروكوست) في بعض التجارب الوحدوية السابقة. أي محاولة ليّ عنق الواقع العربي من قبل هذه الحوامل كي ينسجم مع هذه الأيديولوجيات موضوع البحث ومصالح حواملها الاجتماعيين.
إذن إن التعويل على أي مشروع فكري (أيديولوجي)، متعالي على الواقع - أي لا يشكل وعياً مطابقاً للواقع - من أجل تجاوز تخلف هذا الواقع وخلق نهضة فيه، هو غير قادر بالضرورة على تفسير هذا الواقع وتحليل أوالية عمله (الميكانزيم)، وبالتالي هو محاولة للي عنق الواقع كما أشرنا قبل قليل، وفرض حلول لمشاكله من الأعلى. أي محاولة تغييره برؤى فكرية ذات طابع مثالي أو براغماتي سطحي بالغالب، يعتقد حملتها أن هذه الرؤى الفوق تاريخية هي وحدها القادرة على تقديم الوصفات الجاهزة لكل زمان ومكان دون أي مراعاة لخصوصيات الواقع وطبيعة حركته وتطوره وتبدله، وهذا ما سيساهم بلا شك في تعميق أزمة هذا الواقع والأيديولوجيا المتعاملة معه معاً كما بينا عند تناولنا مسألة المشروع الاشتراكي.
ومع ذلك لا يمكننا أن نتجاهل أيضاً ما حققه كل من المشروعين الاشتراكي والقومي من قضايا إيجابية على الساحة العربية، وبخاصة على المستوى الثقافي والفكري والسياسي والاجتماعي عند استلام الأحزاب الديمقراطية الثورية التي ربطت ما بين المشروعين القومي والاشتراكي، حيث لم تزل آثارها قائمة وفاعلة في حياة الدول التي استلمت فيها هذه الأحزاب السلطة، بالرغم من النتائج السلبية التي دمرت الكثير من هذه المنجزات، والتي ظهرت مع ثورات الربيع العربي التي فقدت سماتها الثورية كون حملتها وقعوا في العقلية الإقصاء والوصاية ذاتها التي مارستها تلك الأحزاب الحاكمة عليها والتي ثاروا أصلاً ضدها، وبالتالي هذا ما يدفعنا للقول مع "إنجلز": إن نظاماً (فكرياً) للطبيعة والتاريخ يشمل كل شيء، ويعين نهاية كل شيء مرة واحدة، سيتناقض مع القوانين الأساسية للفكر الديالكتيكي (الجدلي)، ولكن هذا لا يمنع أبداً، بل بالعكس يفرض أن تخطو المعرقة المنظمة لمجموع العالم الخارجي من جيل إلى جيل خطوات جبارة). (1) وهذه الخطوات لا شك أن المشروعين الاشتراكي والقومي قد حققاها على الساحة العربية، بالرغم من كل الدمار الذي حل بهذه الخطوات بسبب رعونة وجهل قادت ثورات الربيع العربي.
انطلاقاً من هذا الموقف المنهجي سنقف هنا عند هذين المشروعين الأيديولوجيين الأساسيين الذين شملا عند حملتهما كل شيء ونهاية كل شيء وعوّل على حلتهما نهضة هذه الأمة وتحررها.
د. عدنان عويّدِ