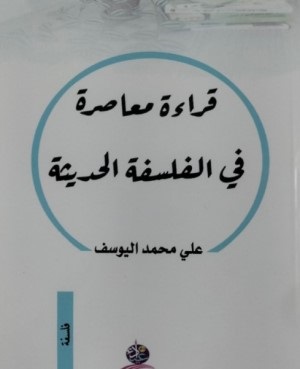قضايا
أوهام أيديولوجيا حركة التحرر العربية (3-4)
 ثانياً: أيديولوجيا المشروع القومي: على الرغم من أن الشعور القومي المتعلق بالهوية العربية كمشروع سياسي يعمل على إثبات الذات أو الهوية كحالة ثقافية إلى جانب كونها حالة سياسية، تعود إرهاصاتها الأولية مع بدء ظهور الحركة الشعوبية في تاريخ الدولة العربية الإسلامية في عصرها الوسيط، إلا أن المسألة القومية كمشروع سياسي يدعو إلى التحرر من الاستعمار العثماني وبناء وحدة العرب، أخذت تظهر فكرياً وسياسياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، وخاصة مع ظهور المسألة الشرقية وازدياد حدة الاختراق الغربي للعالم العربي في مشرقه بشكل خاص، حيث رحنا نلمس تلك الأصوات المنادية بالقومية العربية، وتأكيد شخصيتها من قبل بعض الكتاب والمفكرين العرب المسيحيين على وجه الخصوص، الذين درسوا في المدارس التبشيرية وتابعوا دراساتهم في الغرب وتأثروا بالحضارة الغربية وفكرها القومي من جهة، أو برغبة استعمارية لا ضعاف الدولة العثمانية خدمة لمصالح الغرب من ناحية ثانية. بيد أن هذا الفكر القومي المعبر عن طموحات العرب السياسية أخذ يتبلور أكثر فأكثر مع بدء ظهور حزب الاتحاد والترقي ونزعته الطورانية، الأمر الذي دفع الكثير من النخب الفكرية والسياسية آنذاك من المسيحيين والمسلمين العرب للمطالبة بضرورة منح العرب حريتهم واستقلالهم والتأكيد على عروبتهم قبل أية صبغة اخرى. ثم راح هذا المشروع القومي يتصاعد شيئاً فشيئاً مع قيام الثورة العربية الكبرى واتفاقية سايكس – بيكو ووعد بالفور. فهذه القضايا الثلاثة لعبت دوراً كبيراً في دفع المشروع القومي إلى الأمام، حيث رحنا نجد منذ العقد الثاني للقرن العشرين العديد من الدراسات المتعلقة بمفهوم الأمة والقومية وسماتها وخصائها ومقوماتها وعلاقة القومية بالإسلام والعلمانية وغير ذلك،. بل بدأت تعقد الندوات والمؤتمرات وتقام التنظيمات السياسية المتبنية للمسألة القومية فكراً وممارسة، وراحت تظهر الصحف والمجلات المعبرة عن هذا المشروع. هذا مع تأكيدنا بأن معظم الرؤى والأفكار التي اشتغلت على موضوع القومية منهجاً وفكراً وممارسة، ظلت بعيدة عن الرؤية العقلانية أو المنهجية العلمية في تناول هذا الموضوع، وقد غلب على رؤاها ومناهجها ومواقفها السياسية الطابع العاطفي والوجداني والارتجالي، أكثر من غلبة الجانب العقلاني والموضوعي الذي يرمي إلى تحليل الواقع الذي طرحت فيه المسألة القومية تحليلاً موضوعياً، ودراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية دراسة علمية تبين دور كل عامل من هذه العوامل وتأثيره على مسألة القومية، كما سنشير إلى ذلك في موقع لا حق من هذه الدراسة.(2). وهذا يعني في التحليل المادي الجدلي للظاهرة القومية، غياب الشروط الموضوعية والذاتية التي تساعد منطقياً على إنتاجها – أي القومية - وتطبيقها عملياً في الواقع العربي. وعلى هذا الأساس، لا نستغرب أن نجد فيما بعد حتى القوى السياسية من العرب (المسلمون والمسيحيون) المنضوية تحت راية الأحزاب القومية التي تشكلت في فترة ما بين الحربين أو بعد قيام الحرب العالمية الثانية، ظلت المسألة القومية تُمارس من قبل الكثير من هذه القوى السياسية، فكرياً وعملياً بالطريقة الشعاريه الشعبوية ذاتها، تحت ضغط شهوة السلطة التي دفعت قيادات هذه الأحزاب إلى التركيز على توصيف المشروع القومي وأهدافه، أكثر بكثير من تحليل ظروف تطبيقه ودعم حوامله الاجتماعية والتضحية من أجله من جهة، ثم بسبب طبيعة واقع السياسات القطرية الأنانية الضيقة ومن يمثلها من القوى الحاكمة التي ركزت على القطرية في نهج سياساتها ونشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية من جهة ثانية.
ثانياً: أيديولوجيا المشروع القومي: على الرغم من أن الشعور القومي المتعلق بالهوية العربية كمشروع سياسي يعمل على إثبات الذات أو الهوية كحالة ثقافية إلى جانب كونها حالة سياسية، تعود إرهاصاتها الأولية مع بدء ظهور الحركة الشعوبية في تاريخ الدولة العربية الإسلامية في عصرها الوسيط، إلا أن المسألة القومية كمشروع سياسي يدعو إلى التحرر من الاستعمار العثماني وبناء وحدة العرب، أخذت تظهر فكرياً وسياسياً منذ منتصف القرن التاسع عشر، وخاصة مع ظهور المسألة الشرقية وازدياد حدة الاختراق الغربي للعالم العربي في مشرقه بشكل خاص، حيث رحنا نلمس تلك الأصوات المنادية بالقومية العربية، وتأكيد شخصيتها من قبل بعض الكتاب والمفكرين العرب المسيحيين على وجه الخصوص، الذين درسوا في المدارس التبشيرية وتابعوا دراساتهم في الغرب وتأثروا بالحضارة الغربية وفكرها القومي من جهة، أو برغبة استعمارية لا ضعاف الدولة العثمانية خدمة لمصالح الغرب من ناحية ثانية. بيد أن هذا الفكر القومي المعبر عن طموحات العرب السياسية أخذ يتبلور أكثر فأكثر مع بدء ظهور حزب الاتحاد والترقي ونزعته الطورانية، الأمر الذي دفع الكثير من النخب الفكرية والسياسية آنذاك من المسيحيين والمسلمين العرب للمطالبة بضرورة منح العرب حريتهم واستقلالهم والتأكيد على عروبتهم قبل أية صبغة اخرى. ثم راح هذا المشروع القومي يتصاعد شيئاً فشيئاً مع قيام الثورة العربية الكبرى واتفاقية سايكس – بيكو ووعد بالفور. فهذه القضايا الثلاثة لعبت دوراً كبيراً في دفع المشروع القومي إلى الأمام، حيث رحنا نجد منذ العقد الثاني للقرن العشرين العديد من الدراسات المتعلقة بمفهوم الأمة والقومية وسماتها وخصائها ومقوماتها وعلاقة القومية بالإسلام والعلمانية وغير ذلك،. بل بدأت تعقد الندوات والمؤتمرات وتقام التنظيمات السياسية المتبنية للمسألة القومية فكراً وممارسة، وراحت تظهر الصحف والمجلات المعبرة عن هذا المشروع. هذا مع تأكيدنا بأن معظم الرؤى والأفكار التي اشتغلت على موضوع القومية منهجاً وفكراً وممارسة، ظلت بعيدة عن الرؤية العقلانية أو المنهجية العلمية في تناول هذا الموضوع، وقد غلب على رؤاها ومناهجها ومواقفها السياسية الطابع العاطفي والوجداني والارتجالي، أكثر من غلبة الجانب العقلاني والموضوعي الذي يرمي إلى تحليل الواقع الذي طرحت فيه المسألة القومية تحليلاً موضوعياً، ودراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية دراسة علمية تبين دور كل عامل من هذه العوامل وتأثيره على مسألة القومية، كما سنشير إلى ذلك في موقع لا حق من هذه الدراسة.(2). وهذا يعني في التحليل المادي الجدلي للظاهرة القومية، غياب الشروط الموضوعية والذاتية التي تساعد منطقياً على إنتاجها – أي القومية - وتطبيقها عملياً في الواقع العربي. وعلى هذا الأساس، لا نستغرب أن نجد فيما بعد حتى القوى السياسية من العرب (المسلمون والمسيحيون) المنضوية تحت راية الأحزاب القومية التي تشكلت في فترة ما بين الحربين أو بعد قيام الحرب العالمية الثانية، ظلت المسألة القومية تُمارس من قبل الكثير من هذه القوى السياسية، فكرياً وعملياً بالطريقة الشعاريه الشعبوية ذاتها، تحت ضغط شهوة السلطة التي دفعت قيادات هذه الأحزاب إلى التركيز على توصيف المشروع القومي وأهدافه، أكثر بكثير من تحليل ظروف تطبيقه ودعم حوامله الاجتماعية والتضحية من أجله من جهة، ثم بسبب طبيعة واقع السياسات القطرية الأنانية الضيقة ومن يمثلها من القوى الحاكمة التي ركزت على القطرية في نهج سياساتها ونشاطاتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية من جهة ثانية.
وقبل الدخول في عالم هذه الأحزاب القومية وممارساتها للنشاط القومي، دعونا نقف قليلاً عند أبرز المواقف القومية ممثلة في ندواتها ومؤتمراتها وحركاتها السياسية عند المثقفين العرب، التي ظهرت منذ الربع الأول للقرن العشرين على الساحة العربية بسبب تأثير التبشير والمدارس التبشيرية اولاً، ثم الثورة العربية الكبرى واتفاقية سايكس – بيكو ووعد بلفور ثانياً.
لقد كان هناك (حركة الأعيان السوريين)، التي تشكلت ما بين عامي، / 1877- 1878/، على يد خمسة من المسيحيين السوريين العرب، وعضوية الكثير من النخب المسيحية المثقفة بداية، والتي كانت تعمل على استقلال سورية ولبنان من الاحتلال العثماني، ثم تحصينهما من السيطرة الأوربية خاصة بعد انتصار روسيا عام 1877- 1878 على تركيا، الأمر الذي دعا هذه النخب المسيحية التي انظم إليها فيما بعد نخب إسلامية مثقفة لعقد مؤتمرها الأول عام /1878/ بقيادة "أحمد باشا الصلح"، حيث تقرر في هذا المؤتمر، المطالبة باستقلال البلاد الشامية وتتويج المجاهد الجزائري "الأمير عبد لقادر" ملكاً عليها، مع اشتراط المؤتمرين الإبقاء على الرابطة الروحية مع الدولة العثمانية. (3). فبعد المطالبة بهذا الموقف السياسي في بعده القومي المقتصر على البلاد الشامية من قبل (حركة الأعيان السوريين)، يمكننا القول وبثقه عالية، إن مسألة الفكر القومي بدأت تأخذ طابعا شبه مؤسساتي أو تنظيمي إلى حد ما، رداً على السياسة الطورانية، وعلى اتفاقية سايكس بيكو السيئة الصيت. هذا وقد تمثل هذا الطابع المؤسساتي في تلك الجمعيات الأدبية والسياسية والمؤتمرات التي عقدها الكتاب والمفكرون والسياسيون العرب مسلمون ومسيحيون.
كمؤتمر باريس العربي / 1913/، الذي طرحت فيه قضية الوجود العربي والشخصية العربية المستقلتين، وشخصية الآمة العربية الواحدة.
وفي فترة ما بين الحربين، راحت تتجذر حركة القومية العربية بسبب النضالات السياسية التي خاضها المناضلون العرب من كتاب وسياسيين في الداخل والخارج، للحصول على الاستقلال بعد سايكس –بيكو وظهور مشروع الدولة الصهيونية، حيث راحت الفكرة القومية في هذه الفترة تنتشر أكثر بين الجماهير وتتجاوز النخب السياسية والفكرية، فكان مؤتمر القدس / 1919/ في دمشق، استجابة لهذا الانتشار ولهذا لتحدي الصهيوني، تأكيدها على الأهداف العربية في الاستقلال التام، وقيام الوحدة العربية، وبناء دولة عربية مستقلة، ورفض أي ادعاء صهيوني في فلسطين.
في عام / 1931/ عقد مؤتمر القدس الذي ضم أعداداً كبيرة من القيادين والسياسيين والمثقفين العرب، ومن مختلف الحركات القومية العربية، وقد أعلن في هذا المؤتمر: اعتبار البلاد العربية وحدة تامة لا تتجزأ ورفض كل ما طرأ عليها من أشكال التجزئة. كما دعا إلى توحيد الجهود في كل قطر عربي لتحقيق الاستقلال التام، ومحاربة كل فكرة تدعو إلى الاقليمية السياسية.
أما في عام / 1933/ فقد عقدت (عصبة العمل القومي) في لبنان، والتي اعتبر وجودها من الناحية السياسية تحولا هاماً وكبيراً بالنسبة للخطاب القومي العربي فكراً وممارسة. هذا وقد أعلن في هذا المؤتمر، أن أهداف الاستقلال العربي هي: رفض إخضاع العربي للسيطرة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والثقافية. ورفض اتخاذ البلاد العربية نقطة لانطلاق وتوسع السيطرة الأجنبية على أسيا وافريقيا.
وفي عام / 1934/ وبدعوى من الحزب الشيوعي السوري وعصبة العمل القومي بعد أن تحولت هذه العصبة إلى حزب عربي وطني تقدمي، وبمشاركة اكثر /30/ مندوباً من مختلف الاتجاهات القومية عقد مؤتمر زحلة وأبرز ما طرح فيه: محاربة أعداء الأمة العربية ممثلين بالاستعمار والقوى الرجعية العربية والتعصب الديني والفقر والجهل والنضال ضد الصهيونية باعتبارها أداة الامبريالية للسيطرة على المنطقة، وتطوير الثقافة والتمدن بين صفوف أبناء الأمة العربية، كما تم توضيح أبعاد التجزئة وحدود الوطن العربي، والتركيز على قضية الأمة العربية الواحدة كحقيقة قومية جوهرية من أجل إيقاظ وتنظيم قوى الأمة العربية وإقامة دولة عربية موحدة مستقلة متحضرة. (4).
وفي النصف الأول من القرن العشرينً، بدأت تتشكل أحزاب قومية ذات توجهات عرقية وجغرافية مختلفة، فمنها من كانت له توجهات قومية ضيقة كالفينيقية والقومي الاجتماعي السوري والفرعونية، ومنها من له أبعاد قومية شملت كل الساحة العربية كحزب البعث العربي الاشتراكي في سورية وحزب الاستقلال في العراق، وحزب النداء القومي اللبناني، والاتحاد الاشتراكي العربي الذي تأسس في مصر بعد فشل مشروع الوحدة بين مصر وسورية، ثم الكثير من الأحزاب الناصرية وغيرها.
قراءة نقدية في الخطاب السياسي / الأيديولوجي للقومية العربية:
بعد هذا العرض الأولي لأهم المحطات التي الفكرية والسياسية للنخب القومية العربية، التي شكلت المنطلقات الأولية للفكر القومي فكراً وممارسة، ولا أقول الإرهاصات الأولية للفكر القومي العربي كون هذه الإرهاصات تعود في الحقيقة إلى العصور الوسطى من تاريخ الدولة العربية الإسلامية، وخاصة في العهد العباسي منها، رداً على المواقف الشعوبية كما أشرنا في موقف سابق، (5). دعونا نعود للنظر في قضة الايديولوجيا القومية العربية ونقدها انطلاقاً من إيماننا بمقولتي (الواقع الملوس في الزمن الملموس للظواهر وتاريخيتها).
إن قراءة أولية للأيديولوجيا القومية في بعدها السياسي وتاريخ نشوئها وانتشارها وبالتالي تمظهرها كأيديولوجيا نهضوية تحررية، تبين لنا أنها ظهرت في أوربة مع تشكل الطبقة البرجوازية وثورتها الصناعية، حيث جاءت هناك مشروعاً سياسياً يعمل دعاته أو حملته على تحقيق الوحدة القومي لدول أوربا المجزأة، وقد وقفت هذه التجزئة عائقاً أمام طموحاتها الاقتصادية والسياسية. فدول أوربا المقسمة إلى دويلات (CITIES STATES)، في عصر الاقطاع، لم تعد تتفق في وجودها مع طموحات الطبقة الرأسمالية التي وجدت في بنى الدولة الاقطاعية عائقاً أمام انتقال بضائعها أوالفسح في المجال واسعاً أمام حرية حركتها الاقتصادية، وتحقيق دولة المجتمع المدني، أو دولة القانون، الذي تجد فيها ذاتها أو خلاصها من سيطرة النبلاء والكنيسة وحتى الملك في نهاية الأمر. فراحت تطرح شعارها (الميركانتيلي) الذائع الصيت، (دعه يعمل دعه يمر)، هذا الشعار الذي حقق كل ما جاء بعد تطبيقه من طموحات اقتصادية وسياسية لهذه الطبقة التي أخذ مفكروها ينظرون بعد أن استتب الأمر السياسي لها ووصولها إلى السلطة للمسألة القومية التي وجدو فيها توحيداً للسوق قبل أي شيء أخر، وقد ساهم هذا المشروع القومي فعلاً في توحيد (دول المدن) داخل أوربا، وشكل منها دولاً قومية كما نراها اليوم بكل قوتها وعظمتها وعلمانيتها.
نقول: إذا كانت هذه هي إحدى المعطيات الأساسية التي شكلت المشروع القومي في أوربا وأظهرته على حيز الوجود، فإن ظهور الفكر القومي وتطبيقاته العملية المتخلفة والقاصرة فكراً وممارسة في الواقع العربي من وجهة نظر التحليل السوسيولوجي، يرتبط إلى حد كبير في طبيعة قوى وعلاقات الإنتاج ودرجة تطورها، وتطور البناء الفوقي المرتبط بهذه القوى والعلاقات والحوامل الاجتماعية المتبنية لهذا المشروع، مقارنة مع حالة ظهور الفكر القومي في أوربا الذي ساهم أسلوب الإنتاج الرأسمالي في ظهوره أو إنتاجه بسبب توافر الظروف الموضوعية والذاتية له، ويأتي في مقدمتها الحامل الاجتماعي (الطبقة الرأسمالية) الواعي لذاته، الذي قاد هذا المشروع القومي كما أشرنا أعلاه. هذا مع تأكيدنا هنا: بأن الفكر القومي كمشروع سياسي يعمل على وحدة الأمة وتحقيق نهضتها اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً لا يمكن أن يوجد أصلاً دون وجود الأمة كمعطي تاريخي لها وجودها الأنطولوجي بكل مقوماته الموضوعية والذاتية أيضاً.
إذاً، إن النظر في جملة الظروف الموضوعية والذاتية التي توفرت في أوربا وساهمت في إنتاج الفكر القومي وتطبيقاته العملية هناك، نجدها غائبة في الحقيقة كمقدمات أساسية لإنتاج الفكر القومي السياسي في الساحة العربية، بالرغم من وجود الأمة كمعطى أنطولوجي تاريخي،. فالأمة العربية لها حضورها التاريخي أو وجودها الأنطولوجي بغض النظر هنا عن حالات تجزئتها أو استعمارها في فترات تاريخية ماضية أو حتى في حالة توزعها القطري المعروف اليوم، (6) وهي أمة تستدعي بالضرورة ظروف تجزئتها واستعمارها وتخلفها طرح مشروعها القومي، بالرغم من أن أحد المشاكل الأساسية التي واجهت تبلور ووضوح أبعاد وآلية عمل هذا المشروع هنا، هي غياب الوضوح الفكري القومي ذاته عند الأحزاب القومية العربية والكثير من مفكري وسياسي هذه الأحزاب الذين تبنوا هذا المشروع القومي، ويأتي في مقدمة هذا التشوش الفكري وحتى المنهجي ذاك الخلط بين مفاهيم الأمة والقومية والعروبة. حيث اعتبر بعضهم القومية هي العروبة كما جاء عند "عبد الرحمن البزاز"، وهو أحد منظري وسياسي حزب البعث على سبيل المثال لا الحصر بقوله: (والقومية العربية، ومختصرها "العروبة" هي سبيلنا لتحقيق الحياد الذي تؤمن به الأمة العربية...).. أو اعتبارها هي الأمة (nation أو (nationlisim. (7) عند بعضهم الآخر. علما أننا لو أردنا توضيح هذه المسألة أو تحديدها معرفياً في إطارها العام، لتبين لنا أن الأمة كمفهوم هي جماعة من الناس توجد على أرض جغرافية محددة استطاع افرادها عبر تاريخ نشاطهم وعلاقاتهم المادية والروحية مع الطبيعة ومع بعضهم أن يشكلوا أمة تتميز عن غيرها، بعد أن أصبح لها لغتها وتاريخها وعاداتها وتقاليدها وثقافتها وبنيتها النفسية والأخلاقية وآمالها وآلامها المشتركة، التي تمنحها خصوصيتها الحضارية، كقولنا الأمة العربية أو الفرنسية أو الإنكليزية.. إلخ. وبالتالي فالعروبة هنا تأتي صفة للأمة العربية بوجودها الأنطولوجي والتاريخي، وهي ليست القومية كما يدعي البعض، لأن القومية هي مشروع أو عقيدة سياسية تهدف إلى تحقيق وحدة الأمة التي وقع عليها فعل التجزئة والاستعمار بغض النظر عن وجود الأقليات الإثنية أو التعدد الإثني في جسد هذه الأمة، ثم هي في المحصلة مشروع تحرري ونهضوي بكل ما تعنيه الكلمة من دلالات، تشارك في تحقيقه كل القوى الاجتماعية المنضوية أو الداخلة في مضماره الجغرافي والثقافي والاقتصادي والسياسي .
إذا إن الإشكال الأساس عند الكثير من كتابنا ومفكرينا وسياسي أحزابنا القومية كحملة مشروع قومي، يتجلى بداية في تحديد مفهوم القومية من الناحية الجغرافية والاجتماعية، أما الاشكالات الأخرى التي عرقلت قيام هذا المشروع أو نجاحه، ووفقاً للتحليل السوسيولوجي، فنستطيع تحديد أهمها في واقعنا العربي بالتالي:
1- إن الوجود التاريخي الأنطولوجي لأي أمة من الأمم ومنها أمتنا العربي بما تحوز عليه هذه الأمة من سمات وخصائص مشتركة (بين كل مكوناتها العرقية) كاللغة والعادات والتقاليد والتاريخ والآمال والآلام وغير ذلك، يمنح وجود المشروع القومي في صيغته النهضوية المشار إليها أعلاه مشروعيته، أي اعتبار مسألة طرحه وممارسته واقعياً، أمراً مشروعاً تفرضه تلك الظروف بشقيها الموضوعي والذاتي. وقد أثبتت تجارب التاريخ كيف وقفت هذه القوى الاجتماعية بكل انتماءاتها العرقية في وجه القوى الغازية في العصر الحديث وهي التي صهرتها في بوتقة واحدة تلك السمات والخصائص من لغة وعادات وغيرها.
2- سيادة قوى وعلاقات الإنتاج ما قبل الرأسمالية: حيث نجد مجتمعاً أو مجتمعات ذات أنماط إنتاجية متعدة، تبدأ بالنمط الرعوي مروراً بالزراعي التقليدي، وصولاً إلى نمط الإنتاج الريعي واقتصد السوق الصغير بكل أشكاله، فهذه الأنماط من الإنتاج فرضت بالضرورة وجوداً اجتماعياً من حيث طبيعة تكويناته وآلية نشاطه يعود إلى ما قبل المجتمع المدني، كما فرضت بناءً سياسياً وثقافياً وأخلاقياً هجيناً لم يستطع أن يساهم عملياً في إنتاج فكر قومي سياسي عقلاني حائز على شروط تطبيقه موضوعياً على أرض الواقع، وبالتالي إنتاج دولة حديثة، رغم أن هناك أحزاباً سياسية ذات توجهات قومية قد طرحت المشروع القومي على الساحة العربية منذ منتصف القرن الماضي، إلا أنها لم توفق في تحقيق نتائج ملموسة حتى عندما تنازل بعضها عملياً في مستويات طرحه القومي الوحدوي، إلى صيغة (التضامن العربي). بل على العكس لمسنا أن هذه الأنظمة أو الأحزاب السياسية التي تبنت المشروع القومي إضافة لعجز وشعارية برامجها وحواملها الاجتماعية، وتأثير شهوة السلطة القطرية على هذه الحوامل تجاه بناء هذا المشروع بعد استلامها السلطة او قيادة الدولة والمجتمع، قد لاقت هذه الأحزاب القومية العداء ولم تزل تلاقيه من قبل القوى الرجعية داخل هذه الأنظمة من جهة، ومن قبل الأنظمة التقليدية الرجعية وبخاصة "دول الخليج" التي تجلى دورها الرجعي الفاضح في ما سمي بثورات الربيع العربي من جهة ثانية، وأخيراً من قبل قوى الإسلام السياسي التكفيري الجهادي وفي مقدمة القاعدة والإخوان من جهة ثالثة. هذه القوى السلفية التكفيرية التي وجدت في هذا المشروع (القومي عرقلة وتحدي لمصالحها، إن كان داخل هذه الأنظمة المحكومة من قبل القوى والأحزاب القومية، التي قضت على الحكومات أو الأنظمة التقليدية، أو تجاوزها بقوانينها ومؤسساتها الوضعية لشريعة الله وحاكميته كما تدعي. ففصائل القاعدة والإخوان يعتبران القومية ضد إرادة الله التي جاءت بهذا الدين للعالمين وليس للعرب وحدهم. هذا على الرغم من أن هذه القوى والأحزاب القومية حاولت أن تتعامل براغماتياً مع مسألة الخطاب الديني عندما ربطت العروبة بالإسلام كما سنرى في موقع آخر من هذه الدراسة.
3- إن غياب الظروف الموضوعية والذاتية وبخاصة الحامل الاجتماعي المؤهل في هذه الأحزاب القومية العربية لحمل المشروع القومي كما أشرنا في موقع سابق، لم يمنح هذا الفكر مشروعية وجوده واستمراريته أيضاً، وظل التعامل معه وفقاً لمعطيات شعاريه وحالات حدسية ووجدانية لم تستطع الدخول إلى عمق الواقع والقبض على مكوناته الحقيقية والتحكم بآلية عمله وتغييره باتجاه متطلبات المشروع القومي للأسباب التالية:
آ- إن شهوة السلطة بعد وصول هذه الأحزاب القومية إلى قيادة الدولة والمجتمع في بعض الأقطار العربية، دفعت قيادتها إلى التفنن في كيفية التحكم بالسلطة واستمرارية هذا التحكم، وهذا ما ساهم بالتالي في دعم وتأسيس مشروع الدولة القطرية من الناحية العملية أولاً، ودفع قيادات هذه الأحزاب أن تدخل في صراعات داخلية مع بعضها غالباً ما كانت ذات بعد طبقي ساهمت في تصفية بعضها حتى جسدياً، كما ناصبت العداء الشرس لمن يختلف معها أيديولوجياً، أو حتى مع من يتفق معها أيديولوجياً من الأحزاب التقدمية أو القومية الأخرى التي تشعر بأنها قد تنافسها على السلطة ثانياً. فالكثير منا يتذكر كيف حارب البعثيون بعضهم بعد استلامهم السلطة في سورية والعراق، وكيف حارب الناصريون البعثيين، أو العكس، ثم كيف حارب البعثيون والناصريون الشيوعيين، والعكس صحيح أيضاً.
ب- إن من أهم أسباب دخول أنظمة أو دول هذه الأحزاب المنادية بالمشروع القومي في حالات صراع دامي مع بعضها، إضافة لشهوة السلطة عند قياداتها، تأتي مسألة اللدنية أو عبادة الفرد، ممثلة هنا بالشخصية الكاريزمية، أي (القائد الملهم)، هذا القائد الملهم الذي اختزل في شخصه الحزب والدولة والوطن والامة العربية بكاملها فكراً وممارسة، وراح الحزب والدولة والمجتمع كله يدور في فلكه، لذك لا نستغرب أن نرى مع وفاة عبد الناصر كيف سقط الاتحاد الاشتراكي في مصر ومشروعه الفكري القومي/ الوحدوي، وراح السادات بعده ينسق مع القوى الأصولية الدينية والرجعية داخل مصر وخارجها، وضرب كل الانجازات التي حققتها المرحلة الناصرية للشعب المصري بعد تبنيه مشروع الانفتاح، ثم تغيير مصر من الجمهورية العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، وبالتالي التخلي عن المشروع القومي برمته الذي كان قد تبناه عبد الناصر والاتحاد الاشتراكي، والسير في ركاب مشروع الاستسلام مع الصهيونية في اتفاقية كامب ديفد.
أما في العراق فمع سقوط صدام إنهار بعث العراق، وبرزت على الساحة العراقية الصراعات الطائفية الدامية، كما ظهرت التنظيمات السلفية الجهادية من صلب التنظيم البعثي ذاته ممثلة بتنظيم (النقشبندية) خاصة.
و في ليبيا مع سقوط نظام القذافي سقط مشروعه القومي والوطني وكتابه الأخضر، لتتحول ليبيا إلى بؤرة لتنظيم القاعدة، وتدخل في صراعات قبلية ليس لها حدود. هذا مع إيماني العميق بان مشروع البطل ممثلاً، (بشيخ الطريقة الصوفية، وشيخ العشيرة أو القبيلة أو الطائفة أو بالقائد الفرد) يشكل نتاجاً طبيعياً للعلاقات الاجتماعية والسياسية السائدة في مجتمعاتنا. بيد أن المهم في هذا الاتجاه أن نعمل على كشف دور البطل السلبي وتحجيمه، ودعم دور البطل الايجابي وبلورته انطلاقاً من أهمية دور الفرد في التاريخ من جهة، ثم من أهمية هذا البطل الايجابي وإمكانية تحقيق رمز منه يمكن أن تلتف حوله الجماهير بكل تعدد مرجعياتها الدينية والسياسية والعرقية التي تشكل نسيج الدولة أو المجتمع، إذا ما لمست في هذا البطل القدوة الذي تتجسد في شخصيته وفكره وممارسته روح المواطنة الحقيقة التي تدفع بالمجتمع نحو الوحدة الوطنية وروح الديمقراطية التي تؤمن مشاركة الجماهيرية في قيادة الدولة والمجتمع، وبعلمانيته التي تراعي خصوصيات بنية الدولة والمجتمع عندما تكون هذه الدولة أو المجتمع متعدد الطوائف والمذاهب والديانات والأعراق، ثم إيمان هذا البطل بالحرية القائمة على احترام الرأي والرأي الأخر والتعددية وتداول السلطة.
ج- من أهم معالم التعامل البراغماتي والعاطفي والشعاري مع الفكر القومي من قبل هذه الأحزاب، هو قيام هذه الأحزاب بغرس مفاهيم وروح الشعبوية لدى أعضائها داخل بنية أحزابها وداخل بنية الدولة والمجتمع معاً، فكان من أبرز هذه المفاهيم، ربطها ما بين النضال القومي والنضال الاشتراكي في دول أو مجتمعات لم يتبلور فيها الوضوح الطبقي بعد كعالمنا العربي، وذلك بتعويلها على الجماهير الكادحة التي لم تصل أصلاً إلى مرحلة الطبقة الواعية لذاتها في بناء مشروعها القومي، محاولة في ذلك إبعاد القوى الطبقية المالكة من البرجوازية الكومبرادورية وبقايا الإقطاع عن المتاجرة ايضاً بهذا المشروع، وهي القوى الطبقية التي تعتبر نفسها من حيث السياق الموضوعي لنشوء المشروع القومي، هي صاحبة المشروع الوطني والقومي في الآن ذاته، في الوقت الذي تعرف هي نفسها بانها فشلت في تحقيق نهضة وتقدم واستقرار البلاد التي سيطرت على دفة حكمها بعد خروج المستعمر، وذلك لعجزها من الناحيتين الموضوعية والذاتية أيضاً، ثم لبقائها أداة بيد هذا المستعمر الذي سلمها السلطة بعد خروجه. وهذا ما أدركته فيها الأحزاب القومية التقدمية من خلال تأكيدها بأن هذه القوى الطبقية غير مؤهلة لقيادة هذا المشروع لكونها قوى كومبرادورية، وقد أشارت هذه الأحزاب في أيديولوجياتها إلى هذا العجز. كما أنها تدرك ضمنياً، بأن الجماهير الكادحة التي عولت عليها قيادة هذا المشروع القومي، هي غير مؤهلة كذلك لقيادة هذا المشروع، ولم تصل إلى مرحلة وعي الذات لتحقيق مصالحها ومصالح المجتمع، أي هي طبقة لم تتكون بعد بسبب غياب الظروف الموضوعية لتكوينها، هذا إضافة إلى ما تتمتع به هذه القوى الكادحة من أمية سياسية وحرفية وتعلق الكثير منها بمرجعيات تقليدية مأزومة كالعشائرية والقبلية والطائفية، الأمر الذي دفع البرجوازية الصغيرة من (الانتلجنيسيا) لقيادة هذه الأحزاب، وهي برجوازية من حيث بنيتها الطبقية مالكة ومنتجة معاً، ولكونها كذلك، فهي الأكثر انتهازية ووصولية ومتاجرة بمصالح الجماهير الكادحة ذاتها، وهذا ماساهم في تحويل قسم كبير منها وخاصة الجناح العسكري منها بعد وصولها إلى السلطة إلى برجوازية (بيروقراطية) و(طفيلية)، لا تعمل إلا لذاتها فقط، في الوقت الذي تفهم فيه كل شيء بصب في مصالها عدا مصلحة الوطن والمواطن. هذا مع تأكيدنا هنا، بأنها عند استلامها السلطة في بعض البلاد العربية استطاعت في الحقيقة أن تحقق انجازات كثيرة على المستوى المادي وخاصة على المستويات الاقتصادية والخدماتية، إلا أنها عجزت عن تحقيق ثورة ثقافية حقيقة في عقلية المواطن ونقل البنية العقلي لديه من بنية ماضوية تلفيقية امتثالية استسلاميه، إلى بنية عقلية نقدية فاعلة مُحَرَرَة ومُحَرِرِة معاً، كما عجزت كذلك عن تحويل انتماءات المواطن من مرجعياته التقليدية القائمة على العشيرة والقبيلة والطائفة والحزب والقائد، إلى مرجعية الوطن والأمة والقومية.
د- لقد اشتغلت هذه الأحزاب براغماتيا على مستوى الخطاب الديني عندما ربطت برؤية توفيقية/ تلفيقيه ما بين العروبة والإسلام، لاعتقادها بأنها قادرة بهذا الربط أن تُكسب مشروعها السياسي مشروعيته أمام الجماهير التي يغطي الوعي الديني حيزاً كبيراً من ذهنيتها أولاً، ولمنافسة الأحزاب الدينية، وبخاصة الإخوان الذين ربطوا الدين بالسياسة أيضاً عبر طرحهم مشروع الحاكمية لله ثانياً، ثم منافسة الأحزاب اليسارية (الشيوعية) التي تشاركها الشعارات النهضوية والتقدمية وإظهارها معادية للدين أمام الجماهير ثالثاً. هذا دون أخذها بالاعتبار أنها بربطها بين العروبة والإسلام كانت تعمل على تعميق أزمة خطابها السياسي، كون الدين الإسلامي في المحصلة هو أيديولوجيا ترفض الفكرة القومية، كما ترفض فكرة المواطنة وكل ما يتعلق بمفاهيم الحداثة والعلمانية التي تتبناها هذه الأحزاب في خطابها الأيديولوجي. وهي أيديولوجيا غيبية لا تؤمن بوجود قوانين موضوعية تتحكم بألية عمل الظاهر الطبيعية والاجتماعية، كما لا تؤمن أيضاً بوجود أي قوى اجتماعية قادرة على التشريع لحل قضايا الناس بعيدا عن التشريع الذي وضعه الله وأقره السلف الصالح. وهذه المسألة يقرها خطاب الإخوان وكل القوى السلفية المعاصرة في خطابهم السياسي الذي يكفر كل من يخرج عن فكرة الحاكمية كما جاء في كتاب سيد قطب (معالم في الطريق)، أو أدبيات القاعدة وفروعها مثل داعش والنصرة ومن يلتقي معها، وما تقوم به هذه القوى الأصولية اليوم في ثورات الربيع العربي يؤكد ذلك. على العموم هذه المسألة سنتناولها بالتفصيل في موقع لا حق من هذه الدراسة بالنسبة للأحزاب القومية التي ربطت بين العروبة والإسلام. ولكن لا بد لنا من الوقوف قليلاً هنا عند خطورة هذا الربط كما بينها بعض المفكرين الإسلاميين والعلمانيين معاً.
إن مسألة الاشتغال على الخطاب الديني لتحقيق مصالح سياسية لقوى اجتماعية أو سياسية محددة، يبقى لها مخاطرها ومحاذيرها إذا ما اشتغلت عليه الأحزاب التقدمية، وذلك كون الدين إذا ما تجذر ايديولوجيا في عقل لإنسان لم يعد من السهل بمكان توجيه عقله وتفكيره خارج توجهات هذا الدين وبخاصة توجيهه فيما بعد لفكرة الانتماء إلى المواطنة أو الوطن أو الأمة او القومية، هذه الانتماءات التي تتنافى مع مسألة الانتماء الأممي للدين، وهذا ما أكده الكثير من رجال الدين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر الشيخ الإمام "محمد عبده" حيث يقول : ( لأن جرثومة الدين متأهلة في النفوس بالوراثة من أحقاب طويلة، والقلوب مطمئنة إليه... فلا يحتاج القائم بإحياء الأمة (قصده الأمة الإسلامية) إلا إلى نفحة واحدة يسري نفثها في جميع الأرواح... ومن طلب إصلاح أمة شأنها ما ذكرنا بوسيلة سوى هذه، فقد ركب شططاً وجعل النهاية بداية.). (8). ثم يقول أيضاً : ( إن الأجناس قامت على العصبية (القومية. لأن أفرادها تلاحموا حفاظاً لحقوقهم من جور حاكم من جنس آخر، أما الوضع فيختلف بين المسلمين. وأضاف : وهذا هو السر في إعراض المسلمين إلى اختلاف أقطارهم عن اعتبار الجنسيات، ورفضهم أي نوع من أنواع العصبيات ما عدا عصبتهم الإسلامية. فإن المتدين بالدين الإسلامي متى رسخ فيه اعتقاده يلهو عن جنسه وشعبه ويلتفت عن الرابطة الخاصة إلى العلاقة العامة.) (9).. وهذا "عبد الرحمن الكواكبي" كان منذ نهاية القرن التاسع عشر أكثر قدرة على فهم مسألة الدين وخطورة اللعب على وتره، وخاصة في المجتمعات المتعددة الديانات والطوائف والمذاهب، وخاصة اللعب عليه من قبل الأحزاب والقوى التي تدعي القومية والعلمانية ف مطالبتها بالربط ما بين العروبة والإسلام، متناسية مكوّن هام من مكونات المجتمع وهو الأقليات الدينية، حيث يقول عبد الرحمن الكواكبي عن خطورة اللعب على الدين، ومحاولة ربط الدين بالدولة (السياسة) في المجتمع السوري الذي ينتمي إليه: (دعونا يا هؤلاء ندبر شأننا بالفصحى ونتفاهم بالإخاء ونتواسى بالضراء ونتساوى في السراء، دعونا نتدبر حياتنا الدنيا ونجعل الأديان تحكم في الأخرى فقط . دعونا نجتمع على كلمة سواء ألا وهي فلتحيا الأمة، فليحيا الوطن، فلنحيا طلقاء. ).(10). . أما "ساطع الحصري" المفكر القومي الأصيل الذي يعتبر المنظر الأكثر اهتماماً وعمقاً في الفكر القومي على الساحة العربية في القرن العشرين فيقول حول مسألة ربط العروبة بالإسلام: ( إن الأبحاث التي نشرتها في مؤلفاتي المختلفة، أظهرت إلى العيان وبأجلى المظاهر وأجلها، الدور العظيم المنقطع النظير الذي قام به ظهور الدين الإسلامي في تكوين الأمة العربية وتوسيع نطاق العروبة، وترسيخ كيان بنيانها، وتشديد مقاومتها التجزئة التي عصفت بها، ومع ذلك لم تر تلك الأبحاث مجالاً ولا لزوماً لاعتبار الدين من المقومات الأساسية للقومية العربية.). (11).
إن الموقف التصالحي البراغماتي ما بين السلطة والمؤسسة الدينية اليوم، يعود بنا إلى البنية الفكرية للعصور الوسطى التي اتفقت فيها السلطتان الزمانية ممثلة برجال الدين والمكانية ممثلة بالخليفة، على اقتسام السلطة وقيادة الجماهير. بل لنقل إن هذه العلاقة لم تغب جوهرياً عن تاريخنا السياسي، وإنما تغير شكلها فقط.
نقول: إن الأحزاب القومية العربية (العلمانية) قد اشتغلت على تثبيت سلطتها في الحكم، بالتوازي مع اشتغالها على الدين، من خلال ربطها العروبة بالإسلام في سياق عملها، بل كان اشتغالها على المسألة الدينية أكثر من اشتغالها على الفكر القومي ذاته للأسباب التي أشرنا إليها سابقاً، في الوقت الذي أثبتت عجزها عن تحقيق أية قضية من قضايا مشروعها القومي، هذا العجز الذي غالباً ما يزيد الطين بلة من حيث زيادة عمق التناقضات وحدّة الصراع ذاته بين القوى الوحدوية ذاتها والقوى المناوئة لها عند سعيها لتطبيق أي مشروع قومي، كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر، مشروع الوحدة بين مصر وسورية الذي خلق للدولتين وللأمة العربية أزمات وصراعات وحسابات سياسية من قبل القوى التقدمية والرجعية المناوئة للوحدة معاً لم تزل قائمة حتى الآن. الأمر الذي جعل القوتين تتمسك بورقة الدين أكثر من تمسكها بالورقة القومية، وذلك للحفاظ على السلطة من قبل القوى الوحدوية التقدمية التي استلمت السلطة، أو للوصول إلى هذه السلطة من قبل القوى الرجعة المعادية لها والمتهمة إياها بالعلمانية، وبالتالي بالكفر والالحاد.
إن قراءة أولية لفكر مؤسسي الأحزاب الديمقراطية الثورية ذات التوجه القومي، تبين لنا وبكل وضوح ذاك التخبط المعرفي والمنهجي معاً بالنسبة لخطابهم القومي وابتعادهم عن الروح العقلانية النقدية في التعامل معه، فهذا "مشيل عفلق" أحد مؤسسي حزب البعث العربي الاشتراكي وأمينه العام لفترة زمنية طويلة، يكتب في كتابه " في سبيل البعث" حول أهمية الدين الإسلامي بالنسبة للعروبة، وعن موقفه في الوقت نفسه على العلمانية التي حدد طبيعتها وبين دلالاتها الفكرية والسياسية والحقوقية بالنسبة للبعث بقوله: ( إن هذه الدولة (التي يعمل لها البعث)، هي نقيض الإلحاد والفساد وكل ما هو سلبي وهدام، وعلمانية الدولة بهذا المعني ليست إلا إنقاذاً للروح من شوائب الضغط والقسر.... وما دام الدين منبعاً فياضاً للروح، فالعلمانية التي نطلبها للدولة هي التي بتحريرها الدين من ظروف السياسة...وملابساتها، تسمح بأن ينطلق في مجاله الحر في حياة الأفراد والمجتمع، وبأن تبعث فيه روحه العميقة التي هي شرط من شروط بعث الأمة). (14). إن هذا الموقف البراغماتي من الدين والعلمانية معاً، يتجلى واضحاً بتمسك عفلق بالدين، معتبراً إياه حجر الزاوية في رقي هذه الأمة كونه مصدر الإلهام القومي والروحي لمعتنقي البعث، نجده أيضاً يتبنى العلمانية بعد محاولته تحييد للدين عن السياسة، على اعتبار السياسية مصدر التلوث والفساد للقيم الايجابية كما أشار، والتي بفسادها ستلوث الدين الفياض للروح لهذه القيم الايجابية.
إن هذا الموقف الضبابي المشوش فكرياً والتلفيقي منهجياً من الدين الإسلامي، ظل يتبناه حزب البعث فيما بعد في العراق فكراً وممارسة عندما غادر مشيل عفلق إليه، أو في سورية عمليا حتى بعد سقوط مشيل عفلق. وهذا ما عبر عنه "عبد الحليم خدام" الرجل السياسي الثاني في دولة البعث لأكثر من ثلاثة عقود، الذي أشار في كتابه اليتيم بقوله: (إذا كانت بعض القوى السياسية العربية قد استخدمت الدين لأغراض سياسية، وكذلك بعض الدول العربية، فإن ما يعاب على القوى القومية ردة فعلها التي أظهرتها وكأن صراعها ضد الدين وليس ضد الذين أساؤوا استخدامه وتجاهلوا أن الأمة العربية جسد روحها الدين الإسلامي كما عبر عن ذلك مشيل عفلق مؤسس حزب البعث. ).(15).
والسؤال هنا: هل عفلق في طرحه ومن يؤيده من رجالات البعث، يعتقدون بأن الإسلام بكل ممثليه سيقبلون بهذا الموقف الذي تمثله علمانية البعث من الدين كما يراها عفلق ومؤيديه؟!. وهم – أي الإسلاميون - الذين يعتبرون ما يقره الإسلام والشريعة الإسلامية أمراً مقدسا صالحاً لكل زمان ومكان. أو بتعبير آخر، هل ستلتزم النصوص (الدستورية والقانونية) الوضعية بصيغتها العلمانية كما يراها البعث في دستوره ومنطلقاته النظرية بالتشريع القرآني المفصل والشامل لكل نواحي الحياة كما يدعي الكثير من رجالات الإسلام السياسي؟، أم ستأتي بديلاً عنه؟. وهل ستبقى هذه العلمانية علمانية إذا التزمت بهذا التشريع الإسلامي؟، يبدو إن هذه القضية لم تشغل عفلق ومن أخذ أو يأخذ بموقفه تجاه الدين كثيراً، بقدر ما شغلته قضية الربط الميكانيكي بين العروبة بالإسلام، حيث راح يطالب المسيحيين ويعمل على إقناعهم بقبول الإسلام أكثر مما يهمه قبول المسلمين بالعلمانية. حيث يكتب في هذا الاتجاه: ( ولكننا وضعنا الأمور في نصابها عندما وضعنا الإسلام كثورة أخلاقية وفكرية واجتماعية حاسمة في تاريخ البشر... وضعناها في صلب القومية العربية. بهذا المعنى لا يوجد عربي غير مسلم، هذا إذا كان العربي صادق العروبة، وإذا كان متجرداً من الأهواء والمصالح الذاتية. فالعروبة تعني الإسلام بهذا المعنى الرفيع.... إن جميع المسيحيين في هذا الشرق العربي إذا لم يقبلوا عن طوع وإرادة واقتناع ومحبة بأن يكونوا بمعنى من المعاني مسلمين، فإنهم لا يكونوا أمناء لفكرهم ووطنهم وعروبتهم) (16).. من هذا المنطلق جاء تخليه عن مسيحتيه وإعلانه الإسلام ديناً له، وهو بتخليه عن دينه قدم إهانة لكل الأقليات الدينه في الوطن العربي من جهة، وأعلن عنصرية من يقبل بهذه الفكرة في صفوف البعث الرافضين لهذه الأقليات الدينية من جهة ثانية . إن القومية عند عفلق في المحصلة هي الوجه الآخر للدين، وهي من منبع واحد القلب والروح، وليس من العقل وتناقض وصراع مصالح القوى الطبقية. حيث يقول: ( إن الدين جزء من القومية التي تنبع مثل الدين من معين القلب، وتصدر عن إرادة الله.). كما كتب أيضاً: (على الأمة العربية أن ترتقي بما يساويها بماضيها المجيد.) (17)، أي ضرورة عودتها إلى قيم الماضي الإسلامية، أي التمسك بأهل السلف، وهو هنا لا يختلف برأيي عن القوى السلفية في دعوتها بالعودة إلى "النبع الصافي" والتمسك بما قاله الإسلاف الذين لم يتركوا شيئاً للأخلاف، لتحقيق تقدم ونهضة هذه الأمة.
هكذا نرى كيف ينظر عفلق إلى المسألة القومية نظرة سلفية لا تختلف من حيث الجوهر عن الموقف السلفي الديني للدين، فهي إضافة لكونها (حب من القلب)، فهي عنده إيمان، ومصدرها الله كالدين تماماً.
أما موقفه ميشيل عفلق من الشيوعية فيحدده موقفه البراغماتي النفعي من الدين ذاته، وبالتلي جاء رأيه معادياً للشيوعية معتبراً إياها : (رسالة مادية أممية مصطنعة تنفي حقيقة القوميات في العالم وتنكر الأسس الروحية والوشائج التاريخية التي تقوم عليها الأمة... (معتبراً) أن العربي الواعي لا يمكن أن يكون شيوعياً إلا إذا تنازل عن عروبته)، ناسياً أ، لينين هو أول من ربط بين النضال القومي والنضال الاشتراكي، وهو الطريق الذي قرر البعث السير عليه في مؤتمره القومي السادس. (18). كما كان له موقف معادي ومشبوه من الماركسية وماركس نفسه حيث يقول : ( إن كارل ماركس نفخ في الماركسية من روحه اليهودية الناقمة وجعلها على شكل نبوءة عن تحقيق الفردوس الأرضي، بعد تهديم عام شامل للعالم الحاضر).(19). وعفلق هنا في طرحه هذا لا يختلف في الحقيقة عن موقف الإخوان المسلمين من الفكر الوضعي عموماً ومنه اليساري على وجه الخصوص. وعلى الرغم من أن حركة 23 شباط 1966 قد تبنت الكثير من قوانين ومقولات الفكر العلمي الجدلي كما جاءت في كراس (العلمية والثورية) الصادر عن القيادة القومية للحزب من قبل قيادة حركة 23/ شباط، إلا أنه بعد قيام الحركة التصحيحية في سورية، وما تركه موقف الإخوان وردود فعلهم على قضية دين رئيس الجمهوري في الدستور (الدائم) الذي طرح الرئيس الراحل حافظ الأسد بعد قيام الحركة التصحيحية، ثم الانتماء المذهبي للرئيس الأسد، ثم قيام الثورة الإسلامية في إيران وموقف النظام السوري الإيجابي من هذه الثورة، وأخيراً حوادث ثمانينيات القرن الماضي المعادية لنظام البعث، دفع القيادة السورية لحزب البعث برئاسة الأسد على إعادة النظر بالفكر العقلاني النقدي العلماني للمنطلقات النظرية، بالرغم من بقاء المنطلقات النظرية نفسها التي تتضمن هذا الفكر وبخاصة في مقدمتها، معبرة عن الخط السياسي والفكري للحزب، ولكن بصورة شكلية فقط، بل راح بعد أحداث الثمانينيات يُهمش يساريي البعث بإقصائهم عن المواقع القيادية حتى تناقصت أعداهم وأصبحوا من العملة النادرة في صفوف تنظيم البعث، وأصبح البوطي ومدرسته الأشعرية سيد الساحة الثقافية في سورية، الأمر الذي الرئيس بشار الأسد أن يسأل أحد أعضاء المؤتمر في المؤتمر القطري الذي انعقد قبل الأزمة في سوري : (ألا يوجد مثقفون في المؤتمر؟. فرد عليه عضو المؤتمر : أعتقد هناك إثنان فقط هو ورفيق آخر.)
من هذا المنطلق قام البعث في سورية بعد حوادث الثمانينيات وفي بداية العقد الثاني من القرن الحالي ببناء عشرات آلاف الجوامع ومعاهد تحفيظ القرآن، وأهل عشرات الآلاف من الدعاة والداعيات الذين راحوا بعلم السلطة أو بدونها يدعون الناس للصلاة والمرأة للحجاب - (ظاهرة القبيسيات) -، ويبشرون بالفكر السلفي الأشعري والوهابي، وتعليمه للشباب من خلال المساجد التي شرعة أبوابها ليل نهار لمشايخ الفكر السلفي،، في الوقت الذي أصبح فيه الشيخ البوطي وتياره السلفي الأشعري (الحنبلي)، وشيوخ الطرق الصوفية الخزنوية والشاذلية وغيرهما هم أسياد الساحة الثقافية، بينما حوصر الفكر العقلاني وحورب المثقفون والمفكرون التنويريون. فهذا الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي لذي له حضوته ومكانته في دولة البعث، يعلن موقفه المعادي للعلمانية بكل صراحة في كتابه (العقيدة الإسلامية والفكر المعاصر)، في دولة البعث العلمانية، وهو كتاب مقرر لطلاب الشريعة في جامعة دمشق: حيث يقول البوطي في هذا الكتاب: ( أما الدين الإسلامي فيحوي في أصله إلى جانب مبادئ الاعتقاد، والأحكام التي تضبط شؤون الدولة وتتكفل بإقامة أنظمتها وقوانينها، فإن حجزه عن ممارسة صلاحياته ومسؤولياته، ففي ذلك تغيير لجوهره وإبطال لكثير من مضمونه... ). (12). ثم يتابع ناعتاً من يؤمنون بالعلمانية ضمناً ويتقربون إلى الإسلام قولاً، قائلاً: (إن التظاهر بالخضوع له – أي الدين - بعد ذلك كذب عليه ومخادعة له ولمشرعه.) (13)، بل هو لم يتوان في اعتبار الإسلام بداية ونهاية كل شيء، ويدفعه هذا الاعتقاد بموقف شعوبي واضح، بمحاولته نزع الأخلاق عن العرب قبل الإسلام وعن العروبيين المعاصرين كما ذكر في إحدى حلقاته التي تبث على قنوات التلفاز السوري وهي بعنوان، (لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) حيث يقول: (إن العرب ليس لديهم أخلاق قبل الإسلام، وإن القوميين العرب الذين يقولون بأن العرب كان لديهم أخلاق قبل الإسلام هم كذابون.). بل في حلقة اخرى على قناة نور الشام يقول : (إن العرب قبل الإسلام كانوا أعراباً كلهم.). وهو يريد تاكيد موقفه الشعبوي من العرب من خلال القول ضمناً : (إن الأعراب أشد كفراً ونفقاً ).. و(قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل أسلمتم)
أما في العراق فعلينا أن لا نستغرب كيف قام نظام البعث فيه بحرق كل الكتب التراثية التي تعوّل على العقل في قضايا الفقه والاجتهاد، التي وقعت تحت يدية. إضافة إلى محاربة كل القوى العقلانية التنويرية في العراق، ولا نستغرب أيضا كيف تحول قسم من البعثين إلى تيار سلفي تكفيري مثل (النقشبندية) بعد سقوط نظام البعث في العراق، وهو تيار ارتبط بالقاعدة في الآونة الأخيرة وشكل القسم الأعظم من الهيكل التنظيمي لداعش.
أما عبد الناصر وجمهوريته العربية المتحدة، فله موقف من الدين لا يختلف من حيث الجوهر عن موقف عفلق حيث يقول : (إذا كانت الماركسية مؤلفة من عشرين نقطة، فنحن نتفق معها في ثمان عشرة نقطة ونختلف في نقطتين هما الدين والصراع الطبقي.). فموقف عبد الناصر من الدين لا يختلف في حقيقة أمره عن موقف البعث من حيث ربطه ما بين العروبة والإسلام، رغم صراعه المرير مع الإخوان. ولكي يتجاوز عبد الناصر عقدة الإخوان التي كان ينتمي إلى تنظيمها قبل الثورة أو يتعاطف معه، قام بتشكيل موقف إسلامي إصلاحي سخر له بعض المنشقين عن الإخوان ووفر له سبل النشر عبر نشرة (الاشتراكي) الصادرة عن الحزب الاشتراكي الحاكم، لترويج هذا الموقف عند الشعب المصري المتدين أصلاً، وعند الأخوة من التيار الناصري الأكثر حضوراً، من الذين آمنوا بربط العروبة والإسلام.
لقد كان هذا التوجه الديني يعكس تصوراً ذا جوانب مشتركة مع رؤية عبد الناصر للدين، واعتباره جزءاً من عملية التحول الاجتماعي نحو التنمية. بيد أن هذا الاتجاه في الحقيقة لم يستطع رفع التناقض البنائي والمعرفي بين العروبة والإسلام ، بل ظل يعبر عن نهج إصلاحي براغماتي تلفيقي يحاول تجديد النص الديني الثقافي ليس انطلاقاً من النص الديني ذاته، وإنما من ثقافة مضادة للسلفية الإخوانية (20). والملفت للنظر أن الشيخ (المتولي شعراوي) ظل يصول ويجول على المستوى الإعلامي في مصر في نشر الفكر الديني السلفي طوال العهد الناصري والساداتي حتى وفاته، وهو ذاته من صلى ركعتين لله تعالى شكراً له، كون النظام الناصري (الكافر) خسر حرب حزيران عام 1967أمام الكيان الصهيوني.!.
أما في ليبيا القذافي، فنجد صورة دينية أخرى في هذا النظام ذات توجه أصولي متطرف، حيث يعلن القذافي بأن (القرآن) هو المصدر الوحيد للتشريع، مع إهمال السنة والآراء الفقهية الإسلامية المعترف بها تاريخيا، وذلك لاعتقاده بأن المورث السني النبوي قد شابه الكثير من الوضع ولا يمكن الاطمئنان إليه، وبالتالي لا بد من اعتبار القرآن فقط مصدراً أساسياً للتشريع. وعلى هذه المنطلقات الفكرية لديه اعتبر أن الشعب خليفة الله على الأرض، مستنكراً بذلك وجود البرلمان أو النظام النيابي والأحزاب والمنظمات، ومعتبراً أن الديمقراطية المباشرة وما تتضمنه من آلية عمل ممثلة باللجان الشعبية ومؤتمراتها الدورية التي تشرع وفقاً لمقاصد الدين الإسلامي وعدالته، هو ما يهم مصالح الناس، في الوقت الذي تختار فيه مسؤوليها وتحاسبهم وتقصيهم عند الضرورة. مع التأكيد هنا أن هذه المحاسبة لا تشمل (القائد الملهم – القذافي) كونه الحاكم بأمر الله، وهو فوق القانون والشعب والدستور، ولا تشمل أيضاً أولاده وحاشيته المقربين. وأخيراً، فإن وعي القذافي ومشروع النظرية العالمية الثالثة التي نظر لها، يحملا صبغة إسلامية بلبوس اشتراكي، وما حرصه على وصف أفكاره وتصوراته بأنها إسلامية، إلا ليضمن شرعية طموحه للزعامة، وتعبئة الجماهير الشعبية العريضة وراءه، وهي الجماهير ذاتها التي قتلته ومثلت به في ثورتها الربيعية، التي تبين أن محاولة القذافي إيهامها – أي الجماهير - بأنه قريب جداً من وعيها الإسلامي الذي راح يغذيه، في الوقت الذي يعمل فيه على محاربة الفكر التقدمي والعقلاني، قد أعطت أوكلها ببروز أشد التنظيمات الأصولية السلفية الإسلامية المتشددة في ليبيا، لتلتقي مع أصولية وسلفية التيارات الإسلامية في سوريا والعراق وومصر وكل شمال أفريقيا، ولتمارس هذه القوى مجتمعة قهرها التاريخي على أنظمة وشعب سورية والعراق وليبيا ومصر وتونس والجزائر بإسم الدين.
وفي ختام عرضنا لهذه المسألة أحب أن أضيف هنا مسألة أخرى حول ربط هذه الأحزاب براغماتيا بين العروبة والإسلام وهي: إن هذه الأحزاب تعني بالعروبة هنا المشروع القومي، والمشروع القومي في جوهره مشروع يعمل على تحقيق الوحدة العربية، وهذا العمل هو في المحصلة عمل سياسي، والسؤال هو: كيف تبرر هذه الأحزاب لنفسها ربط السياسة بالدين هنا، في الوقت الذي تحرم وتحارب الأحزاب السياسية الدينية التي تربط بين السياسة والدين؟!.
ويظل السؤال المشروع الذي يطرح نفسه في هذا الاتجاه هو: إذا كانت القومية في سياقها العام (أيديولوجيا) أو مشروعاً سياسياً واجتماعياً وضعياً، يتجسد في وعي ونفسية وسلوكية المرء عبر التربية والثقافة، بهدف تحقيق الوحدة العربية وتنمية وتقدم العرب، فلماذا نربط هذا المشروع بمشروع آخر، أو أيديولوجيا أخرى يراها الكثير من القوى السلفية الإسلامية ذات طابع مطلق مقدس متعالي ترفض أي مشروع أو عقيدة أخرى وضعية ومنها المشروع القومي، معتبرة إياه كفراً وإلحاداً من جهة، ومنافياً للدين لجهة دعوته إلى جماعة محددة، وهم العرب، في الوقت الذي جاء الدين برأي هذه القوى الإسلامية دعوة عالمية من جهة ثانية؟... نقول: لماذا هذا الربط بين جوهر هذين المشروعين لدى أحزابنا القومية؟، مع تأكيدنا في طبيعة الحال على أهمية الدين بالنسبة لتاريخ العرب، وتاريخ الشعوب عموماً ويجب أن يستفاد من طبيعته الإنسانية السمحة، ومن مواقفه الإيجابية تجاه عدالة الإنسان وحريته ومساواته، دون العمل على نقله كتراث وعقيدة مقدسة بحذافيره إلى الحاضر، واعتبار أن الأسلاف لم يتركوا شيئاً للأخلاف ؟.
ملاك القول:
نقول : في عالمنا العربي فشل مشروع الأيديولوجيا القومية سياسياً، كونها جاءت فكراً يفتقد إلى الكثير من شروطه الموضوعية والذاتية في واقعنا العربي، أي فاقداً لشروط مطابقته الموضوعية والذاتية لهذا الواقع كما أشرنا في موقع سابق من هذه الدراسة،، بالرغم من كل محاولات دعاته إعطائه صفة التقديس، وربطه بوجدان الفرد والأمة، واعتباره حالة وجدانية نابعة من القلب، وهي كالدين معطاة من قبل الله، وبالتالي ربطه تلفيقياً أو براغماتياً كفر سياسي، في إنتاجه ومعطياته بالعقيدة الإسلامية، مع تحفظ حوامله الاجتماعية لفكرة الحاكمية لله التي تطرحها بعض الأحزاب السياسية الدينية التي ربطت الدين بالسياسة كحزب "الإخوان المسلمون". كما أن هذه الحوامل الاجتماعية للمشروع القومي السياسي فشلت أيضاً في محاولة تطبيقه على الساحة العربية وفي أبسط صوره (التضامن العربي)، بل على العكس تماماً شاهدنا ولمسنا إحياءً لكل المرجعيات التقليدية في الدول التي تبنت المشروع القومي، وهي مرجعيات منافية للروح القومية، كالعشائرية والقبلية والطائفية.
لقد ظل دعاة القومية يشتغلون لأكثر من قرن من الزمن على بعدها النظري والشعاري البراغماتي والعاطفي، وقد فشلوا في تحقيقها على الواقع كمشروع سياسي، بالرغم من أن مقوماتها النظرية أو الروحية (سمات وخصائص الأمة العربية) قائمة في الواقع العربي كما أشرنا سابقا، كاللغة والتاريخ والعادات والآمال والآلام والمصالح الاقتصادية المشتركة.
نقول : إن القومية العربية ليست سمات وخصائص تتجسد في أمة فحسب، أي ليست لغة وعادات وتاريخ وتقاليد وآمال وآلام مشتركة، أو هي روح ووجدان مشترك لأبناء أمة ما، وإنما القومية العربية أيضاً مشروع حياة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تهدف إلى تحقيق الوحدة العربية والإيمان بها، وتتطلب العمل وفقاً لحالة الإيمان هذه على ضمان تقدم هذه الأمة ونهضتها وتحقيق ذاتها في عالم لم يعد فيه وجود إلا للكتل الاجتماعية الكبيرة المتحدة على كافة مستوياتها، الاقتصادية والسياسيةً والاجتماعية والثقافية. بيد أن هذا المشروع له ظروفه الموضوعية والذاتية التي تتكون تاريخياً عبر إنتاج المجتمع لخيراته المادية والروحية تاريخياً... إنها مشروع إنساني نهضوي لامة متخلفة ومجزأة، مورس على أبنائها القهر والظلم والاستبداد والاستعمار، وهي تريد إثبات ذاتها. وبالتالي هي مشروع يهدف إلى تحقيق كل ما يحقق لهذه الأمة ممثلة بأفرادها وقيمهم الإنسانية بما تمثله هذه القيم من كرامة وحريه وعداله ومساواة... أي تحقيق المواطنة ودولة القانون والمجتمع المدني والتعددية السياسية وتداول السلطة، أي تحقيق الدولة التي تقوم على العلمانية والديمقراطية، كونهما هما الكفيلان بتحقيق التوازن في المجتمع.
فالديمقراطية تمنح المشاركة لأبناء هذه الأمة في بناء وتقدم الدولة والمجتمع، والعلمانية تحقق فكرة الدولة المدنية بكل مكوناتها وعدم تحويل هذه المشاركة الديمقراطية، إلى مشروع تسويات شكلية بيد السلطة، خدمة لمصالح الطبقة أو القوى الحاكمة. وعلى هذا الأساس تأتي القومية هنا ضد كل مظاهر القهر والظلم والتفرد والوصاية والاستبداد والشمولية والجمود والإطلاق. فالقومية في هذا السياق هي النهضة بكل تعابيرها.
بتعبير آخر: إن مناهج البحث في المسألة القومية التي استخدمها معظم القوميين العرب ونخبهم كانت تفتقد في العديد من محطاتها عن البعد العقلاني النقدي من حيث استخدام الأساليب والمبادئ التي يجب استخدامها في معرفة الواقع وتحليله وإعادة تركيبة وطرح المشروع القومي ثورياً عبره. أي البحث عن المنهج العلمي العقلاني النقدي القادر على كشف جوهر وأشكال الظواهر والروابط الاجتماعية والثقافية والسياسية والطبقية والإثنية للواقع العربي، ومدى انسجامها وتناقضاتها، وبالتالي إدراك التناقضات القومية وإظهار قوانين تطورها ورسم قواعد أو أسس ومبادئ العمل السليم سياسياً، وتعيين النتائج الايجابية والسلبية المترتبة على ممارستها.
أما أهم هذه الأسس أو المبادئ فهي :
أولاً مبدأ الواقع الملموس: الذي لا يمكن دراسة أية ظاهرة دون ربطها بواقها الملموس، لأن الاتكاء على المواقف الشكلية والمجردة والمثالية والامتثالية والذاتية والمرتجلة والعاطفية يتعارض والجوهر الإنساني. ذلك على اعتبار أن الإنسان بالذات هو الذي يظل دائماً جوهر كافة التشكيلات الاجتماعية، وأن جوهره بالذات هو مجموع كل العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية عبر مراحل تاريخ وجوده.
ثانياً مبدأ التاريخية:أي المبدأ الذي يدعو إلى بحث كل ظواهر الحياة القومية في تطورها، فخواص الأمم لا تحمل طابعاً واحداً إلى الأبد، لذلك لابد من مراعاة خصوصيات العصر التاريخي والظروف التي تتطور فيها الأمم والأقوام في كل بلد أو مجتمع معين. هذا مع تأكيدنا في هذا المبدأ على ضرورة دراسة الوحدات القومية وعلاقاتها مع بعضها في المجتمع الواحد، ثم درجة تطور كل وحدة ودرجة نضوجها وخواصها النوعية داخل أبعاد العصر أو مرحلة التطور. واخيراً التأكيد في هذا المبدأ على التحليل الشامل للترابطات والعلاقات المتبادلة بين العوامل القومية والعوامل الأخرى من الحياة الاجتماعية، أو الوجود الاجتماعي على السواء، لأن الظواهر القومية لا تنوجد خارج الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، كما لا يمكن فصلها عن تطور المجتمع روحياً وأخلاقياً ونفسياً، وذلك على اعتبار أن الثروات المادية والروحية التي تمتلكها الشعوب أو الأمم وخواص الناس القومية تتكون على حد سواء من تلك الثروات التي خلقتها هي نفسها. ولآن تلك المنجزات التي اقتبستها هي جزء لا يتجزأ عن كل الظواهر القومية للوحدة القومية المعينة. هذه الوحدة التي تعتبر صفة من أهم صفات الأمة وشرط من شروط تكونها وتقدمها. وأن الأساس الاقتصادي لهذه الوحدة هو وحدة الحياة الاقتصادية والسوق الواحدة، أما أساسها السياسي فهو وحدة أراضيها القومية وقيام دولتها القومية بطابعها المدني. وأساسها الاجتماعي هو الحوامل الاجتماعية المناسبة القادرة على استيعاب الظروف الموضوعية والذاتية لهذا المشروع القومي والقدرة على التفاعل مع هذه الظروف وتسخيرها التسخير الأمثل لخدمة هذا المشروع من خلال التحكم بقوانين وآلية عمل مكونات هذه الظروف. اما أساسها الروحي فهو عقيدتها وثقافتها القومية ووعيها القومي ونفسيتها القومية. هذا مع تأكيدنا بأن وحدة الآمة الاقتصادية وما يقوم عليها أو يناسبها من عوامل اجتماعية وسياسية وثقافية، هي التي تلعب الدور المقرر في تعيين جوهر الأمة، حيث تكون وحدة الحياة الاقتصادية للأمة على قاعدة أسلوب إنتاج الخيرات المادية والروحية، وأن الروابط القومية التي تنتجها وحدة الحياة الاقتصادية تحل محل الروابط الاقليمية التي تتسم بها الوحدات السابقة، أي الأقوام أو الشعوب المنتمية لهذه الأمة، والأقل تلاحماً من النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية، ولا يفهم من إشارتنا الواضحة هنا إلى أهمية العامل الاقتصادي في تحديد آلية عمل المشروع القومي أنني أننطلق من منطلق اقتصادوي، بل على العكس تماماً فأنا أعترف وأقر بأهمية وتأثير بقية العوامل الأخرى المكونة للوجود الاجتماعي لأي أمة وخاصة العامل الروحي/الثقافي في تكوين المشروع القومي.
د. عدنان عويّدِ - كاتب وباحث من ديرالزور- سورية