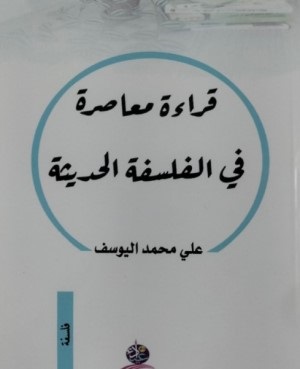قضايا
العقل الدَّعوي واحتكار الحقيقة (2): كرامة الإنسان .. ومفهوم الرحمة
 لقد جاء الإسلام رحمة للعالمين. ومعنى كونه رحمة للعالمين أن يجمع جميع المنتسبين إليه تحت راية الرحمة، وأن جميع المنتسبين إليه كذلك بغير استثناء مرحومون من ربِّ العالمين، لا بل ليس تجاوزاً أن نقول إنّ جميع بني الإنسان (لا المنتسبين إلى الإسلام فقط) مرْحُومُون بمقتضى نعمة الخلق والإيجاد. ومن شمول تلك الرحمة لهم أنهم موضع التكريم الإلهي وموطن إرادة الله للبشر جميعاً حين خلقهم وأوجدهم ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممَّن خلق أكرم الخلق وأفضل التكريم:"ولقد كرَّمنا بني آدَمَ وحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ والبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ من الطيِّبَاتِ وَفَضَّلنَاهُمْ عَلى كثير مِمَّنْ خَلقْنَا تَفْضِيلاً" (الإسراء: آية70).
لقد جاء الإسلام رحمة للعالمين. ومعنى كونه رحمة للعالمين أن يجمع جميع المنتسبين إليه تحت راية الرحمة، وأن جميع المنتسبين إليه كذلك بغير استثناء مرحومون من ربِّ العالمين، لا بل ليس تجاوزاً أن نقول إنّ جميع بني الإنسان (لا المنتسبين إلى الإسلام فقط) مرْحُومُون بمقتضى نعمة الخلق والإيجاد. ومن شمول تلك الرحمة لهم أنهم موضع التكريم الإلهي وموطن إرادة الله للبشر جميعاً حين خلقهم وأوجدهم ورزقهم من الطيبات وفضلهم على كثير ممَّن خلق أكرم الخلق وأفضل التكريم:"ولقد كرَّمنا بني آدَمَ وحَمَلْنَاهُمْ فِي البَرِّ والبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ من الطيِّبَاتِ وَفَضَّلنَاهُمْ عَلى كثير مِمَّنْ خَلقْنَا تَفْضِيلاً" (الإسراء: آية70).
هذا التكريم هو من شمول الرحمة الإلهية لبني الإنسان "ولقد كرَّمْنَا بني آدم"، لاَحظ قوله تعالى: بني آدم بإطلاق؛ لا فرق في ذلك بين يهودي ومسيحي وبوذي وهندوسي. لم يخصص أحداً من بنى آدم. بنو آدم بإطلاق: بغض النظر عن أجناسهم وألوانهم وعقائدهم، وبقطع النظر كذلك عن أوطانهم ولغاتهم ومصالحهم. فإله المسلمين هو هو الخالق؛ إله اليهود، وإله المسيحيين، وإله الهندوس، وإله كل شيء، كل الملل والنِّحَل بصرف النظر عن العقائد والديانات أو عن الأجناس والأوطان .
وإنّا لنجد في هذا المعنى الشامل للرحمة مفهوماً معاصراً "للمواطنة (citizenship)"؛ بكل المعاني التي يتيحها هذا المفهوم المستحدَث، الأمر الذي ينقض الكثير مما يعوّل عليه بعضهم من إنّ نشوء الدولة القوميّة الحديثة في الفكر السياسي، قد اقترن بالخروج من إطار المسألة الدينية إلى إطار المسألة الوطنية كما عَبَّر عنه "فرح أنطون" في مقدمة كتابه "ابن رشد وفلسفته"، من نظرة علمانية (Secularism) فاصلة بين الدين والدنيا. ومن هذه النظرة يرى "أركون" في كتابه: (الفكر الأصولي واستحالة التأصيل) إنه:" ما كان ممكنناً لأي فقيه أو متكلم أو فيلسوف طيلة العصور الوسطى حتى فجر الحداثة أن يفكر في "المواطنة" بالمعنى الذي نعرفه حالياً ... ويشرح معنى "المواطنة " ليقصد بها ذلك الفضاء الذي يتساوى فيه جميع المواطنين بغض النظر عن أصلهم العرقي أو دينهم أو مذهبهم أو جنسهم. هذا فيما يخص عنده مستوى ما لا يمكن التفكير فيه؛ بسبب مانع يعود إلى محدوديِّة العقل ذاته أو انغلاقه في طور معين من أطوار المعرفة (طبعة دار الساقي 1999م وترجمة صالح هاشم: ص10). وهذا عندي غير صحيح؛ فإن فكرة " المواطنيِّة" (Nationality) تنبثق عن روح التسامح العليا التي جاء الإسلام ليبثها بين أهله حين يكون هناك تعامل مع أصحاب الديانات الأخرى .
وفرقُ؛ وفرق كبير؛ بين أن تكون "الفكرة" موجودة، وبين أن يكون التعبير عنها مفقوداً أو محجوباً. وفكرة التسامح بل فكرة المواطنية، وإشعاعاتها اللفظية، اسُتخدمت في التصوف خاصّة في نصوص الحلاّج، وابن عربي، والجيلى، وابن الفارض، من حيث أن الدين لا يتصل بوطن ولا قومية ولا عنصرية ولا عرقية ولا مذهبية، بل الأديان فيما يذكر الحلاج كلها لله عز وجل: شغل بكل دين طائفة لا اختياراً منهم بل اختياراً عليهم . فمنْ لام أحداً ببطلان ما هو عليه؛ فقد حكم أنه اختار ذلك لنفسه، وأن اليهودية والنصرانية والإسلام، وغير ذلك من الأديان؛ إنما هى ألقاب مختلفة وأسامي متغايرة، والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف..." (راجع: ل: ماسينيون وب. كراوس: أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج، مطبعة القلم، باريس سنة 1936م؛ ص 39، 40، وأيضاً: Nicholson (R): studies in Islamic، Cambridge، 1953 ، (P. 150)
هذا ليس مفهوماً للتسامح بالمعنى التقليدي اللفظي، بل مفهوم معاصر للمواطنة، وللتعايش السلمي ينبثق من قلوب عارفة بحقيقة الجوهر الإنساني المطلوب إطلاقه من شتى القوميات العرقية والخلافات المذهبية ومن شتى القيود والحدود .
لا شك هذا الإله العظيم الخالق لكل شيء، ربّ كل شيء، لم يشأ أن يجعل رحمته مقصورة على شيء دون شيء، أو على مخلوق دون مخلوق، ولكنه جعل رحمته وسعت كل شيء، لا يحدِّد هذه الرحمة بشر، ولا يكيفها على هواه مخلوق، ولا يعرف كيفيتها بشر، ولا يدرك أسرارها عقل بشرى محدود؛ لا لشيء إلا لأنها من ربِّ العالمين وكفى؛ ومادامت من رب العالمين، فالرحمة هنا رحمة خلق وإيجاد. والناس مرحومون بمقتضى هذه النعمة: نعمة الخلق والإيجاد. فهل معنى ذلك إن البشر لم يعطوا لأنفسهم حق الفهم لهذه الرحمة، وحق المعرفة لأبعادها ودرجات شمولها للخلق أجمعين؟
في الواقع لقد أعطى البشر - ممَّن فَقِهَ عن الله ألطاف حكمته - لأنفسهم حق الحديث عن الرحمة الإلهية بما يستوجب النظر إلى فضل الله على سعة قدره هو لا على سعة أقدارنا نحن البشر الضعفاء المحدودين، وعلى شمول رحمته هو لا على ما تشتمل عليه عقولنا من مفاهيم الرحمة وحدودها البشرية؛ فكان أن قسَّم ابن عربي (ت 638 هـ) صاحب "الفتوحات المكية" و"فصوص الحكم"، الرحمة إلى قسمين: الأول وهى " الرحمة العامة" وقد وصفها برحمة "الامتنان". والثاني: وهى "الرحمة الخاصَّة"؛ وقد وصفها بأنها الرحمة "الواجبة"؛ من قوله تعالى:" فسأكتبها للذين يتّقون" (الأعراف: آية 156) وفي قوله تعالى:" كتَبَ رَبُكُمْ عَلى نفْسِهِ الرحمة" ( الأنعام: آية 54). ففي قوله تعالى:"ورحمتي وسعت كل شيء"،جاء المراد برحمة الامتنان، فكانت الرحمة العامة التي هى رحمة الخلق والإيجاد .
وقوله تعالى: "فسأكتبها للذين يتقون"؛ هى الرحمة الواجبة التي كتبها على نفسه. فالله، الرحمن، رحيم بالرحمتين: العامة التي هى رحمة "الامتنان"؛ والخاصة التي هى "الواجبة". وعرَّف ابن عربي رحمة "الامتنان" بأنها تنال من غير استحقاق بعمل. وبرحمة الامتنان هذه، رحم الله من وقَفَهُ للعمل الصالح الذي أوْجب له الرحمة الواجبة. وبهذه الرحمة العامة أيضاً - رحمة الامتنان - ينالُ العاصي وأهل النار إزالة العذاب عنهم، وإنْ كانت جهنم مسكنهم ودارهم، وبرحمة الامتنان أيضاً يزيل الله بها عن أهل العذاب في النار عذابهم ويعطيهم النعيم فيما هم فيه بالاسم الرحيم ( الفتوحات المكية، جـ 6؛ ص 415 - 416 و462 - 463، وأيضاً جـ 4؛ ص88). ومن خصائص الرحمة الإلهية عند ابن عربي أنها "سابقة": أوجد الله تعالى بها الأشياء في صور أعيانها الثابتة على نحو ما ظهرت عليه في وجودها؛ فهى بهذا أصل الخلق ومنشأ الوجود، وقد وجدت قبل أن يوجد تمييز بين خير وشر أو بين طاعة ومعصية. فالوجود - من ثمَّ - كلُّه مرحوم بمقتضى هذا الأصل: أصل الخلق، وبمقتضى هذا الأساس: أساس الوجود؛ فليس في الوجود شيء إلا ذكَرَتْهُ الرحمة الإلهية، وذكر الرحمة الإلهية للأشياء عين إيجادها إيِّاها:"فكل موجود مرحوم" (فصوص الحكم: ص42).
كل موجود مرحوم ! ولو أنك تأملت عٌمْيقَّاً مثل هذا الكلام، ورجعت على التكريم الإلهي (ولقد كرَّمْنَا بني آدم) لشمول الرحمة لبني الإنسان؛ فلن تجد في ثقافات الدنيا قاطبة قولاً يدعو إلى التعلق بالله، والقربة منه، والانفتاح على حضرته، والأمل في لقائه على شرعة المحبة والتفاؤل والمعرفة، أعلى ولا أرفع ولا أجدى نفعاً في التعلق به سبحانه من هذا القول. فهل يأتي أحدُ - من بعدُ - ليحتكر الخطاب الديني ويعبِّر عن رحمة الله ليَقفها على خصوصية فهمه هو دوناً عن سواه، ليعطي من عندياته تعبيراً عن الحقيقة المطلقة مأخوذة فقط من كلامه ومقصورة على فهمه وبيانه؟!
إنّ احتكار الخطاب الديني أو دعوى امتلاكه مستحيلٌ في العقل، مستحيلٌ في الشرع: مستحيلٌ على العقل تصديقه؛ لأنه يناقض حرية العقل، ويناقض بصيرة الشرع؛ فيستحيل على الشرع أن يأمر به فيما لو فُهِمَتْ بصيرة الشرع على أرقى مقاصدها وأدق معطياتها، تلك البصيرة المفتوحة على التلقي عن الله مباشرة؛ فوق كونه (أي هذا الذي يحتكر الخطاب) تعبيراً عن عجز الفهم عن الله .
وقريباً من مورد ابن عربي الذَوْقيِّ التبَصُّري يُفَرِّق عبد الكريم الجيلي (ت 805 هـ) أحد تلاميذه، في مجال الرحمة ومفهوماتها بين نوعين من الرحمة: الرحمة العامة. والرحمة الخاصة. فالرحمة العامة هى التي تظهر في سائر الموجودات. والرحمة الخاصَّة هى التي يختص بها أهل السعادات وعنده أن: "الرحيم والرحمن اسمان مشتقان من الرحمة. ولكن الرحمن أعمَّ، والرحيم أخص وأتمُّ. فعموم الرحمن لظهور رحمته في سائر الموجودات. وخصوص الرحيم لاختصاص أهل السعادات به" (الإنسان الكامل- جـ2 ص؛ 28- 29).
والجيلي هنا يتفق مع ابن عربي في أن:" كل موجود مرحوم"؛ فما عَمَّ الرحمن رحمته إلّا بظهور رحمته في سائر الموجودات؛ وهو المراد برحمة الامتنان عند ابن عربي. ثم إن هذه الرحمة تأتينا على سعة قدر الله لا سعة أقدارنا نحن، فنحن البشر لا نسع حتى رحمة أنفسنا بأنفسنا ولا نطيق في الغالب رحمة هذه النفس بإزاء نفسها فما بالك بغيرها؟! ولكن رحمة الله الواسعة هى أعرف بجاحة النفس إلى رحمة خالقها؛ لأنه هو الذي خلقها وأعطاها من الأمل في فضله ما يقرُّها على الثقة به وحسن الظن فيه سبحانه وتعالى .
ومن الرحمة التي لا حدود تحدِّدها حدود العقول البشرية، ولا وصف يقتدر على تشخيصها: قوله صلى الله عليه وسلم من حديث الترمذي: قال الله تعالى:" يا ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم: لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً؛ لأتيتك بقرابها مغفرة" .. ثم ماذا ..؟
لقد جاء الإسلام رحمة للعالمين من لدن ربّ العالمين، فمن شاء أن يقيد هذه الرحمة بخصوصية إدراكه هو، فقد أراد أن يحجِّر واسعاً من عند الله، ويضيق بتصوراته هو ما وسَّعه الله على عباده ويتخذ من فهمه لدين الله منهجاً - معوجَّاً أو غير معوَجِّ !- يفرضه فرضاً مبالغاً فيه على خلق الله، ليظن، من بعدُ، ظناً ليس فيه يقين إنه هو المنهج الذي جاء به الله سبحانه، لا لشيء إلا ليحتكر الخطاب الإلهي وحده تعبيراً وتفكيراً وإلزاماً للناس تمهيداً لاحتكار الحقيقة ثم تملُّكها، وتخطئةً؛ بل وتكفير في أكثر الأحيان، من يرى غير رأيه أو يقول غير قوله، أو يُعَبِّر عن تلك الحقيقة بفهم غير فهمه ومعيار غير معياره، ولو أنه قال:" هذا فهمُ أُوتِيه رجل مسلم، فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه"؛ لكان أقرب إلى الحقيقة، وأصوب في التقدير والتفكير، وأرقى في لغة التعبير خطاباً غير محتكر ولا متعدى ولا متجاوز ولا مملوك .
مثل هذا الرقي في التصور يدلُّ على رقي في الإدراك، وهو من علامات المحقق إذُ المحقق على الحقيقة فيما يقول ابن عربي هو الذي يدعو إلى الله على بصيرة، وهو الذي كما روي الشعراني في طبقاته:" لا يأتي بشرع جديد وإنما يأتي "بالفهم" الجديد في الكتاب والسنة" (طبقات الشعراني: جـ1، ص6) .
ومن هنا؛ من ذلك المعنى المفتوح لإدراك مفهوم الرحمة كما تقدَّم؛ وفوق ما تقدَّم، يمكننا القول مرة ثالثة بأن الإسلام جاء رحمة للعالمين. وهذه الرحمة للعالمين تشمل خلق الله جميعاً بغير استثناء فرقة ولا طائفة ولا مذهب ولا دين: في البوذية جزء من الإسلام، وفي اليهودية جزء من الإسلام، وفي المسيحية جزء من الإسلام، وفي الأديان غير الكتابية جزء من الإسلام، لأنها جميعاً قد مسَّت الحقيقة في جزء منها. والإسلام هو الحقيقة الكبرى؛ والضخمة، والتامة، والشاملة؛ وهو هو الرحمة التي أرسلت في المطلق للعالمين:
" وَمَا أرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً للعَالَمِينَ"
وفكرة "التمام" لمكارم الأخلاق، التي نضح بها حديث المصطفى، صلوات ربي وسلامه عليه - على بساطتها ويسرها - هى من أصول فهم الإسلام للعقائد والأديان السابقة، والإقرار بما لديها من مساس الحقيقة؛ في جزء منها لا في كلياتها، والاعتراف بوجود المكارم؛ أخلاقية عملية كانت أو عقائدية كبرى، ففي الحديث قوله؛ صلى الله عليه وسلم:"إنما بعثتُ لأتمِّم مكارم الأخلاق"؛ فكأنما هذه المكارم الخلقية كانت موجودة في السابق، غير أنها في الوقت ذاته لم تكن كاملة، ولم تكن تامة، ولم تكن كلية شاملة يلمُّها مبدأ "التوحيد". ومعنى كونها لم تكن تامة لا يلغي في السابق عدم وجودها. وفي الحديث اعتراف بفضل السابق: أنهم كانوا أهل مكارم، وإنْ كانت لديهم ناقصة قاصرة ليست بتامة ولا شاملة. وما يُقالُ عن جانب الأخلاق يقالُ في نفس اللحظة الكاشفة لفكرة "التمام" هذه - على بساطتها ويُسرها - عن العقائد الكبرى: التوحيد والعالم الآخر.
فالذي يفهم من ثمَّ هذا الجزء من أصحاب الديانات - كتابية كانت أو غير كتابية - يقبل الإسلام على أنه حقيقة إلهية ضخمة وكبيرة، تخاطب الضمير وتستقر في السريرة بمقدار ما تخاطب كل وعي مفتوح لتلقِّي الحقيقة بما فيها من دعوة عالمية، ومن دين شامل لا يتقيد بقيود الحدود الجغرافية والحدود الفكرية والثقافية سواء. والذي ينكر هذا الجزء من المنتسبين إلى الإسلام ينكر أولاً خلق الله. وينكر ثانياً تقدير الله على عبادة فيما قدّره على خلقه من عقائد وعبادات. وينكر ثالثاً مفهوم المواطنة (citizenship)
بمعناه الاصطلاحي والإجرائي معاً. وينكر رابعاً هؤلاء الذين عرفوا الحقائق التي جاء الإسلام ليُقرَّها في الضمائر والقلوب، وهو من بعدُ يدعو إلى الإسلام على جهالة وغلبة ظن، ليكون على لسانه بمثل تلك الدعوة المغلقة يتبنَّاها، ديناً ضيقاً لا يتسع لخلق الله ولا لعبادة الله الواحد الأحد .
إنما الإسلامُ في حلِّ عن الأشخاص .. مهما كان هؤلاء الأشخاص وأينما كانوا: أعرف الحق تعرف أهله، ولا تعرف الحق بالرجال؛ فإن معرفة الحق بالرجال فيها من النكوص والبطلان ما يؤخِّرها عن رتبة المعرفة الحقة؛ لاختلاف الأهواء والتَصورات ومواطن القوة لديهم ومواطن الضعف.
لا تعرف حقاً قط على ألسنة الرجال، بل أعرف الحق من الحق أولاً تعرف أهله وتعرف رجاله. أعرف الحق من الحق وتمادى في العرفان! ليس كل علم يستقل بالإحاطة به كل شخص، ولا كل شخص يستقلُ في نفسه بالإحاطة بالعلوم، وليس كل إنسان في مستطاعه أن يدرك الحقيقة المجرَّدة عن نزغة الهوى، ولا كل إنسان بمقدوره أن ينظر إلى الواقع الفكري والثقافي نظرة الذين يفكرون ويعقلون ما هم يفكرون فيه، ولا كل إنسان بقادر على أن يكون من أولئك الذين يرون الأشياء بالله من خلف حجاب السبب، ولكنما هى مواهب وقدرات تتصل بتكوين العقل؛ وإحاطة القلب بنور المعرفة في غير حجاب. ومن أجل ذلك؛ قال سيدنا الإمام على بن أبي طالب رضى الله عنه:" لا تعرف الحق بالرجال، أعرف الحق تعرف أهله".
وأهلُ الحق يأخذون الحق من الحق لا يحيدون عنه، ويأنفون من أخذ الباطل ولا يطيقون استطالته وطغيانه. وبما إنهم إذا هم كانوا يأخذون الحق من الحق؛ فإنهم لا يأخذونه من جهة أخرى من أفواه الرجال؛ لأن معرفة الحق تحول بينهم وبين تقديس الرجال، وكما أن للحق أهله وطلابه وعارفي فضله فمعرفة الحق هى أيضاً تقود إلى معرفة أهله وطلابه وعارفي فضله. ومن هنا؛ فقد وَجَبَتْ معرفة الشيء في ذاته بعيداً عن خزعبلات الأشخاص، بعيداً عن تقديسهم وتحميلهم ما لا طاقة لهم به مما لا يمكن احتماله.
ومن هذا المدخل المُتَّسع المفتوح نلحظ أن أغلب الذين يَدْعُون إلى الإسلام اليوم - إلا مَنْ رَحَمَ ربك - ممَّن نراهم على شاشات الفضائيات، أو في ساحات الميادين والمنابر والطرقات، ويعقدون من أجل الدعوة أحكم المؤتمرات وأحشدها ويعبِّرون في وداعة (!!) عن "العقل الدعوي"؛ يدعون له وهم في الواقع يدعون لأنفسهم ولمصالحهم ليعبدهم الناس بدلاً من عبادة الله . إنما يريدون أن يكتسبوا المكانة الاجتماعية، وربما ما هو فوق المكانة الاجتماعية أيضاً؛ بمثل هذه الدعوات التي لا تدلُّ على الحقيقة بل تحتكرها !
والزعامة الدينية لا تنهض دليلاً على الإخلاص في الدعوة. ومداخل الشيطان ومساربه إلى نفوس الداعين إلى الله أخطر وأدق من أن يتنبه إليها أحدُ إلا في أقل القليل النادر. واكتساب الزعامات الدينية فضلاً عن كونها تسيء إلى الإسلام فهى تقدح في نية طالبها وفي وعي صاحبها بهذا الدين: روحه وخطابه وتبليغه بهذه الروح وبذاك الخطاب ..!
د. مجدي إبراهيم