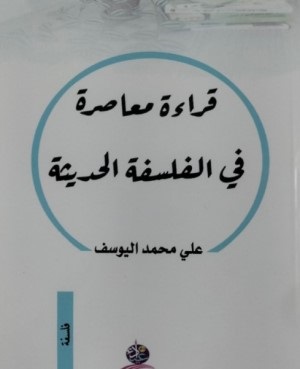قضايا
عنف التأويل الديني
 للتنظيمات الإرهابية أيديولوجية مُغلقة تستندُ إلى تراث ديني دموي موبؤ، مُوغل في التعصب والعنصرية والأصولية الظلاميّة والتخلف الفكري بكل معانيه، هذه الظلامية نفسها تحمل خصائص الفكر الرجعي العدائي الاستبدادي المُنحرف، وتدعو إليه بمختلف الوسائل التي تملكها أو لا تملكها إرساءً لتلك الخصائص وتدعيماً لأفكارها الرجعية المتبلدة التي حافظت عليها من طريق التقليد والإتباع .
للتنظيمات الإرهابية أيديولوجية مُغلقة تستندُ إلى تراث ديني دموي موبؤ، مُوغل في التعصب والعنصرية والأصولية الظلاميّة والتخلف الفكري بكل معانيه، هذه الظلامية نفسها تحمل خصائص الفكر الرجعي العدائي الاستبدادي المُنحرف، وتدعو إليه بمختلف الوسائل التي تملكها أو لا تملكها إرساءً لتلك الخصائص وتدعيماً لأفكارها الرجعية المتبلدة التي حافظت عليها من طريق التقليد والإتباع .
هذه الرجعية الكاسدة كانت رفضت كل صنوف محاولات العقل التأويليّة، حتى إذا هى اجتهدت فأوّلت اختارت العنف؛ فأقامت عليه دعائم التأويل ليصبح عنف التأويل الديني نصَّاً مقدَّساً هو الشغل الشاغل لكساد الحياة الفكرية لديها، ولينقلب "المقدس" من فوره تحت دعائم العنف المُأدْلَج إلى "مدنّس". وبالمثل؛ كانت رفضت كل الدعوات المستنيرة التي حَمَل مشاعلها دعاة التنوير ورعاة الوعي الروحي والفكري في ثقافتنا العربية والإسلاميّة؛ فهى بحق : نقطة سوداء في جبين العقل العربي على التعميم.
باسم الدين أصبح العنف يرسم صورة دمويّة لله هى نفس الصورة القديمة لآلهة الحرب، والتي كانت غارقة في الأساطير تحت غطاء الحروب المقدسة؛ فالجماعات الإرهابية وثنية حديثة تجدّد الحواشي القديمة لآلهة الحروب، ولغة الخطاب الخاص بها يقطر دماً ويفضي لا محالة إلى الموت؛ فمن يتأمل مصاصى الدماء الجُدد، المتشددون باسم الدين سيعلم أن متعلقات الإله الذي يعبدونه ليست إلا السّهام والسروال الحربي والعيون الغاضبة والجباه الناريّة والأطراف المنتصبة والمبارزات الفتاكة : تجسيد غرائزي قبيح لتشوُّه الحب المفقود في آله قتل وتدمير ليعود النص الديني أسطورةً حول إله دموي بمجمل المعاني العنيفة، لا إزاء الآخر فحسب، بل تجاه الأنا كذلك.
على أن التفرقة بين الله والإله ظاهرة بوضوح؛ فالله مفهوم ديني كتابي توحيدي متعالٍ مُنَزَّهُ عن لوثات البشر وتأويلات البشر، ولا يعرف الله على الحقيقة إلا الله كما في مقولة أبي بكر الصديق التي عليها يستند الصوفية. أمّا الإله فهو مقولة ثقافيّة قديمة ترجع جذورها إلى رسوم ونقوش وأخيلة حول المقدّس، وهو بهذه الدلالة يرتبط بوجود الإنسان في أزمنته المختلفة؛ فكل مِنّا يتملك إلهاً نتصوّره من موقعنا الثقافي لكننا لا نمتلك الله بحال. لقد أعاد الإرهاب الديني اليوم تشغيل ماكينة الأساطير القديمة التي ربطت الآلهة بالحروب العنيفة وتمَّ اعتبار الإله "تقنية عدم"؛ تؤسس لأشكال الموت والإقصاء والبتر في المجتمعات الإنسانيّة، ومن هنا صارت آلهة الحرب صورة ثقافية قديمة بمضمون فلسفي.
من البحوث الممتازة التي تناولت هذا الموضوع بعمق وجديّة بحث قدَّمَه الصديق العزيز الدكتور "سامي عبد العال" أستاذ الفلسفة بآداب الزقازيق (مصر)، وناقشه مُؤخراً في مؤتمر "الفلسفة في مواجهة العنف". عرض فيه لفكرة العنف التأويلي للدّين واستعادة آلهة الحرب في العقائد القديمة؛ إذْ رَسَمَ المجاهدون الإسلاميون باسم الله دور "حَفَّاري القبور"، وذلك بعدما غاب تأويل ثري لمعاني الإله بأساليب غير إقصائية، في الوقت الذي حَضَرت فيه تأويلات ملوثة بإجابات قاطعة، وبفضل شيوع صورها العدوانية تذهب به إلى المقابر.
وتَمَزَّق مفهوم الله (الاسم الإبراهيمي بامتيازه التوحيدي المتعالي) إلى مجموعة آلهة متناحرة، وكل جماعة إسلاميّة اختلقت إلهاً يقف في جانبها حاملاً سلاحه منافحاً عن كيانها؛ فالدواعش ينشدون إلهاً، والقاعدة تحدِّد لها إلهاً آخر، والسلفيّة الجهادية يعتبرونه مغايراً، والسلفية التقليدية تضع مواصفات غير هذا وذاك، وكل يُوقّع باسمه تحت ما كان أختار لنفسه من مفهوم الإله الذي على هواه، بينما يشتركون جميعاً في تحويل العالم إلى سَاحَات حرب.
يتعدّد مفهوم الإله بمعطياته المختارة، ويستعيد فكرة تعدد الآلهة في الثقافات القديمة؛ فهناك إله السلطان، وإله العدو، وإله الجهاد، وإله الخوف، وإله القربان، وإله الخلافة، حتى ليستولي هذا الوضع الخطر على فكرة الإلوهيّة لتجيء في صورة صنم عابد. أضْحَتْ دلالة الإله في الثقافات الجهادية التقليدية المعاصرة ثقباً أسود يمتص طاقات التسامح ورغبة الحياة، أو ربما كانت نموذجاً يعوض عجزنا عن اليقين والفعل العام، وقد تصبح انفتاحاً خطيراً على مستقبل الإنسان، ولكنها تظل مع ذلك مبرراً غيبياً غامضاً لأفعال قتل تجاه الآخرين.
وإزاء الدين تجدرُ التفرقة بين مستويين : مستوى الإيمان، وهو التجربة الذاتية المُرْتَهنة باليقين الشخصي والسّر الإلهي تجاه المُقدّس. ومستوى تصوري، وهو الموقع الثقافي الذي يحتله الإله في ثقافة بعينها ليرتدي تصورات نوعيّة خاصَّة بالأفكار السائدة ثم يصبح هذا التصوّر مفروضاً بموجب العنف المُقنن داخل تأويل المعاني المحيطة به. إنّ هذا المستوى الثاني لهو أكثر فاعلية من الأول، أكثر واقعيّة يُمارس في مستوى الفعل بالواقع العملي مشروطاً على شرطه وفي خلال تصوراته النوعيّة، وهو الذي يُفْرَض بقوة الحقائق العنيفة داخل المجتمعات .. ثمَّةً تغطية مقصودة نصيَّاً لمعاني الله في حركة الثقافة تتجنب زواياها الإنسانية لترسّخ هيمنة التأويل التقليدي للفكر الديني؛ فمقولة الحلاج المتصوف الشهير "ما في الجُبَّة إلا الله"، لربما تشير بجانبها السِّري إلى زَيْف الواقع الثقافي وصوره وأساليبه التي تزعم امتلاكاً لله، وتدَّعي احتكار حقيقته.
فالعبارة تُعلن إمكانية حصر مدلوله المفتوح في هيئة بشرية كانت سلاحاً في أيدي الغوغاء ورجال السُّلطة تاريخياً. وقول "الواسطي" كذلك "أعمال الشريعة كفر"؛ بمعنى أنها ستر وتغطية، وحجاب أيضاً فيما لو طلبت لذاتها ولم يتجاوزها طالبها إلى حيث البلوغ بها إلى مقام التوحيد، إلى الله مباشرة؛ لأن الشريعة في ذاتها خارج الذات الطالبة، والذات الطالبة تطلب مقصودها الله لا عمل الشريعة، فكما أن العلم نور، فكذلك سرعان ما يصبح ظلمة غاسقة فيما لو طلب لذاته ولم يتجاوزه صاحبه من ظاهر إلى باطن ليرحل من كونه إلى مكوِّنه، والشريعة علم متى تمَّ الانشغال به عن الله في غير توصيل إلى الحقيقة الإلهية ليصبح عملاً من خارج الذات وهمَّاً من هموم الدنيا الصاخبة يعكس واقعاً ثقافياً زائفاً بشتى الصور المقلوبة وبشتى المقاصد الملتوية المنقوضة التي أخطأت طريقها إلى التوحيد كما أخطأت من قبل ممارسته، فهو هنا قد صار حجاباً، والحجاب كما تقدَّم ستر وتغطية وخروج عن المطلوب؛ لأنه يعمل في المستوى التصوري، مستوى الموقع الثقافي التأويلي التقليدي، فهو ها هنا ثقافة ليست سّراً إلهيّاً تجاه المقدس بل كفران ..!
وفي الثقافة العربية الإسلاميّة من يمتلك الله هو من يقول؛ وفعل القول تخريجٌ على هامش المقدّس، يُشْبِه أن يكون بذاته مُقدّساً لمجرّد نسبته إلى الله. كانت الذهنية العربية في منشأ المجتمع الإسلامي ذهنية حسيّة، الخيال يُرادف الحسّ إلى درجة التوحُّد؛ وربما كان هذا رابضاً وراء منطق البرهان التمثيلي في القرآن، لكأنما هناك تأويل تقليدي وتأويل تجديدي للفكر الديني، وكلاهما يتوقف على ذهنية مَنْ عَسَاهُ يمتلك، في حضور أو غياب، عناصر التأويل. التأويل التقليدي ينتج عنه العنف بالضرورة؛ لأن ذهنية صاحبه لا تتوقف عن غسق التلقيد فتوؤل ما من شأنه أن يظهر لها من خلاله، ولا تأخذ بمنطق التجديد، ولا تمتلك عنصراً واحداً من عناصر التأويل وأهمها : إعمال العقل فيما هو فارقٌ بين الثقافة والتجربة.
ولمَّا كان مفهوم "الإله" في الأقوام البدائية قد تجسَّد في صورة ماديّة أو مثال مُفَارق خارج الواقع كما أتخذ صورة تجسيديّة كالآلهة الوثنية التي رَمَزَتْ إلى القداسة؛ كان كائناً مُخيفاً حقيقةً يشكل مصدراً للتحريم والرهبة شأن "الطواطم" في المجتمعات البدائية. أصبح خيالاً متجمّداً في وضع المفارقة؛ من حيث اعتباره مقدّساً وفي نفس الوقت له تَعَيُّنُ مادي، له بعدٌ أثريٌ كنوع من الحضور المضاعف، وهو بذرة نابتة في أحشاء الأساطير والسرديات الكبرى عن الكون وعن أنفسنا وعن الوجود الخَفي، وبحكم تعريفه كان متعدداً في وجوده القديم، إمّا بجوار آلهة آخرين، وإمّا في أشكاله من مجتمع لآخر. لقد أحيت الجماعات الإرهابية هذه الصورة الرعويّة للإله فلم يعد الخيال الديني لديها سوى مادة مُحمَّلة بكثافة لأرشيف العنف وسفك الدماء وقتل الأبرياء وتفزيع الآمنين.
فلئن كان الإله بمثابة الموقع الأعلى للإيمان فهو ليس إلا موقعاً تأويليّاً يوظَّف العنف بدرجات متباينة؛ ولأجل تناحر الأفكار والمنظومات الدينية أصبح موضوعاً للحروب الرمزية ناهيك عما أظهره الإرهابيون من قابليته للتملك الخاص، وبجانب هذا تشتعل الصراعات الاجتماعية باسم (الإله) على صعيد الحياة اليومية؛ فكل منَّا يدفع عن الإله الذي يتبنّاه، ويتقرّب إليه كما كان يتقرب الهمج الرعاع بالبغاء المقدس وسفك الدماء حتى إنّ قتلاً مقدساً لا ينتهي دون إبطال كل التصورات الجارية على محيطه.
تعني آلهة الحرب كل أشكال الموت والدمار، فيستعيدها الإرهابيون اليوم من بطن كهوف التاريخ المظلمة ليكون الموت مُقدَّساً لآلهة مدنسة. أما الله في الأديان الكتابية فيعني الحب والتسامح والرحمة المرسلة من قِبَلِه للعالمين.على ناصية الموت أصبح العنف مادة يتخذها المتشددون باسم الدين ليستمر نباحهم كما الكلاب في وجه المجتمع بمقدار ما يتنطع بشكل ديني قميء لدى "داعش" و"القاعدة" حتى بات سمّة عالمية. وقد عرى العنف ليس الأبنية الثقافية للمجتمعات فقط بل كيان الإنسان كموجود متربص على الدوام : تربص للانقضاض، للتفجير، للتفخيخ، للإفناء؛ فماذا بقى منه للآخر؟ لا شيء .. لا بل الموت والتدمير. أصبح الموت بديلاً عن الحب، وأصبح العنف ملتصقاً بالغرائز الأوليّة فيخبو في اللاوعي ليكون مسرحاً لأشباح تاريخية تحضر مرة بعد أخرى.
قارن - إنْ شئت - هذه الدمويّة التي تُكَرِّس للعنف وتستحضر آلهة الحرب، بصورة أخرى راقية، وداعية في الوقت نفسه للمحبة والتسامح والإيثار كما عُرِفَت في التصوف؛ فالموت يكشف تحوّل هذا العنف، هذا الحُلم الآدمي القديم في ثمار شجرة الحياة، وهل هناك حياة أكثر أبديّة من الجنة ؟
فإذا كان المتصوف يصل إليها بوحدة العناصر الطبيعة ومعها الإنسان، فالمتطرِّف لا يجد بداً من الوصول إليها بزفاف دموي بالأكفان.
بقلم: د. مجدي إبراهيم