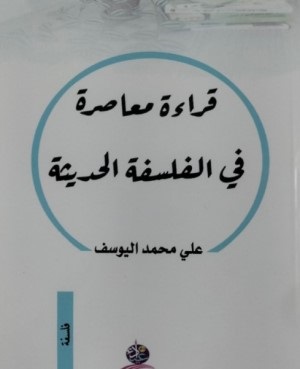قضايا
عند مطالبة الحقائق يفتضحُ أهل الرسوم
 لماذا تكتب في التصوف؟ هل يحتاج التصوف إلى قلمك؟
لماذا تكتب في التصوف؟ هل يحتاج التصوف إلى قلمك؟
قد تكون نكبة شديدة أن تكتب في هذا الفن، وأنت مُحَاط بالغرض أو بالهوى أو بالعلائق أو بالأغيار. هل تكتب في هذا الفن لشهرة؟ كيف وحكمة الحكمة البالغة فيه تقول: أدفن وجودك في أرض الخمول؛ فما نبت ممّا لا يدفن لا يتمُّ نتاجه.
هل تكتب فيه لأجل غرض من أغراض الدنيا، جمع مال تتكسب منه، أو إعجاب تناله ممّن يفهم أو لا يفهم، أو وقت تقضيه أزجاءً لفراغ عاطل؟ لماذا تكتب في هذا الفن؟
إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال : "تعس عبد الدينار، والدرهم، والقطيفة، والخميصة، إن أعطي رضى، وإنْ لم يعط لم يرض ". تعس كل راغب في التملك. تعس كل راغب في السيطرة والاستحواذ. تعس كل جشع طامع ليس ينظر فيما وراء ما يُبلى. فاللَّهم لا تجعلنا من الأرذال المتاعيس عبّاد الدرهم والدينار.
تكتب ليقال عنك الجهبذ الذي لا مثيل له، أو العالم الذي لم تنجبه ولادّة، أو الكاتب الذي وقف بكتابته على ما لا يقف عليه الأوائل. تكتب لهذا الغرض الخسيس أو ما يُشابهه من أغراض الدنيا. إذن؛ فأنت من أفشل الفاشلين؛ لأن كل هذا كله شئ، والتصوف شئ آخر.
تلك كانت طامة كبرى على الذين لم يعوا خطورة البحث في هذا العلم، وأنا واحدٌ من هؤلاء.
واجهت نفسي كلما خلوت بها لماذا الكتابة في التصوف؟
وكلما رددتها عن هذا العلم وصرفتها إلى غيره، عادت إليه منهارة القوى كسيفة المأوى تتلمس بقاءها في حكمة الفقراء .
أشعر بنقص شديد مع الأولياء، بمقدار ما استشعر عقاب الله لي، وأقول دائماً إن مصيبتي في نفسي شديدة من حيث إنها انحدرت إلى هذا الصفاء وهى تعيش عكارة المأوى. كان حظي أسوأ الحظوظ أنني تخصّصتُ في هذا الفن، وكتبتُ فيه، ونشرت المطولات ووضعت صورتي على كتبي ليراها من يراها وهو يرى الغرور الأحمق ظاهراً على الكاتب ولم يكن يشم من آثار القوم رائحة اللّهم إلّا لجلجة اللسان دون خفقة الجنان.
كنتُ أقول ولا زلت : لا بد لك من كارثة تفيقك من هذا العته الذي تعيش فيه صباح مساء. إنك لمُحاسب على كل حرف كتبته ولم تعمل به، إذا لم تكن لك تجربة تعطيك من ذاتك؛ فلا أنت تعرف عن القوم إلاّ ما قرأت، وفعل القراءة وحده لا يغني فتيلاً عن الممارسة الحيّة والصدق المخلص في ظلال التجربة، لكن هذه التجربة ليست باختيارك ولا هى من إرادتك ما لم يكن وراؤها توفيق من الله. أذكر جيداً إنه " عند مطالبة الحقائق يفتضح أهل الرسوم".
ماذا يفيدك المجموع فيما لو كانت قناعتُك أقلَّ من اندفاعك نحو ما تكتب؟ لماذا أحرق الجنيد أوراقه؟ وقد نظرت كيف أنه حكي حين رؤى بعد مماته إن الإشارات التي كان يلقيها طارت، وإن العبارات التي كان يعطيها غارت، ولم يبق في النهاية إلّا بصيص أمل في موعود الله من طريق الأذكار .
ليست المشكلة في المبادئ النظرية تعج بالمثاليات .. كلا .. المشكلة في الممارسات، وفي القدرة على التطبيق من عدمها أو قلتها أو ندرتها .. تردي الأحوال سببه الرئيس يكمن في البعد عن تطبيق المبادئ النظرية، وانفراد الواقع الوهمي بالضغط على عروق الحيويّة الخلاقة. وبكثرة الضغط الذي لا يرحم انفجرت تلك العروق فياضة بدماء الحياة. وإذن، فإلى الفناء الذي لا يعقبه بقاء !
إذا كانت أنوار السالكين أربعة : نور العقل في الفكر، ونور القلب في الذكر، ونور السّر في الإخلاص، ونور الوجه في التقوى، فليس من شرط للترقي إلا الذكر المشروط بالمراقبة. أين ذهبت منك هذه الأحوال؟ ألم تكن صادقاً؟ ما الذي يمنع الأنوار يا رجل أن تتغشى رجلاً يَلْهَج بذكر الله على الدوام بغير انقطاع؟!
وما الذي يُحجبه عن ربه، وقد وعده قطعاً بالمعيّة؛ لا بل وعده بالذكر المتبادل، فذكر العبد لله يتبعه ذكر الله للعبد، والجزء الذاكر على الدوام من العبد موصولٌ باستمرار بمعيَّة الرَّب؟ أفي غير هذا يمكن أن تكون دعوى الأنوار ولا مِكْنة لها في عينه أو في مثله؟!
إنه الحق تعالى هو الذي يقول :
"أفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ للإسْلَام؛ فَهُوَ عَلى نُور منْ رَبّه"
فَكّر في هذا "النور"، وتأمل تلك الحياة التي ينشرح فيها صدر صاحبها للإسلام؛ ليكون مَنْ شرح الله صدره على نور من ربّه، فيجيء هذا النور يَتَغَشَّاهُ حتى ليكاد من سطوته يحترق.
فكر في هذا، وتأمل أو تخيله مجرَّد تخيل فيما لو كانت حالتك على غير هذا الوصف؛ ليصلك بعد التخيل أحساس عظيم : أن تكون على نور من ربك؛ ثم مدد هذا الإحساس إلى منتهاه لتستشعر عظمة هؤلاء الناس الذين شرح الله صدورهم للإسلام، فكانوا على نور من ربّهم.
والمنشرحة صدورهم للإسلام هم الداعون إلى الله على بصيرة؛ العارفون به، الصادقون في طلبه، الآخذون عليه العهد أن يبقوا في معيته، السائلون التوفيق منه فيما يأخذون وفيما يدعون .
أتدري معنى أن تكون على نور من ربك ..؟!
أن تنظر به، وأن تسمع به، وأن تبطش به، وأن يملئك كما يملأ السموات والأرض؛ يملئك في كليتك، ويفنيك عن كليتك، ويأخذك به عنك، ويحييك حياة الذين أحياهم بعد موات؛ ويسقيك شراب الأحباب تشربه كأساً بعد كأس فلا نفذ الشراب لديك ولا رويت.
تستشعر صنعته فيك، ومخلوقيتك له، وتجلياته عليك، وفعله فيك؛ وَقَيُّوميته عليك، تستشعر هذا كله شعور إيمان وتسليم وتقصير ونقصان، وتقابله بالمذلة والافتقار فهما روح العبوديّة؛ واللحظة التي تعرف فيها عبوديتك لله تتكشف ذاتك، وتكتشفك ذاتك بالوصول إلى حقيقتك الأصلية فتدرك حقيقة قوله تعالى :
" واللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ "
إنّ الذين كشفوا عن الله، فحملوا الشّعلة المقدَّسة وأناروا للبشرية جوانب غموضها هم أهل فكرة علويّة وجهاد كبير : أحبّوا الحقيقة خالصة (الحقيقة الكلية)، وعبَّروا عن هذا الحب، واتصلوا بها عن طريق الوحي والإلهام، وكأنهم جمعياً فرداً، فذّاً، واحداً، يتجدَّد ظهوره مع دورات الزمن، أو كأنهم روحاً واحدة تتقمَّص في كل زمان صورة جديدة من صور" الإنسان الكامل".
يملكُ الصوفي وعياً داخلياً عالياً مبْطوُناً بوظائف الخبرة التَّبصُّرية التي تفوقُ دقة الإحساس، وتدلُ على فهم تصوِّفي لنظام كوني غير محدود، يدفع النفس دفعاً إلى تجاوز عالم الحسِّ والعقل تدركه النفس بالذوق، أو تدركه في النفس حاسّة متعالية كونية (Cosmic Transcendental sense)؛ كما يقول الصوفية، وكما يصفها علماء النفس المحدثون أيضاً، ولم يهتد الصوفية أنفسهم إلى معرفة كُنْه هذه الحاسَّة الغريبة، ولا إلى موضعها من الحياة الروحيّة، وهى قديمة في التأملات البشرية. المهم أن بعض علماء النفس الذين اخضعوا التصوف لمقاييسهم المادية، واعتبروه مرضاً نفسياً ومجرَّد حالات غير سويّة، ردّدَوا بعض العبارات الجائرة عن التصوف؛ لأنهم حصروا أنفسهم في دائرة التجربة الحسيّة وحدها، وصار اختلاف المنهج من العوائق المُسدلة أمام فهمهم للحالات الصوفية. ومادام المنهجُ مختلفاً فلابد أن تجئ الرؤى متباينة والنتائج لا شك مختلفة. هذا يبحث في الحسِّ والتجربة الحسيّة, وذاك منهجه الذوق والتجربة الروحيّة، والذي يقيس هذا بذاك هو من الجهالة بمكان بحيث يريد أن يقيس الشيء، وهو يجهل كيف يقاس !
ولو رجع هذا الذي رَدّدَ بعض عبارات علماء النفس إلى مؤلفات عالم النفس الأمريكي وليم جيمس، أو إلى كتابات ليوبا، وباستيد، وأندرهيل، وثولس، وغيرهم من علماء النفس الديني؛ لعرف أن هذه الآراء قتلت طرحاً وبحثاً من قبل، ولكفى نفسه مؤنة التقليد الأعمى لآراء تمّ الرد عليها من قبل علماء النفس الديني أنفسهم.
أضف إلى هذا، أن المرض النفسي أو العقلي يصاحبه فقدان لشعور مستمر للأنا، والصوفي في كل حالاته لا يفقد استبصاره لذاته مطلقاً ولا شعوره بوحدته الذاتية مع الحق. الحالة الصوفية، كالبرق الخاطف لا يثبت ولا يدوم : فناءُ وبقاء، غيبةُ وحضور، سُكر وصحو، جمع وتفرقة، قبض وبسط، أوجاع لا حصر لها تعانيها الذات العارفة بين وصال وجذب، ونكوص وانقطاع ممّا لا يخطر على بال مخلوق سواه.
وإذا نحن جعلنا من الصوفي شخصاّ مريضاً؛ لجعلنا من الشاعر والكاتب والمُلهم والفنان والموسيقى جميعاً مرضى عصابيين لا لشيء إلا لأنهم يعانون مشاعر خاصّة تنزع بهم إلى التفرّد والامتياز؛ لأنها تنزع بهم إلى التأمل خلال تجارب خاصَّة لا تُعَمّم, ولكنها مع ذلك تُفْرقهم عن غيرهم مِمَّن لا يعانون معاناتهم : تجارب روحيّة ذاتية لا يعانيها غيرهم من أفراد الناس العاديين.
من يقول بنسبة التصوف إلى المرض يصطنع منهج المماثلة في دراسة حالات التصوف. وهذا خطأ في الحكم العلمي؛ لأنه لم يقم بتجربتها فيتعذر مماثلة الصوفي في حالاته الوجدانية والشعوريّة مماثلة حقيقية. وعلماء النفس الذين يعتمدون التجربة الحسيّة، ويصدرون أحكامهم على المتصوفة من خلالها، ليسوا بصوفيّة ولا هم يدرسون صوفية موجودين بالفعل، يتعاطفون معهم أو يفتقدون التعاطف معهم، وإنمّا يكتفون بتحليل قشور عرضيّة مِمّا كان تركه قدماء الصوفية من آثار أدبية ويقيمون عليها أحكامهم جُزافاً في غير تحقيق، الأمر الذي يعني أن دراستهم ليست دراسة تجريبيّة مُنصفة بالمعنى الحقيقي للكلمة.
التقليد للآراء السابقة، والإيغال في ترديدها ترديد الببغاوات دون الرجوع إلى ما أثارته في زمنها من ردود فعل وما اقتضته من مناقشات ثم صدور الرأي تحقيقاً عن صاحبه، هو عندي لا يدل على تفكير، ولا يسمح على الإطلاق بوصف قائله بالمفكر، بخساً وجوراً لصفة التفكير.
والاستناد على مغالطات منهجية وتقويم قيم الحوار العلمي على أساسها، شيء يقدح في جديّة هذا الحوار. والتقليل من شأن معارف أثبتتها وقائع التجربة الحياتيّة على حساب علوم أخرى يُراد لها الغلبة والانتصار؛ هو تقليل في الوقت نفسه من شأن الإنسان : مواهبه وملكاته وقدراته؛ لأن إعلاء جانب على جانب فيه فضلاً عن كونه يفقده التوازن المطلوب ويقدح قطعاً في ميزان العدالة لديه؛ فهو أيضاً يُلقيه مدحوراً في حماة الاعوجاج. ويمكن التركيز على هذه النقاط الآتية :
فالأولى : الحواس لدى الصوفية مرهفة ومشاهداتهم بالطبع أعلى وأرقيً، لأن الوعي لدى الصوفي عالي ليس بالعادي. الصوفي صاحب مجاهدات مضنية شاقة، وعن هذه المجاهدات تصدر أحوال هى ثمرة ونتيجة، وبالتالي لا تستغرب عنه مثل هذه الهواتف الربانيّة ولا أشياء من هذا القبيل، وغير هذا الكثير والكثير.
والثانية : وهى اعتبار الصوفي من أهل الخلاص، وبالتالي يتعالى على الناس بوصوله إلى حضرة القدس, فهذا كله من الكذب والافتراء على الصوفية بحيث لا يمكن أن تمر على عقل عادي له مِسْكَة من وعي أو من تفكير. الصوفي دائماً لنفسه متّهم، شاعر بالتقصير يتوب ويستغفر ويجعل من الاستغفار عادة له وديدناً. فكيف يشعر أنه من أهل الخلاص؟!
والثالثة : وهى عداء الصوفي للدنيا وإنكاره خلق الله، وفيها أغاليط كثيرة؛ إذْ الحياة الواقعيّة من خلق الله، والصوفي يعبد الله فكيف، بالبداهة، ينكر ما خلق؟! نعم .. هو على عداء ولكن مع الفساد، وعلى الفساد، فساد النفس أو فساد المجموع.
والرابعة : ليس الصوفي وحده من يدعو لقطع الشهوات، ولكن قطع الشهوات كما يقول ابن رشد أمام العقلانية شرط في صحة النظر. بالطبع لا يُفهم من هذا، بتر الحيويّة الإنسانية والقضاء عليها بالمطلق، فهذا ممّا لا يجوز؛ فليس قطع الشهوات المقصود به قطعها بالمرة، ولكن ترويضها؛ والفرق من بعدٌ كبير.
والخامسة : وهى أن المنهج والموضوع بين التصوف وغيره مختلفان، ولا يمكن إقناع الغير إلا بالتجربة الصوفية نفسها، وإلّا بالسلوك المروّض على ارتقاء المعالي .
بقلم : د. مجدي إبراهيم