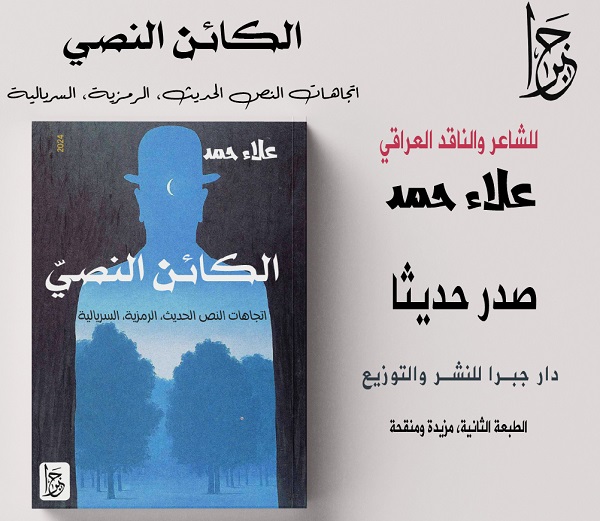قضايا
أيام وليالٍ
 منذ بدأت الحياة على الأرض اعتاد الإنسان أن يؤرخ لها، وكانت له وسائل مختلفة لحساب الزمن اعتمادًا على الأجرام السماوية وتعاقب الفصول على سطح الأرض، وهكذا تتابعت علينا الأيام والليالي. وعلى وضوح مفهوميّ اليوم والليلة فهناك أشياء كثيرة متعلقة بهما تخفى على كثير من شباب هذا الجيل.
منذ بدأت الحياة على الأرض اعتاد الإنسان أن يؤرخ لها، وكانت له وسائل مختلفة لحساب الزمن اعتمادًا على الأجرام السماوية وتعاقب الفصول على سطح الأرض، وهكذا تتابعت علينا الأيام والليالي. وعلى وضوح مفهوميّ اليوم والليلة فهناك أشياء كثيرة متعلقة بهما تخفى على كثير من شباب هذا الجيل.
أيام الأسبوع: أيام الله
يقول تعالى في كتابه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: 5]، وقطعًا فإن المقصود هنا التذكير بأيادي الله ونعمته الوفيرة على عباده عندما تعود ذكراها، وكذا تذكر لطفه بعباده عندما نزلت بهم النوازل والخطوب العظيمة. لكن كيف نتذكر تلك المناسبات لنصبر ونشكر كما هو الأمر في الآية الكريمة؟
أجدادنا علّمونا أن أيام الله هي أيام الأسبوع، والتي لم يختلف الخلق عليها قط، فالعالم بأسره شرقًا وغربًا لا خلاف بينهم في أي يوم من أيام الأسبوع يكون اليوم، فإن كان اليوم جمعة في مصر، فهو جمعة في فرنسا، وهو كذلك في الصين، والأمر لا يعدو سوى اختلاف لغات. بينما اختلفت الشعوب في حساب سنواتها، من حيث اليوم الذي يبدأ فيه العام، ومن حيث اعتماد الشمس أو القمر كأساس للتقويم.
اعتاد الناس في عصرنا أن يكون احتفاءاتهم بالمناسبات سنويًا، والحقيقة أن الأعياد والمناسبات الدينية فقط هي التي كان الاحتفاء بها وتذكرها يجري سنويًا في القديم، أما أيام الله تلك الخاصة بكل عبد فكان يحتفي بها ويذكرها أسبوعيًا. علّمنا الأجداد أنه لا ينبغي أن تمر علينا أيام الله (أيام الأسبوع) دون أن نعتبر ونشكر الله. وهذا كان حال الناس جميعًا قديمًا قبل أن يتصلوا بالثقافة الغربية. دل على ذلك ما ورد في الحديث الشريف من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد كان يصوم يوم الاثنين، ويقول إن هذا يوم وُلِدت فيه، كما كان يزور مسجد قباء كل سبت راكبًا وماشيًا ويصلي فيه.
السبت بداية الأسبوع أم نهايته؟!
قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ﴾ [ق:38]
بينما جاء في سفر التكوين عن الله ﴿فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل﴾ (تك 2: 2)
﴿وبارك الله اليوم السابع وقدَّسه. لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقًا﴾ (تك 2: 3)
وفي سفر الخروج
﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ صَنَعَ الرَّبُّ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَالْبَحْرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا، وَاسْتَرَاحَ فِي الْيَوْمِ السَّابعِ. لِذلِكَ بَارَكَ الرَّبُّ يَوْمَ السَّبْتِ وَقَدَّسَهُ﴾ [خر 20: 11]
﴿لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس﴾ (خر 31: 17)
بينما في سفر أشعياء ﴿إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكلُّ ولا يعيا﴾ (أش 40: 28)
لست معنية هنا بمناقشة بعض الفروق العقدية بين المسلمين وأهل الكتاب، بل يعنيني توضيح بعض الاختلافات التي قد لا يُلتفت إليها بين الشرق والغرب، والتي لها صلة بتلك الفروق العقدية. فأنا هنا لا أناقش معنى تلك الراحة التي نسبتها التوراة لله عز وجل، والتي قالوا إنها تعني الكف عن العمل وليست تعبيرًا عن التعب، حاشاه تعالى. فوفقًا لليهودية والمسيحية؛ الله تعالى بعد الستة أيام لم يباشر خلق أي شيء بيده، بل القوانين التي أوجدها هي التي تعمل، لكن وفقًا للمنظور الإسلامي، فالله هو الخلّاق، وعملية الخلق مستمرة وفقًا لما تم سطره في أم الكتاب. سبق أن ناقشنا ذلك المعنى في مقال "المسيح.. كلمة الله القديمة" ومقال "الله الخلّاق".
نعرف جميعًا وجود اختلاف في بداية الأسبوع بين الشرق والغرب، فبينما يكون السبت عندنا هو بداية الأسبوع، ثم تتلوه الستة أيام التي تمثل أيام الخلق، والتي تبدأ بالأحد وتنتهي بالجمعة، تكون تلك الستة أيام المبتدئة بالأحد في بداية الأسبوع، ليكون السبت بعد ذلك هو اليوم السابع عندهم الذي استراح الله فيه بعد الخلق وفقًا لما ورد في سفري التكوين والخروج. واستراح بالعبرية تعني "شابات"، ومنها جاء لفظ "السبت" بالعربية.
ومن ثم يكون تحديد بداية الأسبوع هو تبني لأي الرؤيتين القرآنية أو التوراتية، التي اختلفت في السبت هل كان قبل الخلق أم بعده.
البداية الليل أم النهار؟!
كانت العرب تقول قديمًا: حساب الشمس للمنافع، وحساب القمر للمناسك.
ومعروف أن الأعاجم يأخذون بالتقويم الشمسي، وتعويلهم دائمًا على الشمس، ومن هنا كان النهار هو البداية لديهم، بينما العرب يحسبون بالتقويم القمري، ومن هنا فالليل هو البداية لأنهم يعولون على القمر، والتاريخ عندهم يبدأ بالليالي، فهي أوائل الشهور.
في القرآن الكريم يقول تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الأعراف: 142]، وقد استدل بالآية كثير من المفسرين على أن التأريخ يبدأ بالليل لا بالنهار.
ونحن نحدد صيام رمضان بظهور الهلال في أول ليلة منه، وكذا نحدد دخول ذي الحجة بظهور هلاله، والذي تترتب عليه مناسك الحج. لكن هذا لا يمنع أن الشمس هي الأساس في تحديدنا لأوقات الصلاة اليومية، وأننا نصلي فروضنا بالنهار وليس الليل، فأما الليل فقد جُعِل للتنفُل.
كانت جدتي رحمة الله عليها بعد صلاة المغرب من كل ليلة تقطع ورقة التقويم الخاصة باليوم لأنه انتهى، ودخلت ليلة اليوم الجديد، وكنا -ونحن صغار- كثيرًا ما نجد تقويمات تضع مواقيت الصلاة اليومية فيها بدءًا من المغرب والعشاء لليلة السابقة على اليوم، ثم الفجر والظهر والعصر لليوم، وهكذا دواليك. لم يعد هذا معتادًا في بلادنا العربية منذ عقود، ولكن لا زلنا نعتبر أن الليلة تسبق اليوم، وهذا يسبب كثيرًا سوء فهم وإشكالية في تحديد المواعيد بين الشرقيين والغربيين.
إن كنت تزور بلدًا أوروبيًا لأول مرة، وأخبرك أحد معارفك هناك أنه سينتظرك على العشاء ليلة السبت، فعليك أن تفهم أن ليلة السبت تلك التي يعنيها هي الليلة التي تلي يوم السبت، وتفصله عن يوم الأحد، والتي تعني بالنسبة لك ليلة الأحد لأنها تسبق الأحد! اللهم إلا إن كنت من المتأثرين بالثقافة الغربية ممن أصبحوا يتعاملون بمفاهيم الغرب، وحتى هؤلاء غالبًا يستخدمون تعبير مساء السبت وليس ليلة السبت عند التحدث بالعربية، في محاولة للتوسط بين المفاهيم الشرقية والغربية.
ليلة العيد
لأن النهار هو البداية لدى الغربيين، فالغربيون يحتفلون بدخول أعيادهم ومناسباتهم مع بدء اليوم، بينما العرب يحتفلون بعد غروب الشمس، لأنه يعني أن ليلة العيد قد بدأت.
لكننا نعرف أنهم في الغرب أيضًا يحتفلون بليلة الكريسماس وليلة عيد الميلاد، فيبدأون الاحتفال عشية اليوم السابق، ثم ينتظرون تمام الثانية عشرة والتي تعد بدء اليوم الجديد.
المسيحيون يرجعون بدء الاحتفال ليلًا لأن المسيح عليه السلام وُلِد ليلًا، ولكن إن دققنا فهذا يخالف ما اعتاد عليه الغربيون من اعتبار الليل تابعًا للنهار الذي يسبقه وليس النهار الذي يليه، فالمفترض وفقًا لهذا أن يكون يوم الميلاد هو اليوم السابق لليلة احتفالهم، ولكنهم هنا يقلدون الشرقيين، ولا يخفف من تقليدهم سوى اعتبارهم انتصاف الليل في الثانية عشرة هو بدء اليوم الجديد.
ولعل هذا التحول الغربي باعتبار بدء اليوم عند انتصاف الليل هو شكل من أشكال التأثر الثقافي بالشرق، والتقليد لعاداته، والشرق مهد الديانات كما نعرف؛ فالمسيحي الغربي الذي كان يأتي الشرق حاجًا ليجدهم يحتفلون في الليلة السابقة ليوم الميلاد لم يكن ليدع هذا عندما يعود إلى وطنه؛ فليلة عيد الميلاد عند الغرب هي تأثر بالمفاهيم الشرقية في أن الليل يسبق النهار.
الربيع هو بداية العام
على اختلاف البشر في احتساب بدء التقويم السنوي إلا أن أغلب الشعوب التي استخدمت التقويم الشمسي اعتبرت الربيع بداية العام. بل ومن يقرأ الأبراج يجد أولها برج الحمل، والذي يوافق الاعتدال الربيعي في 21 مارس. يشذ عن ذلك بعض الأمم كالمصريين القدماء واليهود الذين تابعوهم في اعتبار الخريف هو بداية العام؛ فبدأوا العام بتشريه (تشرين)، لارتباط حياتهم بفيضان النيل.
بوجه عام، فإن الربيع هو رمز لعودة الحياة كي تدب في الأرض بعد موات الشتاء. وزهرة نيسان (أبريل) هي رمز البكور والإثمار.
كان الربيع عند القدماء هو البداية الحقيقية للسنة، وليس الشتاء، وبقي كذلك آلاف السنين، لكن في في عهد الملك تشارلز التاسع ملك فرنسا في القرن السادس عشر الميلادي، وتحديدًا عام 1564م، تقرر أن يكون أول يناير هو ابتداء السنة الميلادية لقربه من تاريخ مولد المسيح عليه السلام، ومن هنا جاءت كذبة أبريل حيث كان الناس يمزحون مع أصدقائهم ويدعونهم لحفل رأس السنة في أول أبريل مثلما كان معتادًا قبل إحداث ذلك التغيير.
مع ذلك لا زالت أمم كالفرس والأكراد يحتفلون ببدء العام الجديد في الربيع.
إصلاح التقويم الشمسي: التقويم الجريجوري
لم يكن تعديل موعد بداية العام هو التعديل الهام الوحيد الذي حدث في النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي، ففي عام 1582م لاحظ البابا جريجورس الثالث عشر أن الاعتدال الربيعي قد حدث يوم 11 مارس بدلًا من يوم 21 مارس، بسبب تراكم الدقائق والثواني المحتسبة خطأ وفقًا للتقويم اليولياني الذي وضعه يوليوس قيصر عام 46 ق.م، وكان ذلك التقويم أطول من السنة الشمسية بفارق مقداره 11 دقيقة و 14 ثانية.
قرر البابا انتظار موعد الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر من العام نفسه ليقوم العلماء بقياس ظل الشمس مرة أخرى وحساب الفروق، وعندها تأكدوا أن هناك فرقًا مقداره عشرة أيام كاملة بين السنة التقويمية والسنة الشمسية، وتقرر إصلاح الخطأ فصدر الأمر بأن يكون اليوم التالي ليوم الخميس 4 أكتوبر من ذلك العام هو الجمعة 15 أكتوبر وليس 5 أكتوبر!
ونظرًا لأن السنة الجريجورية أطول من السنة الشمسية بمقدار 26.3 ثانية، ولأجل عدم تراكم الكسور مرة أخرى أصدر البابا قرارًا بأن يكون هناك تصحيح كل أربع سنوات بإضافة يوم إلى شهر فبراير من تلك السنين لتكون تلك السنوات كبيسة، وبحذف ثلاثة أيام كل أربعمائة سنة، وأن يكون ذلك في السنوات القرنية، فتأتي كل سنة منها بسيطة رغم أنها تقبل القسمة على أربع، على أن تكون السنة المتممة للأربعمائة هي وحدها الكبيسة. فكانت سنة 1600 سنة كبيسة، بينما سنوات 1700 و 1800 و 1900 تم حذف اليوم الإضافي من شهر فبراير منها لتكون سنوات بسيطة، ثم عادت سنة 2000 فكانت سنة كبيسة.
ورغم تلك التصحيحات المتوالية فإن هناك فروقًا بسيطة من الثواني تتراكم علينا، ومن المنتظر أن تكمل يومًا كاملًا يكون قد أضيف للتقويم خطأ عام 4316م، وعليه فالأمر وقتها سيتطلب حذف اليوم الإضافي من شهر فبراير مرة أخرى لإزالة تلك الفروق المتراكمة، ولتكون تلك السنة أيضًا بسيطة وليست كبيسة رغم أنها تقبل القسمة على أربع. لكن من يعلم هل ستبقى حياة على الأرض إلى حينها؟!
وبسبب رفض الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والروسية التعديل الذي قامت به الكنيسة الكاثوليكية استمروا في استخدام التقويم اليولياني، والذي لم يتم فيه تصحيح الكسور، حتى بلغ الفرق بين التقويمين حاليًا 13 يومًا، وهذا سر احتفال المسيحيين الشرقيين بعيد الميلاد يوم 7 يناير وليس 25 ديسمبر.
ولمن يسأل لماذا فبراير تحديدًا الذي ينتهكونه فيقصرون أيامه؟ فليعلم أن يوليوس قيصر عندما وضع التقويم اليولياني كان أول من اقتنص يومًا من فبراير ليضيفه إلى الشهر السابع الذي أعطاه اسمه "شهر يوليو"، ليصير عدد أيامه 31 يومًا، ثم جاء من بعده ابنه بالتبني أغسطس فاقتطع يومًا آخر من فبراير كي يصير عدد أيام الشهر الثامن المسمى باسمه هو أيضًا 31 يومًا. ومن وقتها صار كل من احتاج تصحيحًا بالخصم من السنة الشمسية اقتطعه من فبراير، ولكن صار يحدث مثل هذا التصحيح فقط في سنوات كبيسة ليتراجع فبراير فيها من 29 يومًا –كما يُفترض أن يكون- إلى 28 يومًا، رغم أن السنة تقبل القسمة على أربع!
معرفة تواريخ الحوادث في الماضي بالرجوع بالزمن للوراء!
دائمًا ما يتوارد على مسامعنا تحديدات للزمن الذي ولد وعاش فيه فلان أو مات فيه آخر أو وقع فيه حادث ما، ويدّعي المؤرخون وعلماء الدين أنها أقرب للدقة.
يحدث هذا استعانة بالآثار والكتب الدينية والتاريخية وغيرها، لكن محاولاتنا للرجوع بالزمن إلى الوراء لحساب زمن حدث هام لا تكون دقيقة تمامًا كون ما نعتمد عليه من أدلة نستدل بها عليه غير مقطوع بدقتها، ولكوننا نعود إلى الوراء وفقًا لنظام سنواتنا الذي لا تتغير عدد أيامه، بينما كان للقدماء إضافاتهم وخصوماتهم للحفاظ على زمن الاعتدال الربيعي بلا تغير، كما كانت لهم تقويماتهم التي تختلف عن تقويماتنا.
يقول تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا ۖ قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (77) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ (78)﴾ [الأنعام 75: 78]
ومن أطرف ما قرأت يومًا لشندي الفلكي المصري أنه وبمساعدة هذا الحدث الفلكي الذي أوردته الآيات الكريمة، والذي ظهر فيه كوكب المشتري وأفل قبل بزوغ القمر، واستعانة بمعلومات أخرى دينية وتاريخية استطاع تحديد ليس فقط السنة التي وقعت فيها هذه الحادثة الفلكية الشهيرة، بل استطاع تحديد الليلة التي وقعت فيها!
أخيرًا، فإنه كما كانت تراعى الكسور في التقويمات الشمسية فيبدو أن ذلك كان يحدث قديمًا في التقويمات القمرية بإضافة النسئ، ولأجل ذلك كان موعد رمضان يكاد يكون ثابتًا، ولكن رمضان عندنا الآن صار يلف على فصول وشهور العام كلها!
د. منى زيتون