قراءات نقدية
من وحي: صخرة نيرموندا.. ألف باء التحرير
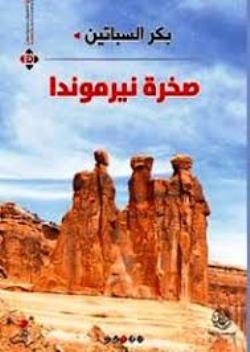 ترصُدُ رواية "صخرة نيرموندا" (ط1 2016)، الصادرة للكاتب بكر سباتين عن دار الآن ناشرون وموزعون في عمّان، سقوط يافا بيد قطعان العصابات الصهيونية من خلال تتبع مصائر عدد من أبنائها وأبناء القرى التابعة لها.
ترصُدُ رواية "صخرة نيرموندا" (ط1 2016)، الصادرة للكاتب بكر سباتين عن دار الآن ناشرون وموزعون في عمّان، سقوط يافا بيد قطعان العصابات الصهيونية من خلال تتبع مصائر عدد من أبنائها وأبناء القرى التابعة لها.
الرواية، إلى ذلك، تلقي ضوءاً على الآليات الاستيطانية الاحتلالية الإحلالية التي اتبعتها الوكالة اليهودية مستفيدة من الدعم البريطاني غير المحدود والتواطؤ الدوليّ (وحتى العربيّ) غير المخفيّ.
وبدون تهويل أو تدليس، تضع الرواية يدها على جرح عميق يتعلق بكثير من اليهود الذين كانوا يقيمون في فلسطين، إذ تبيّن عند المواجهة الكبرى أنهم كانوا رأس حربة للعصابات الصهيونية (داوود نموذجاً). وقد فعلوا ذلك بدوافع متباينة منها الأطماع الذاتية، الاستلاب للخرافات والشعوذة والأساطير البائدة. وهم، بعمومهم يتسمون بالخسة والغدر وطعن مفهوم حسن الجوار بالظهر تماماً.
في المقابل فإن طيبة الفلسطيني على وجه العموم، المترافقة مع بساطةٍ موجعةٍ عند كثير من أهل القرى، ساعدت هؤلاء الذين كانوا يقيمون بين ظهرانيّ أهل يافا وحيفا وعكا والبلاد، بتحقيق مكائدهم، وعدم اكتشاف حقيقتهم المتوارية خلف أقنعتهم، إلا بعد فوات الأوان.
بمراوحة بين سردية روائية مشوّقة، وبين إنشائية بلاغية ممهورة بنفسٍ شعريٍّ لافت، وبين خطابية قيمية فرضت مكانها داخل صفحات الرواية، يقدم بكر سباتين وثيقة من لحم ودم وقصص ناس وحكايات أمكنة، حول ضياع يافا، وحول ماهية أحلامها قبل هذا الضياع، دون أن ينسى الروائي توثيق موقفه الأخلاقي من بعض مظاهر المدنية والتحرر الذي كانت يافا تتمتع بها، رائياً، على ما يبدو، أن التحرر ليس بعدد كؤوس الخمر التي يمكن أن يحتسيها واحد من سهارى يافا أو مدّعي الثقافة والتحضر في حاراتها وأحيائها وداخل مقاهيها وملاهيها ومطاعمها التي لا يبخل سباتين بتعدادها ووصف أجوائها، ورسم خريطة دقيقة وأمينة للطرق الموصلة إليها (بمعنى الشوارع والأحياء والأمكنة المحيطة من جهة، وبمعنى الظروف والتداعيات والدوافع والمعطيات التي يمكن أن تقود شاب أو تاجر أو موظف أو يائس أو فلاح إليها وإلى أجواء العتمة والمجون والضياع القابعة هناك).
ثمة محاولة جادة داخل متن الرواية للإحاطة بمختلف الظروف والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والوطنية والأخلاقية والمعرفية التي كانت سائدة خلال عقد من الزمان (على الأقل) قبل اغتصاب يافا وطرد معظم أهلها منها.
يسجّل للرواية: الدراية الدقيقة العميقة بمختلف جغرافيا يافا ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، دراية شملت مختلف نواحيها والمعالم الأهم في كل ناحية من تلك النواحي، من مساجد ومبان حكومية ومدارس ومؤسسات وكنائس ومحاصيل وغابات وأنهر وشواطي وأبراج وقلاع وأحياء ومناطق وأجواء بحر وبحارة وحتى بعض البيوت الرئيسية، خصوصاً بيوت الحجر ومن ثم نوع هذا الحجر، وبعض التفاصيل داخل تلك البيوت، ومستوى الخدمات المدنية التي كانت قد وصلتها المدينة (درّة القلادة الفلسطينية كما وصفها سباتين)، ووجود خط قطار فيها، وكذلك وجود بنوك وخدمة هاتف وانتشار السيارات فيها إلى جوار عربات الخيل. كما تطرق للمراكب في البحر والمنارة هناك (الفنار) ومكاتب الشحن وشركات الاستيراد والتصدير.
كما يسجل لها الدراية العميقة لما كان وصله كثير من أبناء عائلاتها من درجات علمية ومهن أكاديمية من محامين وأطباء ومهندسين ومحاسبين. طبقة التجار وكذلك طبقة الأعيان ورجال الدين (السيد كنعان وبطرس نماذجاً).
ويسجل لها أيضاً أنسنة الصراع الذي دار فيها بين مختلف مكوناتها وقيمها من جهة، وبين العصابات الصهيونية بعد ذلك من جهة ثانية.
من النقاط التي تسجل لصالح الرواية إلى ذلك، تثمين صاحبها دور المرأة الفلسطينية إنْ في النضال (بلقيس نموذجاً) أو في العمل (زكية نموذجاً) أو في العلم (منى نموذجاً) أو في تعزيز أركان الصمود (زوجة كنعان نموذجاً) أو في القدرة على القيادة وتسلّم زمام المبادرة (بلقيس نموذجاً)، وليس أخيراً تثمينه عواطفها الصادحة الصادقة الجياشة لصالح الحب الجليل والمحبة المقبلة على الرجل وإيلائه (أمّاً وحبيبة وزوجة وشقيقة وبنتاً) قدراً غير محتجبٍ من الاهتمام والرعاية والحدب والاحتضان (كلهن نماذجاً).
كما يصعب نسيان تسليط الرواية ضوءاً ساطعاً على التناغم الحقيقيّ العميق بين مكونات الشعب الفلسطيني، دون أن يتجاوز سباتين أمانته عند تطرقه للتقسيمات الطبقية التي كانت موجودة فعلاً بين فلاح ومدني، يافي أو لداوي، وتاجر وأجير وغير ذلك من التقسيمات. وكذا تسليطه الضوء على الانتماء الوطني لأبنائها المسيحيين وحتى بعض أبناء الطوائف اليهودية المختلفة، وتبيينه الموازييك المتنوّع الذي كانته يافا، وتمددها كمساحة وفضاء باذخ وزاهر لأبناء الدول العربية القريبة منها وللسياح، ومنافستها في هذا السياق لكثير من المدن الساحلية.
ويؤخذ عليها: عدم تمحيصها بدقة في طبيعة الدور الصهيوني للشيوعية في ذلك الوقت (وفي هذا السياق أحيلك صديقي بكر إلى الفيلم الوثائقي "قرب النهر" للمخرج نزار حسن).
عدم إبحارها بحجم المؤامرة كي يفهم المتلقي كيف ضاعت يافا من يد عشاقها المجنونين بها (سعد نموذجاً) العاشقين لكل تفصيلة من تفاصيلها (كنعان وأسرته نموذجاً).
عدم الإسهاب في مواجهة عسكرية واحدة على الأقل، لتفنيد مقولة إن الشعب الفلسطيني باع بلاده دون أدنى مقاومة.
باستثناء المكانة الرمزية الأسطورية لصخرة نيرموندا، وباستثناء تمسك كثير من شخوص الرواية بالصلاة وإظهار الراوي لتدينهم، وباستثناء حكايا الجدات وأجوائهن وقصص الغولة والشاطر حسن وباقي هذا النوع من قصص ما قبل النوم، فقد غاب إلى حد ملحوظ، رصدٌ موسعٌ للمواسم والطقوس الشعبية والأغنيات والمأكولات والأزياء التراثية والحرف اليدوية وغيرها، وكذا رصد عادات يافا في الأفراح والأطراح، وشعائر الجنائز وطقوس الطهور وما إلى ذلك.
الخلاصة هي أن "صخرة نيرموندا" تتجلى كصيحة تنبيه ونداء هِمّةٍ فحواها أن غربان النعيق لن تبرح سماءنا إلا بشحذ الإرادة والإعلاء من شأن المقاومة، ومنطق الصلابة الجسورة الشجاعة الواعية الملتزمة، في وجه عدوٍّ غاشمٍ مُتَسَلِّحٍ بالخرافة والأكاذيب، ومستفيدٍ من تواطؤ العالم. عدوٌّ لا يفهم غير لغة القوة، ولن يدحره عن ربوعنا إلا بطولات أصحاب الحق والأرض والذاكرة.
محمد جميل خضر








