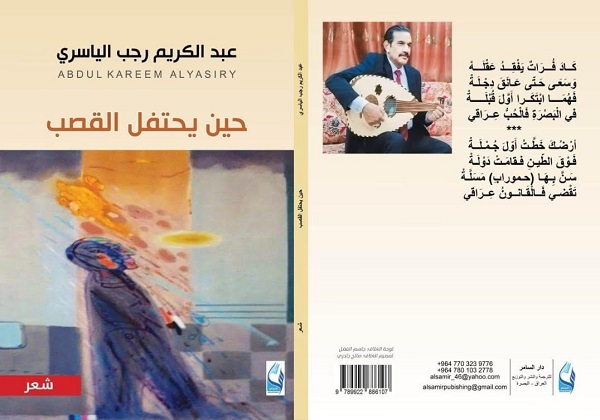دراسات وبحوث
جدلية الهوّية والمواطنة في مجتمع متعدّد الثقافات (2-3)
![]() 3- الهوّية: بعيداً عن التبشير!: في كتابه " موسيقى الحوت الأزرق" [21] يناقش أدونيس فكرة الهوّية ويستهل حديثه بالعبارة القرآنية التي تضيء بقِدَمِها نفسه، حداثتنا نفسها على حد تعبيره، وأعني بها "التعارف"، أي الحركة بين الإنفصال والإتصال في آن، من خلال " روية الذات، خارج الأهواء" وبخاصة الآيديولوجية، ويمكن أن نضيف الدينية والقومية وغيرها، بمعايشة الآخر داخل حركته العقلية ذاتها، في لغته وإبداعاته وحياته اليومية.
3- الهوّية: بعيداً عن التبشير!: في كتابه " موسيقى الحوت الأزرق" [21] يناقش أدونيس فكرة الهوّية ويستهل حديثه بالعبارة القرآنية التي تضيء بقِدَمِها نفسه، حداثتنا نفسها على حد تعبيره، وأعني بها "التعارف"، أي الحركة بين الإنفصال والإتصال في آن، من خلال " روية الذات، خارج الأهواء" وبخاصة الآيديولوجية، ويمكن أن نضيف الدينية والقومية وغيرها، بمعايشة الآخر داخل حركته العقلية ذاتها، في لغته وإبداعاته وحياته اليومية.
وبعد أن يستعرض أدونيس آركيولوجية الغياب المعرفي العربي على خارطة المعرفة الإنسانية، وهو ما أشارت إليه على نحو صارخ تقارير التنمية البشرية في العقد الماضي، لاسيّما شحّ المعارف ونقص الحرّيات واستمرار الموقف السلبي من حقوق الإنسان وبخاصة حقوق المرأة والمجاميع الثقافي، الدينية واللغوية والسلالية والإثنية وغيرها، يطرح سؤالاً حول سبل الخروج من هذا الغياب، ويسأل أيضاً ولِمَ هذا الغياب؟ لاسيّما بتمثّل ذلك نقدياً ومعرفياً، من خلال معرفة الآخر بمعرفة ذاتنا معرفة حقيقية، ولعلّ الخطوة الأولى التي ظل يركّز عليها في كتابه الممتع والعميق، هو كيف يمكن أن يصغي بعضنا إلى بعض!؟[22]
هذه الرؤية تستند إلى إحلال الفكر النقدي التساؤلي، محل الفكر التبشيري- الدعائي، حيث يصبح الوصول إلى الحقيقة التي هي على طول الخط تاريخية ونسبية، وصولاً يشارك فيها الجميع رغم تبايناتهم إلى درجة التناقض أحياناً، وهذا يعمّق الخروج إلى فضاء الإنسان بوصفه أولاً، إنساناً، ويدفع الذات إلى ابتكار أشكال جديدة لفهم الآخر ثانياً، وثالثاً يكشف لنا إنّ الهوّية ليست معطى جاهزاً ونهائياً، وإنما هي تحمل عناصر بعضها متحرّكة ومتحوّلة على الصعيد الفردي والعام، وهو ما يجب إكماله واستكماله دائماً في إطار منفتح بقبول التفاعل مع الآخر.
هل الهوّية جوهر قائم بذاته، لا يتغيّر أو يتحوّل؟ أم هي علاقة تجمعها مواصفات بحيث تكوّن معناها وشكلها؟ وبالتالي لا بدّ من تنميتها وتعزيزها وتفعيلها في إطار المشترك الإنساني، الأمر الذي يتخطّى بعض المفاهيم السائدة، ذات المسلّمات السرمدية السكونية لدرجة التقوقع، وينطلق إلى خارج الأنساق والاصطفافات الحتمية، من خلال قراءات مفتوحة تأخذ التطور بنظر الاعتبار عناصر تفعيل وتعزيز وتحوّل في الهوّيات الخاصة والعامة.
بهذا المعنى لا يكون اختلاف الهوّيات أمر مفتعل حتى داخل الوطن الواحد، إذا كان ثمة تكوينات مختلفة دينية أو إثنية أو لغوية أو سلالية، ناهيكم اختلاف الهوّيات الخاصة للفرد عن غيره وعن الجماعة البشرية.
ولعلّ هناك علاقة بين الشكل والمعنى التي تتكوّن منها الهوّيات الفرعية – الجزئية الخاصة وبين الهوّيات الجماعية العامة ذات المشتركات التي تتلاقى عندها الهوّيات الفرعية للجماعات والأفراد، حيث تكون الهوّية العامة أشبه بإطار قابل للتنوّع والتعددية، جامعاً لخصوصيات في نسق عام موحد، ولكنه متعدّد وليس آحادي، فمن جهة يمثل هوّية جامعة ومن جهة أخرى يؤلف هوّيات متعدّدة ذات طبيعة خاصة بتكوينات متميّزة، أما دينياً أو لغوياً أو إثنياً أو غير ذلك، فالشكل ليس مسألة تقنية، حسب أدونيس، وإنّما هو مسألة رؤية.
إن الحديث عن هوّيات فرعية، أو خصوصيات قومية أو دينية، لأقليات أو تكوينات، يستفز أحياناً بعض الاتجاهات المتعصبة دينياً أو قومياً، فهي لا ترى في مجتمعاتنا سوى هوّية واحدة إسلامية أو إسلاموية حسب تفسيراتها وقومية أو قوموية حسب أصولها العرقية ونمط تفكيرها واصطفافات طبقية كادحيّة حسب آيديولوجياتها الماركسية أو الماركسيوية، أما الحديث عن حقوق وواجبات ومواطنة كاملة ومساواة تامة وحق الجميع في المشاركة وتولّي المناصب العليا دون تمييز بما فيها حقوق المرأة وحقوق متساوية للأديان والقوميات، فهي تصبح في الواقع العملي "مؤامرة" ضد الأمة والدين، تقف خلفها جهات إمبريالية- استكبارية تضمر الشرور للمجتمعات العربية – الإسلامية، وبهذا المعنى لم تسلم حتى حقوق بعض المبدعين في التميّز والاستقلالية والتفكير الحر، واعتبرت بمثابة "انشقاق" وخروج على الجماعة، أما في معارضة تفكيرها، فالأمر قد يستحق العقاب والتحريم والتجريم.
ولعلّ مثل هذه الممارسات، لاسيّما بحق الجماعات القومية أو الدينية دفعها للانغلاق وضيق الأفق القومي، وبخاصة إذا تعرّضت للاضطهاد الطويل الأمد وشعرت بالتهديد لهوّيتها، وهو الأمر الذي كان أحد نقاط ضعف الدولة القطرية العربية تاريخياً، خصوصاً في مرحلة ما بعد الاستقلالات.
وقد تجد هناك من يدعو لعدم نشر الكلام الذي ينتقد أوضاعنا العربية، لأنه يتحدّث عن المساوئ لكي لا يستفاد منها العدو، تحت مبرّر عدم نشر الغسيل الوسخ، ولكي لا نسيء إلى صورتنا أمام الآخرين، وينسى هؤلاء المبشّرون أن إخفاء المرض لا يشعر المرء بالطمأنينة على صحته ولا يعيد له العافية، كما أن التغلّب على العدو يحتاج إلى تشخيص لنقاط ضعفنا والتخلص من بعض النزعات العنصرية إزاء الآخر في داخلنا بل إزاء بعضنا البعض كما يتطلّب قراءة واقعنا موضوعياً بروح النقد والنقد الذاتي والاعتراف بحقوق المجموعات الثقافية وبالهوّيات المتعدّدة في مجتمعاتنا المتنوّعة، وعدم تجميل صورتنا أمام أنفسنا، خصوصاً إذا كانت صورة البعض كالحة.
وما زال الموقف من المجموعات القومية والدينية قاصراً في الكثير من الأحيان، وحتى الاعتراف ببعض الحقوق يأتي كمنّة أو مكرمة أو هبة أو حسنة، حيث تسود تصوّرات مخطوءة عنها، بل إن الكثير من السائد الثقافي يعتبرها، خصماً أو "عدواً " محتملاً أو أن ولاءها هشاً وقلقاً وسرعان ما يتحوّل إلى الخارج، دون أن نعي أن هضم حقوقها، تارة باسم مصلحة الإسلام وأخرى مصلحة العروبة والوحدة وأحياناً بزعم الدفاع عن مصلحة الكادحين، والقوى العلمانية والمدنية وقيم النضال المشترك وغير ذلك، هو السبب الأساسي في مشكلة المجموعات الثقافية وليس نقصاً في ولائها أو خروجها على الهوّية الوطنية العامة التي تصبح لا معنى لها بسبب معاناتها، وبسبب نقص المواطنة الفادح والنظر إلى أفرادها كرعايا لا مواطنين من الدرجة الأدنى، وإنْ كان المواطنون ككل مهضومي الحقوق، فإن العبء الذي سيقع على كاهل المجموعات الثقافية سيكون مركباً ومزدوجاً ومعاناتها كذلك.[23]
إن الموقف من المجموعات الثقافية ودلالاتها لا يقوّم الإنسان بوصفه إنساناً، له حقوق وواجبات معروفة في الدولة العصرية، بحقوق المواطنة، وإنما يقيّمه بوصفه "انتماءً "، أي هو يحوّل الإنسان إلى سياسي برأس إثني أو قومي أو ديني أو مذهبي، وهكذا يتحوّل الإنساني إلى سياسي، وهذا الأخير إلى حقل من الحروب تبعاً للمصالح السياسية والمادية، فتهيمن الأهواء والنزعات على العقول وتظهر الوحشية عند الممارسة، ويغيب كل ما هو إنساني، وأحياناً كثيرة تستخدم القوى الخارجية هذه الثغرات والعيوب والنظرة الاستعلائية القاصرة للنفاذ منها لتشتيت الهوّية الجامعة، والعزف على الهوّيات الخاصة لدرجة التعارض والتصارع مع المشترك الإنساني.
ولنتأمل الحرب الأهلية اللبنانية، فبعد دماء غزيرة وخراب استمر 15 عاماً، غسل الجميع أيديهم وتعانقوا وكأن شيئاً لم يكن، وظلّت الهوّيات الصغرى طاغية، والهوّية الجامعة هشّة، قلقة، مقصاة وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق، اندلع العنف والإرهاب على نحو لم يسبق له مثيل ليحصد أرواح عشرات ومئات الآلاف من العراقيين من جميع الطوائف والقوميات والاتجاهات، تحت شعارات التفوق الطائفي والإثني أحياناً، وهو ما كانت له بعض الأسباب في التاريخ، لاسيّما المعاصر وبخاصة الاتجاهات التمييزية السائدة، رغم إن المحاصصة والتقاسم المذهبي والإثني كانتا تشكلان أساساً قام عليه مجلس الحكم الانتقالي وما بعده، ولكن ظل جميع الفرقاء والفاعلين السياسيين من جميع الاتجاهات، يعلنون أن لا علاقة لهم بالطائفية والمذهبية، بل هم يستنكرونها ويعلنون البراءة منها، لكنهم عند اقتسام المقاعد والوظائف يتشبّثون بها، ويحاولون الظهور بمظهر المعبّر وربما الوحيد عنها، دون تخويل من أحد.
إن مثل هذه الاعتبارات هي التي دفعت الباحث لاقتراح مشروع لتحريم الطائفية وتعزيز المواطنة في العراق[24] وهو إذّ يعرضه على جميع الفرقاء، يأمل أن يثير نقاشاً وحواراً واسعاً لدى الجميع، آملاً أن تتبنّاه القوى السياسية الوطنية وفاعليات المجتمع المدني، التي لا تؤمن بالطائفية وتدعو إلى تحريمها ومحاسبة كل من يمارسها أو يدعو ويروّج لها أو يتستر عليها، واعتماد مبادئ المساواة التامة والمواطنة الكاملة، فذلك هو السبيل لتعزيز الهوّية الوطنية العراقية وتأمين حقوق الهوّيات الفرعية القومية والدينية وغيرها. وبقدر ما يصلح القانون عراقياً، فإنه يتضمن خطوطاً عريضة لمبادئ تحريم الطائفية عربياً.
ولا بدّ من إقرار ذلك دستورياً، خصوصاً إذا تمكّن البرلمان، لاسيّما في ظروف سلمية وطبيعية من اعتماد مشروع القانون، الذي لن يكون بالإمكان التخلص من المحاصصات والتقسيمات الطائفية، دون إقرار ذلك قانونياً وعملياً. وبدلاً من التبصّر والتعامل مع المشكلة بالتحليل والبحث والتساؤل، يتم إلقاء الخطابات الرنانة والكلمات الحماسية والعناقات الفارغة والحديث عن مصالحات سميّت "وطنية" وهي مصالحات سياسية محدودة جداً في ظل نزعات الهيمنة وادعاء الأفضليات وإقصاء الآخر أو الانتقاص من دوره، دون نسيان توزيع الاتهامات وتحميل الآخر المسؤولية كلّها، سواءً الآخر الخصم والعدو أو الآخر التكفيري، الإجرامي.
إن الفكر اليقيني المطلق، هو فكر إمحائي لا يؤمن بالآخر، ويريد إلغاء الفروق داخل المجتمع بكياناته ومكوّناته وأفراده وسجن التعددية وإقصاء الخصوصيات وتطويق ومحاصرة التنوّع، والأكثر من ذلك يريد إلغاء تاريخ مكوّنات بحيث يلعب فيها مثل كرة عمياء تتدحرج في طريق أعمى وبأيد عمياء. [25]
إن التعصّب والعصبية هما اتجاهان إلغائيان لمن لا يتعصّب لهما، ولعلّ جدل الهوّيات يكشف إن اختيار الصراع بدل التعايش، والصدام بدل الحلول الإنسانية، سيكون ضاراً وخطيراً على الهوّيات الكبرى مثل الهوّيات الصغرى، وهذه الأخيرة إنْ لم يتم احترامها وتأمين حقوقها المتساوية ستكون عنصر ضعف كبير ويتّسع باستمرار على مستوى الهوّية والدولة العراقية، إذ لا بدّ من اتباع طريق المعرفة وشراكة الناس في المسؤولية والبحث عن الحقيقة وعن المعنى، سواءً عبر الهوّيات الفرعية- الجزئية أو من خلال الهوّيات الأوسع والأكبر، ولكن بانسجام مع الهوّية العامة التي لا تستقيم كينونتها وحقوقها الاّ باحترام الهوّيات الفرعية وخصوصيتها على مستوى الجماعات أو الأفراد [26] .
القسم الثاني- في المواطنة
1- المواطنة العضوية[27]
لم تترسّخ، فكرة المواطنة في الدولة العربية الحديثة بعد، سواءً على الصعيدين النظري والعملي، فهي تحتاج إلى جهدٍ كبيرٍ على صعيد الدولة والحكم (السلطة والمعارضة)، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني على حدٍ سواء، نظراً لغياب ثقافة المواطنة وضعف الهياكل والتراكيب والمؤسسات الناظمة للاجتماع السياسي الحكومي وغير الحكومي، بما فيه فكرة الدولة المدنية وسياقاتها!
وإذا كان بالإمكان اعتبار فكرة الدولة كأعظم منجز بشري، لاسيّما في إطار المنتظم الاجتماعي لحماية أرواح وممتلكات المواطنين وحفظ النظام والأمن العام، فإن فكرة المواطنة ارتبطت بالدولة الحديثة أو أخذت أبعادها الفكرية والحقوقية منها، ناهيك عن أساسها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الراهن.
اعتمدت فكرة المواطنة في القرن الثامن عشر بالدرجة الأساس على بناء الدولة، لاسيّما بأفقها الليبرالي الذي بشّر بإعلاء قيمة الفرد والحرية والسوق في إطار سيادة القانون، وشهد القرن التاسع عشر تطوراً في فكرة المواطنة بتعزيز الحقوق السياسية بعد إقرار الحد الأدنى من الحقوق المدنية، وبشكل خاص عند تطوّر مفهوم الديمقراطية الناشئ وقبول مبدأ الاقتراع العام.
أما في القرن العشرين فقد توسّعت فكرة المواطنة لتشمل مبادئ حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بعد التطور الذي حصل بإقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، لاسيّما الحقوق المدنية والسياسية، ولهذا حظيت فكرة المواطنة باهتمام أكبر خصوصاً بانتقالها من فكرة تأسيس دولة الحماية إلى تعزيز دولة الرعاية.
وقد خطت بعض البلدان خطواتٍ مهمةٍ في طريق تأمين الحقوق والحرّيات المدنية والسياسية وسارت شوطاً بعيداً في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتأكيد حيوية وديناميكية فكرة المواطنة بمزاوجة الحقوق والحرّيات بالعدالة، وهو الأمر الذي نطلق عليه " المواطنة العضويّة "، أي المواطنة التي تقوم على قاعدة المساواة أولاً في الحقوق والواجبات، وأمام القانون ودون تمييز بسبب الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس أو العرق أو المنشأ الاجتماعي أو لأي سبب آخر.
وثانياً ، قاعدة الحرّية كقيمة عليا لا يمكن تحقيق الحقوق الإنسانية الأخرى بدونها، فهي المدخل والبوّابة الضرورية للحقوق الديمقراطية السياسية، بما فيها حق التعبير وحق تأسيس الجمعيات والأحزاب وحق الاعتقاد وحق المشاركة السياسية في إدارة الشؤون العامة وتولّي المناصب العليا، وإجراء انتخابات دورية، إلى حق التملك والتنقل وعدم التعرّض إلى التعذيب ... الخ .
أما القاعدة الثالثة فهي تستند إلى فكرة العدالة بجميع صنوفها وأشكالها، وفي جوانبها القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فمع الفقر لا تستقيم العدالة، ومع هضم حقوق المرأة ستبقى ناقصة ومبتورة، ومع التجاوز على حقوق المجاميع الثقافية الإثنية والدينية وغيرها، ستكون العدالة مشوّهة، ولعلّ مقاربة فكرة العدالة يمكن أن تتحقق من خلال التنمية، وهو ما أُطلق عليه التنمية المستدامة: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستندة إلى قاعدة الحريات والحقوق المدنية والسياسية، التي تغتني بالمعرفة وتنمية القدرات، لاسيّما التعليمية وتأمين حقوق المرأة والمجموعات الثقافية وتقليص الفوارق الطبقية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتقوم القاعدة الرابعة على الحق في المشاركة دون تمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو اللغة أو اللون أو المنشأ الاجتماعي، إذ لا مواطنة حقيقية دون الحق في المشاركة والحق في تولّي المناصب العليا دون تمييز لأي اعتبار كان.
وتتشكّل الهوّية الوطنية العامة من خلال القواعد الأربعة المشار إليها، وعلى أساسها يمكن أن تتعايش هوّيات مصغرة (فرعية) في إطار من المساواة والحرية واحترام حقوق "الأغلبية" من جهة، وتأمين حقوق "الأقلية" من جهة أخرى على أساس التكامل والتكافؤ والتكافل والمساواة، أي التنوّع في إطار الوحدة، وليس التنافر والاحتراب، فقد ظلّ الإتجاه السائد في الثقافة المهيمنة يميل إلى عدم احترام الخصوصيات أو التقليل من شأنها ومن حقوق المجموعات الثقافية، سواءً كانت قومية أو دينية أو لغوية أو غير ذلك .
تعتبر الحرية قاعدة أساسية للجيل الاول لحقوق الانسان، لاسيّما اقترانها بفكرة المساواة في الكرامة والحقوق، وبخاصة الحق في الحياة وعدم التعرّض للتعذيب وحق اللجوء وحق التمتع بجنسية ما وعدم نزعها تعسفاً، وحق الملكية إضافة إلى الحقوق والحريات الأساسية.
وارتبط الجيل الثاني لحقوق الإنسان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيّما المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص عام 1966 التي شملت حقوق العمل والضمان الاجتماعي والتعليم وحقوق المرأة والطفل والمشاركة في الحياة الثقافية والاستفادة من منجزاتها وغيرها .
أما الجيل الثالث لحقوق الإنسان فهو يستند إلى الحق في التنمية والحق في السلام والحق في بيئة نظيفة والحق في الاستفادة من الثورة العلمية – التقنية .
ويمكن اعتبار الجيل الرابع ممثلاً بالحق في الديمقراطية، والحق في التعددية والتنوّع الثقافي، لاسيّما بعد انتهاء عهد الحرب الباردة وتحوّل الصراع الآيديولوجي من شكل إلى شكل آخر بانهيار الكتلة الاشتراكية وتفكيك دولها وبخاصة الاتحاد السوفيتي. وكان مؤتمر باريس المنعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 1990، قد وضع أساساً جديداً لشكل العلاقات الدولية ورسّخ هذا الاتجاه مؤتمر برلين (حزيران – يونيو) 1991 بعد حرب الخليج الثانية، بتأكيد: التعدّدية والتداولية وتشكيل مركز دائم لمراقبة الانتخابات وحرّية السوق، رغم أن القوى المتنفذة حاولت توظيف هذا التوجه العالمي الايجابي لمصالحها الأنانية الضيقة.
ولعلّ انكسار رياح التغيير التي هبّت على أوروبا في أواخر الثمانينيات عند شواطئ البحر المتوسط، كان بسبب سعي القوى الدولية المتسيّدة في توجيه الأحداث طبقاً لمآربها السياسية ومصالحها الاقتصادية دون مراعاة لحقوق شعوب ودول المنطقة، الأمر الذي عطّل عملية التغيير، تلك التي جرت محاولات لفرضها من الخارج، ولكن على نحو مشوّه، خصوصاً بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 الإرهابية، ونجم عنها احتلال أفغانستان والعراق والحرب على لبنان بحجة مكافحة الإرهاب الدولي العام 2006 وكذلك الحرب على غزة بعد حصارها منذ العام 2007.
مثل هذا الأمر يطرح فكرة العلاقة الجدلية بين المواطنة وحقوق الإنسان، وبقدر تحقيق هذه المقاربة، تكون فكرة المواطنة ببعدها الكوني وأساسها الحقوقي الإنساني قد اقتربت من المشترك الإنساني، مع مراعاة الخصوصيات الدينية والإثنية واللغوية، أي بتفاعل وتداخل الحضارات والثقافات، لاسيّما باحتفاظها بكينونتها الخاصة في إطار علاقتها العضوية بالأبعاد الكونية الانسانية .
المواطنة تقوم وتستند إلى قاعدة المواطن – الفرد الذي ينبغي مراعاة فردانيته من جهة، ومن جهة أخرى حرّيته الأساس في مساواته مع الآخر تساوقاً في البحث عن العدالة، وتتعزز مبادئ المساواة والحرّية في إطار المنتظم الاجتماعي الوطني والائتلاف والانسجام من جهة، وتغتنيان بالتنوّع والتعددية من جهة أخرى ، وذلك من خلال الوحدة والاشتراك الإنساني والحقوق والواجبات وليس الانقسام أو التشظي أو التمييز.
وإذا كانت فكرة المواطنة تتعزز من خلال الدولة ، فإنها تغتني وتتعمق بوجود مجتمع مدني حيوي وناشط، بحيث يكون قوة رصد من جهة للإنتهاكات المتعلقة بالحرّية والمساواة والحقوق، ومن جهة أخرى قوة اقتراح وليس احتجاج حسب، بحيث يصبح شريكاً فعالاً للدولة في توسيع وتعزيز دائرة المواطنة العضوية وتأمين شروط استمرارها، لاسيّما إذا تحولّت الدولة من حامية إلى راعية[28] ، مرتقية لتعزيز السلم المجتمعي والأمن الإنساني، لاسيّما بوجود مؤسسات ترعى المواطنة كإطار والمواطن كإنسان في ظل الحق والعدل.
2- الدولة العربية والمواطنة!
مثلما هي فكرة الدولة حديثة جداً في المنطقة العربية، فإن فكرة المواطنة تعتبر أكثر حداثة منها وجاءت انبثاقاً عنها. ورغم وجود تجارب " دولتية " أو ما يشابهها في العهد الراشدي الأول وما بعده أو عند تأسيس الدولة الأموية بدواوينها ومراتبيتها التي توسعت وتطورت في ظل الدولة العباسية، وفيما بعد الدولة العثمانية، خصوصاً في الفترة الأخيرة من تاريخها، حيث تأثرت بمفهوم الدولة المعاصرة في أوروبا وبالأفكار الدستورية والقانونية الحديثة، لاسيّما فكرة المواطنة التي اغتنت في القرن العشرين، باعتبارها "حقاً" من الحقوق الأساسية للإنسان.
وإذا كان مفهوم المواطنة جنينياً في الدولة العربية -الإسلامية، لاسيّما فيما يتعلق بتحديد مسألة الهوّية، ناهيك عن الحقوق الإنسانية، فإن هذا الحق، تساوقاً مع التطور الفقهي على المستوى الدولي، اكتسب بعداً جديداً في الدولة العصرية ومنها الدولة العربية، رغم النواقص والثغرات التي ما تزال تعاني منها قياساً للتطور الدولي. وقد تكرّس مبدأ الحق في المواطنة في أواسط القرن العشرين خصوصاً بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العام 1966 والعديد من الوثائق الدولية ، التي أكدت : أن لكل فرد في أي مكان من العالم الحق في أن تكون له صلة قانونية بدولة من الدول .
ويستخدم في القانون الدولي، مصطلح المواطنة الذي يوازيه مصطلح الجنسية بالتبادل فيما بينهما، حين يتم الحديث عن منح الأشخاص الحق في حماية دولةٍ ما إلى جانب حقوقٍ سياسيةٍ ومدنية ، تلك التي تشكل ركناً أساسياً في هوّية الفرد – الإنسان، ويمكن تعريف المواطنة الحيوية أو العضوية بأنها " الحق في الحصول والتمتع بالحقوق بصورةٍ عادلة ".
وإذا كان الحق في المواطنة قد ضمنه القانون الدولي ، الذي حظر حرمان أي شخصٍ من مواطنته أو جنسيته التي أكّدتها المادة 15من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن: لكل إنسان الحق في الحصول على جنسية ولا يجوز حرمان إنسان بصورةٍ تعسفيةٍ من جنسيته ولا من حقه في تغييرها، إلاّ أن ذلك لم يمنع من بقاء ملايين البشر في جميع أنحاء العالم بدون جنسية، الأمر الذي ينتقص من مبدأ الحق في المواطنة ، بغض النظر عن أن حالات إنعدام الجنسية قد تنشأ من التعارض في القوانين ونقل تبعية الإقليم أو حالات الزواج أو وجود تمييز أو عدم تسجيل المواليد أو إسقاط الجنسية [29].
ولعلّ المثل الأكثر سفوراً في العالم العربي، هو تهجير الفلسطينيين منذ العام 1948 وإسقاط حقهم في وطنهم وبالتالي جعلهم عرضةً لحالات إنعدام الجنسية. ولا شكّ أن اتساع وانتشار حالات اللاجئين وأوضاعهم هي التي دفعت الأمم المتحدة إلى إنشاء مكتب للمفوضية السامية للاجئين كإحدى وكالات الأمم المتحدة المسؤولة عنهم وللحد من ظاهرة إنعدام الجنسية.
وقد عرف الوطن العربي حالات كثيرة من المواطنة المنقوصة، سواءً من أفراد أو مجموعات بشرية وبهضم حقوقها أو انتزاع أو عدم حصولها على الحق في الجنسية، كما حصل للمهجرين العراقيين، لاسيّما عشية وخلال الحرب العراقية - الإيرانية ومعظمهم من الأكراد الفيليين، إذْ انتزعت منهم جنسيتهم وصودرت أملاكهم في العراق بحجة التبعية الإيرانية، ولم يعترف بهم في إيران أيضاً، فعاشوا بدون جنسية وبدون وطن ومواطنة، وكذلك حالات ما سمّي بالمكتومين من الأكراد السوريين الذين لم يحصلوا على الجنسية وبالتالي على حقوق المواطنة، وحالات البدون في الكويت وبعض دول الخليج التي حرمت عشرات الآلاف من حقوق المواطنة، إضافةً إلى الكثير من الحالات والإشكالات بسبب الزواج من فلسطينيين أو أشخاص بلا جنسية أو من جنسيات أخرى وحصول حالات طلاق، الأمر الذي جعل الأبناء بلا جنسية، إذْ أن الغالبية الساحقة من قوانين البلدان العربية لا تسمح بالحصول على الجنسية عن طريق الأم، الأمر الذي خلق مشاكل لا تتعلّق بالحقوق المدنية والسياسية حسب، بل بالحق في التعليم والتطبيب والعمل وغير ذلك.
وقد أدركت العديد من الحكومات أنه لم يعد بإمكانها اليوم التملّص من حالات المساءلة بموجب القانون الدولي بإلغاء أو سحب أو حجب حق المواطنة عن الأفراد والجماعات الذين يمكنهم إثبات وجود علاقة حقيقية وفعالة بينهم وبين بلدهم، سواءً عن طريق رابطة الدم "البنوّة " للآباء رغم ان العديد من البلدان العربية ما زالت تحجب هذا الحق عن الانتساب إلى جنسية الأم، في حين إن القانون الدولي لحقوق الإنسان يعطي مثل هذا الحق، أو " طريق الأرض "، أي الولادة في الإقليم أو الحصول على جنسيته ومواطنته أو اكتساب الجنسية نظراً للإقامة الطويلة والمستمرة والتقدم بطلب إلى السلطات المسؤولة عن ذلك. [30]
3- النخب العربية وفكرة المواطنة
وإذا كان انشغال النخب العربية بفكرة "الأمة الإسلامية" أو "الجامعة الإسلامية" في القرن التاسع عشر وربما في بدايات القرن العشرين، فإن الانبعاث القومي العربي بدأ يتعزز لاحقاً، حيث بدأت النخبة الثقافية والتنويرية الاسلامية والعلمانية، الاهتمام بالفكرة الحديثة عن الدولة التي تعتبر المواطنة أحد مظاهرها الأساسية، فالشعب والحكومة والارض والسيادة أركان الدولة وعناصر وجودها، التي تستقيم وتتعزز في ظل احترام الحقوق والحريات وتكريس مبدأ المساواة الكاملة والمواطنة التامة في إطار سيادة القانون.
وبالإمكان القول إن الموقف الذي حكم الدولة العربية الحديثة ومجتمعها الأبوي التقليدي كان قاصراً واستعلائياً في نظرته إلى المواطنة والأقلية، وهذه النظرة أعاقت ترسيخ سلطة الدولة، فالأقلية قومية أو دينية حسب وجهة النظر هذه، قد تكون "متآمرة" أو "انفصالية" أو تاريخها غير "مشرّف" أو " مسؤولة عن كوارث الأمة" أو غير ذلك من الأفكار السائدة التي تأخذ الامور بالجملة وعلى نحو سطحي، دون الحديث عن جوهرها لاسيّما : الحقوق والمساواة والحرية وتكافؤ الفرص والمواطنة العضوية القائمة على قاعدة العدل. وقد أضعفت هذه النظرة من التوجّه نحو المجتمع المدني ابتداءً بالانتقاص من مفهوم المواطنة إلى الضغوط الاجتماعية المسنودة بالمؤسسة التقليدية العشائرية والدينية في الكثير من الأحيان.
واستندت الدولة العربية الحديثة على بعض النخب "الأقلوية" على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب، ولذلك أصبحت دولاً "سلطوية" أو " تسلطية"، لاسيّما بغياب مبادئ المساواة وتهميش "المجموعات الثقافية الأخرى" وحجبها عن حق المشاركة، والهيمنة على "الأغلبية" وإبعادها عن الحكم، والإستعاضة عن ذلك بأقلوية ضئيلة، على حساب مبدأ المواطنة!
وظلّ المجتمع العربي يعاني من الموروث السلبي بما فيه الديني الذي جرت محاولات لتوظيفه سياسياً بالضد من تطوّر فكرة المساواة والحرية والعدالة، وصولاً للمواطنة الكاملة والتامة باتجاه المواطنة العضوية أو الديناميكية، خصوصاً في النظرة الدونية إلى المرأة، وعدم الإقرار بالتعددية السياسية والفكرية والاجتماعية والقومية والدينية، الأمر الذي ينتقص من مبدأ المواطنة !!
في الثقافة والأدب، مثلما في علوم السياسة والاجتماع ثمت دلالات، وهذه لا تأتي الاّ بعد دراسة وتأمّل لتجارب وممارسات، وصولاً إلى نتائج، ولهذه الأخيرة معاني إيجابية وسلبية، لأنها تعتمد على مدى التحقّق، وهذا الأخير يكون مقاربة من الهدف ذاته، الذي يعني القدرة على الامتلاء، أي مدى التوازي بين الهدف والوسيلة، من خلال معيار، لا يأخذ بالتطابق بقدر سير التطبيق بموازاة النظرية، وكلّما اقتربت من ذلك، كلّما يمكن القول أن الدلالة تعني النجاح أو الفشل.
منذ العام 2011 كان الربيع العربي وتفرعاته هو الشغل الشاغل للحوار: الدولة المدنية وعلاقة الإسلام بالدولة، ودور الحركات الإسلامية والإسلام السياسي في مشروع الثورات وبرامجها ونتائجها الانتخابية، والإسلامفوبيا (الرهاب من الإسلام)، والإسلاملوجيا (استخدام الإسلام بالضد من تعاليمه السمحاء)، والأمن القومي العربي والسياسة الدولية والعامل الاقليمي، لاسيّما الصراع العربي- الإسرائيلي ودول الجوار الإيراني والتركي ومشروعيهما الإقليميين في ظل غياب أو ضعف المشروع العربي، وأمن الخليج وما يهدّده والمخاوف من الملف النووي الإيراني، والثقافة واللغة ودور التكنولوجيا والعلوم ووسائل التنمية والهوّية ومستجداتها والمواطنة وإشكالاتها.
ما دفعني لاستعراض ذلك هو النقاش الذي دار في إحدى حلقات البحث في مهرجان الجنادرية [31] (الثقافي)، التي ضمّت المفكرين أبو يعرب المرزوقي ويوسف مكي وجمال سلطان وآخرين، وشارك في التعقيب والحوار عدد من الباحثين، لاسيّما وأن فكرة المواطنة حديثة في الأدب السياسي والقانوني، مثلما حداثة فكرة الدولة ذاتها، وإنْ كان للمسألتين علاقة بتاريخنا، لكن الفكرة المعاصرة وتجلّياتها تختلف عن إدارة اجتماع سياسي لمجموعة من البشر، ضمن المفاهيم التي جاءت بها الثورة الفرنسية وما تعمّق بعد الثورة الصناعية، وصعود الطبقة الوسطى، من تداولية السلطة سلمياً وإجراء انتخابات دورية وفصل السلطات وسيادة القانون وإطلاق الحريات واحترام حقوق الإنسان.
وإذا كان ثمت واقعية في موضوع المواطنة، باعتبارها ركناً أساسياُ للدولة العصرية، لا غنى عنه لتقدّمها ورفاه شعبها، فإن هناك من يدعو لنموذج آخر " لمواطنة افتراضية"، أساسها آيديولوجي يقوم على الهوّية الدينية أو الطائفية أو القومية أو الأممية بحسب مصدر التوجه، فالإسلاميون بمختلف تياراتهم سواءً جزؤهم الحركي أو الساكن، قدّموا نموذجاً لمواطنة إفتراضية حين دعوا إلى "دار الإسلام" و"دار الشرك"، وهم وفقاً لهذا التقسيم افترضوا مواطنة عابرة للحدود والجنسيات والقوميات والطوائف، وذلك بتجاوز مشروع "الدولة الوطنية"، لاسيّما عندما يتم الحديث عن مواطنة إسلامية.
ومثله التيار القومي العربي، فإنه لا يعترف بالحدود والكيانات التجزيئية، التي فرضها المستعمِر، ويتحدّث عن فكرة مواطنة عربية، وقد نجد هذه الفكرة الجنينية قد أخذت طريقها إلى التطبيق التمهيدي، مثل الحديث عن المواطنة المغاربية والمواطنة الخليجية، على الرغم مما حقق مجلس التعاون الخليجي من بعض النجاحات في التقارب والتنسيق، لكن ثمت عوائق أمام فكرة مواطنة خليجية أو كونفدرالية على هذا الصعيد، سواء تم توحيد العملة أو الاحتفاظ بها لحين، على طريقة الاتحاد الأوروبي. والماركسيون أيضاً يتجاوزون على فكرة "الدولة الوطنية"، وكان كارل ماركس هو الذي قال "ليس للعمال من وطن"، بمعنى تجاوز الطبقة العاملة لما هو قائم باتجاه مواطنة أممية لشغيلة العالم.
وسواءً كانت المواطنة الإسلامية أو المواطنة العروبية وربما الكردية غداً أو غيرها، أو المواطنة الأممية بنموذجها السوفييتي أو الكوبي الأمريكي اللاتيني، فإنها جميعها صيغ لمواطنة افتراضية، تقوم على الموقف السلبي من فكرة الدولة الوطنية، فهو الجامع بينها، علماً بأن الكثير من المشكلات القانونية والسياسية، تواجه مثل هذه الأفكار في ظل غياب صيغة قانونية مثل صيغة الاتحاد الأوروبي مثلاً، لكن هذه الصيغ ذات الطبعة الآيديولوجية الملوّنة، التي تأخذ اسماً دينياً (المواطنة الإسلامية) وإسما قومياً (المواطنة العروبية أو العربية) واسماً أممياً (المواطنة الأممية)، فإنها ترضع من ثدي واحد، فالأولى تسعى لقيام نظام إسلامي، والثانية تستهدف قيام نظام وحدوي قومي، والثالثة تريد بناء الاشتراكية، وفقاً لوحدة الطبقة العاملة على أساس مركز أممي وفروع مرتبطة به.
لعلّ الفكرة النظرية التي تروّج لها التيارات المختلفة تصطدم بعدد من الجوانب العملية، فيما يخص الدولة الوطنية وهويّتها، ناهيك عن عدد من الأسئلة الشائكة التي تواجهها مثل: تنازع القوانين، كيف السبيل للانتقال من دائرة المواطنة الوطنية إلى دائرة المواطنة الأوسع الإسلامية والعروبية والأممية؟ هل بإسقاط الرغبات على الواقع؟ علماً بأن ما طرحته موجة ما يسمى "الربيع العربي" وعموم موجات التغيير التي حصلت في أوروبا الشرقية وبعض دول أمريكا اللاتينية، أدّت إلى انبعاث الهوّيات الفرعية، وقادت إلى حروب وانقسامات وتشكيل دول أو حتى دويلات.
أفكار من هذا النوع كانت محطّ نقاش وجدل لتيارات فكرية وسياسية خلال العقود الماضية، خصوصاً علاقة الدين كعقيدة، بالسياسة كممارسة ومساومة ومصالح، ومن جهة أخرى كانت فكرة الدولة المدنية حاضرة، لاسيّما باعتبارها "الكفيل بوضع حدّ لنزاعات القوة والهيمنة وتنظيم حياة الناس" بعيداً عن دينهم ولغتهم وعرقهم ولونهم وجنسهم ومعتقدهم وأصلهم الاجتماعي، وذلك بوجود مؤسسات ضامنة لحقوقهم في إطار سيادة القانون، وربّما هذا ما كانت تسعى إليه بعض حركات التغيير، حتى وإن هناك من حاول وضع العقبات في طريقها أو واجهها بتحدّيات، ناهيك عن المنعرجات التي صادفتها والخيبات التي اعترضتها، لكن ذلك هو الواقع بكل تعقيداته، وهو واقع وليس افتراضاً بكل الأحوال!!.
د. عبد الحسين شعبان