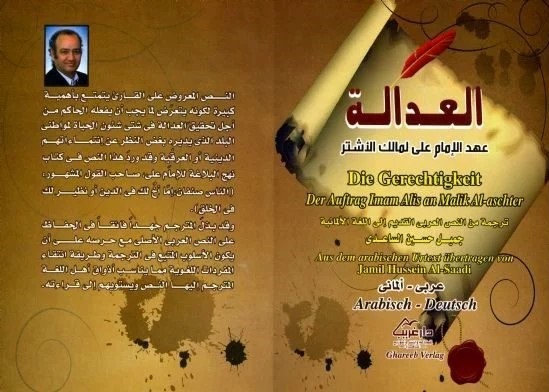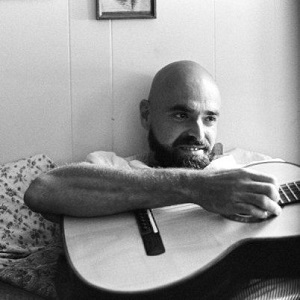صحيفة المثقف
الإرهاب وتلوث الهُويِّة المصريّة (3)
 نعود ثانية فنستكمل حدثتنا عن الإرهاب وتلوّث الهويّة المصرية؛ فنقول: أجل إنِّ الأفكار العلمانية والشعارات الماسونية قد أرادت نشر الإلحاد في بنية الثقافة الإسلامية، وكان الغرض الأول من وجود هذا التيار - كما بينا - هو تفكيك تماسك بنية الهوية المصرية، وذلك بعد فشل دوائر الاستشراق الغربية في الإيقاع بين المسيحيين والمسلمين أو في غرس الاتجاه الوهابي عن طريق الجماعات السلفية والإخوان، فكلاهما لم يكن يقوى على إحداث شقاق كبير بين المواطنين أو يشكل قوى ناعمة؛ لتزييف وعي الجمهور باسم الدين.
نعود ثانية فنستكمل حدثتنا عن الإرهاب وتلوّث الهويّة المصرية؛ فنقول: أجل إنِّ الأفكار العلمانية والشعارات الماسونية قد أرادت نشر الإلحاد في بنية الثقافة الإسلامية، وكان الغرض الأول من وجود هذا التيار - كما بينا - هو تفكيك تماسك بنية الهوية المصرية، وذلك بعد فشل دوائر الاستشراق الغربية في الإيقاع بين المسيحيين والمسلمين أو في غرس الاتجاه الوهابي عن طريق الجماعات السلفية والإخوان، فكلاهما لم يكن يقوى على إحداث شقاق كبير بين المواطنين أو يشكل قوى ناعمة؛ لتزييف وعي الجمهور باسم الدين.
والسؤال الذي يطرح نفسه : هل يمكن لدوائر الاستشراق الغربي اللعب بفريقين متضادين لخدمة مصالحها في مصر؟ أعني اتجاه ديني متشدّد، وأخر علماني متطرف؛ نعم إن الكتابات الغربية نفسها تؤكد أنه لا سبيل لسقوط مصر إلا من الداخل وذلك باصطناع تيارين يتصارعان لهدم الثوابت والمشخصات التي جُبل عليها المصريون. وكانت أولى الخطوات لذلك الهدف هي تفكيك الطبقة الوسطى وقادة الرأي، وذلك عن طريق الخلافات السياسية والصراعات الحزبية.
فلم تقف دعوة حسن البنا عند برنامجه للإصلاح الأخلاقي والاجتماعي ونصرة المعوذين من طبقات الشعب الدنيا، بل تجاوزت ذلك إلى الحديث عن قضية الدين والدولة. إذ راح يقنع جماعته بأنه حقًا لا ثيوقراطية في الدين الإسلامي، ورغم ذلك لا يمكن الفصل بين الشريعة والسياسة، فالدين هو الأساس الذي تقام عليه الدولة والاعتراف بوجود دولة مسلمة إلا إذا قامت على الأسس الشرعية وإلا أضحت من المجتمعات الكافرة، ولمّا كان غرض الجماعة هو إعداد الفرد المسلم ثم البيت المسلم ثم المجتمع ثم الدولة ثم أستاذية العالم، فإنّ كل ذلك ينطلق من إيمان الجماعة برسالتها الإصلاحية الشاملة، تلك التي لم تظفر بها أوروبا عندما فصلت بين الدين والدولة في ثورتها الإصلاحية، الأمر الذي مهد الطريق لسيد قطب بعد ذلك ليردد حديث المودودي عن الحاكمية الإسلامية وتكفير الخصوم.
وقد تعمد حسن البنا اللعب على المسرح السياسي باسم الدين ويبدو ذلك في جل أحاديثه وتحالفاته مع القوى الغربية. فقد اتصل حسن البنا بالمخابرات الألمانية وراح يقنع أتباعه بأن هتلر في طريقه لإعلان إسلامه، وأن إيطاليا واليابان سوف تمد يد العون لدعاة الجماعة لنشر الإسلام في بلادها، وذلك على صفحات النذير قبيل الحرب العالمية الثانية، وقد منحته المخابرات الألمانية دعما ماليا لمؤازرتها ونقض تحالفه مع الإنجليز. الأمر الذي أغضب المخابرات الإنجليزية والأمريكية وقررا آنذاك التخلص من حسن البنا والبحث عن بديل مناسب للعب الدور نفسه. وأدرك حسن البنا أن السبيل لخروجه من هذا المأزق هو مهادنة الإنجليز وإقناعهم بأن ما يفعله مع الألمان ما هو إلا تنفيذًا لأوامر القصر (الله مع الملك)، أمّا ولائه الحقيقي فهو للإنجليز وليس للأحزاب أو الملك، وذلك لأن هدفه هو إقامة خلافة إسلامية ووحدة المسلمين ثانية. وصرح لأعوانه أن أمريكا وبريطانيا سوف تمنح الدول الإسلامية استقلالها، وبذلك سوف تزول العداوة بين المسلمين والغرب، بل أن التعاون بينهما سوف يتيح للبنا أن ينشر دعوته للوحدة الإسلامية في بلادها. غير أنه سرعان ما انقلب على الإنجليز والأمريكان بعد رفضهم مَدَّه بالمال لمجابهة الشيوعيين والجماعات الإلحادية التي علا صوتها في منتصف الأربعينيات من القرن العشرين.
وذلك رغم تأكيده للسير "والتر سمارت" السفير البريطاني في القاهرة أن من مصلحة إنجلترا التحالف مع الإخوان؛ لضمان تواجدهم في مصر، وإن من مصلحة الإخوان الإخلاص لهذا التحالف ليمدَّهم الإنجليز بكل أشكال الدعم شأن الدعوى الوهابية، وأوضح حسن البنا أنه لم يعد يثق في القادة الحاليين ولا في الملك، وأن الشيوعية عدو مشترك يجب تنسيق الجهود للقضاء عليه. وقد نشرت صحيفة الإخوان في فبراير 1946م جانبًا من حديث حسن البنا مع مستر سبنسر المراسل الحربي الأمريكي، جاء فيه : أنّ الثورة البلشفية الشيوعية على الأبواب وأن خلاياها السريّة في مصر لا يقدر على مجابهتها سوى الإخوان، ومن ثمّ يصبح التعاون بين الإخوان المسلمين والمخابرات الأمريكية أمرًا حتميًا، وذلك لأن تعاليم الإسلام تناقض الثورة البلشفية الشيوعية.
وأرجح أن مقتل البنا كان بإيعاز من إحدى المحافل (الماسونيّة) التي أدركت أنه مراوغ وطماع وكذوب، فتخلصت منه على يد أحد المنشقين عليه.
أمّا دعوة الإخوان للخلط بين السياسة والدين وتقويم المعوج عن طريق السيف تبدو في كلماته على صفحات مجلة "النذير" (نحن حرب على كل زعيم أو رئيس حزب أو هيئة لا تقوم على نصرة الإسلام، ولا تسير في الطريق إلى استعادة حكم الإسلام ومجد الإسلام)؛ ذلك بالإضافة إلى توجيهه الآيات والأحاديث التي تحث المؤمنين على قتال المشركين توجيهًا سياسيًا مفاده أن جماعة الإخوان هي الفرقة الناجية ودونها يجب أن يُحارب باسم الجهاد، وقد ذكر ذلك في رسالته "نحو النور"؛ الأمر الذي برر تكوينه عصابة النظام الخاص واعتباره جماعة سرية جهادية لإقامة العدل وهدم حصون الظلم، وكانت أكبر حركاتها في هذا المضمار الثورة اليمنية المسلحة التي أطاحت بالإمام وقتلت ثلاثين من أبناءها عام 1948م، ووصف البنا هذه الواقعة بأنها الخطوة الأولى في رحلة الإخوان للحكومة العالمية الإسلامية. وتحولت حرب العرب ضد الصهاينة إلى حرب إسلامية ضد اليهود في داخل مصر وفي الخارج، الأمر الذي أغضب الدوائر الغربية واعتبروا ذلك انحرافًا عن الرسالة التي رُسمت لها.
لا ريب فى أن تصريحات البنا فى ذلك السياق كانت بمثابة الجرثومة الأولى لجل الخلايا الإرهابية فى مصر، وقد نجحت كلماته إلى حد كبير فى غرس روح البغض والكراهية فى صدور معتنقي الفكر الإخواني تجاه المجتمع المصرى باعتباره - وحكومته وما فيه من اتجاهات فكرية وعقدية ووسطية أزهرية - مجتمعًا مارقًا يجب تقويمه. وقد تمكن المرشدون الذين خلفوا حسن البنا بداية من حسن الهضيبي وسيد قطب من ترسيخ مبدأ الجهاد والتقويم والتمكين عن طريق العنف فى نفوس شبيبة الإخوان، متخذين من مبدأ الطاعة والولاء، الذى وضعه المرشد، على رأس شروط البيعة والانضمام إلى هذه الجماعة سبيلًا لذلك.
وقد برروا حملتهم التكفيرية للمجتمع المصرى بتبنّي قادته العسكريين للفكر العلماني الذى توغل فى نظم التعليم والتربية والثقافة والأدب والفن والأخلاق العامة والسياسة، واضطهادهم للتيار الإسلامي المتمثل فى الفرقة الناجية التى يمثلونها، ذلك فضلًا عن جنوح المثقفين عن صحيح الدين وتبنيهم الفلسفات المادية الهدامة باسم العلم والحرية والتقدم.
وإذا ما انتقلنا إلى دور الدوائر الغربية فى نشر الجماعات الإلحادية فى مصر - تحت مسميات عدة - فإننا سوف ندرك أمرين، أولهما : قدرة دوائر الاستشراق على انتقاء معاونيها ووكلائها لحمل أفكارها ونشرها فى المجتمع المصرى، إذ وضعوا شروطًا وصفات أساسية يجب توافرها فى اختيار قيادات هذه الجماعات، أهمها : الإحساس بالاغتراب ورفض الواقع، النرجسية وتضخم الأنا، التطلع والرغبة فى الشهرة والمال، الانتهازية، العوز والاحتياج، الإصرار على تحقيق الهدف بغض النظر عن الوسائل، حب المغامرة، طاعة الرؤساء والإخلاص فى تنفيذ الأوامر؛ وثانيهما : دراسة المجتمعات المستهدفة دراسة وافية ودقيقة قبل وضع الخطط لغرس هذه الجماعات وتوفير قدر كافٍ لحمايتها ورعايتها لأداء مهمتها على أكمل وجه (دعم لوجيستي، وتخطيط استراتيجي، وغطاء إعلامي براق، والقضاء على كل ما يعيق التنفيذ من الاتجاهات المعارضة).
ولعلّ أولى جراثيم الإلحاد النظري فى مصر (إنكار وجود الله والأنبياء والكتب المقدّسة، وتبنى الفلسفة المادية)، يرجع إلى ذلك التلاقح الثقافي الذى حدث فى العصر الحديث وبالتحديد مع الاتصال المباشر لشبيبة المصريين بالفكر الغربى (البعثات - الجاليات الأجنبية فى مصر - المحافل الماسونية - المدرسون الأجانب)، حيث فُتح باب النقاش - فى الصالونات الأدبية وبعض الصحف - حول ما جاء فى الكتب المقدّسة من أخبار غيبية وتعاليم شرعية ومبادئ أخلاقية، واستعراض حجج الملحدين عبر التاريخ الإنساني، لا سيما ما روى عن «ثيودوس القورينائي» (نحو ٢٩٥ ق. م)، وما عُرف عن السفسطائيين و«أبيقور»، وما ورد فى محاورة القوانين لـ «أفلاطون»، وما جاء فى مقدمة كليلة ودمنة من طعن فى الأديان، وما نسب من أقوال لأبى بكر الرازي وابن الرواندي عن النبوات، وكتابات «جان مسلييه» (١٦٧٨-١٧٣٣م) التى تهكم فيها على عقيدة الخلاص المسيحية، و "فيورباخ" (١٨٠٤-١٨٧٢) صاحب نظرية أنسنة الإله، وكتابات العالمين «كارل فوجت» (١٨١٧-١٨٩٥م)، و«لودفيج بوخنر» (١٨٢٤-١٨٩٩م) تلك التى كذّبت ما جاء فى الأديان عن قصة الخلق ووجود الله، ذلك فضلًا عن كتابات الماركسيين الأوائل «إنجلز» و«لينين» و«ماركس»، الذين نظروا للدين باعتباره أهم عائق للعلم والتقدم وأكبر الداعمين للعبودية والاستبداد والأفيون الذى يحول بين المقهورين والمظلومين والثورة على الإقطاعيين المستغلين والرأسمالية الفاسدة، وأخيرًا فلسفة «فريدريك نيتشة» (١٨٤٤-١٩٠٠م) الذى نظر للدين على أنه يمثل أخلاق الضعف والهوان والعبودية وإن من كان يعبد الرب عليه أن يعلم أنه قد مات على الصليب، ويملأ روحه بالآداب والفنون عوضًا عن معتقدات الكنيسة المضللة، وكتيب «برتراند راسل» (لماذا أنا لست مسيحيًا) الذى هدم فيه أدلة وجود الله التى اعتمد عليها الفلاسفة لإثبات وجوده.
وقد حمل هذه الأفكار إلى مصر العديد من المفكرين الشوام الناقمين على سلطة الكنيسة الكاثوليكية ومعتقداتها الرجعية القامعة لكل من يخالفها انتصارًا للعلم أو العقل، والكتّاب الأتراك، الذين ضاقوا باستبداد الخلفاء العثمانيين وتنكيلهم بكل من يرغب فى اللحاق بركب الحضارة الأوروبية - تلك التى وجدوا فيها طوق النجاة من قلاع الاستبداد ويده الباطشة بالعقول باسم الدين - وأخيرًا معتنقو الماسونية والماركسية والفلسفات المادية التى ارتشفوها على يد فلاسفة أوروبا، الذين تتلمذوا عليهم وتغذوا على نوازعهم (الارتيابية، اللا إرادية) فى الدين وثورتهم النقدية على ما جاء من تعاليم وتصورات وآراء فى الكتب المقدسة.
وبالطبع لم تكن المهمة سهلة أمام قوافل الملحدين، ويرجع ذلك إلى سببين: أولهما قوة الحس الديني عند المصريين حيث الجين الحضاري الذى لم يعتنق قط أى شكل من أشكال الإلحاد (فالإله موجود وهو الخالق المبدع الذى يهب للكون خيريته وجماله والمنعم على سائر الموجودات بالحياة، وهو القادر المنتقم الذى يحاسب عبيده على ما ارتكبوه من آثام فى محكمة العالم الآخر، وهو الملك العادل الكامل الذى يفيض ببعض صفاته على الحكام والرؤساء والكهنة والعلماء لإرشاد الرعية)، وثانيهما الالتزام الخلقي والفطرة الخيرة السمحة الودودة المؤمنة بأن الحب والرحمة، هما دستور الحياة، وأن القوة والعنف عقابان رادعان لمن يجترئ ويتهجم على السلم وحقوق الغير، ويعتدى على الحرمات والأعراض والثروات، التى قسمها الإله بعدله بين البشر.
ويعنى ذلك أن الاتجاه الإلحادي لم تكن له جذور فى مشخصات الهُويّة المصرية، الأمر الذى يمكننا أن ننظر إليه باعتباره عارضًا من عوارض التلوث القيمي، وليس أدل على ذلك من أثر هذه الأفكار فى الثقافة المصرية، فلم تلقَ قبولًا إلا عند حفنة من الكتاب الذين لم يحسنوا قراءة ثوابتهم العقدية، فافتتنوا بما تحمله الفلسفات الغربية من نظريات وتصورات وآراء مغايرة للمعتقد السائد المتمثل فى رجعية المحافظين وتعصب المتدينين وجمود الأزهريين وتعاليم الكنيسة الأرثوذكسية.
ولعلّ أشهر الدوريات التى وثقت العديد من المساجلات حول القضايا التى أثارها أنصار الاتجاه المتطرف الإلحادي (فى الفترة الممتدة من العقد الأخير للقرن التاسع العشر، والنصف الأول من القرن العشرين)، هي: (صحيفة المقتطف ١٨٨٥م)، (المقطم ١٨٨٨م)، (الحقيقة ١٨٨٩م)، (صهيون ١٨٩٤م)، (الجامعة ١٨٩٧م)، (المنار ١٨٩٨م)، (الإمام ١٩٠٣م)، (الدستور ١٩٠٧)، (المستقبل ١٩١٤م)، (الحضارة ١٩٢٠م)، (الزمان ١٩٢٠م)، (الجديد ١٩٢٥م)، (السياسة الأسبوعية ١٩٢٦م)، (العصور ١٩٢٧م)، (المجلة الجديدة ١٩٢٩م)، (حرية الشعوب ١٩٣٠م)، (الرسالة ١٩٣٣م)، (الحديث ١٩٣٤م)، (الشمس ١٩٣٤م)، (مجلتي ١٩٣٤م)، (أدبى ١٩٣٦م)، (الثقافة ١٩٣٩م)، (الكاتب المصرى ١٩٤٥م)، (الكتاب ١٩٤٥م).
وذلك بأقلام: إسماعيل مظهر، إسماعيل أدهم، محمود عزمي، سلامة موسى، أحمد ذكى أبو شادي، عصام الدين حفني ناصف، حسين فوزى السندباد، حسين محمود، عمر عنايت، حسين تقى أصفهاني، حسن كامل الصرفي، كامل صموئيل مسيحة، بندلي البيلونى، على أدهم، عبدالحميد سالم، طاهر خميري، عبدالحليم محمد حمودة، السيد عبدالرازق الحسنى، نظيرة زين الدين، حامد محمد الشيال، إبراهيم حداد، محمود على الشرقاوي، بهنام سلمان، جورجي اسكندر، عبدالجليل سعد، طاهر خميري، عبدالحميد حمدي، وفليكس فارس.
بالإضافة إلى أعلام الاتجاه المحافظ المستنير من تلاميذ الإمام محمد عبده الذين تولوا الردود، وحفنة من الكتاب العلمانيين الشوام الذين وقعوا بأسماء مستعارة، وانتصروا إلى الطعون.
أما عن القضايا التى طُرحت خلال هاتيك المناقشات فيمكن إجمالها فى : ماهية الإلحاد وأشكاله واللا أدرية والارتيابية وثقافة العصر، أشهر الجمعيات الإلحادية والفلسفات المادية، آراء «شارلس سميث» رئيس جمعية نشر الإلحاد الأمريكية، الاتجاهات الجانحة وفلسفتها وخطر ذيوعها فى مصر (البابية، البهائية، اليزيدية)، القصص الساخر من المعتقدات الدينية، حقيقة الكتب المقدسة وتناقضات محتواها وتحريف نصوصها، الكنيسة وألوهية المسيح، الإيمان والإلحاد والفكر الحر، التدين والأخلاق وعلم النفس الحديث، الأساطير والقصص الدينى، المرأة والجنس والأساطير الدينية، السفور والحجاب وسلطة الرجال وأكذوبة العفة الدينية، المعتقد الدينى بين العقل والعاطفة، الخرافة ومناقب الأولياء، رجال الدين وتقديس الوهم، تطور الأنواع وأكذوبة الخلق، خطورة الربط بين الدين والعلم، الأزهر والغيبيات بين الهرطقة والعلم، شيوخ الأزهر بين الجمود والإرهاب، الماركسية والعلم وجحد الأديان، العلمانية والدين ورجعية التعليم فى مصر، أقلام العلماء والفلاسفة وسيوف اللاهوتيين، العمائم ونقم المدنية الحديثة، الأديان والفنون الجميلة، فصل الدين عن المدارس الحكومية الأولية والكتاتيب وصبغة التعليم بالصبغة العلمانية، إلغاء الجماعات الدينية، وعلى رأسها الإخوان المسلمون، إخضاع كتب السيرة والأحاديث للبحث العلمي الحر والنقد الموضوعي، فصل الدين عن الاقتصاد والسياسة.
وحقيقٌ بنا فى هذا السياق إثبات أمرين : أولهما أن الإلحاد النظري المتمثل فى رؤى العلمانيين وتصوراتهم للتقدم ودعوتهم لتخليص الهوية المصرية من الأثر الدينى لم يكن أخطر من الإلحاد العملى - على الهوية المصرية - الذى تغلغل فى سلوك المصريين لا سيما ساكني المدن وبين أبناء الباشوات والأعيان، أولئك الذين نظروا إلى الأخلاق الدينية والواجبات الشرعية على إنها جزء من التراث الرجعى الذى يجب التخلص منه. ومن المؤسف أن الإلحاد العملى قد استشرى منذ أخريات القرن العشرين فى جميع طبقات المجتمع المصرى حتى أضحى ملوثا حقيقيا لأخلاقيات المصريين وعوائدهم بداية من غيبة الحياء فى السلوك والعادات والحوارات وانتهاءً بالإدمان والشذوذ الجنسي وزنا المحارم وإرهاب الفوضويين، ومن ثم يمكننا التأكيد على أن هذا الجنوح والجحود للدين كان من أكبر ملوثات الهوية المصرية فى النصف الأول من القرن العشرين، وكان كذلك من أهم مبررات الجماعات الدينية للتلويح بالعنف والتصريح بأن هوية مصر الإسلامية فى خطر وأن كتابات الماركسيين والعلمانيين من أهم الآليات التى تعمل بجد على هدم الدين مسايرة لما حدث فى تركيا.
أمّا الأمر الثانى الذى يجب إثباته هو أن الموضوعات التى طرحها المجدفون والملحدون المصريون - فى هذه الحقبة - لم تكن سوى نقول مقتبسة من كتابات غلاة المستشرقين وادعاءات الجمعيات الإلحادية الإنجليزية والأمريكية والروسية، فلا نكاد نلمح من بين الموضوعات التى نوقشت فى الصحف أو فى الحلقات النقاشية أفكارًا أصيلة أو انتقادات مستنبطة من أبحاث علمية دقيقة بما فى ذلك الطعون الموجهة للقرآن وحياة الرسول والمنهج الأخلاقى الدينى الذى قامت عليه التربية ومعظم العوائد والتقاليد، وليس أدل على ذلك من تراجع الكثيرين من المفكرين المصريين عن تلك الآراء الجانحة، وعلى رأسهم إسماعيل مظهر ومنصور فهمى وسلامة موسى وخالد محمد خالد.
نعم تلك الآراء الإلحادية التى تسللت إلى النصف الثانى من القرن العشرين، وذاعت فى أيامنا هذه على يد الكثيرين من المتعالمين الذين زعموا بأن نقداتهم وطعونهم فى الدين وليدة إبداعاتهم وأفكارهم الحرة.
ولعلّ السبب الرئيس فى تزايد ملوثات العنف وما صاحبها من أصوات تكفيرية وعمليات إرهابية هو خلو منابرنا الثقافيّة منذ السبعينيات من القرن العشرين وحتى الآن من تلك العصبة الواعية التى تصدت لكل أشكال الانحراف والتطرف سواء من المتعالمين المتعصبين للدين أو من الجانحين السائرين ضدهم والمتعصبين للغرب، أجل إن غيبة الطبقة الوسطى المستنيرة هى العلة الرئيسية التى تكمن وراء ما نحن فيه من فوضى فكرية واجتراء بالباطل على الثوابت العقدية والتعلق عن جهل بكل ما ينتجه الغرب من مذاهب ونظريات.
ولا يخفى على أحد الدور الذى تلعبه الجماعات الإلحادية فى مصر - الآن - وذلك عن طريق الصحف والقنوات التليفزيونية والمواقع الإخبارية، تلك التى تغذى وكلاءها بالمعلومات والشائعات والأكاذيب من المصريين، الذين ارتدوا قبعات الماسونية وشعاراتها البراقة، وأسسوا عشرات الجمعيات الأهلية لحقوق الإنسان وأخرى ثقافية؛ ليتخرج فيها الناشطون السياسيون وجُمّاع البيانات والإحصاءات، وأخيرًا اجتماعية لاستقطاب الشباب من الطبقات الدنيا.
ومن أشهر الأدبيات التى صورت المساجلات التى دارت بين التيار المحافظ المستنير الممثل للطبقة الوسطى، والتيار الإلحادي الممثل لغلاة العلمانيين والمستغربين: «لماذا أنا ملحد؟» لإسماعيل أدهم، و«لماذا هو ملحد؟» لمحمد فريد وجدى، و«لماذا أنا مؤمن؟» لأحمد زكى أبوشادى، و« من هنا نبدأ» لخالد محمد خالد، و«من أين نبدأ؟» لعبد المتعال الصعيدي، و«على أطلال المذهب المادي» لمحمد فريد وجدى، و«حقائق حرة» لمحمد أمين هلال، و«حدث جلل» ليوسف الدجوى، و«عظمة الإسلام» لأحمد زكى أبوشادى، و«ملقى السبيل» لإسماعيل مظهر.
لم تكن أفكار الاتجاهين المتعصبين للموروث العقدي أو للفكر العلماني الأوروبي من أهم ملوثات الهوية المصرية فحسب، بل كانت هناك وما زالت مؤثرات أخرى لا تقل أثرًا أو خطرًا عن سابقتها: - فإذا كانت أفكار الجماعات الإسلامية المتشددة - التى قادت شبيبتنا إلى العنف انتصارًا للفهم الجانح والتأويلات الجاهلة بحقيقة الشرع ومقاصده - والأفكار العلمانية التى روجت لها مئات الكتابات والأحاديث - وذلك لتزييف الرأى العام التابع لا سيما للشباب المنبهر بتقدم الغرب واليائس من نهوض مصر بخاصة والشرق بعامة والرافض لسلوك المتأسلمين وخطابهم الدعوى المتهافت عقليًا وعلميًا والمنفصل تمامًا عن نبض الحياة فعملت على نشر الفوضى بينهم وغرست فيهم جراثيم الشك والإلحاد - قد نجحت فى انقسام العقل الجمعى وشتتت ولاءه - بعد انسحاق الطبقة الوسطى المستنيرة - إلى فريقين متناحرين!
فإنّ فساد المؤسسات الحكومية - بما فى ذلك التعليم والثقافة والإعلام - قد لعبت دورًا أكثر خطورة وأقوى أثرًاً فى بنية الهوية المصرية. فالفقر والعوذ وتفشى الأوبئة وغيبة الرعاية الصحية والاجتماعية ولاسيما فى الطبقات الدنيا، واتساع الهوة بين الطبقات، قد دفعت شبيبة المعوزين إلى الجنوح بكل أشكاله بداية من انحطاط الأخلاق، ومرورًا بممارسة العنف فى الجريمة المنظمة وتعاطى المخدرات وانتهاءً بجحد مشخصات الهوية وعقيدة الولاء للأرض والانتماء للعائلة. أجل إن انحطاط مستوى التعليم فى كل مراحله قد حرم خريجي المدارس والجامعات من إيجاد فرصة عمل فى الداخل أو الخارج (تلقين، معارف بلا مقاصد، مدارس فنية بلا خبرات، وكليات ومعاهد بلا تخطيط، وزراء بلا رؤية، حكومات بلا صلاحيات واستراتيجيات)، وذلك على العكس تمامًا من سياسة القادة المستنيرين فى فجر النهضة المصرية الذين كانوا يخططون وينفذون ويعدلون ويطورون فى عمل متواصل اختفت فيه الأنانية والتبعية والانتهازية وعلت فيه الرؤى العلمية الإصلاحية والمصالح العامة المدروسة.
ناهيك عن غيبة المقررات الدراسية التى كانت تعمل على تربية النشء خلقيًا ووجدانيًا وتربويًا وسياسيًا (التربية الدينية - الأخلاق العملية - التربية الوطنية والتربية القومية - الأنشطة الفنية) فقد أضحى جميعها من المدركات المهمشة التى لا تخلو من الإهمال الخلل والعوج. وقد حاق هذا التردي والانحطاط بمنابرنا الثقافية (صحف إخبارية، أقلام مرتعشة، أبواق مزيفة للوعى وتابعة للجالسين على الكراسي الحكومية أو رجال المال الذين يملكون الثروة والعطايا) وقد أدى ذلك إلى تعملق الأقزام وانزواء المبدعين وتزييف الوعى وخضوع الكتاب والمفكرين - من بقايا الطبقة الوسطى - إلى من يدفع الثمن، فلم تعد برامجنا الإذاعية والتليفزيونية وأفلامنا ومسرحياتنا قنوات فياضة ناعمة للتربية والتثقيف والتنوير، الأمر الذى دفع الشباب للعزوف عنها إلى غيرها من الثقافات المغايرة لهويتنا ومشخصاتنا. وباتت آدابنا الشعبية (الأغنية، الموال، الملحمة، الحدوتة، الحكاية، النكتة) لا تمثلنا ولا تعكس أوجاعنا وطموحاتنا بل جاءت مصطبغة بصبغة الثقافة العفنة السائدة فبدت فى أثواب قذرة : كلمات مريضة، وألحان لا صنعة ولا فن فيها، وأصوات أقرب إلى الرقاعة والبهيمية منها إلى العذوبة والحلاوة والجمال، وحكايات وقصص مهجنة سفاحًا لا جدة ولا طرافة فيها من فرط التقليد، ونكات إباحية لا نقد فيها يقوّم المعوج، ولا سخرية تنذر بالخطر المتحدق بنا.
أما القنوات الإعلامية فحدث ولا حرج لا سيما بعد الخصخصة والانفتاح على العالم دون تحفظ أو تطعيم الرأى العام بأمصال تقيه خبائث أجوائه. ومن المؤسف أن الحكومات المتتالية بداية من فترة السبعينات إلى الآن - لا سيما بعد الانتقال المفاجئ من الاشتراكية الناصرية غير المدروسة إلى نفايات الليبرالية ووحشية الرأسمالية - لم تحاول وضع خطة لمعالجة ذلك التلوث الذى أوشك أن يصبح وباء، بل على العكس من ذلك تمامًا إذ ساعدت السياسات العشوائية للحكومات المتتالية على انتقال الواقع السيئ إلى الأسوأ، فأضحى الشارع المصرى شاغلًا بالسفالة والجهالة والانحطاط والصراع والاغتراب واليأس والتطاول والتبجح والتطرف بكل أشكاله والانحلال بكل مظاهره. وإليك بعض الأمثلة :
- قانون الإسكان الذى تحطمت على نصوصه العديد من القيم والمشخصات وعلى رأسها الولاء للمكان والألفة بين العشيرة فى الحى والتعاون والتآزر والحمية والشهامة والآداب العامة بين الجيران، فبات شعار (الولاء الأوحد للمال) ومن أراد العيش يجب أن يعمل لامتلاء جيوبه دون تحفظ على الوسيلة (اللذة القريبة والمضمونة هى الحقيقة التى يمكن التأكد من وجودها. أمّا الفضائل؛ فمشكوك فى صحتها وقائليها والثواب عليها فى غد مجهول).
- وإليك أيضًا : غياب المدارس العسكرية وانسحابها من مشهد التعليم، وإهمال نظام التجنيد وتسريح الشباب، وإهمال تحديث المعايير للالتحاق بكليات الحقوق، والسياسة والاقتصاد، والإعلام، والتربية، والآداب، وقد هُدمت بذلك البوتقة، التى كانت تلفظ رجالات النهضة والمسئول الأول عن صناعة الطبقة الوسطى والضامن الأقوى لعقيدة الولاء والانتماء والتضحية والإخلاص من أجل مصر.
- ناهيك عن غيبة الرقابة على المصنفات الفنية التى كان يقودها الأحرار من المستنيرين والأيقاظ الواعون بمصلحة البلاد، وذلك تحت شعار أجوف هو حرية الإبداع، الأمر الذى كان وراء ما يمكن أن نطلق عليه مخلفات الفكر وجيف الابتداع ومرايا القبح فى جلّ أعمالنا التى لا يمكن وصفها بأنها فنية لأنها شاغرة تمامًا من مواطن الأصالة والابداع.
أجل تلك كانت أهم ملوثات الهوية المصرية ومظاهرها وعللها المباشرة وغير المباشرة، تلك التى لا يمكن فصلها عن البيئة والأوضاع الاجتماعية السياسية والعلمية والاقتصادية، فمن الخطأ الاعتقاد بأن التطرف والجنوح والجموح عن مشخصات الهوية هو العلة الحقيقية لما نحن فيه من تلوث أوشك أن يصيب هويتنا فى مقتل بل إن ذلك كله هو مظهر ورد فعل مباشر لغيبة الطبقة الوسطى التى أشرنا إليها وبيّنا رسالتها ومسئوليتها ودورها فى تربية الرأى العام وتوجيه العقل الجمعى والحفاظ على مشخصات الهوية الثقافية والاجتماعية المصرية. وأخيرًاً لا أقول إن هناك للحديث بقيّة، بل أنتظر - من الذين لم يقتلهم اليأس ولم يثبطهم الفساد المتفشي، ولم يقعدهم عدم إصغاء الجمهور إلى تحذيرهم وندائهم ودعوتهم لإعادة البناء - أجل أنتظر من يلبى دعوتي منهم لفعل ما يقدر عليه لاسترداد وتعافى هويتنا المريضة وإنقاذها ممّا حاق بها من ملوثات تستشرى لقتلها ولكن هيهات! فإذا لم يفعل من نطلب منهم العون، فسوف يأتي يوم تستيقظ فيه العقول وتتطهر فيه الأنفس وترتقى فيه الأذواق وتخلص فيه النوايا وتنبض فيه القلوب بحب مصر التى لن تموت أبدًا.
بقلم: د. عصمت نصار