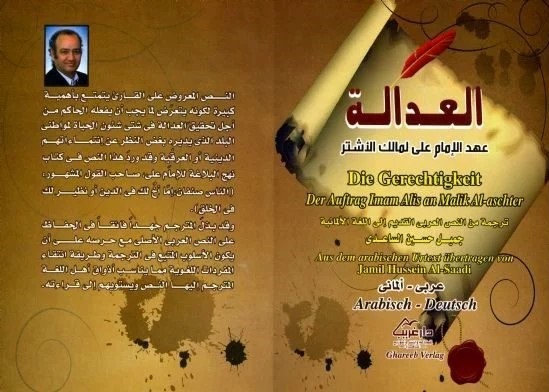قضايا
المفارقات المنهجية في نشأة اللغة العربية (3)
 نعود إلي الجزء الثالث والأخير من حديثنا عن المفارقات المنهجية في نشأة لعتنا العربية، حيث نتحدث عن بعد آخر، وهو "البعد المنطقي" : فنقول بشأنه: هناك فريق آخر من الباحثين والمفكرين، يرون أن الروايات التي أجمع المؤرخون على ذكرها في نشأة النحو والمنسوبة إلى الإمام "علي بن أبي طالب "، تدل على احتمال وقوفه على تقسيم الكلم إلى اسم، وفعل، وحرف على المنطق الأرسطي المتداول لدى أهل العراق ؛ إذ كيف يتصور المرء أن إنسانًا مثل الإمام" علي" يستطيع أن " يجلس بمفرده، ثم يجيل النظر في محيط اللغة التي يتكلم بها قومه، وهو غير مسلح بعلم سابق باللغات ولا بمعرفة مسبقة بقواعدها، ثم تنثال عليه المعرفة ويستخرج منها بنفسه القواعد المذكورة، ثم يضع لأبوابها تلك الأسماء التي لا يمكن لأحد وضعها، (لأنها تحتاج إلى شخص لديه معرفة) بقواعد اللغات عند الأمم الأخرى، لأنها مصطلحات علمية منطقية، ولا يمكن أن تخرج من فم رجل لا علم له بمصطلحات علوم اللغة والمنطق، ولأنها ليست من الألفاظ الاصطلاحية البسيطة التي يمكن أن يستخرجها الإنسان من اللغة بكل سهولة وبساطة، حتى نقول إنها حاصل ذكاء وعقل متقد، وكيف يعقل أن يتوصل رجل إلى استنباط أن الكلمة : إما اسم،أو فعل، أو حرف، ثم يقوم بحصرها هذا الحصر الذي لم يتغير ولم يتبدل حتى اليوم، بمجرد إجالة نظر وإعمال فكر، من دون أن يكون له علم بهذا التقسيم الذي تعود جذوره إلى قبل الميلاد، ثم كيف يتوصل إلى إدراك القواعد المعقدة الأخرى التي لم يبتدعها إنسان واحد، وإنما هي من وضع أجيال وأجيال، إذا لم يكن له علم بفلسفة الفعل، وعمل الفاعل، وما يقع منه الفعل على المفعول، وكذلك الأبواب المذكورة التي لا يمكن أن يتوصل إليها عقل إنسان واحد أبدا.
نعود إلي الجزء الثالث والأخير من حديثنا عن المفارقات المنهجية في نشأة لعتنا العربية، حيث نتحدث عن بعد آخر، وهو "البعد المنطقي" : فنقول بشأنه: هناك فريق آخر من الباحثين والمفكرين، يرون أن الروايات التي أجمع المؤرخون على ذكرها في نشأة النحو والمنسوبة إلى الإمام "علي بن أبي طالب "، تدل على احتمال وقوفه على تقسيم الكلم إلى اسم، وفعل، وحرف على المنطق الأرسطي المتداول لدى أهل العراق ؛ إذ كيف يتصور المرء أن إنسانًا مثل الإمام" علي" يستطيع أن " يجلس بمفرده، ثم يجيل النظر في محيط اللغة التي يتكلم بها قومه، وهو غير مسلح بعلم سابق باللغات ولا بمعرفة مسبقة بقواعدها، ثم تنثال عليه المعرفة ويستخرج منها بنفسه القواعد المذكورة، ثم يضع لأبوابها تلك الأسماء التي لا يمكن لأحد وضعها، (لأنها تحتاج إلى شخص لديه معرفة) بقواعد اللغات عند الأمم الأخرى، لأنها مصطلحات علمية منطقية، ولا يمكن أن تخرج من فم رجل لا علم له بمصطلحات علوم اللغة والمنطق، ولأنها ليست من الألفاظ الاصطلاحية البسيطة التي يمكن أن يستخرجها الإنسان من اللغة بكل سهولة وبساطة، حتى نقول إنها حاصل ذكاء وعقل متقد، وكيف يعقل أن يتوصل رجل إلى استنباط أن الكلمة : إما اسم،أو فعل، أو حرف، ثم يقوم بحصرها هذا الحصر الذي لم يتغير ولم يتبدل حتى اليوم، بمجرد إجالة نظر وإعمال فكر، من دون أن يكون له علم بهذا التقسيم الذي تعود جذوره إلى قبل الميلاد، ثم كيف يتوصل إلى إدراك القواعد المعقدة الأخرى التي لم يبتدعها إنسان واحد، وإنما هي من وضع أجيال وأجيال، إذا لم يكن له علم بفلسفة الفعل، وعمل الفاعل، وما يقع منه الفعل على المفعول، وكذلك الأبواب المذكورة التي لا يمكن أن يتوصل إليها عقل إنسان واحد أبدا.
ومن هنا يمكننا القول بأنه بغض النظر عن الجهة العليا التي أشارت إلى "أبي الأسود" أن يضع مبادئ هذا العلم ؛ فإن الراوية المنسوبة إلى الإمام" علي" رواية لا تتفق مع طبيعة العلوم ونشأتها التي تبدأ بالملاحظة أولًا، لا بصياغة المصطلحات والحدود، وذلك يؤكد أن هذه الرواية موضوعة على لسان الإمام "علي"، لأن عصر "أبي الأسود الدؤلي" كان عصر ولادة النحو (أي المرحلة الوصفية)، وليس عصر نضوجه (المرحلة الاستنباطية) . بل إن المتأمل في رواية "الزجاجي" وما تلاها من روايات يجد أنها تتضمن قضايا نحوية ثلاث : فهي تتناول أولاً تقسيم الكلام إلى اسم، وفعل، وحرف، ثم تعرف كل قسم منها، ثم تتحدث ثانيًا عن أقسام الأسماء، ثم ثالثًا بذكر حروف نصب الأسماء، وبشيء من التأمل يتضح أن كل واحدة من هذه المسائل الثلاث تتطلب قدرة على التجريد والتقعيد معا، وهو ما لم يكن في عصر الإمام "علي" و"أبي الأسود"، وقد استغرق الوصول إلى مثل هذه النتائج التفصيلية أجيالاً كثيرة، حتي عصر "سيبويه" ، بل إن سيبويه نفسه الذي يفصل بينه وبين الإمام "علي بن أبي طالب " قرابة قرن ونصف قرن لم يستطع أن يصل إلى هذه الدقة من التفاصيل التي نسبت إلى "علي" وعصره.
فسيبويه في كتابه لم يعرف الاسم بما ذكر في رواية "الزجاجي" التي تقول الاسم ما أنبأ عن المسمى، ويحد سيبويه الاسم بقوله :" فالاسم رجل وفرس وحائط "، فلم يذكر سيبويه ما ذكرته هذه الرواية المزعومة عن الاسم ووظيفته، ولذلك فإنني أؤيد قول القائلين عن هذه الرواية التي رواها الزجاجي وغيره أنها " حديث خرافة، وطبيعة زمن "علي"، و"أبي الأسود" تأبي هذه التعاريف، وهذه التقاسيم الفلسفية، والعلم الذي ورد إلينا من هذا العصر في كل فرع، علم يتناسب مع الفطرة، ليس فيها تعريف ولا تقسيم، وإنما هو تفسير أية أو جمع لأحاديث ليس فيه تبويب ولا ترتيب، فأما تعريف أو تقسيم منطقي فليس في شيء مما صح نقله إلينا عن عصرهما.
فالعلوم لا تولد مكتملة النمو، بل تنشأ ساذجة مبعثرة، ثم تنمو وتكتمل، وما ذكر في هذه الرواية المزعومة من تبويب وتقسيمات منطقية لا تصح إلا بعد النمو والاكتمال، يخالف طبيعة الأشياء في النشأة والتكوين، ثم النمو والارتقاء .
نعم إنه من السذاجة تصور أن النحو العربي قد حمل في نشأته الباكرة على يد "أبي الأسود" أو الإمام "علي"، حدا من التطور فاق كل تطور حققه من بعد طوال أكثر من قرنين، لأن هذا يجعلنا نصطدم بعقبة ابستمولوجية، وهذه العقبة تتمثل في أن فصل المقال في العلم يؤدي إلى فصل المقال في المنهج ؛ الأمر الذي ينجم عنه الاصطدام بظاهرتين متناقضتين: الأولى: أن: " النحو قد نشأ متطوراً حتي إنه يناقش في مرحلة نشأته ظواهر بالغة الدقة، وقضايا غاية في التفصيل، في حين أنه – وهذه هي الظاهرة الثانية – قد جمد بعد ذلك بحيث لم يستطع أن يضيف جديدا من أبواب النحو، ولا أن يدرك مزيدا من ظواهر اللغة " .
ولاشك أن هذا كله ضد منطق التطور الطبيعي، فليس معقولا أن ينبثق فجأة علم يتصل باللغة، متكامل المنهج، محدد الظواهر والأبعاد، دون سابق معاناة في تحديد ظواهره، وبلورة أبعاد قضاياه، وذلك لأن اللغة ظاهرة اجتماعية، وتحليل الظواهر الاجتماعية يتطلب مرحلة طويلة من المعاناة في تناول الظاهرة المدروسة، والتردد في تشكيلها طبقا لتعدد علاقاتها وتنوعها، "ومن البديهيات في تاريخ الاختراع أن المنهج الجديد يندر أن ينشأ فجأة من لا شيء، ويسبق الاختراع الفني عادة بتطورات في النظرية العلمية " .
إن العقلانية تفرض علينا بأن نؤمن بأن القواعد اللغوية لا بد من أن تمر بمرحلتين:
المرحلة الأولى : مرحلة الممارسة العفوية أو الإدراكات التلقائية لوجود قواعد، وهو إدراك نستطيع أن نصفه بأنه تطبيقي أكثر منه تجريدي، أي أنه يتم من خلال استيعاب النماذج اللغوية، وليس بالبعد عنها، وهو السبب في قبول ما يقبل من هذه النماذج، ورفض ما يرفض فيها، من غير تبرير ذهني مقبول أو مرفوض، ثم هو إدراك يمكننا أن نسميه جزئيا وليس كليا، فإنه قد لا يستطيع أن يصل إلى حكم عام يشمل أحداثا لغوية متعددة، بيد أنه قادر دائمًا على التعامل مع الأحداث اللغوية المتعددة، كما حدث منها على حدة – بالتصويب أو بالتخطئة . وهو إدراك في مقدرونا أن نوسع دائرته بحيث يوشك أن يكون ( صفة للمتمكنين) من اللغة، وليس خصيصة لفريق من الباحثين فيها .
المرحلة الثانية : مرحلة الوعي العقلي، وهي مرحلة تتميز بالرؤية التجريدية التي تحكم كل تطبيق، وهي رؤية قادرة على الإحاطة الشاملة دون أن نتوه في خضم الجزئيات، ولكنها – في مقابل ذلك محدودة في نطاق الباحثين في اللغة، وليس صفة لكل الناطقين بها . ومرحلة الوعي العقلي لا تتسم بالقدم، كما تتسم بذلك مرحلة الإدراك العفوي التلقائي، فإن هذه المرحلة الأخيرة هي التي تحفظ للغة قدرتها على البقاء والاستمرار، وتصونها من الاضطراب، وتنأى بنشاطها عن التخبط، ولا سبيل إلى تصور لغة لا يكون لدى الناطقين بها إدراك لقواعدها، وإن كان – في مقابل ذلك – من الممكن بقاء اللغة، واستمرارها ونموها دون معرفة عقلية كاملة بقواعدها .ومرحلة الوعي العقلي بالقواعد متأخرة بالضرورة عن مرحلة الإدراك العفوي التلقائي لها، وهي مرحلة لا توجد فجأة ولا تنشأ في لحظة واحدة، ولا تتم بأساليب غيبية، فإن كل ذلك يختلف مع طبيعة المادة التي تتناولها، وهي ( اللغة) فإن محاولة الإحاطة بالخصائص اللغوية لأي مستوى من مستوياتها يتطلب قدرة على التجريد وعلى التقعيد معا.
والقدرة على التجريد تستلزم التزام منهج فكري يعتمد على كلية النظرة، حتي يستطيع أن يصدر أحكاما شاملة تتناول المادة بأسرها، دون أن يضلله عن ذلك الركام الهائل من جزئيات المادة، وصورها المشتقة المبعثرة، كما تستلزم في الوقت نفسه إحاطة دقيقة بالجزئيات، بحيث يرتكز تحليله لما بينها من علاقات على إدراك حقيقي لها . وهكذا تتسم النظرة الكلية بالشمول، وتصدر في الوقت نفسه - عن إدراك تفصيلي، فهل كانت هذه القدرة متوافرة في عصر أبي الأسود ؟ من الواضح أن المادة اللغوية التي كانت محور دراسة "أبي الأسود" محصورة في النص القرآني، والنص القرآني على أهميته الكبيرة - جزء من المادة اللغوية المستخدمة في عصر "أبي الأسود الدؤلي" نفسه، ثم دراسة "أبي الأسود" له لم تكن قائمة على أساس تحليل ظواهره التركيبية، لافتقاره بالضرورة إلى منهج محدد لهذا التحليل، وإنما اعتمدت على مجموعة من الملاحظات العامة التي لا يمكن أن تسلم إلى نتائج علمية محددة .
والقدرة على التقعيد تتطلب مقدرة على صياغة الظواهر، في تشابكها وتعددها وتنوع علاقاتها ؛ في قواعد تحيط بها وتدل عليها، دون أن تتسم هذه القواعد بالاتساع فتضلل في فهم الظاهرة بما تضيفه إليها من ظواهر أخرى دون أن تتصف بالقصور عن الإحاطة بأبعاد الظاهرة والإلمام بكل تفاصيلها، وهذا كله يستدعي نوعا من الإدراك لهذه القوانين نوعا من التناقض مع طبيعة التفكير العلمي ذاته، وإذا كان النحو العربي حتى عصوره المتأخرة قد أضاف فهم النصوص، وتفسيرها، إلى النصوص ذاتها ؛ فاعتبر ما يقدم من هذا الفهم بما يقدمه من كلمات للشرح، وهذا التفسير بما يتضمنه من عبارات للتوضيح جزءا من النص يجب أن يوضع في الاعتبار حين التقعيد، مما أدى إلى اضطراب النحاة في فهم الظواهر المختلفة للغة، ومن ثم أسلم إلى الكثير من التناقض في التقعيد لها، ألا يصبح – بعد هذا كله – تصور القدرة على الصياغة التقعيدية للظواهر اللغوية في عصر أبي الأسود نوعا من السذاجة، لا تؤيدها قضايا العلم نفسه .
والسؤال الآن : أين تستمد المرحلة الوصفية لنشأة النحو العربي مشروعيتها إذا كانت الروايات التي رويت بشأن نشأة النحو مشكوكًا في صحتها ؟.
أعتقد أن الأقوال التي قيلت بأن أبا الأسود الدؤلي كان أول من بدأ بالعمل علي وضع قواعد النحو بعد توجيهات أولية من الإمام علي (رضي الله عنه) أقوال مشكوك في صحتها، وأن الحقيقة هي أن النحو الذي وضعه "أبو الأسود" لم يصل إلينا منه شيء . فيما حفظ من التراث النحوي، سوى إشارات عامة ذكرناها فيما مر، وليس فيها رأي محدد، أو تفصيل لمسألة نحوية . ويصدق هذا الأمر أيضاً على جيلين بعد أبي الأسود، إذ لم يصل إلينا مما عملوا في النحو سوى نذر يسير، وبالتالي فإن المرحلة الوصفية لنشأة النحو تستمد مشروعيتها من خلال عملية إحداث النقط وضبط المصحف التي قام بها "أبو الأسود الدؤلي"، نتيجة وقوع اللحن في قراءة القرآن، والخوف من تزيد ذلك مع مرور الأيام، ومن حدوث التغيير والتحريف في نص القرآن ؛ حيث كان الفكر الذي كان وراء نشأة النحو فكراً إصلاحياً، كما يري بعض الباحثين، حاول أن يمنع خللا بدأ يطرأ على الألسنة فلجأ إلى أسلوب عملي مدرسي يرمي إلى إيجاد علامات مادية تساعد على القراءة السليمة من دون اللجوء إلى الاستنباط والتجريد ؛ أي أن البحث اللغوي لم يكن غاية عملية مقصودة بذاتها هنا فلسفة عملية اجتماعية والقائم به حول السماع الصوتي للظواهر الإعرابية إلى مادة مكتوبة يمكن إدامة النظر فيها وإيجاد العلاقات الكلية الجامعة إياها، ثم انتقل الدرس بعد ذلك إلى نمط من النشاط الذهني التأملي الذي يحاول تجريد المعاني المطلقة من المحسوسات إطراداً مع التيارات الفلسفية المتصاعدة مع حركة المجتمع النامية، وهو ما يمكن أن نسمي به النحو في المراحل التي وصلت إلينا نصوصا عن أصحابها ؛ أي بعد أبي الأسود بما يقرب من قرن من الزمان وإلى عصور لاحقة عديدة .
وعلي كل حال فقد كان نقط أبي الأسود الدؤلي للمصحف فاتحة النحو العربي والخطوة الأولى في نشوئه ومجسدة لمرحلته الوصفية، وكان لعمله الذي ذكرته الروايات السابقة ولعمل غيره من القراء المنتشرين في الأمصار الإسلامية أكبر الأثر في نشأة النحو العربي . وإن كانت هذه النشأة لا تزال غامضة لا يُعرف عنها الشيء الكثير، فما ذكرته الروايات من أبواب وضعها أبو الأسود الدؤلي، وهي: باب التعجب، وباب الفاعل، والمفعول، والمضاف، وحروف النصب، والرفع، والجر، والجزم لم يصل إلينا منه شئ يمكن في ضوئه معرفة مدي ما وصل إليه البحث في زمنه أو بعده حتي زمن الخليل بن أحمد .
د. محمود محمد علي
رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط