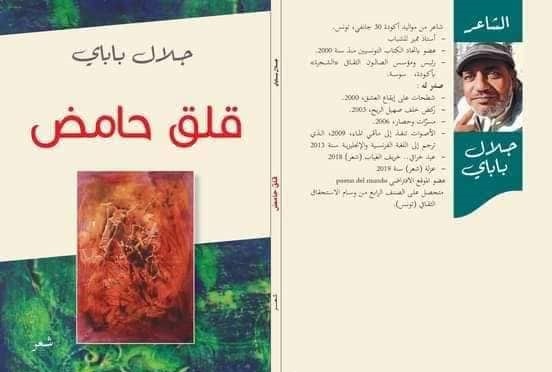قضايا
مشروعية العلاقة بين المنطق والنحو عند نحاة القرن الرابع الهجري (5)
 في هذا المقال الخامس والأخير ننتقل إلي معالجة السيرافي لمبحث العلة حيث يتضح البعد المنطقي من معالجته له، ومن التعليلات التي يبدو فيها أثر الاستعانة بالمفاهيم المنطقية - وبخاصة مفهوم "الجنس" في الحد المنطقي – تعليل السيرافي لوقوع "كم" موقع "رب" وهما نقيضان. يقول السيرافي: "فإن قال قائل: ولم جعلتم (كم) محل (رب) واقعة موقعها، وقد زعمتم أنهما نقيضان، فالجواب في ذلك أن كل جنس فيه قليل وكثير لا يخلو جنس من ذلك، فالجنس يشمل القليل والكثير، ويحيط بهما، ويقعان تحته، فليس يخرج أحدهما كثرته من جنس الآخر، لأنهما معاً يقعان تحت كل جنس، ولأن الكثير مركب من القليل، والقليل بعض الكثير". فبعد أن كان سيبويه يكتفي في تعليل مثل هذه الظواهر بقوله "العرب تجري الشيء مجرى نقيضه" نجد السيرافي يحلل هذه الفكرة على ضوء معرفته المنطقية. فالنقيضان يجمعهما الجنس الأعم، وإن تناقضا من حيث هما "فصلان" تحت هذا الجنس.
في هذا المقال الخامس والأخير ننتقل إلي معالجة السيرافي لمبحث العلة حيث يتضح البعد المنطقي من معالجته له، ومن التعليلات التي يبدو فيها أثر الاستعانة بالمفاهيم المنطقية - وبخاصة مفهوم "الجنس" في الحد المنطقي – تعليل السيرافي لوقوع "كم" موقع "رب" وهما نقيضان. يقول السيرافي: "فإن قال قائل: ولم جعلتم (كم) محل (رب) واقعة موقعها، وقد زعمتم أنهما نقيضان، فالجواب في ذلك أن كل جنس فيه قليل وكثير لا يخلو جنس من ذلك، فالجنس يشمل القليل والكثير، ويحيط بهما، ويقعان تحته، فليس يخرج أحدهما كثرته من جنس الآخر، لأنهما معاً يقعان تحت كل جنس، ولأن الكثير مركب من القليل، والقليل بعض الكثير". فبعد أن كان سيبويه يكتفي في تعليل مثل هذه الظواهر بقوله "العرب تجري الشيء مجرى نقيضه" نجد السيرافي يحلل هذه الفكرة على ضوء معرفته المنطقية. فالنقيضان يجمعهما الجنس الأعم، وإن تناقضا من حيث هما "فصلان" تحت هذا الجنس.
كذلك من التعليلات التي تبدو فيها الأفكار المنطقية تعليله لعدم وقوع ظروف الزمان أخبارا للجثث [=أسماء الذوات]. يقول السيرافي "واعلم أن ظروف الزمان تكون أخباراً للمصادر، ولا تكون أخبارا للجثث، وظروف المكان تكون أخباراً للمصادر والجثث. وإنما كانت ظروف المكان أخبارا لهما لأن الجثة الموجودة قد تكون في بعضها (أي في بعض الأماكن) دون بعض مع وجودها (أي الأماكن) كلها، ألا ترى أنك إذا قلت: (زيد خلفك)، فقدعلم أنه ليس قدامه، ولا تحته، ولا فوقه، ولا يمينه، ولا يسرته، مع وجود هذه الأماكن؟ ففي إفراد الجثة بمكان فائدة معقولة. فأما ظروف الزمان فإنما يوجد منها شيء بعد شيء، ووقت بعد وقت، وما وجد منها فليس شيء من الموجودات أولى به من شيء. ولو قلنا (زيد الساعة) أو (زيد يوم الجمعة) لكنا قد جعلنا لزيد في يوم الجمعة حالاً ليست لعمرو، وليس الأمر كذلك؛ لأن زيدا وعمرا وسائر الموجودات متساويات في الوصف بالوجود في يوم الجمعة".
وهنا تكشف لنا تعليلات السيرافي التي ذكرناها حتى الآن تكشف عن تأثر العلة عنده بطرق الاستدلال المنطقي تارة، وبعناصر نظرية الحد المنطقي تارة أخرى، وبالطبيعيات الأرسطية والرواقية تارة ثالثة .
وثمة نقطة اخري جديرة بالإشارة، وهي اهتمام السيرافي بمنهج الجدل ؛ حيث استطاع السيرافي من خلال هذا المنهج أن يقيم شكلاً من الاستدلال النحوي، يستقصي كل الفروض الممكنة حول المسألة التي يتناولها. لقد انعكست في هذا الاستدلال بوضوح تلك الحركة الذاتية الخالصة للعقل إلى الحد الذي وصل بها، لا إلى بحث لغة الاستعمال العربي، بل إلى بحث لغة واضعي قواعد هذا الاستعمال أيضاً. ولعل فكرة "الشرح" نفسها - أي شرح لغة سيبويه - خير دليل على ذلك.
ولقد كان من الطبيعي - في إطار هذا الاستدلال - أن تتعدد البراهين بكل ما يمكن أن يثمره الجهد التحليلي لأي مسألة يعرض لها السيرافي.: "فإن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن الأفعال مأخوذة من المصادر؟ قيل له: في ذلك ثلاثة أوجه …"، و "إن سأل فقال: لم لم يكن في الأفعال المضارعة جر فإن في ذلك أجوبة منها …" . وتصل هذه الأجوبة إلى خمسة وجوه. "، و"إن قال قائل: فلم دخلت النون في تثنية ذا، فإن في ذلك جوابين "، وهكذا.
لقد كان السيرافي يعتقد أن المعرفة النحوية يمكن أن تنتقل من ذهن المعلم إلى ذهن التلميذ عن طريق هذا المنهج الاستدلالي الجدلي. فالجدل - كما قال المناطقة هو "الارتياض والتخرج في وجود قياس كل واحد من المتناقضين" . وإذا كنا قد رأينا السيرافي يأتي بخمسة عشر وجهاً لجملة سيبويه "هذا باب علم ما الكلم من العربية" فإننا نقابل ذلك - على الفور - بما يروى عن يحيى بن عدى المنطقي من أنه "استخرج من قول القائل": "القائم غير القاعد" وجوهاً تزيد عن عشرين ألفاً بالآلاف ورسالته في ذلك حاضرة" . ومهما يكن من أمر الحقيقة في هذا القول، فإننا نأخذ منه دلالته العامة، وهي أن هذا القرن قد شهد صورة من التحليل اللغوي غاية في الإسراف.
وتحتل صورة القياس الشرطي مكانا واضحا في هذا المنهج الاستدلالي عند السيرافي. ولنوضح ذلك من خلال النموذج التالي: يقول السيرافي: "فإن سأل سائل فقال: ما الدليل على أن الأفعال مأخوذة من المصادر؟. قيل له: في ذلك ثلاثة أوجه، أولها: أن الفعل دال على مصدر وزمان، والمصدر يدل على نفسه فقط. وقد علمنا أن المصدر أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل. وقد صح في الترتيب أن الواحد قبل الاثنين، فقد صح أن المصدر قبل الفعل لأنه أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل" . وليس من العسير وضع هذه العبارة في صورة قياس شرطي متصل على النحو التالي:
- إذا كان الفعل دالا على مصدر وزمان،
- فإن المصدر يدل على نفسه فقط، وقد صح في الترتيب أن الواحد قبل الاثنين.
- إذن فالمصدر قبل الفعل.
رابعًا- أبو علي الفارسي:
كان أبو علي الفارسي من المهتمين بالمنطق، حيث كان المنطق في كتاب الحجة في علل القراءات السبع أكثر ظهورا منه في أي كتاب آخر، وذلك أن الغرض من الحجة التدليل والتعليل، ثم كان لا بد له أن يقيس أوجه القراءات المختلفة، ويخرجها علي ما يشبهها من الأصول المقرؤة، أو المسموع من كلام العرب، ومكن لأبي علي في المنطق أنه حنفي، ثم هو معتزلي، والمعتزلي جدلي، ولعله اقتفي أثر شيخه أبي بكر بن السراج الذي درس المنطق، إلي أن البيئة العامة كانت بيئة جدلية فلسفية يستعان فيها بالمنطق ومسائله علي مقارعة الحجة . وتكثر الألفاظ المنطقية في كتاب الحجة: كالاستدلال، والنظر، والأدلة، والدلالة، والوجه، والحد، والحجة، والقسمة، والغلط، والقياس، والعلة، ومعني الجنس، وخلاف الخصوص، وأشبه الوجوه .... كما تتجلي المنطقية – أيضا- في القسمة العقلية، فتراه يورد الأوجه المحتملة، ثم يصححها جميعا، أو يبطلها إلا واحدة يتعلق بها الحكم، فيصححها.
ومن مظاهر النزعة المنطقية للفارسي، في كتابه الحجة تعمقه في القياس المنطقي، ومحاولة تطبيقه علي الدرس النحوي، فهو يقايس حتي لا يكاد يخلو احتجاج لآية من قياس – ويسلك في قياسه سبيل المناطقة في التدليل والتعليل، واكتفي بمظاهر ثلاثة تشرح سلوكه في تعمق القياس:
1- قضايا من الشكل الأول: فتراه أحيانا يصوغ الدليل في صورة قضية منطقية ذات مقدمات ونتيجة، واقرأ معي ذلك الكلام تجده يسير فيه سيرا منطقيا يؤلف قضية من الشكل الأول: قال: وأما قولنا في وصف القديم (سبحانه)، فإنه يحتمل تأويلين، وبعد أن ذكر أحدهما قال: والآخر أن يكون معناه المصدق، أي المصدق الموحدين له علي توحيدهم إياه، يدل على ذلك قوله " شهد الله أنه لا إله إلا هو " . ألا ترى أن الشاهد مصدق لما يشهد، كما أنه مصدق من يشهد له، فإذا شهد سبحانه بالتوحيد فقد صدَق الموحدين .
ويؤلف هذا الكلام قياسا من الشكل الأول ويمكن وضعه على الصورة الآتية، صغرى، وكبرى، ونتيجة الصغرى: الله شاهد بالتوحيد في قوله تعالي " شهد الله أنه لا إله إلا هو " . الكبرى: وكل شاهد مصدق لما يشهده به (أي التوحيد ). الصغري، كما أنه مصدق من يشهد (أي الموحدين). النتيجة: فالله مصدق للتوحيد، والموحدين . واقرأ تدليله علي المشابهة المعتبرة بين الهاء، والياء، مشابهتهما الألف تجده كذلك قياساً من الشكل الأول.
2- القياس الاستثنائي الانفصالي: وأبو علي الفارسي مغرم بذلك القياس، يقدمه للتدليل على كثير من المسائل، فمثلا العامل في حيث من قوله تعالي:" الله أعلم حيث يجعل رسالته" لا يخلو من أن يكون أعلم هذه المذكورة أو غيرها، وأن عمل أعلم فلا يخلو من أن يكون ظرفاً أو غير ظرف، فلا يجوز أن يكون العامل فيه أعلم هذه ودلل، ثم انتهى من ذلك إلى أن العامل في حيث فعل يدل عليه أعلم .
3- وهناك ما يشبه القياس الاقتراني المضمر الحملي: وذلك قوله: وقول (موسى عليه السلام) أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين في جواب " أتتخذنا هزوا " يدل على أن الهازي جاهل . وقوله تعالي:" وعلى أبصارهم غشاوة" في المعنى مثل " صم بكم عمي "، وكذلك قوله تعالي " صم وبكم في الظلمات، لأن وصف البصر بالكون في الظلمات بمنزلة الوصف بالعمى، وكذلك وصفه يكون الغشاوة عليه، لأنه في هذه الأحوال كلها لا يصح له إبصار .
أما في الكتابات الأخرى لأبي علي الفارسي فنجده يهاجم الحدود المنطقية والآخذين بها من النحاة. ومن أجل ذلك كله حاول الفارسي أن يقيم الحدود النحوية على أساس بعيد عن فكرة الحد الجامع المانع الذي يبدأ من الأعم فالأخص. كما أنه حاول أن يستعين ـ كما استعان المعتزلة ـ بالنظريات المنطقية الأخرى، وبخاصة نظرية "الرسم" الرواقية.
كان أبو علي الفارسي يدرك الفارق بين ما هو من أوضاع النحو وما ليس منها. فهو يجيب عن سؤال: لم صار الظرف المخصوص بالزمان أكثر من الظرف المخصوص بالمكان؟ فيقول: "ليس هذا من أوضاع النحو. النحو في هذا أن تعرف أن الظرف ظرفان: ظرف زمان وظرف مكان، وتحصي أسماء هذا، وتميزها من أسماء هذا، وتقف على هذه المواضع المخصوصة بهما، والإعراب اللازم لهما وبهما".
والنص واضح الدلالة على منهج الفارسي في حدوده النحوية. فهو يدرك أن السؤال سيرمي به إلى طريق آخر، هو طريق التعريفات المنطقية والفلسفية، ومن ثم فهو يرى أن وظيفة النحوي ـ هنا ـ هي تمييز أسماء ظروف الزمان من ظروف المكان، وحصر مواضع كل منها وعلاماتها.
ولنشرع الآن في بيان تعريفات الفارسي لأنواع الكلم الثلاثة: الاسم والفعل والحرف.
يعرف الفارسي "الاسم" على النحو التالي "فما جاز الإخبار عنه من هذه الكلم فهو اسم... والاسم الدال على معنى غير عين نحو العلم والجهل ـ في هذا الاعتبار ـ كالاسم الدال على عين" .
ويعرف الفارسي الفعل بقوله: "وأما الفعل فما كان مسندا إلى شيء، ولم يستند إليه شيء". ولقد ذكرت ـ عند الحديث عن التعريف عند الزجاجي ـ أن مقولتي: المسند والمسند إليه هما أنفسهما مقولتا: الخبر والمخبر عنه. ومعنى ذلك أن تعريف الفعل عند الفارسي مؤداه أنه "ما جاز أن يكون خبرا، ولا يكون مخبرا عنه". ومن ثم فهو يفرق بين الاسم، والفعل على أساس "الخاصية المميزة" لكل منهما فيقول "فالاسم في باب الإسناد إليه، والحديث عنه أعم من الفعل؛ لأن الاسم كما يجوز أن يكون مخبرا عنه، فقد يجوز أن يكون خبرا... والفعل في باب الإخبار أخص من الاسم؛ لأنه إنما يكون أبدا مسندا إلى غيره، ولا يسند غيره إليه"
ثم يقسم الفارسي الفعل بانقسام الزمان، ولا يشير إلى فكرة الدلالة على الزمان بالبنية اللفظية للفعل في هذا الموضع، وإنما يكتفي بذكر الأمثلة. ولكنه سيشير إلى هذه الفكرة فيما بعد عند حديثه عن المفعول فيه ؛ حيث يقول "ألا ترى أنه إذا قال: ضرب أو يضرب، علم الزمان من صيغة الفعل ولفظه".
وفي تعريفه للحرف يقول الفارسي "والحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل". وإذا كان من قواعد التعريف المنطقي القديم أنه "لا يجوز أن يكون التعريف في ألفاظ معدولة (أي سالبة)"، فإن من الواضح أن هذا التعريف لـ"الحرف" يمثل خروجا على هذه القاعدة ارتضاه الفارسي ـ هنا ـ كما ارتضاه في تعريفه "البناء" بقوله "البناء خلاف الإعراب"، وفي تعريفه للاستثناء المنقطع بقوله: "الاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه". ولعل ذلك يمثل جانبا آخر من جوانب خروج الفارسي على نظرية الحد المنطقية الأرسطية.
ومن كل ما سبق نستطيع القول إن مقاومة الفارسي للمنطق الأرسطي بدت واضحة في مبحث الحد النحوي، ولكنها تراجعت تماما في مبحث العلة النحوية. ونستطيع أن نجد لدى الفارسي صور العلة الثلاث كما وضعها الزجاجي: التعليمية، والقياسية، والجدلية. وكما ذكرنا – من قبل – فإن العلة الأولى والثانية تعتمدان على مبدأ التمثيل الفقهي، أو قياس الظواهر لعلة الشبه. وهذا ما يؤكده قول الفارسي "ألا ترى أن الشيء، إذا أشبه في كلامهم شيئا من وجهين، فقد تجرى عليه أيضا أشياء من أحكامه".
وأهم ما يلاحظ في التعليلات القياسية عند الفارسي، هو أنه قد اتجه بها اتجاها صوريا واضحا، بحيث أجاز قياس ما لم تتكلم به العرب، على ما تكلمت به اعتمادا على الاتفاق الشكلي بين المقيس والمقيس عليه. وما يرويه تلميذه ابن جني عنه يوضح ذلك: "قال أبو على الفارسي: لو شاء شاعر، أو ساجع، أو متسع، أن يبني بإلحاق اللام اسماً، وفعلاً، وصفة لجاز له، ولكان ذلك من كلام العرب؛ وذلك نحو (خرجج أكرم من دخلل)، و(ضربب زيد عمرا)، و(مررت برجل ضربب وكرمم) ونحو ذلك. قلت له: أترتجل اللغة ارتجالا ؟ قال: ليس بارتجال، لكنه مقيس على كلامهم فهو إذًا من كلامهم ... ألا ترى أنك تقول (طاب الخشكنانُ) فتجعله من كلام العرب، وإن لم تكن العرب تكلمت به، فبرفعك إياه كرفعها ما صار لذلك محمولا على كلامها ومنسوبا إلى لغتها".
وإذا كان الفارسي قد ابتعد عن الحدود المنطقية الجامعة المانعة، فإنه توسع في استغلال معطيات الاستدلال المنطقي توسعا ظاهرا، بل لاقت نظرية الاستدلال عنده فهما وتقديرا واضحين. ويتضح ذلك في تفريقه بين العلم واليقين – وهو الذي آمن بالفروق اللغوية - عندما قال: "فكل يقين علم، وليس كل علم يقينا، وذلك أن اليقين كأنه علم يحصل بعد استدلال ونظر، لغموض المعلوم المنظور فيه، أو لإشكال ذلك على الناظر … ولذلك لم يجز أن يوصف القدير سبحانه وتعالى به، فليس كل علم يقينا، لأن من المعلومات ما يعلم من غير أن يعترض فيه توقف أو موضع نظر، نحو ما يعلم ببدائه العقول والحواس".
وهذه التفرقة بين العلم اليقيني القائم على الاستدلال والنظر والبرهان، والعلم الفطري الذي يعتمد على قوانين الفكر الأساسية، وعلى معرفة الحواس، أقول: هذه التفرقة ترجع - في جوهرها - إلى أرسطو . ولكن ما يهمنا هنا - هو إدراك الفارسي لأهمية العلم الأول، ولذلك فهو يقول "وعند التباس الأمر وإشكاله يفزع إلى النظر ويرجع إلى الدليل"، كما أنه يرى أن الاستدلال هو "الفاصل بين الحق والباطل" . وكل ذلك يذكرنا بما كان يراه المناطقة من أهمية الاستدلال، واعتباره الطريق الموصل إلى اليقين.
د. محمود محمد علي
رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط