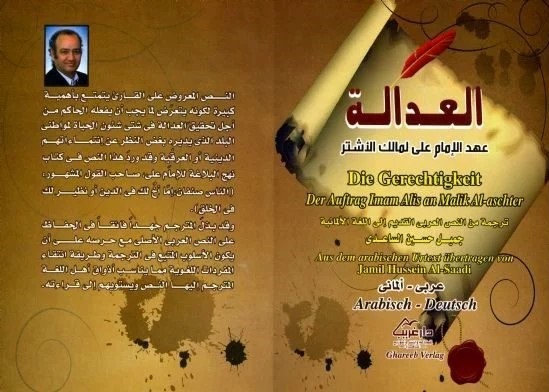قراءة في كتاب
جوزيف بيرن والموت الأسود (2)
 كان جوزيف بيرن الذي افتتحنا به المقال السابق من كتابه " الموت الأسود"، ذا بصيرة. يصعب علينا أن نتخيل الواقع في هذه الفترة، لتصوُّر كيف كان الموت الأسود حقًّا. عليك أن تتخيل أن ثُلث الأشخاص الذين تعرفهم، أو ثُلث البشر الذين تراهم يسيرون حولك في الشارع، قد اختفوا فجأةً. لا يُمكن تصور شكل العالم الذي فقد ثُلث سكانه في غضون ست سنوات، لكنه حدث مرة واحدة فقط في التاريخ؛ وخلال هجمة الطاعون في هذه الفترة، لم يكن هناك مكان كافٍ لدفن جميع الجثث، كان الناس يُترَكون في الشارع، أو ينهارون على الرصيف، محاولين التنفس حتى يموتوا. كنت ستقابل صديقًا لتتناول طعام الغداء معه، بحلول الليل تجده ميتًا. لن تعرف أبدًا مَن الذي سيُصيبه السهم بعد ذلك، زوجتك أو أطفالك أو أصدقاؤك أو ربما أنت. قد ينبثق تورم كبير ومؤلم جدًّا تحت ذراعك، أو في فخذك، أو في لحظة قد تشعر بأنك بخير، وفي اللحظة التي تليها ستبصق دمًا، ودائمًا ما كان هذا البصق الدموي قاتلًا.
كان جوزيف بيرن الذي افتتحنا به المقال السابق من كتابه " الموت الأسود"، ذا بصيرة. يصعب علينا أن نتخيل الواقع في هذه الفترة، لتصوُّر كيف كان الموت الأسود حقًّا. عليك أن تتخيل أن ثُلث الأشخاص الذين تعرفهم، أو ثُلث البشر الذين تراهم يسيرون حولك في الشارع، قد اختفوا فجأةً. لا يُمكن تصور شكل العالم الذي فقد ثُلث سكانه في غضون ست سنوات، لكنه حدث مرة واحدة فقط في التاريخ؛ وخلال هجمة الطاعون في هذه الفترة، لم يكن هناك مكان كافٍ لدفن جميع الجثث، كان الناس يُترَكون في الشارع، أو ينهارون على الرصيف، محاولين التنفس حتى يموتوا. كنت ستقابل صديقًا لتتناول طعام الغداء معه، بحلول الليل تجده ميتًا. لن تعرف أبدًا مَن الذي سيُصيبه السهم بعد ذلك، زوجتك أو أطفالك أو أصدقاؤك أو ربما أنت. قد ينبثق تورم كبير ومؤلم جدًّا تحت ذراعك، أو في فخذك، أو في لحظة قد تشعر بأنك بخير، وفي اللحظة التي تليها ستبصق دمًا، ودائمًا ما كان هذا البصق الدموي قاتلًا.
لقد كان الموت الأسود أمرًا لا نظير له، سواء في حدته، أو في انتشاره، بل وكل أنواع الطاعون مميتة. الطاعون الدبلي غير المُعالَج، الذي ينتقل عن طريق البراغيث عبر الجلد، وهو ملحوظ جدًّا بسبب الانتفاخات الهائلة للغدد اللمفاوية المعروفة بالأدبال، يقتل نحو 60% من المصابين، ويعد النسخة غير القوية للطاعون. أما الطاعون الرئوي، الذي ينتقل عن طريق الهواء من شخصٍ إلى آخر، فيقتل بنسبة 100% تقريبًا.
ومن هذا المنطلق نحاول في هذا المقال الثاني أن نستأنف حديثنا عن عرض كتاب الموت الأسود بالتحليل والنقاش؛ حيث نركز هنا علي حديث بيرن عن الحياة اليومية وسط الموت اليومي الناجم عن هذا الطاعون اللعين وفي هذا يقول بيرن: الحياة اليومية مصطلح يعني ضمناً وجود قدر من الحالة السوية، والرتابة، والاتساق، والنموذجية، والاستقرار، لكن الحياة اليومية للجميع يصيبها الجمود في زمن الطاعون، وتعني لبعض الأشخاص التخلي عن كل شئ والهرب إلي ماكن آمن، ولآخرين عزل أنفسهم في بيوتهم وانتظار الوباء، وتحل أنظمة غذائية خاصة وأدوية تعد بالعافية محل الطعام المعتاد علي المائدة، وتحل أنظمة غذائية خاصة وأدوية تعد بالعافية محل الطعام المعتاد علي المائدة، وتحد قيود السفر الرسمية وغير الرسمية، التي تفرضها السلطات والمفروضة ذاتياً – الاتصالات بشدة، بل إنها تحد حتي من التسوق البسيط . وفي المدن تفرغ المدارس، وتغلق الكنائس، وتهجر الدكاكين، ويرحل الجيران، ويتوقف البناء، وتخلو الشوارع من الحشود، والمسارح من الجمهور، ويبدو الأمر كأنه عطلة طويلة مرعبة.
ويستطرد جوزيف بيرن فيقول: أخذ الموت اليومي يوازن الحياة اليومية التي آلت إلي ما آلت إليه، فاختفت المعارف كما يقول جوزيف بيرن وظهرت إشارات علي الأبواب الأمامية تحذر الزوار وتبعدهم، وحلت النداءات الخشنة " أخرجوا الموتي" محل أصوات البائعين المتجولين في الشوارع الذين يعلنون عن بضائعهم . وسُمع صرير العربات المحملة بجثث الموتي والُمحتضرين علي طول الشوارع بدلاً من العربات المليئة بالمواد الغذائية الطازجة والسلع الأخرى . ولم تعد النيران توقد للطهي أو التدفئة، وإنما لإحراق أمتعة الضحايا، أو معاقبة المجرمين، أو استدخان ( التعقيم بالدخان) الجو " المسموم" علي ما يفترض . وفي مواجهة الوباء، انحسرت الثقة بالأطباء والكهنة الكاثوليك، وتحول كثيرون إلي كتب المساعدة الذاتية الطبية وإلي البروتستنتية .
ثم يؤكد جوزيف بيرن فيقول: مع ذلك استمرت الحياة رغم سيادة الموت الأسود، فعدل الناس عاداتهم وافتراضاتهم، واهتماماتهم، وإجراءاتهم المتبعة للكتيف مع الأوقات الاستثنائية. وحافظت الكنائس والمنازل والشوارع والطرقات والأديرة ومباني البلديات والمستشفيات ومشاهد " الحياة اليومية" علي قدر من حيوتها، علي الرغم من التحولات التي طرأت عليها بفعل الجثث، والباحثين، وحاملي الجثث، والمستدخنين، وأطباء الطاعون، والمحتالين، وحفاري القبور، والساكنين الآخرين في زمن الطاعون . وهذه " الأماكن" هي نقاط الاهتمام الرئيسية في جولتنا بالغرب الذي عاث فيه الطاعون تخريباً وتدميراً . وقد نُظمت فصول الكتاب حول الأنشطة المرتبطة بها وطرق تحول هذه الأنشطة نتيجة الطاعون وتكرر حدوثه . وهي تستعرض الحياة اليومية في زمن الطاعون بالتجول في أماكن انتشاره وترداد أصداء أصوات قاطنيها، من الأطباء إلي الموظفين الحكوميين، ومن كتاب المسرحيات إلي اللاهوتيين، ومن إمبراطور ما إلي دياغ عادي . فالمرض لم يهدد عالم هؤلاء فحسب، وإنما أحداث فيه تغييراً دائماً أيضاً.
ثم ينتقل جوزيف بيرن للحديث عن الموت الأسود في القرون الوسطي فيقول: تفشي الطاعون في وقت ما في ثلاثينات القرن الرابع عشر من موطنه المعزول في أراضي آسيا الوطسي الشاسعة، ومع أنه ربما انتشر شرقاً في الصين وجنوباً في شبه القارة الهندية، فإن السجلات الواردة من هذه المناطق لا تخبرنا إلا بالقليل . بيد أن المرض انتقل شرقا من دون شك، وظهر في المناطق الشرقية من العالم الإسلامي في أواسط أربعينيات القرن الرابع عشر، وامتد إلي الجنوب الغربي حول البحر الأسود أو عبره، فضرب القسطنطينية والأطراف الغربية للبحر المتوسط في أواخر سنة1447م، وفي ذلك الوقت بدأ المسلمون المسيحيون يسجلون ما عرفوه عن منشأ الطاعون ومساره المبكر والأهوال التي لم يعودوا راغبين في أن يشهدوها .
ولم يكتف جوزيف بيرن بل يقول: انتقل الوباء مع التجار والقوافل والجيوش والحجاج والبعثات الدبلوماسية، وعلي متن السفن المحملة بالبضائع والمسافرين من موانئ المناطق التي ضربها الطاعون . فتفشي في صقلية ومرسليا وبيزا وجنوه والإسكندرية . وعبر إلي المناطق الداخلية علي متن القوارب والصنادل علي طول الممرات المائية، وعلي متن العربات في الطرقات ودورب الجياد وعلي حيوانات الحمل .واجتاز جبال الأب والبيرينيه والأبنين والبلقان، والقناة الإنجليزية وبحر الشمال، ووصل في نهاية المطاف إلي السهول الكبري في أوروبا الشرقية والمدن الروسية في حوض نهر الدون وموسكو نفسها . وقد وصف شهود عيان (كما قال مؤلف الكتاب) تطور المرض بين الناس وفي المجتمعات، ومعاناة الضحايا والناجين عل حد سواء، والخراب الاقتصادي والاجتماعي الرعيب الذي خلفه الطاعون بعد انحساره . وسجل الرحالة والأطباء والموظفون المسلمون الدمار الذي حل في المدن الإسلامية من بغداد إلي المشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأندلس، ويبدو أن قليلاً من الجيوب المعزولة نجت، وربما مات في النهاية أربعة من بين كل عشرة أشاص . وأصيب آخرون بالمرض لكنهم عاشوا، وربما اكتسبوا بعض المناعة خلال هذه العملية . وفي النهاية فقد العالم الغربي نحو 35 مليون نسمة، سقط معظمهم في غضون سنتين.
وثمة نقطة مهمة جديرة بالإشارة يؤكد عليها جوزيف بيرن فيقول: تضرع الأتقياء والتقيات، وقدم الكهنة والأطباء الرعاية للمرضي والُمحتضرين، وانتقد الأساقفة خطايا البشر التي أغضبت الرب واستنزلت سخطه المتمثل في الطاعون، وبعد انحساره تاب قسم من الناس، واستغل آخرون الضعفاء بلا رحمة، وتنفس الجميع الصعداء بانتهاء البلوي . لكن أهوال الفترة الممتدة بين سنتي 1347 و1352 م لم تكن إلا البداية فحسب، ومع أن الطاعون لم يضل ثانية البتة إلي هذا الحد من الانتشار والفتك، فإنه ظل يتفشي بين الحين والآخر بينما أشرقت القرون الوسطي علي نهايتها في الغرب . ويبدو حيث تكون السجلات موثوقة أن الطاعون كان يتفشي كل عشر سنين تقريباً، وأن الوفيات تراوحت بين 10 و 20 بالمئة بدلاً من 40 أو 50 بالمئة، ويبدو أن الموت كان أشد فتكاً بالفتيان من البالغين، وبالنساء من الرجال، مع أنه لم يكن أحد يتمتع بالمناعة . وقد أدي هذا الوضع إلي عدم تزايد السكان لدمة قرن ونصف القرن، لكنه حث أيضاً علي إدخال العديد من التغييرات علي السياسة العامة التي ترمي إلي التقليل من احتدام الطاعون – أو حتي الوقاية منه . وتراوح ذلك من تحسين المرافق الصحية والرعاية الصحية إلي الحجر الصحي والإنذار المبكر، وتكيف الحكومات المحلية والملكية مع النظام الجديد الذي يتكرر فيه تفشي الوباء . حاولت مهنة الطب أيضاً التعامل مع المرض أيضاً، لكن نظرياتها ومعالجاتها كانت قديمة بالفعل وعديمة الجدوي . مع ذلك واصل كل جيل ثقته في الأطباء وأنظمتهم الغذائية وأدويتهم وتدابيرهم. وعلي الرغم من فشل رجال الدين في درء غضب الرب، فقد واصل الناس ثقتهم أيضاً في المسيحية والإسلام، وللإصلاح الديني الذي أدي إلي انقسام الكاثوليكية في أوائل القرن السادس عشر جذور عميقة في الاستياء الذي أعقب الطاعون، لكنه لم يتطور إلا بعد مرور قرن ونصف القرن علي تفشي الوباء لأول مرة. ولا شك في أن البروتستنت الأوائل سعوا إلي تنقية الدين لا الحلول محلها.
ثم ينتقل جوزيف بيرن بعد ذلك للحديث عن الطاعون في العصر الحديث فيقول: فيما كانت القرون الوسطي تفسح المجال لتغيرات عصر النهضة وابتكاراته، والكاثوليكية تتصارع مع تحدي البروتستنتية، استمر الطاعون في التفشي بين الحين والآخر . لكن مع انبلاج أوائل العصر الحديث، لا حظ الناس أن هذا المرض أصبح محدوداً علي نحو متزايد في المناطق الحضرية. ومع نمو حجم المراكز التجارية والحكومية والإدارية والتعليمية والصناعية والثقافية وتزايد تعقيدها، واصل المسؤولون والحكام اتخاذ الإجراءات المضادة لهذا المرض الوبائي، ووسعوا نطاق أنشطتهم وحدتها ؛ فأنشأت حكومات المدن المجالس الصحية والهيئات القضائية للإشراف علي أنظمة الإصحاح والحجر الصحي في المدن والمناطق التي تديرها . ومولت مستشفيات الطاعون ومصحات الأوبئة لعزل المرضي وأغلقت الموانئ والانهيار لوقف حركة المرور الملاحية المميتة . ووضعت السياسات والآليات لعزل المرضي – بل حبسهم – وعائلاتهم في بيوتهم . ولأنها رأت أن جذور تفشيات الطاعون المحلية تعود إلي الأحياء الفقيرة، فقد كانت تغلق هذه الأماكن عند أول بوادر ظهور المرض، وتحكم علي قاطنيها بملازمتها والمعاناة في حين تحمي في الظاهر المدينة علي العموم . وتبادلت الحكومات الصغيرة والكبيرة الأفكار وتعلمت من بعضها بعضاً عندما أدركت جميعاً أن ليس في استطاعة أي منها العمل بمفردها لوقف حركة الطاعون الذي لا يقر بأي حدود سياسية .
ويستطرد جوزيف بيرن فيقول: في الوقت نفسه، كانت الجيوش الدولية التي تفشي فيها الطاعون تعبر أوربا الوسطي بكثرة، وتنشر الوباء مثلما تنشر السلب والدمار والقتل بالسيف . بل إن الطرق التجارية استمرت، حتي في زمن السلم، في تسهيل نشر الطاعون ووجد المهربون الذين تزايدت حنكتهم سهولة في تجنب الحواجز التي وضعتها السلطات بنية حسنة . فلا عجب أن تكون آخر المدن الأوربية الغربية الكبري التي تعاني هي الموانئ التجارية مثل أمستردام ولندن ونابولي ومرسليا، أو أن يستمر الطاعون في التردد علي الموانئ العثمانية في البحر المتوسط بعد مدة طويلة من اختفائه من أوربا .
ومن جهة أخري يري جوزيف بيرن أنه عندما ضرب وباء الطاعون أوربا الجنوبية للمرة الأخيرة، في مرسليا في سنة 1720م، لم يكن الطب أكثر قدرة علي التعامل مع المرض مما كان عليه في سنة 1350م . وعلي الرغم من النهضة والثورة العملية، فقد ظلت نماذج وممارسات الطبيبين اليونانيين القديمين أبقراط وجالينوس تشوب التعليم الطبي والممارسة الطبية . وبقي إجراء الحجامة القروسطي لتخفيض " الأخلاط" المضرة، وتوقيت هذه الجلسات وفقاً للخرائط التنجيمية، ممارسة شائعة حتي نهاية الجائحة الثانية . ويصعب علي المرء الإشارة إلي اختراق واحد في المعرفة أو العلاج الطبي المرتبط بالطاعون، مع أن رجالاً ألمعيين واجهوه ما لا يقل عن ثلاثة قرون . وفي إنجلترا التي أنجبت إسحاق نيوتن، نصح الأطباء، بقدر ما نصح رجال الدين، بالصلاة والتوبة قبل أي وقاية أو معالجة للطاعون . وعندما بدأ الأطباء المسلمون يستوردون الطب الأوربي الذي يفترض أنه تفوق في القرن السادس عشر، فإنهم لم يحصلوا علي صفقة رابحة... وللحديث بقية !
د. محمود محمد علي
رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل