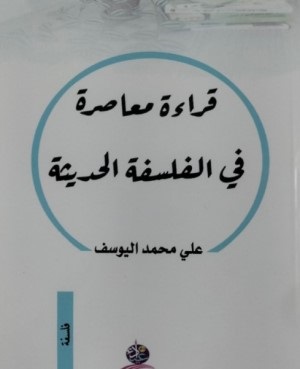دراسات وبحوث
عيونُ القلب
 "إذا كان للوجه عينان؛ فللقلب عيون"
"إذا كان للوجه عينان؛ فللقلب عيون"
عيون القلب نورانية، ليس يشكُ في ذلك مؤمنٌ ببصيرة قلب مفتوح، وإنما يأتي الشك دوماً من حُجُب الظلمة المتراكمة على القلوب، وهى التي سمَّاها القرآن في المطفّفين، آية (14)، "رَيْن"؛ فقال تعالى : "بل رَانَ على قلوبهم ما كانوا يكسبون". والرَّيْنُ صدأ قلبي وانطماس باطني، حجاب مظلم غليظ يغطي القلب حتى يمنعه أن ينظر بنور الله، فلا يبصر ولا يستنير، لا يبصر من الداخل ولا يستنير بنور الله لا في الظاهر ولا في الباطن : عيون الوجه محجوبة بما تراه، وعيون القلب مفتوحة على الجهة العلوية، ترى ما لا يراه الناظرون. عيون القلب تدرك الروح بلا عناء، وعيون الوجه خدّاعة مثلها كأي حاسة لا تدرك إلا الحواس.
عيون القلب مدركة للنور مجذوبة بصفائها نحوه، وعيون الوجه مدركة للظلمة مسدودة بكثافة الحُجُب. عيون القلب صافية شفافة، وعيون الوجه مطموسة أو محجوبة لا تدرك الصفاء ولا يدركها الصفاء. عيون القلب نورانيًّة؛ وعيون الوجه ظلمانية لا ترى إلا الظاهر من المظاهر : في المائدة الآيتين (15- 16) وَجَّه القرآن الكريم خطابه إلى أهل الكتاب في رقة وعذوبة وإقناع :" يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيِّن لكم كثيراً مما كنتم تُخفُون من الكتاب ويعفوا عن كثير. قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سُبُلَ السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم". وإذا كان الخطاب موجهاً إلى أهل الكتاب؛ فمن المؤكد أنه هنا مطلق التوُّجه، مطلق الدعوة، مطلق الدلالة، ليس بخاص ولا بالمقيد ولا هو بالمقصور على أهل الكتاب وكفى بل هو خطاب لكل الناس ولجميع الناس؛ خطاب للإنسان في كل زمان ومكان :
"قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين"
إنه لنور يصل إلى حسِّ المؤمن الصادق ويفعل في شعوره الأفاعيل. فلا يملك إلا أن يدعو الله مخلصاً أن يكون ممَّن يتبعون هذا النور رضواناً لله ولا يتردَّدُون، حتى إذا كان من أهل التمكين دعى الله بخير ما يدعو به المرء ربُّه أن يجعله من الذين يتبعون النور رضواناً لله ولا يتردَّدُون : لا يترددون في إتباعه قيد أنملة، إذْ التردد في إتباع هذا النور غلٌ يقيد المرء بأوهاق المادة الكثيفة أو يقيده بأوهاق الهوى ويُصْرفه صرفاً عن التوجه الحرِّ الطليق. إن عنايتنا بالإتباع هى هى عنايتنا بالاجتهاد، الاجتهاد في الإتباع، ولا يُكتفى فقط بقلة الحيلة في التقليد والمحاكاة، وتقليد الشارع إتباع خطاه، وهو في نفس الوقت اجتهاد ييسِّر سبل الإتباع ولا يُعَسِّره، بل يجعل التابع أهلاً لميراث المتبوع بمقدار ما هو أهلُ لمناشط الخير كله في كل فعل وفي كل قول، وفي كل عمل.
إن إتباعنا له - صلوات ربي وسلامه عليه - ضربُ من الاجتهاد وفضيلة كبيرة مطلوبة في ذاتها يتحرَّر بمقتضاها المرء من تقليد سواه :" قل إنْ كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله". وليس لأحد أن يدَّعي معرفة الله أو يدَّعي محبته - سبحانه - بغير جهد في إتباعه - صلى الله عليه وسلم - أو بغير هاته الفضيلة الكبيرة المطلوبة في ذاتها يتوخَّاها المجتهد في إتباعه والسير في طريقه، وهو من غير شك؛ طريق العصمة الواقية من الآفات والمزالق والدسائس والكروب.
إنه لطريق " الكتاب المبين"؛ فإتباع النور معناه في الأصل إتباع الكتاب المبين : انقيادُ على التصميم لهذا النور المودوع في هذا الكتاب : انقيادُ، وتسليم، وفهم، وتحقيق، وإدراك جوَّانيِّ، داخلي، يرتفع في الشعور إلى معنى كبير متى أرتفع إدراك النور في الكتاب المبين. وليس يدرك هذا "النور" فضلاً عن ارتفاعه وتَرقِّيه، ما لم يكن ها هنا في البداية اجتهاد يهديه، يهدي العبد إلى الإتباع، وإلى إحسان الوسيلة به وفيه، وبالكيفية التي يتمُّ الإتباع بها على شرعة الحب والحضور والإرادة والتكليف؛ وكلها مطالب - كما ترى- لا تكون ولا تتحقق بغير جهاد. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قومٌ نيامٌ تسلوا عنه بالحُلُم، كما قال البوصيري صادقاً، طيَّب الله ثراه؟
"قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين"
إنّ ما يصل إلى شعورنا من هذا المعنى؛ لهو معنى موصول بإتباع هذا النور عندما يتوجَّه قلب المؤمن في التماسه من مصادره القريبة. وأقربُ مصادره هو ذلك المصدر الأعلى الذي لا مصدر سواه، يلتمس منه النور ولا يلتمس من سواه؛ إذْ هو ممد الهمم بمشكاة من النور، وهى التي يُستقى منها كل نور سواه. فالله سبحانه، جاء بنورين، هما المصدر والأساس لذلك النور : نور محمد صلوات ربي وسلامه عليه، ونور الكتاب المبين. النور كما في التفاسير هو سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والكتاب المبين، هو القرآن، حتى إذا ما أتبعنا النور كان لزاماً علينا في حقيقة الأمر أن نتبِّع الكتاب المبين، وصار لزاماً على إثر إتباعنا للنور أن يؤدي بنا إلى إتباع الكتاب المبين.
وأي نور، وأي كتاب؟ إنه نور الحقيقة التي تهدي لهذا الكتاب، هو نور الوجود ينكشف لكل متِّبع مع التوفيق على ديدن الصدق وحضور التلقي، وعلى عادة الإخلاص الدائب في الإتباع .. أي نور هو؟ هو نور "الحقيقة المحمدية" : هو أشرف مخلوقات الله، بحر أنوار الله (معدن أسراره، ولسان حجته، وإمام حضرته، وعروس مملكته، وطراز ملكه، وخزائن رحمته، وطريق شريعته، وسراج جنته، وعين حقيقته، المتلذذ بمشاهدته، عين أعيان خلقه، المقتبس من نور ضيائه .. صلى الله عليه وآله وسلم).
ومن عجيب ما يروي (والراوي هو ابن إسحاق، وابن هشام في السيرة النبويَّة)، وابن إسحاق ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمائة عام، يروى في سيرة "عبد الله"؛ والد النبي أنه قبل زواجه بالسيدة آمنة - والدة النبي عليه السلام - نظرت إليه امرأة، وهو يسير في الطريق، وطلبت إليه أن يتزوجها نظير مائة من الإبل تدفعها إليه، لكنه لم يفعل. فلمَّا أن دخل بالسيدة آمنة وخرج من عندها لقىَ المرأة التي أعترضه من قبل، غير أنها لم تبالِ به، ولم تكترث له فقال لها : مالك لا تعرضين عليَّ اليوم ما كنت عرضته عليَّ بالأمس؟ قالت له : فَارَقَكَ النور الذي كان معك بالأمس؛ فليس لي بك اليوم حاجة". ويقول ابن إسحاق إنّ هذا النور غرَّة بيضاء كانت بين عيني عبد الله، وقد تلاشت عنه بعدما دخل بآمنة وحملت بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية أخرى تختلف قليلاً عن رواية ابن إسحاق هذه، أن المرأة التي اعترضت عبد الله هى أخت ورقة بن نوفل، أحد نصارى مكة، والذي أكَّد للنبي، صلى الله عليه وسلم، حين ظهر له جبريل أول مرة أن هذا الذي يأتيه هو الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسي، وأنه نبي هذه الأمة. وكانت أخت ورقة تعلم من أخيها أن نبياً يوشك أن يظهر في مكة. وعليه؛ فالنور الذي شاهدته هذه المرأة إنما هو "نور النبوة" كان يحمله والده عبد الله، ويظهر على جَبِيِنِه( يراجع سيرة ابن هشام ؛ طبعة القاهرة سنة 1955م؛ ج1 ص 155).
هذا النور إذن حقيقةً لا ينظر إليه على الإطلاق أنه مجاز . واقع مُحَقَقٌ ملموس في شخصه صلوات ربي وسلامه عليه، وليس هو من صنع خيال الروائيين.
لكن مجيء النور هنا لم ينفصل عن مجيء الكتاب المبين، فهما نوران، أصلان لا ينفصلان، وبإتباعهما يتحقق "النور" من المتبوع إلى التابع في وصلة روحية عامرة وغامرة، ويزداد في التابع على قدر جهد الإتباع : نور الهدي النبوي لا ينفصل عن نور الكتاب المبين، ولا ينفصل نور الكتاب المبين عن نور الهدي النبوي : هما نوران كاملان مكمِّلان، إتباع أحدهما يهدي إلى الآخر، وإتباعهما معاً نور على نور. وعليه؛ فتجزؤ الإتباع عند التابع أمر يقدح في الإيمان؛ لأن الأصل هو إتباع "المجيء". والمجيء هو "النور" و"الكتاب المبين" معاً في غير انفصال، فلا ينقدح نور الكتاب المبين في قلب التابع ما لم يكن قد أنقدح من قبل نور المتبوع (الهَدْي النَّبَوي) وبإنقداحهما معاً يتولد نور الهداية ويتزكي ويشعُ في شغاف القلب ليعمَّ الروح والسِّرَ بنوره، وإذْ ذاك يُفهم كتاب الله المبين فهم تلقي، وحكمة، وإلقاء، وأخْذُ عن الله بالمباشرة وبغير واسطة. لا ريب أن تصديق "المجيء" تصديق في الوقت نفسه للإتباع وبذل المجهود فيه فوق قدْر الطاقة.
إن توجُّه القلب إلى الله لهو وحده الذي يدرك بمقتضى بصيرته الشفافة تلك الحقيقة بعيداً عن زيف الزائفين وتوهم المتوهمين. إذا تصفَّى قلب المؤمن وتصافى أدرك الحقيقة الكبيرة من طريق إتباعه لهذا النور (إتباع الرضوان) فيقوده النور المتبوع إلى فهم الكتاب المُبين. إنما القلب الذي يخفق شعوره لإدراك "المجيء" - نوراً وكتاباً - لهو هو القلب الذي يعرف لهذا النور قيمته وقانونه؛ لأنه كان عَرَفَ ابتداءً معنى الإتباع على فضيلة المنهج الواضح ومقاصد الغاية البيّنة.
أما القلب المطموس؛ فهو القلب اللاهي، لا يعرف لهذا النور قيمة ولا يدرك له قانوناً (قيمته في هديه ودوامه. وقانونه في سننه ونواميسه) ولا يتذوق - من ثمَّ - له مصدراً : إحساسه قد نضب من الغفلة، وشعوره قد جف من الأعراض، وتوجهاته قد انتكست من الظلمات، فلم يعد يرْ النور، ولم يتبع رضوانه، ولم يأخذ حظه في مشاهدته، ولم يقترب من مصدره، وهو منه جدٌ قريب!
القلوبُ المطموسة وحدها هى التي تعترض طريق النور. والعقولُ المحجوبة وحدها هى التي لا يُداخلها الإيمان فلم تعدْ تدرك لذلك النور قيمته، وقيَمه : أعني قيمه الروحيّة في الهداية إلى سُبُل السلام؛ ودرء المخاوف البادية في الدنيا والآخرة. فإذا اعترضت فعلى الغفلة، وإذا نأت بجانبها بعيداً عنه؛ فلأنها محجوبة بحجاب الظلمة الحالكة والعائق الكثيف. أنها حقاً كما قال القرآن :"لا تَعْمى الإبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور".
"قد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين"
عيونُ القلب المفتوحة على الجهة العلوية أقرب لتلقى "المجيء" من الله - نوراً وكتاباً- من عنت العقول المحجوبة بحجاب الغفلة والإعراض. إن للقلب البصير عيوناً واعية تدرك نور الله بالمباشرة يوم أن تتبع النور وتتبع الكتاب المبين، وتجتهد في هذا الإتباع إلى غاية ما تستطيعه الطاقة العاملة، ليكون هذا النور طريقها وهذا الكتاب حياتها، ولا حياة لها ولا طريق في الحقيقة أو في الواقع في سواهما. فإذا كان نور الله مجسَّداً في كتابه، وكان هديه نوراً مشخَّصاً في نبيه، صلوات ربي وسلامه عليه؛ فلمَ الإعراض من قلوب لم تجاهد كيما تشاهد؟ وَلِمَ العزوف من عقول ارتضت طريق الظلمة حجاباً؟ في حين كان بمقتضى إتباع تلقى النور مُفاضاً من جهته العلوية أن يكون أفْعَل في نفس المتلقي وأقدر... أفعلُ : من حيث التوجُّه القلبي المباشر، التوجَّه إلى المقصد الأسمى والغاية النفيسة. وأقدر : من حيث التوجُّه به إلى داخل النفس عند تزكيتها وتحليتها وإدراك الصائب فيها، ومنها، بغير عزوف عن هذا النور بل بانجذاب نحوه إلى درجة الجنون !
نعم ..! لقد كان الذين انجذبوا إليه في عرف الناس مجانين! كانوا "بهاليل" مغيبين عن واقعاتهم الحسية، لم يأبَهْ لهم أصحاب العقول المضبوطة العاقلة عن نفسها - لا عن ربًّها! - قانونها، ومع ذلك تشرَّفوا بشرف البقاء دوماً في شهوده، وسعدوا؛ لأنهم أدركوه أو كادوا بغير حجاب، ولأنهم كانوا صدقوا الهمَّة بغير تراجع أو نكوص عن تلك القوة الباهرة التي أدركت بمقتضاها ذلك "النور"، فأدركت تباعاً وجه الحق فاعتمدت جهدها عليه فانجذبت إليه، بعد أن تركت للناس دنياهم ودينهم، شغلاً بلذائذ ما هى فيه.
هنالك وَجَدَتْ القوة القوية البالغة الممدودة من أعلى، في العبد، الفرد، الفذ، المتفرد، أسمى وأنبل وأقدر على المضاء والتحقيق من كل فكرة أرضية يعيش عليها واهماً بغير يقين، ويعيش بها في كل حال وبأية حال في متاهات السّراب المظلم الخادع البهيم تماماً كما تعيش العجماوات بلا انجذاب إلا إلى ما يقع تحت حوافرها.
"قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين"
مَا عَلى الذين يؤمنون بهذا النُّور إلا أن يسيروا في طريقه منقادين إليه على التسليم، وأن يتبعوا صادقين بإخلاص خطاه، وأن يمضوا مخلصين على البداهة في سبيله كيما يدركونه ليتحققوا منه. ولن يتمَّ لهم مثل ذلك "التـَّحَقـُّق" واقعاً، وفعلاً، وممارسة، وسلوكاً بغير "إرادة الإتباع" في كل حال شريفة من أحوال أنفاسهم عادةً اعتادوا أن تلهج بذكرها قلوبهم قبل ألسنتهم؛ حُرقة فيها وشغفاً للوصول إليها. إن "إرادة الإتباع" هنا إدراك على الفور لسُبُل السلام. إدراك من أول الطريق ابتداءً. وصول إلى الله لا وسيط فيه إلا "النور المتبوع"، ولا وسيلة إلى هذا الوصول إلا التزكية للنفس والترقية لها، ليجيء النور من معدن الفضل الإلهي مبثوثاً في طوايا النفس المهذبة الراقية، والمدركة لكل ما في النفس من جميل الخصال، ومن عزيز الصفات كذلك.
إن ترقية النفس مِعْوَانٌ للقلب على إدراك "النور" حقيقة لا مجازاً، ومَدَدٌ له على التهيئة للتلقي والإمداد. ترقية النفس تخليةٌ عن جميع الصفات المذمومة التي تورث التسفُّل والانحطاط. وترقية النفس كذلك تحْليةٌ بجميع الأوصاف المحمودة التي تعينُ عيون القلب أن ترى الحقيقة المطلقة رؤية روحانية أو أشبه بالروحانية، بعد أن تكون قد تحرَّرت سلفاً من كل علائق وعوائق وحجب وأوصاف. وأن تتذوق أسماءها وصفاتها، وأن تشهد أفعالها شهود بصيرة نورانية لا تعرف الحجاب بمثل تلك العوائق والعلائق والأوصاف، وأن تدرك بالذوق - لا بغيره من ألوان الإدراكات - حضرتها العليا وسموها الشريف.
"قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين"
نورُ النبُّوَّة، ونُورُ البيان في الكتاب المبين؛ ما إنْ يتحقق العبد من "نور" الله الذي جاء به، تحقق معرفة ومعاناة وتجريب حتى يُصبح هو نفسه مدْركاً من فوره إدراكاً ذوقياً لهذا النور، مدركاً للرضوان. وعلامة إدراكه : الإحساس والشعور، يَحسَّه في أحواله وأفعاله وأقواله، ويستشعره في جوارحه وظواهره وبواطنه، ويستنبط معانيه في أفكاره وأعماله وخوافيه. إنّ كيانه كله لينقلب، وحياته كلها لتتحول، فما في مقدوره مطلقاً أن يجيد فنون التعبير عن مثل هذه الحالة الروحيّة التي أدركها هداية، وذاق فيها بمدارك الذوق سبُل السلام مما لا يستطيع وصفه بالعبارة العادية أو نطقه باللفظ المعتاد؛ وذلك لأن العبارة العادية واللفظ المعتاد يحصران الحقيقة فيهما حصراً لا يمتاز بالتفتح الباطني ولا بالإشراق القلبي، ويحدانها حدوداً موقوفة على الظاهر من الإدراك لا على الخفي الباطن منه، وبحدود الرؤية الظاهرة تنحصر الحقيقة في العادة وتتوقف عندها.
هذا الحصرُ لا يعطي بغير شك مثل هذا الإدراك العلوي حقه من التعبير الوافي المقصود؛ إذْ يستحيل على تلك الحقيقة العظيمة أن تقبل الحصر والتقييد بقيود العقل المقيد بما يحصر وبما يحدِّ، فكل ما هو في منطوق العبارة العادية واللفظ المعتاد قابل لتحديد العقل وحصره وتقييده، فلا يلزم - من ثمَّ - أن يكون تعبيراً عن الحقيقة الكبيرة التي هى فوق طور العقل، ولا أن يجيء مخاطباً كل فتوحاتها الروحيّة ومنافذ معارفها اللّدنيَّة.
فمن المؤكد عندنا أن العبارة قد ترشد، وقد تُوحي، ولكنها لا تحدد ولا تحصر، فثمة حقائق أكبر من أن تنحصر في منطوق العبارة وأعظم من أن يقيدها الحرْف المعتاد. إن هذا الإدراك الفوري ينتج حتماً عن فضيلة الإتباع المنظم "إتباع الرضوان"، وعن قناعة مستيقنة بأن الإتباع في ذاته عين الوصول، وأن التّحقق من الإتباع هو هو الوصول إلى الله، إلى رضوانه، فنور يؤدي بالضرورة إلى نور، ونور يُسْلم لمعرفة النور.
أي نعم! لأنك حين تتبع نور الله الذي جاء به، فأنت قد وصلت من فورك إلى الله، وقد كفاك! كفاك الله كل ما سواه.
كفاك الله بنوره الذي أرسله مشرقاً وضَّاءاً.
كفاك الله شطط العقول وفتنة الأفكار ولجاجة الإنكار العقيم؛ فلست بحاجة من بَعْد الكفاية إلى أن تبتدع، وتدَّعي، من ثمَّ على البلادة إنك أقدر القدراء على الإبداع في غير مثال مسبوق. إنها لطفولة فكرية محققة، تلك التي يطلب أصحابها الوصول إلى الله والتحقق من هذا الوصول عن طريق العقل والنظر، والعقل في الغالب لا يرى سوى نفسه، ولا يستحسن سوى هواه! فهو على الدوام يبتدع، ويظن أن ابتداعه إتباع !
إن الله الذي يكفيك بمنهجه، وبنوره، وبطريقه، ليس في حاجة إلى سواه، لا لشيء إلا لأنه هو "الله". الله سبحانه : خالقك وخالق هذا الكون معك بما فيه ومن فيه. وهل تحتاج إلى شيء وأنت في مَعِيَّتِهِ، وفي صحبته، وفي نوره، وفي رضوانه، وفي الطريق الذي رسمه لك في بيان كتابه المبين؟ والذين عاشوا في رحاب الله ممَّن عرفوا النور وأدركوا المنهج ومضوا بقوة في الطريق كانت كلماتهم قد جرت، وهم الأسلاف البَرَرَة، مجرى الغذاء الروحي لأخلاف كانوا مثلهم، من طبيعتهم، على ديدن الصدق وتوهُّج التلقي فتربوا بالكلمة النوريَّة : الكلمة الطيبة، الكلمة القرآنية، الكلمة المحمدية، تربوا بالكلمة لما انفتحت عيون قلوبهم لتلقيها، وكفى التربية بالكلمة لمَنْ رَهَفَ عنده الإحساس وَدَقَّ.
كفى التربية بالكلمة أصلاً لمن تذوقوا فيوضات القـُرْبَةِ من الله، واقتربت قلوبهم من منبع الفيض ومصدر التلقي، وفاض منها النور هى الأخرى حتى عمَّ الجوانح كلها.
أقل كلمة كان لها التأثير العجيب في شعورهم، وكانت لها الفاعلية الناهضة في إحساسهم، كانت الكلمة بالنسبة لهم حركة، وفعل، وتوجُّه، وحياة .. وَمَا مِنْ عجب ..! فحياة الروح تغذيها الكلمات، والأرواح تحيا بالكلمات. كانت الكلمة بالنسبة لهم سلوكاً له لا شك دلالة على إدراك النور بعد التجربة المباشرة بتحويل الكلمة إلى فعل، والقول إلى حياة، وكانت معنى ضخماً كبيراً يرجع صداه إلى عيون القلب المبصرة بنور المعرفة الإلهية.
لم يكن "ابن مسعود"، رضى الله عنه، ببعيد عن هذا كله وذلك حين لخَّص لنا "منهج الإتباع" في كلمة مُعجزة حيث قال :" اتَّبعوا ولا تبتَدِعُوا فقد كفيتم"! (يُراجع في شأن هذه العبارة كتاب : لا ندريه كريسون : المشكلة الأخلاقية والفلسفة، ترجمة د. عبد الحليم محمود، والأستاذ أبو بكر ذكري، طبعة دار الشعب، القاهرة سنة 1399هـ - 1989م، والعبارة واردة في مقدمة الدكتور عبد الحليم محمود لهذا الكتاب).
وهى كلمة حق، صادقة، يرتسم فيها وعي البطولة الروحية في الإسلام، ووعي الأمة التي ينبغي عليها أن تدين بقوله تعالى :"قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين".
وبقوله تعالى :"قل إنْ كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله".
فمن دان بالنور الذي جاء من عند الله، ومن توخَّى على الدوام إتباع رضوانه، ومن أراد أن يؤثره الله بمحبته، فلا مناص له من أن يتحقق بالكلية من منهج الإتباع. وقد كفاه الله. كفاه الله بمنهجه عن منهج سواه، وبنوره عن نور سواه، وبرضوانه عن رضوان سواه، وبطريقه عن طريق سواه؛ فعبارة "ابن مسعود" تدور هنا على محورين أساسيين :
المحور الأول : إدراك الكفاية الواعية من حيث كونها من الله، ومن حيث أن الدلالة فيها تدل بالمباشرة على الله؛ ففي قوله :" اتبعوا فقد كفيتم"، نرى الكافي هنا هو الله، سبحانه، الله الذي أوحى الكفاية منهجاً من عنده لمن يريد سلوك الطريق ويدعو إليه على بصيرة، أوْحَي المبادئ والأصول والقواعد، وطبق رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك وبيَّنه، فكان تطبيقه مقياساً وبياناً ومرجعاً يرجع إليه المختلفون.
أما المحور الثاني : ففيه نرى افتقار الكفاية يقود إلى الابتداع لا محالة، أي :" لا تبتدعوا فقد كفيتم". فلا ريب أن الذي يبتدع في مجال الدين لهو الذي يفتقرُ إلى الكفاية، يستغني بما سوى الله فيفتقر في ذاته، وإنْ أغناه هذا السّوَى : مَنْ لا كفاية له في مجال الدين هو المبتدع، ولكن الله سبحانه، بعد أن أكمل الدين وأتمَّ النعمة، لم يعد هناك من مجال ولا من حاجة إلى الابتداع. لقد كفانا الله ورسوله؛ صلى الله عليه وسلم، كل ما يُصْلحنا من أمر العقيدة والدين. ليس هذا بالطبع قدحاً في تجديد الخطاب الديني بحال من الأحوال؛ فإتباع المنهج هو في الوقت نفسه تجديد؛ لأنك ما لم تطبق هذا المنهج في نفسك لا يمكنك فهمه على الإطلاق، وبالتالي لا تستطيع أن تمتلك أدواته وتجدد فيه. شرط التجديد الكفاية في الإتباع أولاً ثم إضافة البعد الذاتي الذي هو ثمرة "التجربة"، أعني؛ الفهم الذي استبصرته من التطبيق والممارسة، والفتح الذي هو من عند الله.
وانظر هنا حين تتبع وأسال نفسك : مَنْ عَسَاكَ تتبع؟ فأنت لا تتبع بشراً ولا تقلد مخلوقاً، ولكنك تتبع منهجاً يوصلك إلى الله من طريق الوحي، فهذا الإتباع هو الصالح في أمر العقيدة والدين، وهو عينه الحاجب عن التقليد في أمر الإبداع الفكري والمعرفة النظرية؛ لأن الذي يتبع منهجاً مُوحى به من عند الله، يتحرر فكره تباعاً عن أدناس البشر مِمَّن يفكرون فيخضعون تفكيرهم لمطالب الهوى أو لحظوظ النفس، فيبدع على صفاء من غير تقليد لأحد، ومن غير تأثر بلوثة فكرية أو عقدية مخلوطة بأوْشَابِ الريب والشكوك، ولعله المطلوب الصالح يثمره الإتباع في أمر العقيدة والدين.
لقد كفينا في أمر العقيدة والدين وعلينا إذن الإتباع؛ ولا منهج لنا ولا طريق إلا الإتباع، يُصلحنا، وينفعنا، ويهدينا إلى نور الله في الدنيا وفي الآخرة. يهدينا إلى "سبل السلام". وهل بعد الهداية إلى سُبل السلام من سبيل أو من غاية؟!
وإذا لم يكن هاهنا إتباع لما كانت تلك القدرة التي توفرت سلفاً لأولئك المدركين لمثل هذا النور، السائرين في طريقه بلا انقطاع ولا فتور؛ فلئن كانت قدرتهم على الإدراك "توفيقية"، تأتي من عين الجود، فهى كذلك"جهادية"؛ تتطلب المجاهدة ليتبيَّن فيها منذ البداية بذل المجهود؛ لأن فضائل الإتباع إذ ْ ذاك مجتمعة تكمن في تلك القدرة القادرة على نهضة النفس وإرادتها، كيما تكون مدركة لكل فضيلة مصروفة عن كل نقيصة، آخذة على عاتقها أنْ تُعلي من جميع الفضائل التي أدركتها وتلازم فيها الإدراك مع التطبيق.
إنها ولا شك لتزكية، وتحلية، وفهم، وإدراك، وتحقق مباشر هو من ثمرات التطبيق الذي كانت توخته قبلاً في منهج الإتباع. وإنها لصورةُ وضَّاءة من صور الترقي الدائم في النفس البشرية تعطي الاستقامة حقها تماماً كما تعطي الصورة الأخَّاذة دوماً مع الفضائل التهذيبية النافعة في كل طريقة هادية إلى النور المتبع من طريق الإقتداء بسيد الخلق؛ صلوات ربي وسلامه عليه.
شرطُ هذا كله ولو فيما نراه نحن : شرطُ إدراك "النور" وإتباعه والمضيِّ فيه، والارتقاء في مراقيه، شرطُ كل تقدَّم فيه. شرط الهداية إلى الصراط المستقيم هو أن تكون عيون القلب بصيرة مفتوحة على إدراك الحق بالمباشرة : طاقتها أن يباشر الإيمان القلب وشغافه. وهمتها أن تتوجه إلى الله على الدوام بغير انقطاع؛ تستحضر عظمته، وتردد في الباطن أسماءه وصفاته، وتستشعر علوه وتفرده في ملكه وملكوته، وتستدعي هيمنته وقهره وجبروته، وتتأمل قيوميَّته؛ لتراه تلك العين القلبية رؤية غيبية شُهُوديَّة مستنيرة بنور الإدراك العلوي المباشر، فهو الله؛ الحيّ الدائم، يحيي ويميت، وهو حي دائم لا يموت بيده الخير، وبيده الهداية إلى سُبل السلام، قيوم على كل شيء، على كل شيء بغير استثناء، لأنه خالق كل شيء بغير استثناء، فاعلُ لكل شيء بغير استثناء، ليس فوقه شيء، وليس بعده شيء و:"ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".
بقلم: د. مجدي إبراهيم