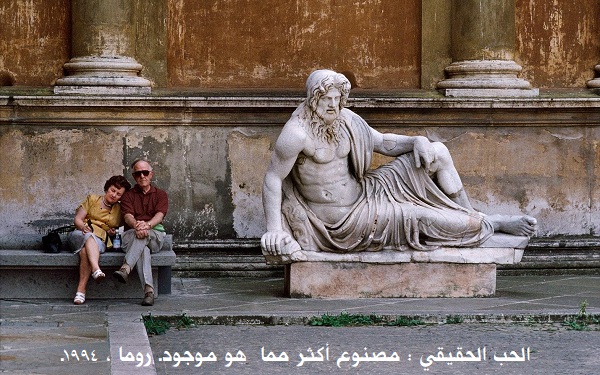صحيفة المثقف
رسالة الفكر في زمن العدوان (2)
 باسم العلم والتقدُّم العلمي نكتب سخافاتنا السوداء مدونة على صفحات التاريخ. باسم العلم والتقدم العلمي نرتكب أشنع الحماقات الإنسانية. باسم العلم والتقدم العلمي تُهْدر الحريات ويُسْتَعبد الناس ويقتلون بعضهم بعضاً بالأسلحة الفتَّاكة التي أخترعها التفوق العلمي، وفي الوقت نفسه نتبارى في نشر الثقافة العلمية وننادي بأهمية دور العلم وتطبيق المنهج العلمي في حياة الإنسان المعاصر، ولا يتنبَّه أحدنا إلى ضرورة أن تكون هنالك قواعد أخلاقية مصاحبة لكل تقدُّم علمي، وأن الثقافة العلمية التي نَشْرع في نشرها وبثهِّا والتشدُّق بها على أوسع نطاق ممكن، وبتطبيقها على جميع جوانب الحياة ينبغي أن تكون وليدة قيم وأخلاق.
باسم العلم والتقدُّم العلمي نكتب سخافاتنا السوداء مدونة على صفحات التاريخ. باسم العلم والتقدم العلمي نرتكب أشنع الحماقات الإنسانية. باسم العلم والتقدم العلمي تُهْدر الحريات ويُسْتَعبد الناس ويقتلون بعضهم بعضاً بالأسلحة الفتَّاكة التي أخترعها التفوق العلمي، وفي الوقت نفسه نتبارى في نشر الثقافة العلمية وننادي بأهمية دور العلم وتطبيق المنهج العلمي في حياة الإنسان المعاصر، ولا يتنبَّه أحدنا إلى ضرورة أن تكون هنالك قواعد أخلاقية مصاحبة لكل تقدُّم علمي، وأن الثقافة العلمية التي نَشْرع في نشرها وبثهِّا والتشدُّق بها على أوسع نطاق ممكن، وبتطبيقها على جميع جوانب الحياة ينبغي أن تكون وليدة قيم وأخلاق.
ولن تتأتى منظومة القيم والأخلاق أبداً بمعزل عن حكمة العقل وثقة الضمير الإنساني المطلقة في الوعي الديني. وقديماً دار حوار بين "إديسون" وصديقه "فورد" فقال "إديسون" : " ليس في هذا الوجود مَنْ نحني له الرأس إجلالاً عن حب وتقدير إلا صُنَّاع الزاد للإنسانية. فاعترض صديقه "فورد" قائلاً :"إذن فأنت تفضِّل رجال الحقول على عُمَّال المصانع!" فضحك "إديسون" قائلاً :"لستُ أعني هؤلاء، إنما أقصد "زاد الأرواح" أقصد رُسُل الفكر من رجال الفلسفة والدين والأدب والفن والفكر".
ونحن بدورنا ما يُخالجنا الشك مطلقاً في حقيقة هذا القول من جانب ذلك المفكر الكبير؛ لأن رجال الفكر والفن والأدب والدين هم تتمِمَة للموكب الخالد وتكميل، أعني موكب الرسالات السماوية التي احتضنت الروح الإنساني : وربَّته وهذبته وأخذت بيده إلى المعاني العليا، والمثالية التي تسمو بها الحياة، أو على أقل تقدير تساهم في سموها ورقيها وتقدُّمها؛ لتكون حياة أفضل جديرة بعالم يصدر عن الله. وهل ترانا اليوم جديرين بعالم يصدر عن الله أم ترى العالم الإنساني تجسّد فيه شيطانه اللعين فدمّر نفسه بنفسه وقتل بالسُّم الهاري روحه قبل جسده؟!
فماذا عَسَاها تكون رسالة الفكر في زمن الحرب والعدوان؟ أعني الزمن الذي يستخدمُ فيه انجاز العقل البشري في قتل الأرواح وإبادة الأفراد والجماعات، ومن ثمَّ قلة الثقة في تحقيق السلام والأمان تحت راية العلم والبحث العلمي وتفوق الإنجازات العلمية، ناهيك عمَّا تشاهده دوماً من "قلة الأدب" في الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي!
إننا بالحقيقة مفتقدون - كما قلنا فيما تقدّم - إلى ما يسمى في لغة السياسة بــ "التعايش السِّلمي". ولأجل هذا، فلقد وجَّه المفكرون المعاصرون النذير بعد إطلاق القنبلة الذَريَّة وقبلها على السواء في الحرب العالمية الثانية في أغسطس عام 1945م؛ حينما ضُرِبَتْ مدينتي هيروشيما وناجازاكي. أقول؛ وجه أولئك المفكرون المعاصرون النذير تلو النذير، فكان منهم الفيلسوف البريطاني "برتراند رسل", والمستشرق الفرنسي "لويس ماسينيون"، ومن قبلهما بسنين بعيدة كان "كانط" الفيلسوف الألماني صاحب المصنفات الفلسفية البديعة ومن أهمها في هذا المستوى كتاب "مشروع السلام الدائم"، ثم جاء بعد ذلك المُفكر الفرنسي الأستاذ "ألبير باييه" أستاذ الأخلاق والاجتماع بالسربون، فكتب قبل الحرب كتابه "أخلاق العلم"، وترجمه الأستاذ الدكتور عثمان أمين سنة 1936م، وجعل عنوانه المُعَرَّب :"دفاعٌ عن العلم"، وصدر في طبعته بنفس التاريخ؛ أي قبل الحرب العالمية الثانية بتسع سنوات، عن دار إحياء الكتب العربية (مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة سنة 1365هـ، الموافق سنة 1936م). وقد جاء فيه تعريف لمعنى العلم حيث قال إنه :"البحثُ عن الوقائع والقوانين بحثاً بريئاً"(ص39).
عبَّر الكتاب عن وجهة نظر المفكرين المعاصرين الذين وجهوا النذير تلو النذير، ولسان حالهم يقول :" لقد آن لنا أن نتعلم كيف نعيش معاً في وفاق وأمن وسلام، وأن نعمل على تنظيم أنفسنا وضَمّ صفوفنا في مواجهة الفتنة النائمة التي لو قدِّر لها أن تستيقظ لقضت على الغالب والمغلوب على السواء" (ص33 وما بعدها).
لم يكن "ألبير باييه" مؤلف كتاب "دفاع عن العلم"، يدري إذْ ذَاَكَ أنه سيأتي اليوم المشئوم الذي تستخدم فيه أمريكا في العراق الأسلحة المحرمة دولياً، وتستخدم إسرائيل قنابل الدايم والفسفور الأبيض في حروب الإبادة الجماعية قضاءً على الأخضر واليابس، وهل كان يدرى دخول العالم التعيس في حرب بيولوجية تذله وتقهره وتبيد فيه القوى والضعيف؟
لكنه كان يوماً متوقعاً بالنسبة له لاشك فيه. ويا لها من شناعة بشعة تكشف عن قبح بغيض يتجاوز كل تصورات العقول المستنيرة، ويحيط آمالها بخيبة وخيمة تحت ستار تجليات القوة في زمن تُستغل فيه القوة أسوأ استغلال خدمة للمآرب الوضيعة والأطماع الساقطة، وإيغالاً في استخدام براءة العلم لضرب القيم والأخلاق ..!
وليس من شك في أن الجرائم التي تُستَخْدَم باسم العلم إنما هى جرائم أخلاقية في أول مقام، الأمر الذي يجزم معه العاقل بوجود تناقض ظاهر للعيان بين العلم والأخلاق، مع أن الأصل في الواقع الفكري دونه في الواقع المشهود : الأصل في الواقع الفكري هو أنه إذا غابت الأخلاق عن العلم تغيب عنه لا بمعنى التناقض ولكن بمعنى عدم كفاية المعرفة العلمية السائدة لسعادة الإنسان، وأن صداقة العلم أو عداوته للإنسان إنما هى مسألة إنسانية في صميمها، ترجع إلى قوة النفوس وحكمة العقول وأخلاق الخير والرأفة والتسامح والمحبة والإحساس بالآخرين.
هذا هو الأصل في الموضوع كله، الأصل الذي يقرِّره الواقع الفكري. ولكن هذا الأصل مع شديد الأسف قد انقلب في الواقع المشهود ليقول بأبلغ لسان : إنّ العلم قد أضحى خطراً على الأخلاق، مفصولاً عنها ومعزولاً، وأن الجرائم الأخلاقية سببها في الواقع إنجازات علمية تَدرُّ الشر كله على الجنس البشري! أية قيمة في الإنجاز العلمي إذا استخدمناه للموت والقتل والتدمير؟ وأية قيمة في الإنجاز العلمي إذا كانت غايته اللعنة الدائمة والخوف المقيم؟ وأية قيمة في الإنجاز العلمي إذا استعمله شبابنا في فساد الأخلاق وسقوط القيم وهتك الحرمات؟ وأية قيمة في الإنجاز العلمي إذا لم يستخدم لنشر ثقافة السلام والتسامح، وخَلْق رُوح المحبة، والترقي في مدارج التعاون ومعارج التضامن والإنصاف لتحقيق أبسط حق من حقوق الإنسان : (الأمان)؟
هذا كله يعني لا شيء إذا فرغت القلوب من الحكمة، وصارت مقاصد العقول مقاصد مادية لا يزكيها وجود روحي ولا يفعِّلها ضمير حييَّ. ولما كانت طبيعة عصرنا تتغلغل فيه مطالب التفكير المادي كواقع مشهود يقدم المنافع العملية على كل قيمة روحية وخلقية، صار موصوفًاً بالمادية البغيضة، وبالواقعية المشروطة بالانعزال عن القيم الخُلقية.
ومن شأن التفكير المادي أن يُورث الفُرْقَة والتّضارب والشقاق، ويشيع لغة التمزق، ويدعو إلى الانقسام والخلاف. والانقسام والخلاف هما أساس السعي في الحياة لكنهما هما أيضاً أساس الحرب وسبب التعاسة والشقاء. والتفكير الروحي على العكس يهدف إلى الوحدة، والوحدة تعاون وتضامن ومحبة وسلام. الأول ينزع إلى الحروب. والثاني لا يعرف الحرب بل يطلب التسامح والمحبة والتعايش السلمي برضا من الله.
بقلم: د. مجدي إبراهيم