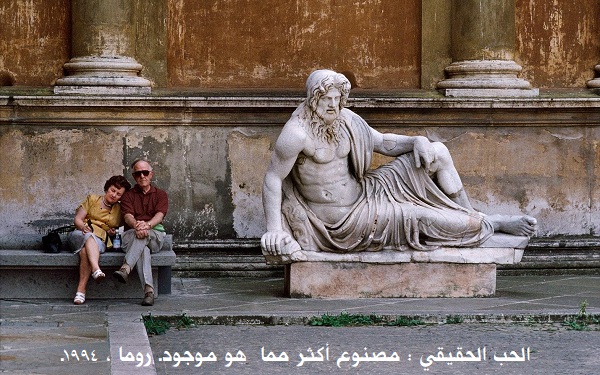صحيفة المثقف
تفكيرٌ في الدين
 تَعَدَّدَتْ الكتابات في الفكر الفلسفي الإسلامي بتعدُّد العقول التي كانت ومازالت تبحث فيه، وتتناوله باتجاهات مختلفة وضروب في المناهج متعددة ومتباينة، بل ومتصارعة في أحيانٍ كثيرة، كلٌ يريدُ أن يلتمس جوهر الحقيقة، وكل يرى في نفسه القدرة القادرة القويّة على الوصول إلى "الحقيقة" من خلال رؤيته هو؛ ومنهجه هو، وطريقة عرضه لموضوعه المبحوث. لكن هذه "الحقيقة" مطلقة كانت بعيدة وأحياناً غائبة عن عقول الباحثين والمفكرين والفلاسفة، كانوا يدركون منها جانباً ضئيلاً هو شعاع الضوء الذى يفتح أمامهم طاقة الرؤية عَلَّهم بهذا الفتح يرون منها ما يريح لديهم نزعة التشوِّف تَطَلُّعَاً وإدراكاً، وما عساهم يتحرَّقون إليه شوقاً إلى تلك الحقيقة المجهولة فيلتمسون فيها ظمأ الكشف عن جديد مُغَيَّبِ مجهول.
تَعَدَّدَتْ الكتابات في الفكر الفلسفي الإسلامي بتعدُّد العقول التي كانت ومازالت تبحث فيه، وتتناوله باتجاهات مختلفة وضروب في المناهج متعددة ومتباينة، بل ومتصارعة في أحيانٍ كثيرة، كلٌ يريدُ أن يلتمس جوهر الحقيقة، وكل يرى في نفسه القدرة القادرة القويّة على الوصول إلى "الحقيقة" من خلال رؤيته هو؛ ومنهجه هو، وطريقة عرضه لموضوعه المبحوث. لكن هذه "الحقيقة" مطلقة كانت بعيدة وأحياناً غائبة عن عقول الباحثين والمفكرين والفلاسفة، كانوا يدركون منها جانباً ضئيلاً هو شعاع الضوء الذى يفتح أمامهم طاقة الرؤية عَلَّهم بهذا الفتح يرون منها ما يريح لديهم نزعة التشوِّف تَطَلُّعَاً وإدراكاً، وما عساهم يتحرَّقون إليه شوقاً إلى تلك الحقيقة المجهولة فيلتمسون فيها ظمأ الكشف عن جديد مُغَيَّبِ مجهول.
لقد جاءت هذه "الحقيقة" لتعكس "مواقف" بعينها ممثلة في رجال كان هَمْهُم إبرازها على أيدهم كما أرادوا وتصوروا، ولكن ما لبثت تلك "الحقيقة" المجهولة المغيبة أن تفلتت من شباكهم كلما أمسكوا بطرف منها كما يتفلت الصيد الثمين من قيد صياد.
كانت آفة الفكر الإسلامي ولا زالت هى ذلك الصراع الزاعم في امتلاك الحقيقة المطلقة، وعدم توخي العقل في تَفَهُّم الرؤية المنهجية الإدراكية العقلية لمباحث المتنازعين ومدارك المتصارعين، وسقوط العقل في هوَّة "الموقف" يتخذه ضد غيره فلا يُمَكّن غيرهِ منه بُغية التفهم، ولا يريد أن يقيم جسوراً للتواصل مع الآخر؛ الكٌلُّ يزعم لنفسه الوصول إلى جوهر "الحق"، وما سواه أوهام وأباطيل، لكن الحق الذي يرونه فيتبدى لهم ظاهراً في غير خفاء، هو "حق" من وجهة نظرهم هم وحدهم، لا من وجهة نظر الذين يخالفونهم الرأي كما يخالفونهم المذهب والمنهج.
ظلَّ تراثنا الفلسفي الإسلامي لمدة طويلة - زَمَنْ النشأة وما يلحقها من تطور- اتجاهات ومدارس ومذاهب ومناهج مختلفة، في الفقه والكلام والأصول والجدل والمنطق والفلسفة، كلٌ يلتمس الحقيقة ويريدها، ولكن على شرطه هو لا على شرطها هى؛ هنالك العقلانيون الذين اقتدروا على هضم فلسفة اليونان وإدخالها إلى البيئة الإسلامية بُغْيَة الدفاع عن عقائد الإسلام أولاً ثم تطورت معهم فيما بعد؛ لتتخذ شكل التوفيق بينها وبين مقتضيات النص الديني؛ فإذا بموقفهم يميلُ ميلاً جارفاً إلى الفلسفة غير مبال بتحدياتها المضطربة إزاء ما تمثِّله عنوة في الغالب من انفصال العقل عن النقل، واستقلال الإرادة الإنسانية عن الإرادة الإلهية استقلالاً تاماً، كما هو الحال في موقف المعتزلة، ومن بعده موقف ابن رشد: العقل، والعقل وحده وليس شيئاً سواه. وهو موقفٌ موصوفٌ بالتطرُّف من النقيض إلى النقيض، أعني من تفريط اللامعقول إلى إفراط المعقول.
وهنالك الذوقيون الحدْسِيون الذين يرون أن وراء الظواهر المشهودة والملموسة إدراكات خفيَّة لا يصل إليها العقل، فَثَمَّ وراء "العقل" أطوار من المعرفة تنبعث خارج المدارك العقلية؛ لأنها تنبعث باستمرار عن جهاد النفوس وقدرتها الدائمة على الجهاد والمكابدة والمعاناة. وهذا موقف المُتَصَوِّفة ومن نحى نحوهم، في اعتبار القلب لا العقل هو طريق المعرفة، ومن ثمَّ يكون هو هو طريق الوصول إلى لب الحقيقة المنشودة، شريطة أن يكون المنهج وجدانياً شُعوريِّاً يُذَاقُ ويُحَسُّ، كإحساس المرء بكل عاطفة نبيلة وخيال ندي.
وهنالك طائفة أهل الظاهر الذين لا يعتمدون روح النَّصّ ولا يتجاوزون ظاهر النصوص الدينية ولا يؤمنون من هاهنا بتأويلها، وليس أظهر من هذا الوهم لديهم عند أقرب نظرة، فإن قلة استخدام العقل وتعطيله عن فهم النصّ الديني، يُعوَّل على حجة واهية وضعيفة، إنه مُحَرَّم ومقدس وذو مكانة لا يقتدر العقل كائناً ما كان على إدراكها فضلاً عن تأويلها ومنازعتها. وهذا موقف أهل الظاهر جميعاً كما هو موقف الفقهاء وأهل السلف المتأخرين من دعاة المنع والتضييق والتحريم.
وهنالك فِرَق الكلام على تعدُّد طوائفها واختلاف مواقفها وتباين وجهاتها في المعرفة والمنهج وطبيعة التكوين الفكري والتَّوجُّه في التخريج: معتزلة، وأشاعرة، وأهل السُّنة والجماعة، وجبرية، وخوارج، ومرجئة، وشيعة على اختلاف طوائفهم الكبرى بين زيديَّة، واثنى عشريَّة، وإسماعيلية .. وغيرهم، وغيرهم، مما تجدرُ العودة إليه فى كتب العقائد والكلام.
وإذا كنا ذكرنا الأشاعرة وأهل السنة والجماعة هنا كفرقتين منفصلتين من فِرق علم الكلام نظراً لفروق بينهما حدثت في التطور التاريخي للفكر الإسلامي، فهناك آراء تعتبرهما فرقة واحدة لا فرق بينهما ولا اختلاف؛ فلنقف إذن وقفة قصيرة إزاء تلك "التسمية" المُشكلة، تحديداً لها واستنباطاً لدلالاتها في تمزيق ماضي العالم الإسلامي وحاضره على السواء، ثم تفتيت وجهاته المعرفية وانقساماته العقائدية على الصعيدين الفكري والواقعي؛ فمثل هذا التشتت قديماً وحديثاً والانشغال بالفروع والتفاصيل عن لَمِّ الشَّمْل في وحدة توحيدية وعقائدية واحدة، لم ينشأ من فراغ، ولكنه كان فيما نرى - في القديم كمَا صَارَ في الحديث - كارثة أصابت العالم الإسلامي بالتنطُّع الفكري والثقافي وخمود الحركة الروحية والفكرية تحت شعارات زائفة ومزيفة تنتحل صورة الحفاظ علي العقائد، وما هى في الأصل إلا صورة محدودة لا تتجاوز حدود ما تفكِّر فيه وتتمثَّله ضد الانفتاح والتقدم واستيعاب الآخر.
لنقف هذه الوقفة - قصيرة أردناها وإنْ طالت - حول إشكالية التسمية؛ لتعطينا تبريراً يسيغه ذوق الغيور على صحيح الدين، لكل ما سيأتي بعدها من نقاط خلاف، بمقدار ما تعطينا المثال الواضح والصورة الكاشفة لانشقاق العقائد وتغاير الوجهات المعرفية وتفرّق المسلمين من ثمَّ نتيجة لكل خلاف عقائدي جامد حول الصورة لا المضمون! فمن ناحية الفرق الفارق بينها، أى الأشاعرة وأهل السنة، أن تسمية "أهل السنة والجماعة" كانت في البدء تطلق عند علماء المسلمين على كل من يلتزم السنة، وهى طريقة النبي، ويتبع الجماعة، وهم الصحابة - كما يقول الكستلي في حاشيته على شرح العقائد النسفية للتفتازاني - وَلَعَلَّ المقصود بها جمهور المسلمين مِمَّنْ لم ينتمِ إلى فرقة بعينها من الفرق الكلامية التى اعتبرت في بعض آرائها حائدة خارجة عن طريق السنة، وما مضى عليه الجماعة. وقد سمى أهل السنة أحياناً باسم السلف؛ لإتباعهم طريقة السلف في العقائد، وذلك منذ وقت مبكر في تاريخ الإسلام. ثم اتخذت هذه التسمية بعد ذلك مدلولاً خَاصَّاً - وهذا هو الفرق الفارق بينها وبين الأشاعرة - فهى (أي تسمية أهل السنة والجماعة) قد لزمت ابن تيمية (ت728هـ) ومن تبعه في آرائه منذ القرن الثامن الهجري وهم السَّلَف المتأخرون، وقد أرادوا الرجوع بالإسلام إلى ما كان عليه قبل ظهور الأشعرية؛ لأنهم لم يوافقوا الأشعرية، خصوصاً في مسألة الصفات، فهاجمهم، كما هاجموا غيرهم من المتكلمين والفلاسفة وغلاة الشيعة والصوفية، منتصرين بذلك لعقيدة السلف، ومحاربين لما عداها من الاعتقادات، ولا يزال لهذا الاتجاه السلفي أنصاره في العالم الإسلامي إلى يوم الناس هذا.
الظاهرُ جداً أن ابن تيمية وجماعته وأنصاره وتابعيه إلى يومنا هذا، قد اغتصبوا هذه التسمية اغتصاباً من الأشعرية ليحتكروا الإسلام ويمتلكوا الحقيقة، ولتكون عقيدة السَّلف وقفاً عليهم وليخرجوا منها من عداهم، ممَّن لم يرْ في مسألة الصفات ما كانوا يرون، وهو موقف غاية في التطرف بمقدار ما هو غاية في احتكار الحقيقة التي ليست حكراً على أحد، ولا ينبغي أن تكون.
سَبَقَ الأشعري علماء كُثُر لم يرضوا ما كان ارتضاه المعتزلة من نفي الصفات الأزلية لله تعالى؛ كالعلم، والقدرة، والحياة، والسَّمْع، والإرادة، والبصر، والكلام، والجلال، والإكرام، والخلود، والإنعام، والعزة، والمجد، والعظمة؛ فأثبتوها، فتسموا "بالصفاتية" وهم أهل السلف، وتسمى المعتزلة "بالمعطلة". وكان من هؤلاء المثبتين للصفات الحارث ابن أسد المحاسبي وجماعة من أهل السلف؛ كعبد الله ابن سعيد الكَلاَّبي، وأبى العباس القلاَّنَسي ومن تابعهم.
فلما جاء الإمام أبو الحسن الأشعري (270 هــ - 330هـ) على أرجح الأقوال، وجرت بينه وبين أستاذه الجبائي، وكان معتزلياً، مناظرة في مسألة الصلاح والأصلح تخاصما، فأنحاز الأشعري إلى طائفة السلف وصَاغ مقالتهم صياغة كلامية ومنهجية، وصار المذهبُ الأشعري منذ ذلك الوقت مذهباً لأهل السُّنة والجماعة.
فالمُرَاد بأهل السنة والجماعة في عرف الناس هو" العقيدة الأشعرية" أساساً - على مقولة الشعراني في اليواقيت والجواهر - حتى أن أحدهم كان يقول: فلانُ عقيدته صحيحة؛ لأنها عقيدة أشعرية، وليس مرادهم بصحة العقيدة غير ما ذهب إليه الأشعري على الإطلاق، لهذا كثُر أتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري وانتشروا في أكثر بلاد الإسلام، كخرسان، والعراق، والشام، ومصر، وغيرها من البلاد.
ولم يكن الأشعري وحده - فيما يقولُ الشعراني - هو الذي صَاغ مذاهب جماعة السَّلف صياغة منهجية كلامية، وَدَللَّ عليها بالبراهين العقلية، وإنما كان هناك متكلم آخر معاصرٌ له حاول تحقيق نفس الهدف، هو أبو منصور السمرقندي الماتريدي (ت333هـ)، وإنْ كانت بينه وبين الأشعري خلافات يسيرة حول مسائل العقائد وما يتبعها من فروع وتفاصيل.
ولم يكن الأشعري - وهو تلميذ أبو على الجبائي المعتزلي - راضياً كل الرضى عن طريقة الاعتزال لغلوها في التأويل وترجيح المعقول لديها عن المنقول؛ ولا هو كان مؤسساً لفرقة الأشاعرة الكلامية بالمعنى الدقيق لكلمة فرقة، ولكنه كان يُعبِّر عن جماعة المسلمين كلها، وكانت الأشاعرة هى جماعة السَّلَف التى تَرَسَّمَتْ خطى النبي وسنته بمقدار ما ترسَّمت خطى الصحابة وطريقتهم في العقائد.
هى إذن دعوى من ابن تيمية وأتباعه لا يقوم عليها من تاريخ العقائد في الإسلام دليل، مجرد دعوى تقفز فوق الحقائق لمجرد اختلاف في وجهات النظر كيما تحتكر الحقيقة لنفسها؛ تفكيراً وتعبيراً من جهة، ثم من جهة أخرى تهميشاً لدور غيرها مِمَّن كانوا أسهموا بنشاطهم الفكري وتوجهاتهم المعرفية في إبراز جزء من هذه الحقيقة بمنهج غير المنهج وطريقة غير الطريقة، الأمر الذي أدى قديماً كما أودى حديثاً إلى تمزق العالم الإسلامي، وانقسامه إلى فرق ضالة وعصابات مُضَللة تكفر غيرها في الدين والملة وترْهِب سواها مِمَّن لا يعتقد عقيدتها، ولا ينظر نظرها في الفكر أو في الضمير.
واستعراض مواقف المتكلمين والفلاسفة والباحثين في التراث الفلسفي الإسلامي, يتيح الفرصة كلما أمكن لنقدٌ تلك المواقف من واقع معاصر وأحداث مشهودة، فلقد كان انعكاس هذه المواقف في زمنها على تمزق صفوف المسلمين وتشتت وحدتهم، أمراً ظاهراً بجلاء ثم أثر هذه المواقف نفسها فى حاضرنا الإسلامي بما تركته من موروثات الخلاف، نعيشها إلى يومنا هذا: أفكارُ تجسَّدت في مواقف، فاتخذت لنفسها طريقاً في الواقع فَتَسَببَّتْ في حدوث أزمات على مستوى الفكر الديني كان الأحرى أن ترتفع فوقها وتطلب لنفسها طريقاً حقاً يرضى عنه الله، يَلمُّ وحدتها ويجمع تفرقها ويصمد أمام التحديات التي تواجهها.
من أجل ذلك؛ نختط لأنفسنا خطة منهجية في نقطتين أساسيتين نلتزمهما تفكيراً في الدين:
النقطة الأولى: رفض هذه المواقف كُلها من وجهة نظر نقدية معاصرة - وأقولُ رفضها لا إنكارها ! - لأنها كانت السَّبب المباشر في أزمة الفكر الديني قديماً ومعاصراً من جهة، ثم أنها من جهة أخرى رغم وجودها الذي لا يقبل الإنكار، اتخذت من القرآن الكريم غطاءً شَرْعيَّاً على صعيد النظر تسترت به، ولم تتخذه على مستوى العمل والممارسة العملية تفهم مقاصده، وتحقق تعاليمه في الواقع الفعلي، وتعمل لأجله هو؛ وهو فقط، أعنى تعمل لأجله هو من حيث ذاتيته الخَاصَّة لا ذاتية سواه، ولا تعمل لأجل مآربها ومقاصدها.
والنقطة الثانية: تبني موقف القرآن ورؤيته من حيث ذاتيته الخاصَّة لا ذاتية غيره وخصوصية سواه حتى إذا مَا كُنَّا في النقطة الأولى من منهجنا نرفض تلك المواقف برمتها؛ وبرؤية نقدية، فنحن فى هذه النقطة نقبل موقف القرآن ونطرح ما سواه، ونتمثل منهجيته في قبول ما نقبله ورفض ما نرفضه؛ كمعالجة للقضايا المطروحة تفكيراً في الدين.
بقلم: د. مجدي إبراهيم