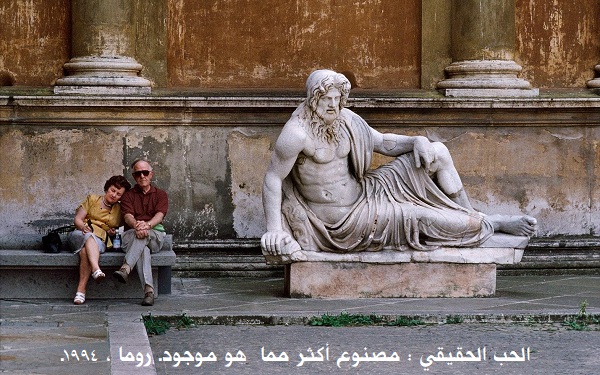صحيفة المثقف
جَبَّار مَاجِد البَهادِلي: تَمَثُّلَاتُ شِعرِيَّةِ الآيرُوتِيكِ الحِسِّي (2)
 وَالمُستَويَاتُ الجَماليَّةُ لشِعريَّةِ التَّناصِّ فِي غَزَلِيَّاتِ يَحيَى السَّماوِي الجَمَالِيَّةِ
وَالمُستَويَاتُ الجَماليَّةُ لشِعريَّةِ التَّناصِّ فِي غَزَلِيَّاتِ يَحيَى السَّماوِي الجَمَالِيَّةِ
3 ـ المَعشُوقَةُ الحِسيَّةُ المِثاليَّةُ (العَفِيفَةُ)
إنّ الهدف الرئيس أو الغاية الأساسية التي يبتغيها الشاعر من فنِّ انزياحاته العشقيه الزمنية في تقنية الآيروتيك الشعري، هي الكشف عن التنوّع الثقافي للنصّ الشعري فوق منطقة المحظور الثقافي الذي هو بالطبع نصٌّ له حضوره الأدبي وقيمته الأدبية المائزة قبل أنْ يكون نصَّاً إبداعياً ذا قيمة جمالية فنيَّ؛ وذلك من خلال أنساق سياقاته النصيِّة التي ينتجها ثقافياً لأول وهلةٍ عبر بناءاته التجددية التي يزخر بها ثالوث العشقية الحسية (أنا) و (أنتِ)، وجدليةُ (الآخرِ). والتي توحي دلالاتها السياقيَّة العميقة بموقفٍ فكريِ آيديولوجيِ إنساني منتظرٍ يتبنَّاه الشاعر، وأنَّ اختراقه بهذه المنظومة الشعرية الواثبة الخطى، يُعدُّ عملاً شعرياً جادَّاً ولافتاً. ولا يمكن أنْ يقوم به بهذه الجرأة، وهذا التجرّد الحسِّي، وهذه الصراحة، إلّا شاعرٌ مثقّفٌ واعٍ له أدواته الفكرية والثقافية التي تؤهِّله لعملية الإنتاج الإبداعي. والَّتي تعتمد أساساً على جملة شرائط من المثيرات الحسيَّة، كتوافر المثير، والإحساس به، ومعرفته وإدراكه، والاستدلال الحسِّي عليه، وحصول الاستجابة المثلى من المتلقِّي (24). إذن بحسب بافلوف كلُّ مُثيرٍ استجابةٌ وكلُّ استجابةٍ تطبيقٌ.
فها هو يحيى السَّماوي يحيل المثير العشقي الحسِّي إلى مثير فنِّي صوري تجريدي في هذه اللّوحة التشكيلة الاقتصادية المكثّفة بلغتها الانزياحية ودلالاتها التكثيفية العميقة،وصورها المرئية الحركية الجمالية الفاعلة والمنتمية إلى الطبيعة في صور فعلها اللُّغوي الجمالي بوجه عامٍ والحياتي الإنساني بوجه خاصٍ:
لِحَبيبَةٍ زَانَتْ بِتِبرِ عَفافِهَا
جِيدَ الهُيامْ (25)
في هذه الصورة الشعرية التي تتجلَّى فيها هندسة الشاعر الجمالية، وبراعته المعمارية الإبداعية التي اعتمد فيها على ثنائية المقابلة في التعبير الضدي لصورة الحبيبة المعشوقة الفنيّة التي رسمها لمشاكلة انزياحية فنيِّة بين مثير شكلي لُغوي محسوس هو (التِبرُ)، والذي أضاف دلالته لمثيرٍ دلاليٍ معنويٍ لَمْسِيٍ آخر وهو (العَفَافُ) الذي ساواه في تعبيره بقيمة الذهب الجمالية والمالية. ثُمَّ حرَّك صورة الحبيبة الحركية المرئية، فجعلها هي من تُزَيِّنُ الهُيَامَ بِتِبرِ عفافها، وليست هي من تَتَزينُ بِهُيامِ تِبرِ العفاف، وهنا تكمن المفارقة الإبداعية في جماليات التعبير الصوري، فالمرأة هي التي تُضفي على الجمال جمالاً آخر يُزينهُ.
4 - المَعشُوقَةُ الحِسيَّةُ ذَاتَ الطّابعِ (الآيروتيكِي الرُّوحِي)
وفي قصيدته الافتراضية (قُطُوفٌ لَيسَتْ دَانِيَةً) ذات الطابع القصصي التشعيري السردي الجمالي تتَّحد العلاقة الحميمة بين الشاعر ومعشوقته المرأة اتّحاداً حسيَّاً آيروتيكياً ساخناً تصل نشوته الروحية إلى حدِّ اللَّذة الجسديَّة والإمتاع النفسي في الاغتراف من هذا النهر الأنثوي الذي لا يجفُّ معينه الإمتاعي الحسِّي الجسدي المُتجدِّد. ويبدو أنَّ علاقة التَّناصِّ في هذا العنوان المثير مع السياق الدلالي للجملة القرآنية ( (قُطُوفُهَا دَاِنيَةٌ))، الذي حوَّر فيه الشاعر سياقها الأصلي بما يسند رؤيته الشعرية، فأفرغ حمولتها الدلالية الأصلية (قُطُوفُهَا دَانيَةٌ) وشحنها بحمولةٍ صوريةٍ جديدةٍ بما يخدم المحتوى الدلالي لقصيدته من خلال بنية الفعل الناقص (ليستَ) من الإيجاب الدلالي إلى السلب الدلالي الفكري. ويستمرُّ بتجسيد حسيَّة هذه العلاقة الإنسانية، ليوصلها إلى محطَّة الإرساء النهائي التي تليق بها في شعرية فلسفة علم الجمال.
ومن الطبيعي أنَّ شاعراً مثل السَّماوي يسلك طريقاً مثل هذا الطريق اللَّافت، لا بدَّ أنْ يتولَّهَ بالعشق الجسدي الجمالي جسراً رابطاً بين العَلاقة الحسيَّة المُجَرَّدَةِ، والعَلاقة الرُّوحية المُتَجَرِّدَةِ، لإنتاج جدلية نورانية من التآخي والتواحد العشقي العرفاني، ذي الروح الصوفية المتسامية ليس بمعناها التألهي الديني الصرف المعروف، وإنَّما بمعناها الجمالي الروحي. ويتحوّل السَّماوي بنصوصه الصورية الحسيَّة شكلاً والرُّوحية مضموناً قريباً من شاطئ فلسفة الحلَّاج، وابن عربي الصوفية في مناطق الشعرية العراقية والعربية التي سعى إلى تأسيسها ثقافياً بهذا التشكُّل (الآيروتيكي) التقديسي الجديد لا بغواية (الستربتيز) الإباحي المُدَنِّس لصورة المرأة الجنسية. وسنلحظ في مقاطع هذه القصيدة إيثاراً جمالياً، كيف تعطي شخصية الشاعر المتسامية الشيء الكثير وترضى بالنزر القليل من العطاء الروحي السامي الذي وصفه لحظة الشبق الكيوبيدي الآيروسي المحتدم غوايةً وغلياناً وتَّشهيَّاً، بالفتى الملاك، بماتجود به شعريته:
وَأَطبَقَتِ الضُّلوُعُ عَلَى الضُّلُوعِ
فَفَرَّ ثَغرِي نَحوَ ثَغرِكِ
حَاطِبَاًّ قُبَلَاً
وَفرَّتْ مُقلَتَاكْ
*
وَانْزَاحَ عَن سَاقَيكِ ثُوبُكِ
فاسَتفزتّْ بِيْ مُجُونَاً رُكبَتَاكْ
*
أوشَكتُ أنْ ...
فَإذَا بِشَيطَانِي يَعُودُ فَتَىً
مَلَاكْ (26)
وعلى الرغم من سيطرة الانتشاء الرُّوحي والشعور بلذة الإحساس والمُتْعَة التي يستشعرها نفسياً، فإنَّ الشاعر بهذه الفراغات (البياضية) الدالة على إتمام تقنية الحذف المثيرة، والمسكوت عنها قصديَّاً؛ كونه يمثلُ صمتاً صوتياً صائتاً فاعلاً غير خفيٍ مُضمِرٍ، ولكنْ لكلِّ صمتٍ أو بياضٍ له موجباته وسلبياته. "وهكذا فإذا كان البياض صمتاً، فإنَّ هذا الصمت ليس محايداً، ولا يدُّل على مطلقيّته، إنَّه صمت وارد في سياق شعري، سواء أكان هذا البياض مؤكَّداً، أم مفروضاً من خلال تموقع النصِّ في الصفحة" (27).
ومع كلِّ هذا التشاكل والتباين الصمتي، كان السَّماوي مُدرِكاً وواعياً تماماً لوحدتي الحضور (الزمكاني) الذي يمرُّ به في توحّده العشقي مع الحبيبة. حتَّى تخال كأنه يريد أن يُخبِرَ متلقِّيه بأنَّ شعوره الحسّي قد تغلَّب على لحظات الشعور الإيماني اليقيني الديني؛ بسبب سحر وتأثير وهيمنة هذه الغواية الافتتانيّة المُحتدمة، فوظَّف مُجسِّداً تصوير هذه المشاهد المكتظَّة بالطاقة الشعورية الجنسية، سائلاً ومتسائلاً بعد أنْ تَمَلِّكتَهُ موجات من سُورَةِ الغياب العقلي التي أمضاها منتشياً سكراناً بحقل الأنوثة والندى إلَّا أنَّه أفاق بغتةً من غيبته، فعاد إلى صحوته الإنسانية التي تعيد لهذه المرأة مكانتها الجمالية الحقيقية في الواقع الحياتي المجتمعي المكاني لوجودها عنصراً أنثوياً باعثاً على الجمال في الحياة.
وقد جمع شعرُ السَّماوي في هذه المقطوعة (الآيروتيكية) بين حسيَّة الغواية وروحيَّة الهداية، وبين صورتي الحضور الجسدي والغياب العقلي (اللاوعي)، وسنرى مثل هذا التشكيل الذي اعتمد فيه كثيراً على أنساق نصوص الرموز الدينية كـ (أَذانِ صلاةِ الفجرِ)، ورموز الطبيعة الكونيَّة كأشجار الجنَّة المقدَّسةـ (التَّينُ والتُّفاحُ)، وزهور الطبيعة كـ (زهوِر اللُّوز والفُلِّ والريحانِ)، فضلاًعن غيرها الحقل والوادي:
حَتَّى إِذَا نَادَى الأذَانُ
إِلَى صَلَاةَ الفَجرِ
أغوَانِي نُعاسُكِ بِاِقتِطَافِ
التِّينِ والتُّفَّاحِ
مِن حَقلِ الأُنُوثةِ
وارتِشَافِ نَدى زُهُورِ اللُّوزِ
خَالطَهُ شَذَاكْ
*
فَدَخَلتُ وَادِيكِ البَعِيدِ
وَهَا أنَا ثَمِلُ
فَمَا أَدْرِي
أأسْكَرَنِي رَحِيقُ الفُلِّ وَالرَّيحِانِ
فِي حَقلِ الأُنُوثَةِ ؟
أمْ نَدَاكْ (28)
في تراتيل هذه الترنيمة الصباحية لأذانِ الفجر كأنَّ السَّماوي في محاولاته الآيروتيكيَّة المنتمية لجمال الطبيعة يقترب بلغته فكريَّاً وروحيَّاً وثقافيَّاً في رؤيته الفلسفية والعشقية من فلسفة الصوفي الثائر الحُسين بن منصور الحلَّاج، والشيخ الأكبر مُحيي الدين بن عربي في تضمين قصائدهما الشعرية وتشفيرها بالرموز التي تدلُّ على صفة المعشوق المطلق المتجسِّد في كل شيء، والتي تحمل في طياتها خطاباً شعرياً عشقياً صوفياً ذا أفكارٍ ورؤىً وجوديةٍ عميقةٍ تتخطّى حدود المعجمية الحرفية، والقياسيّة التداولية المألوفة بنهجها ودلالاتها، فيُحوِّل فيه الشاعر الجسد إلى رمزٍ يفيض جماليةً؛ لإضفاء معنى آيروتيكي جديد يأخذ فيه الكثير من الخصائص الأسلوبيَّة والفنيَّة والوجدانيَّة من فلسفة الصوفيَّة. ولنتأمل دلالات رؤيته في تركيباته اللُّغوية المُتفرِّقة في قصيدته (قِدِّيْسَةُ الشَّفتينِ) ذات البناء التركيبي العشقي الصوفي:
فَأنَا بِهَا
المُتَهَجِّدُ .. الضِّلِّيلُ ..
والحُرُّ المُكَبَّلُ بِالهَوَى القِدِّيسِ.. وَالعَبدُ الطَلِيقْ
*
وَأنَا اللَّهِيبُ البَارِدُ النِيرَانِ ..
وَالمَاءُ الَّذِي أَموَاجُهُ
تَغوِي بَسَاتِينَ اللَّذَائِذِ بِالخَرِيفِ
فأنِجدِي حَلَّاجَكِ المَحكُومَ بِالصُّلبِ المُؤَجَّلِ ..
أَنجِدِيهِ عَسَى يَنشَّ السَّعفُ عَنْ صَحنِ الفُّرَاتِ الجُوعَ..
وَالقِندِيلُ فِي دَيجُورِ دِجلَة يَستَفِيقْ (29)
وهذا التماهي العشقي الإنساني الصوفي التضادي يدلِّل على أنَّ الشاعر يحمل وعاء الشعر الروحي، ويمتلئ بفيوض عرفانيته المقدّسة الَّتي ترفع من مكان المحبوب، وأنَّ كلَّ ما يعشقه السَّماوي زماناً ومكاناً، وأرضاً ومدناً ونخلاً ومحبوبةً يتجسَّد حسيَّاً جميعه في ثنائية (المرأة والوطن) الَّتي تَتَبَأْوَرُ وتتصاهر وتتَّحد فيه كل موجودات الشّاعر الَّتي استوطنت منازلها الأولى في علائق روحه، لتلك الثنائية الجدلية المقدَّسة. حتَّى إنَ عشقه للوطن لم يتغير في منفاهِ وَبُعْدِهِ (الزمكاني) وغربته، بل أصبح حُلُمَاً. فَيؤكِّد تلك العلاقة العشقية للوطن في قوله: "إنني خلال وجودي في العراق كنت أحلم بالمنفى، وحين وصلت المنفى بقيت لا أحلم إلَّا بالعراق، فهو وطني ومنفاي في ذات الوقت" (30)،واليوم يحلمُ بأن تكون إغفاءته الأخيرة به. وصار بهذا المنظور رائياً آيروتيكياً ولاقطاً صورياً مهمَّاً،ودليلاً لعين القارئ الثالثة وعقله وعاطفته الذاتية.
فالسَّماوي على الرَّغم من تعشقاته الغزلية المُفرحة بذائقتها الدلالية الجميلة للمتلقِّي، فإنَّ مِسَاحة الألم وظاهرة الحزن الداخلي الشعوري المضمر، بقيت ترافقه في جميع أعماله الشعرية. ويعلِّلُ تلك الظاهرة ظاهرة الحزن اللَّافت البائن على ضفاف الشعرية المغتربة الدكتور عز الدين إسماعيل عند أغلب الشعراء المعاصرين بقوله: "استفاضت نغمة الحزن حتّى صارت ظاهرةً تلفت النظر، بل يمكن أنْ يُقال إنَّ الحزن قد صار محوراً أساسَّياً في معظم ما يكتب الشعراء المعاصرون من قصائد" (31)،فصار مَصدراً لإبداع؟.
5- المَعشُوقَةُ الحِسيّةُ ذَاتَ الطّابعِ (الرَّمزي الأُسطُورِي)
لم تكن المرأة في خطاب السَّماوي الشِّعري ومرجعياته الثقافية المعلنة أو الخفية مرجعاً نسقيَّاً مهمَّاً للحسيّة اللَّمسيَّة في التمتِّع بأعضائها الجسديَّة، أو نسقاً فريداً للغواية الشيطانية الجنسية التي تتغياها معجميةُ الكثيرِ من شعراء الإباحية الذاتية المستهلكة في مقصدياتها القريبة والبعيدة، وإنَّما هي أُنموذج نوعي ليس له شكل حسِّي ثابت، وهي أيضاً ظاهرة أدبية (حسيِّة روحيِّة) لافتة في منظورها الثقافي والاجتماعي، ونسق جمالي فنِّي عميق من إضاءات أسلوب خطابه الذي ينفتح به روحياً نحو أفاق نوافذ التحرُّر الفلسفي من الدَّنس السياقي الفاحش إلى ظاهرة المقدَّس الرُّوحي التي تجعل العلاقة بينه، وبين المعشوقة الأنثى علاقة صدقٍ وانتماءٍ وتَعلُّقٍ رُوحيِ تَتوهَّج به العبارة الشعرية، وتضيء به أجمل معاني الكمال للحبّ في لحنٍ عشقيٍ تسمو جذوته الروحية إلى السماء السابعة، وتضرب أوتار فضائه الحسِّي جذور الأرض مسرح المكانية الشعرية، ومنبع الإبداع الفكري لتلك المعشوقة الأرضية السومرية، رمز التبتُّل في تعلُّق هُيامه الشعري، ونافذة بابه الواسع في مرافئ التلقِّي، كأسطرتها الملحميَّة في هذا النموذج:
هَلْ مَا تَزَالُ السُّومرِيَّةُ تَنسِجُ الأزهَارَ بُسْتَانَاً
وَتفَرِشُ صَدرَهَا لِطُفُولَتِي ؟
وَنَدَى زُهُورِ اللُّوزِ تَجمَعُهُ لِتُطفِئَ بيْ
لَظَى جَمرِ الغَلِيلْ (32)
فالسَّماوي بهذا التكشيل التراثي الأُسطوري، والرُّوحِ الجماليَّةِ الفاعلةِ التي يرسم بها علاقته التعبيرية الفياضة المتسامية بالمرأة "يظلُّ يهفو (بها) أبداً نحو مرافئ النور، ومواكب الثوار، ويستجمع شظايا نفسه، ليرسمَ بها فُسيفساء الجمال في عالم القبح، وَيُرَتِّق بها بسمة الطفل الغرير وسط جنون الكبرياء وجراحات الوطن، إنَّه ساحر الكلمة الذي يَعِدُ الناسَ بولائم العرس الأسطوري" (33) في بنى قصائده الوطنية، وعشقياته المحتشدة بذاكرته الشعرية التي زخرت بتدفقات هذ السمت الشعوري الجمالي العشقي الرُّوحي .
ويتفاعل السَّماوي مع ظلال تلك المعشوقة السومرية بشغفِ الحبيبِ، وَتُهيامِ ومودَّةِ العاشقِ الأسطوري الذي يُحَطِّمُ أفق التوقّع برصانة لغته وبسالة انحراف تعبيره. والذي يتحوّل فيه البناء السردي للعبارة الشعرية المُتوهِّجة إلى بنية خطاب رمزي تاريخي ديني جديد، يتماهى فيه تماهياً فنيَّاً وروحياً مع قُدسيَّة الرَّمز الديني، فيكشف عن أسرارِ العلاقة العشقية الخرافية المُتَأَجِجَةِ في موضوعها الإنساني، وَبُعدِهاِ الأخلاقي الديني والاجتماعي في جملة فريدةٍ من متضادات ثنائية تضيء فضاءات النصِّ بلغتها البلاغية الانزياحية المسربلة صورياً، وتمنحه روحاً جديدةً متحركةً بصورتيه (المرئية واللامرئية) المتحرِّكة رمزياً:
وَتَمُدُّ حَبلَاً مِنْ ضَفَائِرِهَا لِـ"يُوسُفِهَا" الَّذِي
ألقَى بِهِ فِي بِئرِهَا عِشقٌ خُرَافِيٌّ
تّمَاهَى فِيهِ مِحرَاثٌ وَتَنوُّرٌ ..
وَضِلِّيلٌ وَنَاسِكةٌ ..
وَصُبحٌ والأصِيلْ (34)
إذا كانت (زُليخةُ) التاريخ دالة العشق، قد أحبَّت المدلول الرمز الديني (يُوسُفَ) المعشوق حبَّاً جمّاً لِحُسنِ جماله الحسّي الشكلي الفائق، والعالق في سويداء قلوب النسوة قبل عقولهن، فإنَّ زليخةَ السَّماوي بتلةُ العشقِ السومريَّة الأرضية الحقيقية الجديدة لا المُتخيَّلة، عشقته وتَشغَّفتْ بجماله الروحي الضارب في سمادير العشقية النورانية، رغم كونه عاشقاً معنوياً، لا بجماله الفاتن الحسِّي الشكلي المُناقض تضاديَّاً لمفاهيم طقوس الصوفية والعرفانية الروحية بؤرة الآيروتيك الروحي الجمالي ونقطة إضاءته المشِّعة في هذا التضاد الحسِّي النفسي التألُّهي.لأنّ "قيمة التضاد الأسلوبية تكمن في نظام العلاقات، الذي يُقيمه بين العنصرين المتقابلين، وعلى هذا فلن يكون له أيُّ تأثيرٍ ما لم يتداعَ في توالٍ لغويٍّ، وبعبارةٍ أُخرى: فإنَّ عمليات التضاد الأسلوبية تخلق بنيةً، مثلها في ذلك مثل بقية التقابلات المثمرة في اللُّغة" (35) الشعرية.
وتواصلاً وتفاعلاً مع أجواء النصِّ الدلالية، فلا عيبَ في جماليات التعشُّق وأدوات ثقافته الجديدة أنْ يكون العاشق هو (المُحراثُ)مهمازاً مُحرِّكاً،والمعشوقةهي (التَّنورُ)الُمتَحَرِّكُ مصنع العشق،وهو التائه العاشق الملك الضِلِّيل في غياهب الهوى، وهي الناسكة المعبودة، وهو ميلاد الصبح المضيء بأنواره الروحية ظُلمة غروب الأصيل في جدلية الحياة. والمقاربة التي تتضمنها القصيدة ليست مقاربةً فرويديةً جنسيةً.
في ظلِّ المفارقات الشعرية المفاجئة الكثيرة للمتلقِّي القريب والبعيد، يبدو أنَّ ثورة العشق السومرية الجديدة راحت تأكل نفسها بنفسها بقصديةٍ، أو من غير قصديةٍ، وأنَّ رسول العشق (عِشقائيلَ) الحُبِّ باتَ في دائرة الخطر الشعوري. وهذا ما تخبر به القصيدة التي التزم فيها الشاعر بهذا التحوِّل بأهمِّ خاصيَّةٍ من خاصيَّات الشعر العربي القديم، ألا وهي المقدِّمة الغزلية التي تَخيَّلَ فيها مَعشوقةً أو حبيبةً اِفتراضيَّةً وهميةً ينطلق من خلالها بمخيلته الشعرية في بناء قصيدته فنيَّاً وجماليَّاً، ولكن بروحٍ جديدةٍ ونفسٍ ملحميٍ أسطوريٍ يُناسب جلالة الحدث وأهميته. ففي مطلع قصيدته هذه يضع الشاعر تساؤًلا فكرياً عن حياته المتعبة وأرقه الدائم، ويبحث فيه عن مسوغٍ يكونَ جواباً شافياًعن وجعه الذي يُسميه حياةَ اللَّاحياةِ لهُ فيها:
مَا حِيْلَتِي ؟
تَعِبَتْ حَيَاتِي مِنْ حَيَاةِ
اللَّاحَيَاةْ (36)
وبدأً من عتبة النص الشعري الرئيسة (فَقدتْ مَعانيهَا المَعَانِي)،تلك العتبة العنوانية الموازية لموضوعية ثيمة متنِ هذا النصِّ، الدالة على رموز معانيها الحقيقية المقصودة، والَّتي قدَّم فيها المفعول على الفاعل لغرضٍ أُسلوبيٍ جَماليٍ فنِّي. والَّتي نلتمس من خلالها، ونشعر بأنَّ السَّماوي (سادنُ العشق الروحي الأخضر) و (رُبَّانُ سفينة الحسية المائزة) _ حازماً أكان أم جازماً_ قد تَحوَّل بهذا الشعور الصادم بدلالة صراحته، وصدق الاعتراف الكاشف لقيمة الحبِّ من رحلة مدينة العشق الفاضلة المتجِّسدة ـبـ (إينانا) الحقيقية الوجود إلى أُتون مرحلةٍ جديدةٍ رمزيةٍ في فنتازيا المخيال الصوري، تلكَ هي رهلة اللَّاحب (عودة غودو)، طالما أعلنها صريحةً واضحةً في عتبة القصيدة الأولى؛ لأنَّ المعاني قد فقدت معانيها وضاعت في دهاليز غياهب المجهول الذي لا عودة له أبدا إلَا الذاتُ.
وعلى الرغم من أنَّ السّماوي يُصرِّح بها دون مواربةٍ في هذه الثورة العشقية الصادقة؛ فإنَّه باقٍ ثابتٌ على طبعه وسجيته العشقية في رصيف العشق الصوفي الذي أنسنه حركياً في انزياحاته اللُّغوية، وجعله لم يغادر محطَّاته ومرافئه الرُّوحيَّة. إلَا أنَّه عازم على الرحيل إلى ذاته الشعورية التي ترى في طبع المعشوق حركةً ووثوباً قافزاً لا ترى لها مُستقراً أو ثباتًا على خُطَى العِشق الَّذي وضع أسسه ،ورفع سقف وأثَّث بيته الجميل وصان شرفه الضافي الكبير، ولنقرأ ما يقرُّ به الشَّاعر مُصوراً حالته الشعورية وثباته:
بَاقٍ عَلَى طَبْعِي
رَصِيْفَاً لَا يُغَادِرُ دَرْبَهُ
وَمَحَطَّةً لِلعَابِرِينَ ...
وَأَنْتِ طَبْعُكِ كَالخُطَى فِي اللَّا ثّبَاتْ (37)
إذن بعد هذه المكاشفة الأنوية الذاتية، والعلانية والتّحوِّل الصريح إلى درب التباعد والتجافي بديلاًعن عُرى التَّداني والتلاقي والمحبَّة، لم يَعُدْ للمعاني الرُّوحيَّةِ مَعنىً ساميَّاً يُذكر في مُسميَّات العشق وغيره مثل، (العَراقةُ والسِّيادَةُ والنَّزاهة والصَّبابةُ)، فلاعراقةَ للعراقة، ولا سيَّادةَ للسيَّادةِ، ولا نَزاهةَ للنزاهةِ، ولا صبابةَ للصَّبابةِ طالما أخذ كلُّ معنىً من هذه التوصيفات الثنائية الوجودية يحمل نقيضه التضادي بديلاً عنه. وأصبح العشق مُضاربةً تِجاريةً سُوقيةً يُباع فيها الهوى ويُشترى، كالواقع السياسي المتردِّي،لا يعني المكرمات اللافتات إلى إحياء جذوة روح الحبِّ وتجديده بما يتناسب مع فاعلية الحدث الموضوعي:
كلُّ مَعْنَىً صَارَ يَحتَمِلُ الَّنقِيْضَ
كَأَنْ يَكُونُ الذِّئْبُ يَعْنِي الشَّاةَ
والأَرْجَاسُ تَعْنِي المُكْرَمَاتْ (38)
ويلحُّ الشَّاعر السَّماوي في تدففاته الرُّوحية المتناهية على هذه المعاني الجمالية التي فقدت معانيها المعاني الروحية الندية، فهو يرى في قاموسه العشقي أنَّ الأسماء لا قيمة لها عنده تفقُد روحها وعراقتها الأصيلة، وتُصبحُ خارج نطاق المعنى طالما هي محنَّطةٌ ميِّتةٌ تكمن في داخل الذاتِ الشُّعورية المُضمِرَة:
فَالأَسْمَاءُ خَارِج هَيْكَل المَعْنَى
وَدَاخِلَ مُضِمَرَاتِ الذَّاتْ (39)
فالسَّماوي بهذه الثَّورة العشقية المخياليَّة من القطيعة والإنبتات التي فرضتها أبجديات العشق، وأقرَّتها ونواميسه الاجتماعية الجديدة، قد تَساوت لديه علائم الأنوار والظلمُ، وتشابهت عنده كلُ مشاعر المسرَّة والبهجة والكرامة والمَذلة، والحديقة والفَلَاة، ولم يَعُدْ لديهِ خطٌّ رفيعٌ من أمل الرجاء في العودة إلى الزاهي منه القريب، بل على العكس من، فقد اختار طريق (الحقيقةِ) المُرَّة التي غدت سُباتاً لا أثر لديمومة الحبِّ فيه سوى نظرة عيونِ الوِشاة والشامتينَ الحاقدينَ على جلالة هيبةِ الحُبِّ المقدَّس الروحي وصوتهِ العذبِ:
لَا الأَمْسُ سَوفَ يَعُوُد ثَاِنَيةً
وَفَجْرُ غَدِي المُؤَمَّلُ فِي سُبَاتْ
*
مَادَامَ أَنَّكِ لَا تَرِينَ حَقيقَتيَ
إِلاَ بِأَحدَاق الوِشَاةْ (40)
أتمنى أن يكون كلام السَّماوي في هذه التركيبة النصية المتجانسة الدلالة عتابًا ودِيَّاً، ومناجاةً عابرةَ لا جواباً قَطعياً بَاتَّاً.وقد تكون للشاعر أسبابه التعبيريَّة، ومضمراته الخفيَّة في إعلان نبأ إشهار جفوة التَّجافي بدلاً من التَّقارب والمحبَّةِ والتَّلاقي.ولكنْ من المُؤلم جدّاً أنْ يرى الشاعر صورة حقيقته الذاتية الناصعة في المعشوقة تُصبح ملاذاً لأَعيُنِ الأعداء من الشامتينَ والحاقدينَ على ديمومة هذا العشق الفرائدي الجميل. ويبدو أنَّ كَيْلَهُ العِشقِي قد طفح ميزانُهُ، وباتَ شيئاً مؤلماً جدَّاً على السَّماوي أن يُعلنَها صَرخةَ فراقٍ مدويةً، فكلُّ شيءٍ ماضٍ عنده خاسر في رهان معارك حروبه العشقية السابقة واللَّاحقة لا أثرَ جارٍ لنهر الحُبِّ:
لَا نهرُ قَلَبِي سَوْفَ يُنْبِضُهُ الفُرَاقُ
وَلَا وِصَالك سَوفَ يُرْجِعُ مَا فَقَدْتَ مِنِ الغَنَائِمِ
فَي حُرُوبِي الخَاسِرَاتْ (41)
وتَعلو نبرة القطيعة وأمارات الفراق عند يحيى السَّماوي بهذا الواقع المخيالي المؤلم الصريح، فلا أُلفة لصبابات العشق، وصور الهيُام الرَّوحي بعد أن كانا مفازنينِ مُقفرتين من التقارب والتحابب والتوادُّد، والهلكة والنجاة، يلتقيانِ رُوحينِ كماء (دجلة العذب والفرات)، ويا له من شعور قاسٍ بالتغرُّب والتَّنَكُّر:
بَتُّ الغَرِيْبَ عَلَيَّ ...
أَبْصُرُنِي _فَأسْأَلْ مَنْ أَكُونُ _ النَّهْرَ وَالمَرآةَ
كُنْتِ مَلَامِحِي
وَالَيومَ بُسْتَانِي بِلَا شَجَرٍ
وَأَنْهَارِي الجَدِيْدَةُ مِثْلَ بَادِيَةِ السَّمَاوَةِ
لَا صِفَاتْ (42)
ثُمَّ يصرخ الشاعر متعالياً الصوت من ألم الجراح، وخيبة العمر الذي خَسِرَ مودةَ العشق فاستراح، حتى ليغدو السُّندباد السومري العشقي الجديد الذي يبحث في يمَّ حفرياته السفرية المتلاطمة عن ذاته الوجودية الغائبه المتغيِّبة، فينشر أشرعة السلام والأمان، ويتَّخذ من الصخرة الصماء طوقاً آمناً للنَّجاة:
وّأَنَا غَدَوتُ السُّنْدَبَادَ السَّومَرِيَّ
نَشَرْتْ أَشْرِعَتِي لَأَبْحُرَ بَاحِثَاً عَنِّي
بنيتُ سَفَينَتِي مِمَّا تَبَقَّى مِنْ رَمَادِي
واتَّخَذَتْ الصَّخَرَ طُوْقَاً للنَّجَاةْ (43)
6- المَعشُوقَةُ الحِسيَّةُ المُرتبطَةُ بِجَمالِ الطَّبيعةِ
وهكذا تبدو المرأة في عشقيات السَّماوي ومتضاداته الحسيَّة انعطافاً روحياً باذخاً من رؤى التقديس والتبجيل والتكريم، وتكشف بوضوحٍ تامٍ عن استعارات سير تحوِّلاتها المتعدَّدة، فتبدو رمزاً للعفَّة والرحمة والمودَّة والمسكنة، وتُصبِحُ هالةً للحبِّ والجمال،حتَّى تغدو بستاناً وارفَ الظَّلال من ثمرات الحبّ، ونسقاً دلالياً للعطاء الروحي والجسدي الدافع لاستمرارية الحياة في ارتباطها بجمال الطبيعة، وبألوانها وأشكالها ومفرداتها الوجودية المؤثِّرة ببواعث الإنسان من ماء وشجرٍ وبستانٍ ولوزٍ وكرومٍ وزهورٍ وزنابق وحضور:
جِئتُ بُستَانَكِ شَحَّاذَاً
فَمِي صَحنِي
هِبِينِي مِن كُرُومِ الثَّغرِ
عًنقُودَاً مِنَ اللَّثمِ
فإنِّي أستَحِقُ الصَّدَقَةْ
*
وَامنَحِينِي
شَمَّةً مِن عِطرِ زَهرِ اللُّوزِ فِي وَادِيكِ
إنِّي ظَاِمئٌ
يَكفِي غَلِيلِي مِنكِ شَمُّ الزَّنبَقةْ (44)
إنَّ الحال المقامي لواقعة الحدث المكانية يُخبرُ أنَّ مجيء الشاعر وهيأته، باسطاً لفراش الطَّاعة الكبرى التسليم والانقياد، وراكعاً بهذه الصورة الاستجدائية والتوسُّل، شحاذاً لبستان الحبيبة، وطالباً عنقوداً من كروم اللَّثم، ومنحةَ شمَّةِ ظمأٍ من عطر زهر اللَّوز شفاءً لغليله من تلك الزنبقة التي تُعيد له رماد الحياة الطافي، ما هي إلَّا نوع من القبول الاضطهاد النفسي، وإشارة سلبية واضحة من المازوشية الذليلة التي يمنحها الشاعر في العشقية للمرأة المعشوقة باغتصابه والنيل من حقوقه من غير وعي أو علمٍ بها؛ ولكنَّها في الحقيقة مازوشية قبولِ الأمر بحبٍّ وتقبُّله على أنَّه طريق من طرائق الحبِّ وسمةٌ لأحياء ذاته.
7- المَعشُوقَةُ الحِسيَّةُ المُرتَبِطةُ بِحُبِّ الوَطنِ
المرأة في أشعار السَّماوي هي مركز النواة الرئيسة للحبِّ، بل هي المُحرٍّك العصبي الذي يُغذِّي بنية نصوصه التعبيرية بأشكال الجمال، وهي في الوقت ذاته المحور الفنِّي الذي تدور حوله موضوعات نتاجاته الشعرية. وهي الصورة المثلى من صور الانعكاس المرآتي المتمثِّل بظلِّ الوطن، من حيثُ علائق التماثل القائم على أساس الحبِّ بين (الوطنِ والمرأةِ)، فهو العاشق الهائم الولهان بعشق الوطن والمرأة معاً.
والقصيدة عند السَّماوي على الرغم من أنَّها مُترعة بالغنائية الباذخة وحضور الذات الشعرية، وشعور عارم بالألم والعذاب المضني للروح والذات، وهيمنتها على معظم قصائده الشعرية تقترب في موضوعيتها الفنيَّة أنْ تكون كائناً تفاعلياً محايداً، متحرِّكاً مُتحوِّلاً في قصِّ شعريتها السَّردية الجميلة ،حتَّى تستحيل عنده رُوحاً وطنيةً، ثُمَّ تصبح الوطنية لديه صورةً للمرأةً، وتُصبح المرأة عنده وطناً معشوقاً حدِّ الثمالة، فهما وجهان لعملةٍ واحدةٍ، هي بالتأكيد أيقونة الحبِّ بكل تجلِّياته وأسمى وشائجه وفروعه الإنسانية الرائدة.
وقد انعكست تأثيرات هذا الدرب الشائق العذب على نفسية الشاعر القلقة المتأزِّمة، فاتَّخذ المرأة بكامل تجلِّياتها الثقافية والاجتماعية وطناً (جنَّةً) يسكنُ فيهِ جسداً، وبيتاً يعشق فيه روحاً، فهو يرى في إحدى مقابلاته الصحفية الثقافية أنَّ (الجَنَّةَ تَبدأُ مِنَ الوَطَنِ) (45). إذن (الوطن+المرأة) يشكّلان (آيروتيكا) هاجسِ لغةِ الرمزِ والصورةِ. والسَّماوي يجعل من هذا الاتّحاد الجسدي الروحي لكليهما مطابقةً لمضمون سُنَنِ الأرض، واصلاً في نشيده الشعري حركية القفز والتحوّل من نجيع الدم والقتل ووسائل، التهميش والتعذيب والمعاناة إلى روضة الحبِّ وجِنان الجمال وأفياء الأمان والوئام بهذه السعادة العشقية غير الدائمة.
فيطلق العنان إلى جماح عنانه الشعري، فَيثُورُ هيجانُ اللَّبيدو المكبوت، وينطلق الممنوع المسكوت ثائراً منتفضاً، فيمارس الشاعر جدلية اغتصاب الحبِّ لتفعيل فاعلية الحياة للمرأة المعشوقة، وتحدِّي شبح الموت الذي يطارده زمكانياً،يؤكِّد لقارئه ومتلقِّيه أنَّ الشاعر إنسانٌ عاديٌ،لكنَّه كائن فريد اجتماعي خلَّاقٌ متجدِّد في الحياة، بل هو الطاقة الإيجابية الخلَّاقة في استمرارية فعل الحياة، فيتمرَّد على حركية قيود الزمن العصيب، ويكسر وقع رتابة جدار النمط الحياتي حين يخترق تداولية القياسي المعتاد عليه باللَّافت الروحي الإدهاشي. ليرسم صورة الوطن الشعبوية من خلال هذا التماثل والتعالق الروحي العجيب بالمرأة التي هي ذخيرته الروحية والنفسية المحسوسة التي يطلُّ من كُوَّةِ نافذتها البصرية والحُلُمية الصغيرة نحو واقع الحياة بالأمل والألم واللَّذة، والحبِّ والبغض والشتات،والحنان والحرمان والجفاف،رغم احتراقاته الكثيرة وموته البطيء. وقد مثَّل الشاعر السَّماوي لنموذج المرأة المرتبط عشقها بحبِّ الوطن وعناصر الطبيعة الزاخرة بالماء والخضرة والتَّنُّور والياقوت ورماد الاحتراق، ومثَّل لها تمثيلاً جامعاً لعناصر الطبيعة الأُمِّ:
وَطَنِي سَلِيمٌ مِثلُ قَلبِكِ
غَيرَ أنَّ وَلِيَّ خَيمَتِهِ
مُعَاقْ
*
لَا عَيبَ فِي البُستَانِ
لَكِنْ
حَارِسُ البُستَانِ عَاقْ
*
فَلْتَسْجُرِي التَّنُورَ يَا مَائيَةَ اليَاقُوتِ
وَاحتَطِبِي ضُلُوعِي
وَابعَثينِي مِن رَمَادِ الاحتِرَاقْ (46)
فالشاعر هنا يُقيم وشائج عَلاقة حبٍّ بين الوطن الأمِّ ممثلاً بدلالة قوله: (وطني)، وبين الحبيبة المعشوقة بدلالة ضمير المخاطب الكاف في (قلبِكِ)، فيجعل من الوطن خيمةً كبرى، لكنَّ متولِّيَ أمرِها وراعيها عاجز مشلول مُعاق، ثُمّ يستدرك على هذا الوطن الجريح، فينفي عنه العيب الذي لحقَ بهِ ظُلماً وتعسفاً، بسبب راعيه وحاكمه، فيجعله بستاناً رامزاً للخير، لكنَّ حارسه الرئيس عاقٌ، وغير قادر على ديمومة واستمرار تجدُّد الحياة. فيطلب من معشوقته (مائيَّةِ الياقوتِ) رمز الحبِّ والحياة والجمال من خلال توظيف لام الأمر في فعل الحالية والمشاركة الحركية (فَلتَسجُرِي)،أن تغذَّ وتشرع بتسجير وإشعال التنُّور رمز ديمومة الإطعام الشعبي، لتستمرَ حركية الحياة، ثُمَّ يجعل من ضلوعه حطباً لأَوَارِ نارِها، كي ينبعث حياةً متجدِّدةً من بقايا رماد الاحتراق.غير أنَّ خاتمة هذه الدفقة الانبعاثية تتماهى صورتها الفنيَّة والجمالية موضوعياً مع قصة سيِّدنا إبراهيم في سورة الأنبياء الآية (69) حين جعل نار الله احتراقه برداً وسلاماً عليه في قول عزِّ القائل: (يَا ناَرُ كُونِي بَردَاً وَسَلاماً عَلَى إَبراهِيمَ، وَأَرادُوا بِهِ كَيدَاً فَجعلناهُمٌ الأَخْسَرِيْنَ).
***
" يتبع "
د . جَبَّار مَاجِد البَهادِلي
.......................
* من كتاب بنفس العنوان سيصدر قريبا