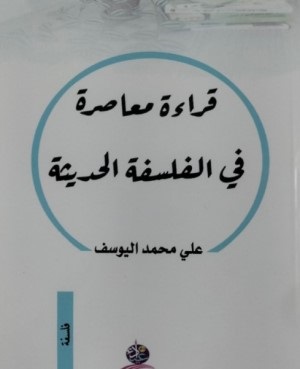شهادات ومذكرات
جمال العتابي: الصحفي محمود الجندي (أبو لينين)

ينتمي الصحفي محمود الجندي لجيل رواد الصحافة العراقية، جيل أسهم في إرساء التقاليد المهنية للصحافة، في المؤتمر الأول لنقابة الصحفيين في العراق المنعقد في 23 حزيران 1959، فاز الجندي بعضوية الهيأة الادارية للنقابة التي ترأسها الجواهري، ومحمد السعدون نائباً له، وضمت الى جانب الجندي كلاً من: جلال الطالباني، عبد الرحيم شريف، لطفي بكر صدقي، فاضل مهدي، محمود شوكت، قاسم حمودي، وفائق بطي ومنعم الجادر أعضاءً في لجنة الضبط.
لم يدرس محمود الجندي في معهد متخصص في الصحافة، ولم يكمل دراسته الأولية، انما بدأ حياته عاملاً في المطابع بصفة (مرتب للحروف)، مرّن نفسه على هذه المهنة، وتفتح وعيه مبكراً، عاش مفعماً بأجواء التحولات السياسية الكبرى في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، فتأثر بأفكار اليسار، يسمعها من أؤلئك الذين يتحدثون بها في المطابع والجرائد، أو من خلال الكتابات البسيطة التي قرأها، كان يلتقط الصور المثلى فيها، ويتعلم بصبر وحذر وخوف، كان يحلم ان كنزاً غالياً يزيده اقتراباً من مبتغاه في سماء شاسعة لا تحدها حدود. فتجاوز المألوف ليسمي نجله البكر (لينين)، وحين حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، نهاية الأربعينات بتهمة الانتماء الى الحزب الشيوعي مع عدد من عمال المطابع، قادوه مكبلاً إليه، توقف قليلا عند باب الزنزانة، نظر الى فوق وأطلق عبارته بألم: (عساها أبّخْتَك لينين) .
عاد الجندي من جديد (بعد أن أنهى محكوميته) مستأنفاً عمله في المطابع التي يقع أغلبها في منطقة (جديد حسن باشا)، حينذاك كان يرتب جريدة (الشباب) التي يديرها الصحفيان سليم طه التكريتي وسعيد السامرائي، في إحد حكاياته التى رواها لنا، يذكر: انه كان ينصت في المقهى الى رجلٍ ما يتحدث عن علاقته بنوري السعيد، متهماً الأخير وزاعماً ان شكوكاً تكتنف سلوكه الشخصي في فترة شبابه.
سرعان ماتلقف الجندي تلك الحكاية المزعومة وصاغ منها موضوعاً عرضه على التكريتي المعارض لسياسة نوري السعيد، فدفعه الى المطبعة.
في اليوم التالي لصدور الجريدة، داهم رجال الشعبة الخاصة (الشرطة السرية) المطبعة، واقتادوا محمود الجندي بملابس العمل في سيارة جيب، عبرت الجسر القديم (الشهداء)، يتابع الجندي القول: واذا بي أمام دار نوري السعيد في كرادة مريم، بعد ذلك، اصطحبني شرطي الحراسة الى الصالة، جلست قليلاً، ثم نهضت للوقوف بعد دخول الباشا الى الصالة بالبيجاما، سألني: أنت اسمك محمود الجندي، أجبت نعم باشا.
- كم عمرك؟
- عشرون سنة باشا. ردّ علي ضاحكاً:
- يعني انت ما جاي للدنيا وآني صديق اللي ما عندهم أخلاق، شلون عرفت؟ وكتبت؟
- سمعتها باشا من شخص جالس في المقهى!
- لازم كنت دايخ من أول الليل!! حاولت أن أعتذر فمدّ يده في جيبه وأعطاني ربع دينار، ثم أردفه بدرهم أجرة العودة الى العمل.
بعد أن طوى الجندي الثمانين من عمره، كان يمنّي نفسه ان يعيش حياته كلها من جديد، والاستمرار فيها، وكأنه مازال شاباً، تغمره المتعة وهو يستعرض مسيرة الأحداث التي عاشها وقد حملته بالمزيد من التجارب، هي جزء من كيانه ووجوده، لكنها تاريخ العراق الحافل بالصراعات والانقلابات، والمفاجآت السياسية التي أجبرته أن يتنازل عن (لينين) اسماً لنجله بعد انقلاب 8 شباط 63، ليكنى بعدها بـ(أبو فؤاد).
كنت ألتقيه بين الحين والآخر لغاية أواسط الثمانينات من القرن المنصرم، وقد وهن جسده النحيل، واجتاحته أمراض الشيخوخة، وتقوست قامته، وحفر الزمن تجاعيد عميقة في وجهه، إلا انه ظل يقاوم بالانكباب المتواصل على التدخين، وتحكي جيوب بدلته المتهدلة على الكتفين معاناة عاشها، وإن تركت آثارها واضحة في حياته إلا انها لم تشطب على أحلامه الضائعة .
لم تنتفخ جيوب الجندي بالمال قط، انما كانت جميعاً معبأة بالمقالات، يوزعها هنا وهناك، على الصحف والمجلات (حسب المقاسات)، لقد عاش أعوامه الأخيرة فقيراّ، الا انه كان يحمل من صفاء الروح والعقل، ووضوح الموقف، هي عدّته ومادّته، تفرّد بكفاحه مع الحياة، فحافظ على نقاء السريرة وخياره الحر الذي كابد ليبقى.
من المؤسف حقاً أن لا أثر لمحمود الجندي، لقد طواه النسيان، لا صورة واحدة له في هذا الفضاء الافتراضي، لا وثيقة، ولا سجل، كل تاريخك يا محمود مكتوب في لوح سماوي، فاهنأ هناك !
لكن عهدي بالأصدقاء الاساتذة باسم عبد الحميد حمودي، وزيد الحلي، وليث الحمداني، وربما علي حسين، كذلك الصديق النقابي فاضل البدراوي، أن يسعفوا ذاكرتي في التصويب أو الاضافة، هي دعوة مخلصة للأصدقاء المهتمين بالذاكرة الصحفية، الاسهام في احياء هذا التراث.
***
د. جمال العتابي