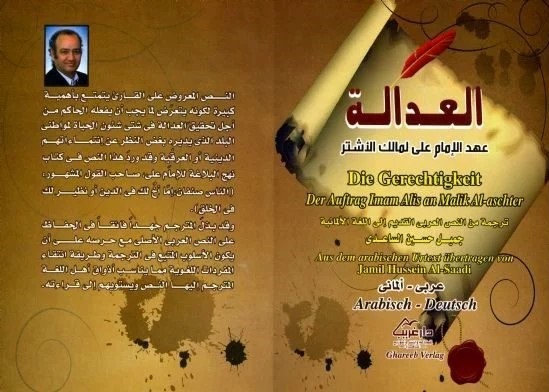قضايا
من الخلافة الراشدة إلي الآداب السلطانية (1)
 كانت الحياة الاجتماعية للعرب قبل الاسلام قائمة على النظام القبلى؛ حيث تعتبر القبيلة هى الوحدة السياسية عند العرب فى الجاهلية، وتتكون من جماعة الناس الذين ينتمون إلي أصل واحد مشترك تجمعهم وحدة الجماعة، وتربطهم رابطة العصبية للأهل والعشيرة، وهو شعور التماسك، والتضامن، والاندماج بينهم . وكان المجتمع العربى فى الجاهلية مقسمًا من الناحية السياسية، إلى وحدات سياسية متعددة قائمة بذاتها تمثلها القبائل المختلفة، وكانت القبيلة فى البادية دولة صغيرة تنطبق عليها مقومات الدولة باستثناء الأرض الثابتة التى تحدد منطقة نفوذها؛ حيث لم تكن لهم أوطان ثابتة بسبب كثرة تنقلهم الدائم حول مصادر الماء والعشب، وبسبب اعتماد القبائل على العصبية، فكانت تظل محتفظة بقوتها طالما كانت محتفظة ببداوتها. علاوة على أن قبائل العرب لم يتفاعلوا ولم يخضعوا للنظام السياسي، لا عند الفرس، ولا عند الروم .
كانت الحياة الاجتماعية للعرب قبل الاسلام قائمة على النظام القبلى؛ حيث تعتبر القبيلة هى الوحدة السياسية عند العرب فى الجاهلية، وتتكون من جماعة الناس الذين ينتمون إلي أصل واحد مشترك تجمعهم وحدة الجماعة، وتربطهم رابطة العصبية للأهل والعشيرة، وهو شعور التماسك، والتضامن، والاندماج بينهم . وكان المجتمع العربى فى الجاهلية مقسمًا من الناحية السياسية، إلى وحدات سياسية متعددة قائمة بذاتها تمثلها القبائل المختلفة، وكانت القبيلة فى البادية دولة صغيرة تنطبق عليها مقومات الدولة باستثناء الأرض الثابتة التى تحدد منطقة نفوذها؛ حيث لم تكن لهم أوطان ثابتة بسبب كثرة تنقلهم الدائم حول مصادر الماء والعشب، وبسبب اعتماد القبائل على العصبية، فكانت تظل محتفظة بقوتها طالما كانت محتفظة ببداوتها. علاوة على أن قبائل العرب لم يتفاعلوا ولم يخضعوا للنظام السياسي، لا عند الفرس، ولا عند الروم .
ولَمَّا جاء الإسلام بدأت مسيرة الدولة الإسلامية السياسية والمؤسساتية. وكان الشغل الشاغل للرسول (صلى الله عليه وسلم)، والصحابة (رضوان الله عليهم)، يكمن في نشر الدعوة وإرساء قواعدها، والتمكين للدين الجديد، لأن يستقر في قلوب المؤمنين، وهنا أكد الرسول أنه لا بد مع الدعوة من عمل، ولا بد مع التشريع من تنفيذ، ولا بد مع العلم من تطبيق؛ فشرع الرسول وأصحابه، في القيام بإبرام المعاهدات، وتنظيم العلاقات الاجتماعية، وصياغة القوانين، والأحكام المستمدة من القرآن كما كان يعمل على تنفيذها.
وفي عهد الخليفة "عمر بن الخطاب"، اتسعت رُقعةُ العالم الإسلامى، بفتح بلاد فارس والروم، وتعدَّدت مواردُ بيت المال، وتنوَّعت ظروف الأمم فيها، وضع" عمر بن الخطاب" نظامًا واستحدث ديواني العطاء والجند، وأصبح هذا النظام في البلاد المفتوحة أساسًا، لِمَن جاء بعده من أئمة الفقهاء في شؤون الجهاد، ومعاملة أهل الذِّمَّة، والخَراج والعُشْر والجِزية.
وفي عام (23هـ) قتل "عمر بن الخطاب" على يد "أبي لؤلؤة المجوسي"، ولترمز نهاية "عمر" بأن هناك أجناسًا وألوانًا جديدة، أصبحت فاعلة في مسار الحكم فى الدولة الإسلامية. وفى أثناء، احتضار "عمر" رشح ستة من الصحابة ليكون منهم خليفة المسلمين، وهم : "عثمان بن عفان "، و"على بن أبي طالب "، و"عبد الرحمن بن عوف"، و"سعد بن أبي وقاص "، و"طلحة بن عبيد الله"، و"الزبير يبن العوام"، وقد استقر الأمر على اختيار " عثمان بن عفان "، وقد عادت العشيرة والقبيلة لتطل برأسها في عهد سيدنا "عثمان"، بسبب قوة وشوكة بني أمية.
وحين بدأت الدولة الأموية حكمها على يد " معاوية بن أبي سفيان "(41-60هـ) تحولت الخلافة إلي مُلك عضود، ووراثة لأمور الحكم في عائلة واحدة، وكان "معاوية" متأثرًا في ذلك بالنظام الذي كان سائدًا في الدولتين البيزنطية والساسانية؛ وسار في تحقيق هذه السياسة بمنتهى المهارة. ولاشك أن تحول الخلافة إلى ملك على يد معاوية والأمويين، جعل منصب الخلافة الإسلامية سياسيًا أكثر من كونه دينيًا، وأن الدولة الأموية وظفت كل ما في جعبتها لاستمرار الخلافة أو الملك في أسرتها، فقامت بتوظيف الدين، والقبيلة، والسيف في استمرار وجودها.
ومع تحول نمط الحكم في الإسلام من الخلافة الراشدة إلى الملك العضُود، كان العديد من خلفاء بني أمية؛ وبخاصة "معاوية" يطلعون على تاريخ ملوك العجم، ويقتدون بسيرهم في الممارسات السياسية، ثم قام بعض الكتاب من الموالي والعجم، بنقل التجربة الفارسية في الحكم، في أواخر عهد الدولة الأموية على يد"عبد الحميد الكاتب"(ت:132هـ)، و"سالم مولى أبي العلاء"، وذلك فيما يعرف بـ"مرايا الأمراء"، أو "نصائح الملوك".
وقامت الدولة العباسية، وكان للفـــرس في قيامها تأثيــر جلي، وبدأت الترجمة على أشدِّها للانتفاع من ثقافة الفرس، والهند، والإغريق الذين سبقوا العربَ في دورهم الحضاري، ولازمت هذه الترجمة، في خط متوازٍ، وحركة تدوين العلوم المختلفة، وأصبحت الدولة تحتاج إلي نظام سياسي وإداري، واقتصادي وعسكري يَحكُمها، ويُدير شؤونها.
وفي أوَّل نشأة الدولة العباسيَّة لم يكن الفقه الإسلامي قد نضج وتكامل، ولم تكن قواعدُ القضاء قد أخذت وضعها من الاستقرار والوضوح، وفي هذه الحقبة نلْقى "عبد الله بن المقفع" (ت:142 هـ/759م)، الذي لم تفته هذه الفوضى التي عمَّت الدولةَ الناشئة في الجند، والقضاء، والخراج، وسوء صحبة الخلفاء من وزراء وعمَّال، فكتب إلي الخليفة "أبي جعفر المنصور" في هذه الموضوعات بأسلوب أدبي قشيب، وكان متأثِّرًا فيما كتب بالثقافة الفارسية.
واستطاع "ابن المقفع" أن يقنع المتلقي العربي (قارئًا وناقدًا) أنه أديب مهمته توليد المعاني الجميلة في قالب بلاغي أجمل لكنه كان، في حقيقة الأمر، يعمل على ترجمة القيم الكسروية والترويج لها في كتب عديدة بأسلوب عربي واضح وسلس، اعتبره بعضهم أنموذجًا في الكتابة، مما كرسه عبر الأجيال مرجعًا في أدب النفس واللسان. ولإدراك البعد الاستراتيجي لمشروع "ابن المقفع"، لابد من معرفة القضايا التي أثارها بأسلوبه الأدبي التمويهي؛ وهي قضايا ترتبط جوهريًا بموضوع الدولة (السلطان)، مما يجعلنا نشك في البعد الجمإلي الذي تقترحه كتابات" ابن المقفع" كما يؤكد بعض الباحثين.
لقد كان الموضوع الذي انكب عليه " ابن المقفع" وحصر جهده فيه هو الأدب؛ وبالتحديد "الآداب السلطانية"، وتدور حول ثلاثة محاور: طاعة السلطان، أخلاق السلطان، أخلاق الكاتب. وهذا التركيز على السلطان، من حيث التأكيد على طاعته ورسم حدود أخلاقه في علاقة بالكاتب، يؤكد أن "ابن المقفع" كان ينظر لوظيفته من زاويتين:
1- من الزاوية الأولى، عمل على توظيف الأدب لتحصيل السلطة، ولذلك كان "ابن المقفع" يقوم بدور الخبير للدولة الجديدة، دور المفتي في شؤون الإدارة والحكم، وكان من الطبيعي أن تكون فتواه عبارة عن إيجاد السبل لتطبيق القيم الكسروية.
2- من الزاوية الثانية، عمل على تغيير الدولة من خلال تغيير السلطان، فقد كان تركيز "ابن المقفع" على السلطان خطة محبوكة لمحاولة تغيير الدولة، من فوق، لأنه كان على وعي بما يتطلبه التغيير من القاعدة من وقت لم يكن بإمكان "ابن المقفع" انتظاره، لأنه كان يفكر في الانتقال إلي الخطة الثانية، وهي إطباق السيطرة على الدولة من طرف العامل الفارسي، ومن ثم إعادة إحياء الإمبراطورية الساسانية، بما تجسده من قيم فكرية وسياسية، في قالب إسلامي.
ويُعد العهد العباسي أنشط العهود في " الآداب السلطانية" ؛ حيث تنامت وتطورت تلك الآداب في منتصف القرن الثاني الهجري على يد مجموعة من كتبة الدواوين، والذين ينتمون إلي ثقافات قديمة سابقة على الإسلام؛ وبخاصة الثقافة الفارسية، حيث كانت "مرايا الأمراء" ، أو "نصائح الملوك"، أو "الآداب السلطانية" تقع ضمن الموروث الثقافي الذي ورثه الإسلام من موروثات الثقافات القديمة للبلاد التي قام المسلمون بفتحها، وهى عبارة عن مجموعة من النصائح والقيم التي تتعلق بالتدبير السياسي، وتقدم إلي الملوك والأمراء، ويتحدد فيها العلاقة بين أطراف المعادلة في نظام الحكم" .
وكانت " الآداب السلطانية" قد اعتمدت على نصوص أولى مؤسسة، مثل عهد "أردشير"، ورسائل "عبد الحميد بن يحيى الكاتب" وأعمال "ابن المقفع"، وأعمال "أرسطو" المنحولة، مثل رسالة "سر الأسرار"، ثم بعد ذلك أُعيد إنتاج معظم هذه النصوص في كل أعمال الآداب السلطانية على مدار التاريخ الإسلامي، ولقد انتحلت هذه النصوص بعضها بعضاً، حيث انتحل المتأخر المتقدم، ولذا بدت نصوص الآداب السلطانية لدى البعض بأنها: نصوص لا تنمو، ولا تغتني ولا تتطور، صحيح أنها كتبت في أزمنة مختلفة، ووجهت إلى ملوك وأمراء من عصبيات ودول مختلفة، وأن الذين أنجزوها لم يكونوا كلهم مجرد كُتاب، فمنهم القضاة، والمؤرخون، والفقهاء، والآدباء، والملوك، والوزراء، ومع ذلك ظلت النصوص تتناسل مستعيدة مضموناً معيناً، ووجهة محددة دون أن تتغير ؛ فهي تقوم في أساسها على مبدأ "نصيحة أولي الأمر" في تدبير شؤون سلطتهم معتمدة تصورًا براجماتيًا للمجال السياسي، مذوبة لكل تعارض محتمل بين الشرع والسلطان، ما يجعل منها فكرًا سياسيًا لا يطمح إلي التنظير بقدر ما يعتمد التجربة، ولا يتوق إلى الشمولية بقدر ما يلزم حدود الواقع السلطاني، وما يجعل الآداب السلطانية ثقافة سياسية مميزة فيما عرفته الرقعة العربية الإسلامية من ثقافات، وعلى وجه الخصوص الثقافة السياسية الفلسفية، والثقافة السياسية الشرعية.
وحين نصل إلى منتصف القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)، وكانت كُتُب الفقه والحديث قد نَضِجت واكتملت، نَلْقى كتبًا تعدُّ من كتب الفكر السياسي الإسلامي، وانتقَينا منها - بعد ابن المقفع - القمَّة الثانية، وهو ابن قُتَيبة الدِّينوري، (ت: 276 هـ/889م) واضع الكتاب المشهور "عيون الأخبار"، وقد قسمه على عشرة أبواب، أوَّلها باب السلطان، وثانيها باب الحَرْب، وهما من صميم هذا العلم. ويعتبر كتاب (عيون الأخبار) لابن قتيبة مرجعًا أساسيًا في الآداب السلطانية؛ حيث لخص فيه مجمل قضايا الفكر السلطاني، التي طرحها ابن المقفع، والتي تتمركز حول مفهوم السلطان، هذا المفهوم الذي استمد حضوره من الامتداد الفكري الفارسي، بطابعه الاستبدادي، أكثر مما ارتبط بالموروث السياسي العربي- الإسلامي. ورغم أن الكتاب، في جملته، ذو مظهر عربي - إسلامي، والقيم التي يعرضها ويحتج لها، لا تتعارض إجمالًا، مع القيم العربية الإسلامية، على الرغم من هذه الأصالة الشكلية، فإن ما يحسم في أمر انتماء هذا الكتاب هو بنيته وليس مظهره، ذلك أن القيمة المركزية فيه هي نفسها القيمة المركزية في الموروث الفارسي؛ أعني "السلطان" وبالتالي "الطاعة" وهي قيمة يخلو منها الموروث العربي الإسلامي، ليس بوصفها قيمة مركزية فحسب، بل يخلو منها حتى بوصفها قيمة مستقلة قائمة بذاتها.
ولقد كانت أفكارًا ابن قتيبة لها مفعول السحر على معاصره "ابن أبي الربيع " (ت:227هـ-842م)، وذلك من كتابه " سلوك المالك في تدبير الممالك"، وكان قد أهداه ابن أبي الربيع إلي الخليفة المعتصم في أوائل القرن الثالث الهجري ليسجل لنا خصائص الفكر السياسي الإسلامي المتداول خلال فترة النصف الأول من القرن الثالث الهجري وأواخر العصر العباسي الأول .
ويضم كتاب ابن أبي الربيع أفكار فلسفية - سياسية مهمة، يتفق فيها ابن أبي الربيع مع علماء عصره وغيرهم من العرب المسلمين أو من غير العرب، من أن الإنسان اجتماعي بطبعه، وأنه لا يكفي الواحد منهم بالأشياء كلها. ثم ينتهي إلى حقيقة مهمة في الفلسفة السياسية قائلاً: " فقد تبين مما ذكرنا أن الناس مضطرون إلى تدبير وسياسة وأمر ونهي، وإن المتولين لذلك ينبغي أن يكونوا أفاضلهم".
ثم يتطرق ابن أبي الربيع إلي موضوعات سياسية لا تقل أهمية عما قاله الغربيون المعاصرون، إذ يقول: إن أركان الدولة هي أربعة، ويودعها المهام القضائية، والتنفيذية، والأجهزة التي تشكل كيان الدولة فيما يبقى الخليفة والشريعة مصدراً وحيداً للتشريع: الملك (الرئيس)- الرعية (الشعب)- العدل (مبدأ العدل وأجهزة العدالة)- التدبير (السلطات التنفيذية).
ويركز ابن أبي الربيع على ضرورة أن يكون الملك أو الرئيس حكيماً عالماً، ويضع ذلك في المرتبة الأولى من صفات الملك، إذ يقول: "أن يكون له قدرة على جودة التخيل" ولكنه من جهة أخرى يؤكد على قدسية مكانة الملك بقوله: "إن الله هو ينصب الحكام" ثم يقول في مكان ثالث وبوضوح أكبر: "إن الله جل جلاله لما خص الملوك بكرامته ومكن لهم في بلاده ودخولهم عبادة أوجب على علمائهم تبجيلهم وتعظيمهم وتوقيرهم، كما أوجب عليهم طاعته" .
فهو إذن يقبل النظام الملكي الوراثي، إذ يشترط في الملك أن يكون من أهل البيت المالك، قريب النسب ممن ملك قبله، وحسب الاتفاق(ولي العهد) ولكن ابن أبي الربيع يبقى السؤال حائراً، ماذا وكيف مع الملك أو السلطان الجائر..؟ وأقصى ما يقبله ابن أبي الربيع، هو أن يتجه العلماء إلى الملك بالنصح والإرشاد و" تزين العدل وتقبيح الجور واستهجانه" ولكن على الرعية الطاعة في جميع الأحوال.
وهنا يلتقي "ابن أبي الربيع " مع الأدبيات السلطانية، ليس فقط في مجال المماثلة بين الإله، أو السبب الأول، وبين الخليفة، أو رئيس المدينة الفاضلة، وهي المماثلة التي سادت الخيال الديني والسياسي في العصر العباسي، والمنقولة من الموروث الفارسي... وللحديث بقية !
د. محمود محمد علي
رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط