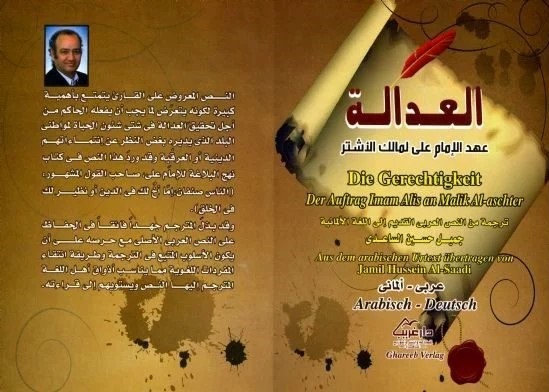قراءة في كتاب
محمود محمد علي: الإسلام السياسي وإشكالية الحاكمية الإلهية (4)
 يعد اصطلاح ومفهوم «الحاكمية» هو نقطة الانطلاق الكبرى والركيزة الأساسية فى فكر كل الجماعات الإسلامية التى انتهجت نهج التكفير والعنف؛ ولهذا نجد الكتابان يؤكدان علي أن جماعات (الإسلام السياسي) تتمسك بوجوب تطبيق فكرة (الحاكمية لله)، باعتبارها معلوماً من الدين بالضرورة، وتطالب الحاكم المسلم الاعتماد علي هذا المبدأ في الحكم وإخضاع جماهير المسلمين، وكذلك غير المسلمين في الدولة التي تعمل بالشريعة، لتطبيقاته وعدم التساهل في ذلك . أما النظم الديمقراطية المدنية الحديثة، فلا يقبلها هؤلاء بديلاً عن التطبيق الحرفي للأمر الإلهي المتمثل في النص والحديث، وحكم الله، ويعدونه كفراً وخروجاً عن قاعدة دين الله كله (39)؛ والهجوم يكون عنيفاً عادة علي من يدعو لتطبيق النظريات، والقيم والإيديولوجيات الغربية، ثم هم اليوم يقصون حاكمية الله، بجلتها، من يأتهم ويقيمون لأنفسهم أنظمة يسمونها (الرأسمالية) و(الاشتراكية) وما إليها، ويقيمون لأنفسهم أوضاعاً للحكم يسمونها (الديمقراطية) و(الديكتاتورية) وما إليها، ويخرجون بذلك عن قاعدة دين الله كله، إلي مثل جاهلية الإغريق والرومان وغيرهم، في اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم. أما النقاش الدائر بين النخب المدنية من جهة، والتي ترفض تطبيق هذا المبدأ، وتقول بالديمقراطية والشرائع، والقوانين الحديثة الوضعية، وبين منظري (الإسلام السياسي) من جهة أخري، فهو نزاع يحاول فيه الطرف الأول سلب المسلمين حقهم في الخضوع لله والاحتكام لأمره ولشرعه، وهو خروج عن الشرع وتعالي علي الله نفسه!، وعليه فالنزاع بيننا وبين العلمانيين ليس في مسألة من مسائل الفروع، بل هي قضية من قضايا الأصول، لأنها تتعلق بحاكمية الله تعالي، هل من حقه هز وجل أن يحكم خلقه ويأمرهم وينهاهم، ويحلل لهم، ويحرم عليهم أم لا؟ . العلمانيون يحرمونه من هذا الحق ويتعالون علي ربهم . وهناك رفض مطلق ومن منطلق ديني أصولي بحت لكل أفكار دعاة الديمقراطية والدولة المدنية، وهناك تكفير وتأليب وتهديد واضح بحقهم (40).
يعد اصطلاح ومفهوم «الحاكمية» هو نقطة الانطلاق الكبرى والركيزة الأساسية فى فكر كل الجماعات الإسلامية التى انتهجت نهج التكفير والعنف؛ ولهذا نجد الكتابان يؤكدان علي أن جماعات (الإسلام السياسي) تتمسك بوجوب تطبيق فكرة (الحاكمية لله)، باعتبارها معلوماً من الدين بالضرورة، وتطالب الحاكم المسلم الاعتماد علي هذا المبدأ في الحكم وإخضاع جماهير المسلمين، وكذلك غير المسلمين في الدولة التي تعمل بالشريعة، لتطبيقاته وعدم التساهل في ذلك . أما النظم الديمقراطية المدنية الحديثة، فلا يقبلها هؤلاء بديلاً عن التطبيق الحرفي للأمر الإلهي المتمثل في النص والحديث، وحكم الله، ويعدونه كفراً وخروجاً عن قاعدة دين الله كله (39)؛ والهجوم يكون عنيفاً عادة علي من يدعو لتطبيق النظريات، والقيم والإيديولوجيات الغربية، ثم هم اليوم يقصون حاكمية الله، بجلتها، من يأتهم ويقيمون لأنفسهم أنظمة يسمونها (الرأسمالية) و(الاشتراكية) وما إليها، ويقيمون لأنفسهم أوضاعاً للحكم يسمونها (الديمقراطية) و(الديكتاتورية) وما إليها، ويخرجون بذلك عن قاعدة دين الله كله، إلي مثل جاهلية الإغريق والرومان وغيرهم، في اصطناع أنظمة وأوضاع للحياة من عند أنفسهم. أما النقاش الدائر بين النخب المدنية من جهة، والتي ترفض تطبيق هذا المبدأ، وتقول بالديمقراطية والشرائع، والقوانين الحديثة الوضعية، وبين منظري (الإسلام السياسي) من جهة أخري، فهو نزاع يحاول فيه الطرف الأول سلب المسلمين حقهم في الخضوع لله والاحتكام لأمره ولشرعه، وهو خروج عن الشرع وتعالي علي الله نفسه!، وعليه فالنزاع بيننا وبين العلمانيين ليس في مسألة من مسائل الفروع، بل هي قضية من قضايا الأصول، لأنها تتعلق بحاكمية الله تعالي، هل من حقه هز وجل أن يحكم خلقه ويأمرهم وينهاهم، ويحلل لهم، ويحرم عليهم أم لا؟ . العلمانيون يحرمونه من هذا الحق ويتعالون علي ربهم . وهناك رفض مطلق ومن منطلق ديني أصولي بحت لكل أفكار دعاة الديمقراطية والدولة المدنية، وهناك تكفير وتأليب وتهديد واضح بحقهم (40).
وهنا يخلص المؤلفان هنا بالقول بأنه :"لا نقاش في قضية (الحاكمية لله) إذن، فهي من أهم دعائم (الإسلام السياسي) ودولته الدينية المنشودة، واي طعن فيها ينسف أساس هذا الإسلام الهادف لتحقيق دولة الشريعة والحاكمية . أما سيادة الأمة والمجتمع ومفاصل الدولة وكل السياسات وأمور الحياة، فلا يجب أن تكون للشعب كما في الديمقراطيات الحديثة، بل لا بد أن تخضع لحكم الله، وأن يكون هذا الحكم هو القانون الملزم العالي، والذي لا يعلي عليه، ومن هنا فإن السيادة العليا في الدولة الإسلامية يجب أن تكون للشرع وحده، حيث أن مفهوم السيادة الشعبية أو سيادة الأمة يطلق حريتها في تبني ما تشاء من قوانين من منطلق كونها السيادة العليا الآمرة في المجتمع، وهذا يخالف الأمر الجازم بوجوب الانقياد لأحكام مما ينفي عن الأمة بداهة أنها صاحبة السادة طالما أنها لا تستطيع بمقتضي إرادتها العليا أن تضع قانوناً ملزماً، أو تقرر أمراً يخرج عن نطاق ما رسمه الشارع" (41).
والفكر الأصولي ومدارس (الإسلام السياسي) في نظر الكاتبان ترفض كلها التشريعات الحديثة التي تقول بسيادة الشعب في الدولة وحقه في تشكيل صبغة إدارة هذه الدولة وكيفية تسيير شؤونها . هناك رفض مبدئي عقائدي للدولة الحديثة، وإصرار علي إحلال البديل الإسلامي محلها . وهذا البديل هو الشريعة وتطبيقاتها . وفكر (الحاكمية لله) وشريعته المتمثلة في القرآن والسنة، هي من يجب أن تكون الأساس في السيادة والخضوع والإدارة وتحديد معالم السياسات الداخلية والخارجية، وطريقة الحياة والعيش، لذلك فقد أكدت تعاليم الإسلام أن السيادة للشرع وليست للشعب الذي يمتلك فقط السلطان المتمثل في تولية الإمام، ومراقبته، ومحاسبته، وعزله، فالدولة لا تستمد سلطة التشريع من الأمة، لأنها لا تملكها أصلا، ومن لا يملك شيئاً، فليس بوسعه أن يملكه غيره بداهة، ولذلك فالفقه السياسي لم يتناول مشكلة السيادة في النظرية السياسية الإسلامية للشرع ؛ ووفقا لهذا الرأي الرافض للدولة المدنية الديمقراطية، والقائل بدولة الشريعة التي تستمد الحكم من النص، وتخضع لـ(حاكمية الله)، فإن طريقة الحكم ظلت في الدولة المدنية الديمقراطية، وهو ما أدي إلي ظهور مشاكل ومصاعب كبيرة في الحكم والإدارة، لم تعرفها الدول الحديثة ولا المجتمعات الخاضعة للديمقراطية ولحكم الأغلبية، كما أن الحكم لله، استعيض عنه كما يؤكد المؤلفان بنظام شوري ظل قاصراً ومتخلفا عن تمثيل الشعب، وبما أن الحاكمية لله وحده، فإن الإسلاميين يرفضون مبدأ الحاكمية الشعبية أو السيادة الشعبية، ولا يولون مبدأ الانتخاب إلا أهمية عرضية، لذا إن لم تظهر أية شخصية تفرض نفسها تلقائيا كأمير، فإن هذا الأخير يمكن أن ينتخبه مجلس شوري أو حتي بالاقتراع العام، وفي هذه الحالة لا تعكس كلا العمليتين حاكمية ما أو سيادة ما، بل مجرد مبدأ الإجماع . والشوري هي مشورة أو نصيحة بالمعني الدقيق للكلمة : ذلك أن الحاكمية أو السيادة تنبع من الله وحده . أما الجماعة فإن الحق الوحيد الذي تملكه هو حق إبداء النصح وتذكير أو تحذير الأمير باسم المبادئ والأصول والمبادئ الإلهية، ومساعدة الأمير علي اتخاذ قراره باسم هذه الأصول وأخيراً لوم الأمير إذا ابتعد عنها (42).
واستخلاصا نجد المؤلفان يؤكدان بأن (الإسلام السياسي) يعتبر مبدأ (الحاكمية) من أهم دعائم فكره، ويقوم برنامجه علي جعل الحكم لله عبر الخضوع التام للنص والشرع وترك نظم الحكم والإدارة والإيديولوجيات الوضعية واعتبارها كفرا من عمل البشر، لا يجب مقارنتها أبدا بالشريعة، أو الاحتكام إليها، ولا يجب ن تحل محل حاكمية الله، التي ينبغي أن يخضع لها بكل مظاهر العبودية والتسليم الكامل (43).. ويرفض (الإسلام السياسي) ومفكروه أي اجتهاد مع مبدأ (الحاكمية لله) الذي طوره “أبو الأعلى المودودي”، وبحث فيه كثيراً سيد قطب، وهم يقولون بأنه مبدا كلي لا يمكن تجزئته، كما طالب بذلك فرج فودة مثلا . ويعتبر دعاة (الإسلام السياسي) كل العصور الذهبية في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية وليدة التمسك بهذا الفكر، وبالتطبيق الحرفي للشريعة، ويعيدون انتصارات الأمة للدين وانكساراتها للبشر الذين رفضوا تطبيق الدين وركنوا لأمور وأيديولوجيات أخري . وفي كل الأحوال يظل (الإسلام السياسي) وكافة جماعاته متمسكا بمبدأ (الحاكمية لله)، ورافضا للمناهج الوضعية، وثمة البعض من جماعاته يعلن ذلك علانية، والبعض الآخر يمارس التقية للالتفاف علي القوانين السائدة والوصول إلي الحكم والسلطة (44).
وختاماً نقول بأن الاختلاف مع الكاتبين لا يفسد للود قضية، كما لا يحق لأحد أن يمنع الاختلاف في وجهة النظر ويحتكر الصواب لنفسه، ويمنع الحوار، ويقمع الحرية، ويستبد في الرأي أو الحكم، فهذا الجانب السياسي هو جانب بشري خالص أخذ مصداقيته من المنهج الرباني، والخطأ القاتل الذي وقع به المسلمون عندما دمجوا ما هو بشري بما هو رباني وسحبوا الصفة الربانية “أي في الدين” فلذا يجب تمييز المنهجية الربانية كونها قواعد ومقاصد ثابتة لحفظ الفرد والأسرة والمجتمع، عن السياسة الإنسانية المتعلقة بالجزئيات والمستجدات التي تتغير حسب تغيير الوقائع (45).
والسؤال الآن : ما معني الحاكمية لله وحده كما يتخبط الكاتبان في تحليلها ؟.. وهل يسير الدين علي قدمين ليمتنع الناس جميعاً عن ولاية الحاكمية، أو يكون الممثل لله في الحكم هو شخصية هذا المؤلفان الداعي، والذي ينكر وجدود الحكام، ويضع المعالم في الطريق للخروج على كل حاكم في الدنيا؟
إن القرآن نفسه يعترف بالحكام المسلمين، ويفرض لهم حق الطاعة علينا، كما يفرض عليهم العدل فينا، ويوجه الرعية دائماً إلى التعاون معهم؛ كما أن الإسلام نفسه لا يعتبر الحكام رسلا معصومين من الخطأ، بدل فرض لهم أخطاء تبددوا من بعضهم، وناشدهم أن يصححوا أخطاءهم بالرجوع إلى الله وسنة الرسول، وبالتشاور في الأمر مع أهل الرأي من المسلمين، فغريب جدا أن يقوم واحد، أو نفر من الناس، ويرسموا طريقا معوجا، ويسموه طريق الإسلام لا غير.. لا بد لاستقرار الحياة على أي وضع من أوضاعها من وجود حكام يتولون أمور الناس بالدين، وبالقوانين العادلة ومن الإسلامية :” إن الله يزع بالقرآن ما يزع بالقرآن”، فكيف يستقيم في عقل إنسان أن تقوم طليعة مزعومة لتجريد الحكام جميعاً من سلطانهم؟!! . وبين الحكام كثيرون يسيرون علي الجادة بقدر ما يتاح لهم من الوسائل، هذا شطط في الخيال، يجمح بمؤلفا الكتاب إلي الشذوذ من الأوضاع الصحيحة والتصورات المعقولة.
علاوة علي أن مفهوم الحاكمية الخاصة بالله عز وجل، هي حاكمية التشريع والتي تعول علي فكرة أن الحاكم هو الله تعالي الذي يقول هذا حلال فافعلوه، وهذا حرام فلا تفعلوه، وفي هذا تحرر كامل من عبودية الإنسان للإنسان، إلي العبودية لله سبحانه وتعالي .. كما أن لفظ ” الحاكمية” لفظ مشترك يطلق علي كثيرين مختلفين، مثل كلمة ” عين” التي تطلق علي الجارحة، وعلي البئر، وعلي النقود وعلي الجاسوس، ومثلها كلمة حاكم فإنها كما تطلق علي الله تطلق علي الإنسان الذي من حقه أن يحكم.
وكما اتضحا من كلام المؤلفان بأن فكرة الحاكمية هي فكرة بدأت منذ الخوارج، الذين أرغموا سيدنا “علياً” رضي الله علي قبول التحكيم، بعد اقترابهم من الهزيمة، ثن اشقوا عنه، وقالوا الحكم لله، وكفروا الصحابة وسيدنا عليا وقتلوه، وبعد أن اندثرت فكرة الحاكمية عادت مرة أخري علي يد عالم في الهند اسمه أبو الأعلى المودودي الذي كان يعيش في عصر سيطرة الإنجليز علي الهند، واتبعها ليحارب بها الإنجليز، ثم ظهرت مرة أخري علي سيد قطب، وبعده الجماعات الإرهابية التي ظهرت بعد 1965م واعتبرت أن مجلس الشعب المصر كفر، والانتخابات كفر، والديمقراطية كفر، لأنها تفتح المجال لحكم البشر، وبالتالي يكون المجتمع كافراً، ومن يحكم به كافر، ومن يرضي بهم دون أن يكفرهم فهو كافر أيضاً.
وقد رأينا من خلال هذا الكتاب الذي بين أيدينا كيف أعجب سيد قطب بكتابات معاصره وصديقه أبي الأعلى المودودي أشد الإعجاب لدرجة الانبهار، وانطلق منه إلي أن الحاكمية لله ؛ لأن الألوهية هي الحاكمية، وكل البشر الذين يعطون لأنفسهم الحق في إصدار قوانين أو تشريعات، أو أي تنظيمات اجتماعية يخرجون من الحاكمية الإلهية إلي الحاكمية البشرية، وأصبح عنده أن البشر محكومون بقوانين غير قوانين الله – سبحانه وتعالي- وبأنظمة لا ترضي عنها شريعة الله، ولم يأذن بها الله، وبالتالي هذا المجتمع مجتمع مشرك وكافر ويعبد غير الله ؛ لأن العبادة طاعة الله في حاكميته.
إن هذه المفاهيم التي جاء بها سيد قطب ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن للأسف الشديد وجدت من يقف وراءها من جماعات الإسلام السياسي الذين ساروا علي هذا المنهج ؛ علاوة علي أنه لا يلزم الحاكم من تطبيق الشريعة إلا ما يطبقه وتطبقه الظروف الموجودة ؛ لكنه لا يُعالج ضرر بضرر مساو له، أو بضرر أكبر، كما أنه يجب عدم الخلط بين الاعتقاد بما حكم الله، وبين التطبيق بما حكم الله، فالتطبيق منوط به البشر، وطالما وجد العدل فالحكم متوافق مع الإسلام، ولذلك فإن الأمة الإسلامية لم تستمر في تاريخها بنظام حكم واحد، أو شكل واحد .
ولذلك فمفهوم ” الحاكمية” ليس قاصرا علي الله تعالي، بل هو أمر مشترك بين الله وبين البشر، والقرآن الكريم في آيات كثيرة منه جعل من الإنسان حكماً وحاكماً وأسند إليه الحكم، والحكم لله هو حكم تشريع، وهناك مسائل كثيرة وصف القرآن فيها الإنسان بأنه حاكم، ومن يقولون إن الحكم لله فقط، وليس للبشر، فهؤلاء يأخذون بآية،ويضربون صفحاً عن بقية الآيات التي يجب أن تُفهم في إطارها وسياقها، كما أن مفهوم الحاكمية بالنسبة لله تعالي يختلف عن مفهوم الحاكمية بالنسية للبشر، فحاكمية البشر حاكمية تصرف، وحاكمية تشريعات جديدة، مرتبطة بالقضاء الإسلامي الأخلاقي والتشريعي، لكن حاكمية الله تعالي حاكمية حلال وحرام وحاكمية عقيدة.
الأستاذ الدكتور محمود محمد علي
رئيس قسم الفلسفة وعضو مركز دراسات المستقبل – جامعة أسيوط
..............
39- الأستاذ طارق حمو والأستاذ صلاح علي نيوف : المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
40- المصدر نفسه، ص 51.
41- المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
42-المصدر نفسه، والصفحة نفسها.
43-المصدر نفسه، ص 58.
44- المصدر نفسه، ص 59.
45-أحمد شقيرات: الألوهية والحاكمية، هدي الإسلام، وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية، المجلد 56، العدد الأول، 2012،، ص 13