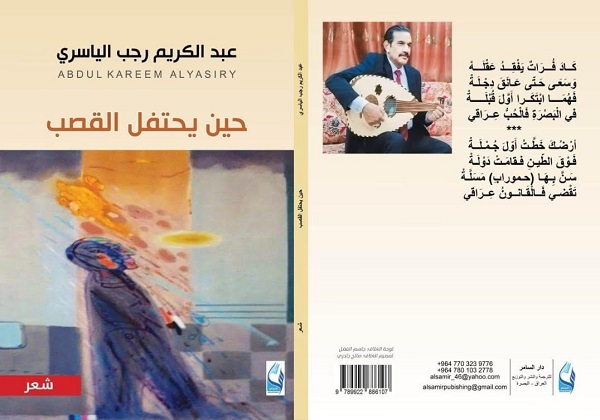شهادات ومذكرات
عبد الحسين شعبان: براغ.. وثمّة عـشـق!! (2-3)
![]() مدن أحببتها وعشت تفاصيل عشقها ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، سواء كنت قريباً منها أو بعيداً عنها:
مدن أحببتها وعشت تفاصيل عشقها ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، سواء كنت قريباً منها أو بعيداً عنها:
النجف مسقط رأسي،
وحسب الروائي محمود البياتي، – عاشق براغ الآخر –: كانت بغداد مسقط رأسه، أما براغ فمسقط حبّه.
وبغداد، حيث النّشأة والتكوّن والأسئلة الأولى.
وبراغ، حيث الاكتشاف والدهشة والقلق المعرفي.
ودمشق، حيث التنوّع والاغتناء.
وبيروت، الأفق واللاّحدود.
وكل تلك المدن مرتبطة بنساء كثيرات، وكل واحدة منهنّ تتلوّن بألوان قوس قزح المدينة وتستحم في نهرها أو بحرها وتتعطّر بعطرها، ومثلما تقرأ المدينة، تكون هي قد قرأتك، من خلال المرأة التي تضفي عليك شيئاً منها، حيث الدهشة الأولى وشاطىء النّهر والأحلام والشوارع الخلفية والزهور والياسمين.
من عاش في براغ أو استمهلته بالبقاء ولم يعشقها، فلا قلب له، وبراغ لها حقوق علينا، وهل للمدن حقوق؟ نعم.
الحق في الأمل
والحق في العشق
والحق في الجمال
والحق في الحلم
والحق في السلام
والحق في البيئة،
إضافة إلى منظومة الحقوق الإنسانية الكاملة. إنها حقوق السعادة، وأعني حق "التأنسن" الإنساني، أي "أنسنة" ما في الإنسان، بمعنى جعله أكثر جمالاً وأكثر عدلاً وأكثر حرّية وأكثر شراكة وأكثر تسامحاً.
بيني وبين براغ علاقة سرّية فيها الكثير من البوح، حتى وإنْ كان صامتاً أحياناً، بعضه يأتي مثل إشارات، وآخر أقرب إلى إيحاءات وثالث يشبه إيماءات ورابع فيه ثمة تلميحات وخامس يعطيك دلالات أقرب إلى التصريح مثل "إعلان حالة حب"، وهو ما اقتفيت إثره.
كلّما تبتعد عن المعشوقة، وتشتاق إليها وتقترب منها، وكلّما تقترب منها تكتوي بنار الشوق أيضاً، فالشوق معها والشوق وأنت بعيد أو غائب عنها. وحين نكتب عن براغ، تخطّها يراعنا لغة أقرب إلى لغة الثلج والمطر والريح في الشتاء، ولغة الغابات في الخريف، ولغة الزّهور في الربيع، ولغة الضوء في الصّيف.
هناك شيفرة في غاية الغموض تجمعني مع براغ، هي في أحد وجوهها لغز باهر لا أستطيع حلّه، وفي وجه آخر سرٌّ مقدّس أحتفظ فيه لنفسي، كأنّه الشعر، والشعر احتفاء بالحياة وبالوجود.
التساؤل جاءني بعد المعاينة والكشف، فزعزع شيئاً من إيماني التقليدي وصارعني، حتى انتصر الإيمان بالعقل، والإيمان بالسؤال، والإيمان بالنقد، والإيمان بالمعرفة، والإيمان بالرأي، والإيمان بالاستقلالية، والإيمان بالاستعداد لتحمّل الخطأ، أي الإيمان بالاجتهاد. والإيمان بدون العقل تعصّب، وهذا يقود إلى تطرّف، ناهيك عمّا فيه من تبعية وروتينية وترهّل وتقليدية وإذعان، لأنه سيكون أقرب إلى الجهل والاستكانة وعدم التفكير والخضوع.
والإيمان دون الضمير يقود في الكثير من الأحيان إلى عصبوية وانحياز مسبق وتأييد أو رفض أعمى، بما فيه أحياناً من تبرير للانتهاكات والتجاوزات، قد يصل إلى الدفاع عن الظّلم، سواء بزعم امتلاك الحقيقة وادّعاء الأفضليات، وإخضاع كل شيء لتحقيق الأهداف المرسومة، وقد يقود إلى تدنيس الآخر، فالآخر سواء كان عدوّاً أو خصماً أو حتى من الموقع ذاته، لكنه يمثل وجهة نظر مغايرة، فإنه سيكون مخالفاً ومعارضاً أو حتى مشبوهاً، أو مرذولاً، في حين ننسب إلى "النحن" وللجماعة التي نتغنّى بالانتساب إليها كل الفضائل والمقدّسات والشّرف والإيثار.
ومهما كانت المبرّرات والمزاعم سواء بحسن نيّة أو بسوء نيّة، فالنتيجة واحدة، هي الاستقواء على الإنسان، والاستعلاء على الآخر، "المختلف" واستصغار شأنه، حتى وإنْ قاد ذلك إلى مجافاة الحقيقة والافتراق عن الضمير الذي هو الخط الفاصل بين الإيمانية العمياء والتفكيرية التساؤلية، لأن التفكير يأخذ باحتمال الخطأ والصّواب، فهو اجتهاد إنساني، وللمجتهد حسنتان إنْ أصاب، وإن أخطأ فله حسنة الاجتهاد، كما قال جدّنا الأقدم الإمام الشافعي.
وإذا كان رأسي مستودعاً للقلق، فإن براغ ألهمتني حباً صافياً ورقيقاً غلّف روحي بوهج لؤلؤي، وهكذا كان الضوء والهدوء ملازمين لي في نافورة العشق المتدفق، فالهدوء يوصلك، أو لنقلْ يفتح الأفق أمامك للسؤال والبحث عن الحقيقة حيث اللاّنهايات، والضوء يضعك في اتصال حميم مع الحقيقة في إطار عذوبة غامضة ومضنية.
و(كما يقول الجواهري) بخصوص الضمير:
ومن لم يخفْ عقب الضمير / فمن سـواه لـن يـخافا
الفارق كبير بين العارف وغير العارف، بين المؤمن بالعقل وبين المؤمن بدونه، وصدق ما جاء في القرآن الكريم (في سورة الزُّمر): (... قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون...؟)، فأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك، وذلك معيار التبصّر والتطهّر.
إذا كانت المعرفة شقاء وقلق وصراع، فإن الجهل بؤس وتخلف وخنوع، والفارق كبير بين البؤس والشقاء، وتلك مفارقة المؤمن العارف والمؤمن غير العارف، والمعرفة تأتي بالهمّ والأرق واللاّقناعة واللاّيقين واللاّاستقرار أحياناً، لكنها تفسح أمامك في المجال لطريق التفكير والسؤال بحثاً عن الحقيقة، في حين يأتي بك الجهل إلى التّسليم بما هو قائم أو رفضه ليس بالبعد أو القرب من الحقيقة، بل لأسباب تتعلّق بالجمود وعدم التفكير، ويكتفي البعض بتبرير "السير مع القطيع والهتاف مع الجميع"، خشية من العزلة، أي التصرّف بسلوك الجماعة التي ينتمي إليها دون تفكير، وإلاّ سيكون وحيداً خارج "مجتمع المؤمنين"، فذلك طريق "السلامة" بالنسبة إليه، وهو الذي اعتبره الجواهري "أرذل السبل"، وتلك لحظة تأمّل وتفكّر وتذكّر.
* * *
كل شيء في براغ معمِّر، وحتى لو ترك الزمن آثاره، يبقى ثمة خلود، للبشر والحجر، والشجر، وكل ما أنتجه الإنسان، تتم المحافظة عليه. تلك سمة حضارية وتقدمية، بالشعوب والأمم التي تحترم نفسها وتحترم تاريخها وتحترم مبدعيها. فهل نستطيع استبدال الشقاء بالبؤس، وأيّهما سيكون مطهّراً للنفس، وعلى أي الجانبين يقف الوهم والعذاب؟ وحسب ابن خلدون، فالخراب بالظلم، والعمران بالعدل، وحتى وإنْ كان الأمر يحمل بعض التناقض، ولكن لحين، فسرعان ما يتّخذ المسار أحد الخيارين.
غالباً ما كان السؤال يكبر: أيّهما نقدّم الإنسان أم الفكر؟ وهو السؤال الفلسفي التاريخي والتقليدي حول أيّهما أسبق: المادة أم الوعي؟ وفي حين يذهب أصحاب المذهب المثالي إلى اعتبار الفكر يتقدّم على المادة، يقول الماديون لا سيّما الجدليون، إن وجود المادة يسبق الفكر، وهذا الأخير انعكاس للواقع.
وقد أخضعنا الإنسان لتجارب وعرضنّاه لتحديّات بزعم إثبات صحة الفكر، علماً أن لا فكر صحيح، دون البراكسيس، وحتى لو سوّغ آيديولوجيون من شتى الأصناف وفلاسفة ورجال دين، أن هدفهم خدمة الإنسان والارتقاء به إلى حيث السعادة والرفاه في الدنيا والآخرة، لكن المعيار يظل هو الإنسان ابتداءً وانتهاءً.
وبقدر ما تكون الغاية شريفة، فالوسيلة ينبغي أن تكون كذلك، لأنه لا انفصال بينهما، مثلما لا تنفصل البذرة عن الشجرة حسب المهاتما غاندي، فإننا لاحظنا وشهدنا كيف انهارت أنظمة كانت مثل القلاع المحصّنة على حد تعبير جون بول سارتر لا يمكن اقتحامها من الخارج، لكنها في حقيقة الأمر، كانت خاوية وهشّة من الداخل، حتى ظهرت وكأنها صُنعت من ورق باستعارة تعبير ماوتسي تونغ، عندما كان يصف الأنظمة الإمبريالية بأنها "نمور من ورق"، فالغاية الشريفة تتطلب وسيلة شريفة وهذه الأخيرة هي جزء لا يتجزأ من الغاية ذاتها.
لقد انهارت جميع التبريرات والحجج الواحدة بعد الأخرى، تلك التي قدّمت ما هو طارىء على ما هو استراتيجي، وما هو استثناء على ما هو قاعدة، وما هو مصلحي على ما هو إنساني، ولم يعد الحديث عن العدوّ الخارجي وحده مقنعاً، وإنْ كان موجوداً ومؤثراً، لكن العدوّ كان يتربّع في الداخل، وعلى أعلى المواقع. وهل يستطيع عدوّ خارجي أن يتمكّن من تحطيم تجارب وإطاحة أنظمة، لولا وجود العدوّ الداخلي المتلبّس بلبوس شتى، لتبرير نهج هيمنته وانفراده وتسلّطه، وبالتالي فشله، دون أن يعني التقليل من شأن العدوّ الخارجي؟
أليس في الأمر ثمة استغفال؟ وأكثر من ذلك حين يبرّر محق الإنسان لكي تنتصر "الآيديولوجيا"، تلك التي سادت كذريعة باعتبارها "الهادي" و"المرشد"، في حين أنها شدّت الإنسان بأكثر من وثاق وقيّدته بأكثر من قيد وأغرقته في بحرها، وهكذا تعطل العقل التساؤلي النقدي ليحلّ محلّه العقل التبشيري الإيماني السكوني، وننسى أن الإنسان هو الأساس، وهو مقياس كل شيء، حسب الفيلسوف الإغريقي بروتاغوراس، وصدق كارل ماركس حين قال: الإنسان أثمن رأسمال. ومهما قيل من تبريرات أو حجج لانتهاك كرامة الإنسان، تحت أي سبب كان، فإنها لا تصمد أمام حقيقة سمو الإنسان، الذي لأجله قامت الأديان وتبلورت الفلسفات وتأسست النظريات، إنه الهدف وينبغي أن يكون الوسيلة.
في براغ: الكشف، والفيض، والإلهام
هناك تجد نقطة البداية التي توصلك إلى نقطة النهاية، لأنها تقوم على بُنية دائرية، فثمة مركز وثمة أطراف، ومن حيث تبدأ تصل إلى النهاية، تصل إلى الذروة والتّحقق، وتلك علاقة العلّة بالمعلول، والعاشق بالمعشوق!
لمجرد سماع اسم براغ سيكون أمامك:
يوليوس فوتشيك الذي خاطب الغزاة الألمان وهم يريدون مساومته قائلاً لهم: ستكون براغ أجمل بدونكم، وهم يحاولون من على قلعة براغ أن يستثيروا غرائزه الإنسانية، كي يتنازل، لكنه اختار طريق الشرف والتضحية، دفاعاً عن وطنه وأفكاره، وهو القيادي الصحافي ورئيس تحرير صحيفة الرودي برافو "الحقيقة الحمراء". نستذكر "سكّة الغابات" والمقاومة، واللحن الذي يردّده البراغيون (خلال الحرب العالمية الأولى): نحن "البراغيون" لن نسلّم براغ.
ولا ننسى كيف قرأنا فرانز كافكا: المسخ، والمحاكمة، والقلعة؟ وكيف استهوانا هذا الروائي المبدع ورائد الرواية الكابوسية؟ على الرغم من محاولة التقليل من شأنه بزعم فردانيته وسوداويته المخالفة للواقعية الاشتراكية "الجدانوفية". وكنّا في صراع مستمر بين ما هو سائد وما هي رغباتنا ومشاعرنا، والإنسان في داخلنا.
لم نكن نستطع – أقصد من داهمتهم عاصفة الشّك والسّؤال وخرق الولاء والطاعة العمياء – أن نهضم لماذا يهمّش كاتباً بهذا الوزن؟ لذلك أقبلنا على قراءته كجزء من الرفض التساؤلي والشك الوجودي والتمرّد الأول، والشغب "المشاكس"!
كان كافكا من جلاّس مقهى سلافيا Slavia الذي كنّا نرتاده في أوائل السبعينات من القرن الماضي، أي بعد نحو ستة إلى سبعة عقود على ارتياد كافكا. والمقهى الذي افتتح في العام 1863، يطلّ على نهر الفلتافا ويقابل مبنى المسرح الوطني "الشهير"، ويواجه في الوقت نفسه قلعة براغ التي تنتصب فوق الجبل، هو قريب من الجسر الحجري المعروف باسم "جسر جارلس"، وهو من أقدم جسور أوروبا.
كما كان من رواّد المقهى الشاعر والكاتب راينر ماريا ريلكه البوهيمي النمساوي الذي كتب بالألمانية والمولود في براغ والمتوفي في مونترو في سويسرا، والموسيقار دفورجاك والموسيقارة سميتانا، والشاعر ياروسلاف سيفرت (الحائز على جائزة نوبل العام 1984)، وطائفة من الفنانين والفنانات والأدباء والمسرحيين، وكان يترددّ عليه عندما يزور براغ الشاعر التركي ناظم حكمت، كما كان الشاعر الجواهري يرتاده أيضاً، وخصوصاً في الثمانينات، ومن رواده المشهورين الكاتب المسرحي فاتسلاف هافل الذي أصبح رئيساً للجمهورية، بعد التغييرات التي حصلت في خريف العام 1989.
حين أستحضر براغ بعد غياب، أستمتع بقراءة ميلان كونديرا: الذي لجأ إلى فرنسا العام 1975 وأخذ يكتب بلغتها لاحقاً: خفّة الكائن التي لا تحتمل، الضحك والنّسيان، البطء، فالس الوداع، فأية مواهب طُردت وأية كفاءات هاجرت وأية مظالم ارتكبت؟
قرأت براغ الأخرى من خلاله، براغ التحتانية وليس براغ الفوقانية، براغ السرّية وليس براغ العلنية، براغ الشعبية، وليس براغ الرسمية، وكنتُ كثير الفضول لمعرفة ما يدور في الخفاء. وبعد إنهاء دراستي وقبل مغادرتي براغ العام 1977، كنت قد قرأت Charter 77. تداولته وتناقلته مع صديقات وأصدقاء بحذر شديد، وقد لا أكون متفقاً مع كل ما جاء فيه، خصوصاً بنزع روح الاشتراكية، لكنني كنت أرغب في معرفة خفايا حركة تمرّد واحتجاج، كان هناك الكثير من التعتيم عليها، بل وازدرائها لدرجة اتّهام أي صوت معارض أو مختلف بشتى التهم المسيئة، ودون تمييز أحياناً، في حين كان الغرب كثير التهويل فيها، وهو ما كانت إذاعة أوروبا الحرّة التي تشرف عليها الـ CIA تبث عنها في إطار دعاية سوداء وصراع آيديولوجي إلغائي، وفقاً لنظرية "بناء الجسور" التي صمّمها تروست الأدمغة (مجمّع العقول) الذي يعمل بمعيّة الرؤساء الأمريكان لتحطيم البلدان الاشتراكية من داخلها.
لم تكن الأخطاء والخطايا مخفية، بل كانت مظاهرها تفاجئك حتى إذا كنت عابراً، فما بالك حين تعيش وتعرف وتتكوّن لك صداقات. هكذا سقطت التجربة مثل "التفاحة الناضجة" بالأحضان، وكانت قد تركت تأثيرات فكرية وعملية على الحركة الاشتراكية الماركسية بمجملها منذ وقت مبكر، وأعني بذلك الحراك الذي عرف باسم "ربيع براغ" الذي أثار انشغالاً عالمياً (العام 1968) وآراء متعارضة ومواقف متناقضة.
وكنت قد كتبت قبل عقدين ونيّف من الزمان عن تأثيراتها الشخصية عليّ، تلك التي ترافقت مع عدوان الخامس من يونيو (حزيران) العام 1967، وما تركه من مرارات وخيبات، وهو ما أعدت قراءته في أوقات لاحقة، خصوصاً فكرة الاشتراكية ذات الوجه الإنساني، من منظورين نقديين: الأول من منظور التوظيف الإمبريالي الغربي، والثاني من منظور "التدخل" العسكري والسياسي السوفييتي، والمواقف المتطابقة معه، بل والمغالية أحياناً في تبنّي توجهاته، ناهيك عما له علاقة بالحرّيات، ولا سيّما حرّية التعبير، إضافة إلى بطء عملية التنمية وتعثّرها والاختناقات الاقتصادية التي صاحبتها، ولعلّ تلك رؤية ثالثة أخذت ببعضها أحزاب شيوعية واشتراكية أوروبية، وهو ما تحدثت عنه في محاضرة لي في لندن، بديوان الكوفة، ولاحقاً بكرّاس صدر لي بعنوان: بعيداً عن أعين الرقيب – بين الثقافة والسياسة 1994.
ولعلّ التوقّف عند المعلن والمستتر والظاهر والمخفي، ولا سيّما بعد التغيير، يعطينا تصوّراً أكثر واقعية عن ازدواجية "الإنسان" في ظل الأنظمة الشمولية تلك، التي لا تترك مساحة فارغة إلاّ وحاولت أن تسدّها، سواء بطبعتها الأصلية أو بنسختها الفرعية العالمثالثية بما فيها العربية، بشكل عام والعراقية بشكل خاص.
نستذكر بعض دراسات الاستشراق: مثل بيتراجيك، الذي ترجم القرآن إلى اللغة التشيكية، ومعهد الاستشراق، ونأسف لماذا لم نستثمر ذلك، بما كان لدينا من طاقات وإمكانات كعرب وكماركسيين (ماديين جدليين). وقد اكتفينا بما هو سائد ورسمي من العلاقات، وبالنتيجة حتى العلاقات القديمة لم نستثمرها على نحو جيد، وهو ما كان حديثي مع رفاق عراقيين وفلسطينيين وسوريين.
نعيد اسم كارل غوت المغني الجميل والصوت العذب، رحل إلى المنفى ثم عاد. من يستمع إليه يغنّي يشعر أن براغ كلها أصبحت مُلكه، بل هو أصبح مثل طائر يحلّق فوقها ليبسط جناحيه على أبراجها الذهبية وهضابها وتلالها المكتظة ونهرها الفلتافا العريض والمتدرج وجسورها الممتدة وحاناتها الأنيقة.
نستحضر الموسيقار دفورجاك وسمفونياته، وخصوصاً سمفونيته التاسعة "العالم الجديد"، وأسماء أخرى لسمفونياته التي أبدعها حيث وُلد في بوهيميا التابعة حينها لإمبراطورية النمسا 1841 ودرس في براغ، وقدّم أعماله في لندن ونيويورك وبلدان أخرى، وتوفي في العام 1904، تاركاً وراءه تراثاً موسيقياً ضخماً، هو امتداد وتواصل "لِـ" و"مع" موسيقاريين كبار مثل بتهوفن وموزارت وباخ وتشايكوفسكي وآرام ختشادوريان، وغيرهم.